السَّبيل إلى الفلسفة لغير الفلاسفة
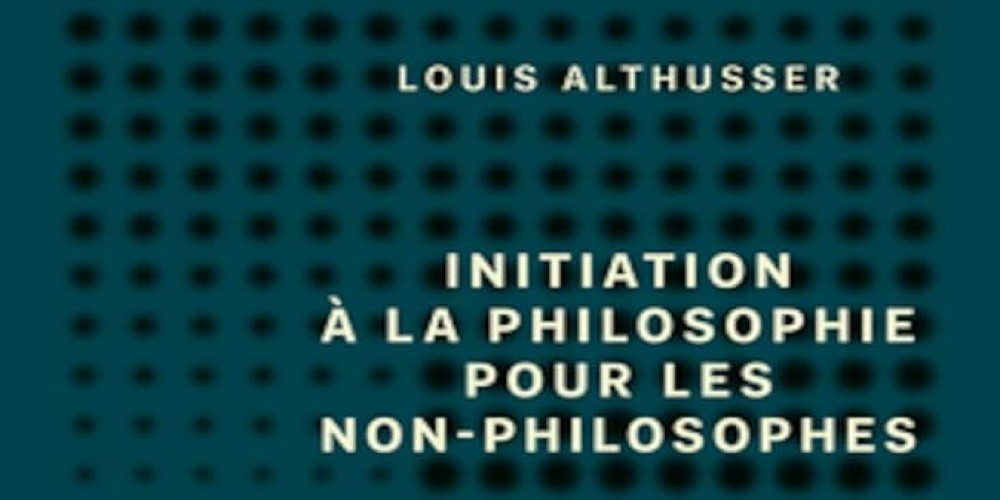
* لويس ألتوسير/ترجمة: عبد الوهاب البراهمي.
” هل من الصدفة حقّا أن تكون الفلسفة فعلا، مرتبطة إلى هذا الحدّ بتدريسها، وبأولئك الذين يدرّسونها؟ وهل من الصدفة أن لا تصلح الفلسفة سوى لتعليمها الخاص فحسب، ولا لشيء آخر؟ وإذا كانت لا تصلح فقط إلا لتعليمها الخاص، فما يعني ذلك يا ترى؟”( ل. ألتوسير)
“في أي معنى يستقيم القول بأنّ: كل إنسان فيلسوف”؟
” ماذا يصنع إذن أستاذ الفلسفة؟ إنه يعلّم تلاميذه التفلسف، بتأويل النصوص الكبرى أمامهم أو المؤلفين الكبار للفلسفة، بان يلهمهم الرغبة في التفلسف. وإذا ما التمس في نفسه قوّة، أمكنه أن يتقدّم درجة ويمرّ إلى التأمّل الشخصي، أي إلى مخطّط فلسفة أصيلة.”(ل. ألتوسير)
****
ماذا يقول ” غير الفلاسفة”؟
يتوجَّه هذا الكتاب إلى كلّ القرّاء الذين يعتبرون أنفسهم، أصابوا أم أخطأوا، من ” غير الفلاسفة”، والذين يريدون مع ذلك أن يكوّنوا فكرة عن الفلسفة. ماذا يقول ” غير الفلاسفة”؟ العامل والفلاح والأجير:” لا نعرف شيئا من الفلسفة، لم تخلق لأجلنا. إنما هي لمثقفين مختصين. إنَّها جدّ صعبة. ولا أحد حدّثنا عنها قط: لقد غادرنا المدرسة قبل أن نتعلمها.” بينما يقول الإطار والموظّف والطبيب، الخ:” نعم تابعنا درس الفلسفة. لكنَّه مفرط في التجريد. والأستاذ عارف بصنعته، لكنه كان غامضا. فلم نحتفظ بشيء منها. وبالمناسبة، فيم تصلح الفلسفة؟ ” ويقول آخر:” عفوا! لقد اهتممت بالفلسفة كثيرا. يجب أن نقول بأنه كان لنا أستاذ أخّاذ. وكنا نفهم الفلسفة بصحبته. لكن، انصرفت منذ ذلك الحين إلى تحصيل لقمة العيش ماذا نفعل إذن، ليس لليوم سوى 24 ساعة: لقد فقدت صلتي بها. مع الأسف. ” وإذا ما سألتهم جميعا:” لكن عندئذ، بما أنكم لا تعتبرون أنفسكم فلاسفة، فمن من الناس في نظركم من يستحقّ اسم فيلسوف؟”، فسيجيبون، بصوت واحد:” إنما هم أساتذة الفلسفة!”. وهذا عين الصواب: فبخلاف الناس الذين، لأسباب شخصية، أي من أجل متعتهم أو لنفع ما، يستمرّون في القراءة لكتّاب فلسفة، في” ممارسة الفلسفة”، فإنّ من يستحقّ اسم فيلسوف هم فعلا أساتذة الفلسفة. يطرح هذا الأمر بالطبع سؤالا أول، أو بالأحرى أثنين.
- هل حقّا من الصدفة أن تكون الفلسفة فعلا، مرتبطة إلى هذا الحدّ بتدريسها، وبأولئك الذين يدرّسونها؟ يجب أن نعتقد أن الأمر ليس كذلك، إذ في النهاية، لا يعود هذا الزواج فلسفة – تعليم إلى أقسام الفلسفة عندنا، لا يعود إلى الأمس: فمنذ بدايات الفلسفة، كان أفلاطون يدرّس الفلسفة، وأرسطو يدرس الفلسفة… وإذا كانت هذه الزيجة فلسفة – تعليم (تدريس) ليست نتاج الصدفة، فهي تعبّر عن.ضرورة خفيّة. وسنحاول اكتشافها.
2. لنذهب إلى أبعد من ذلك. بما أن الفلسفة في الظاهر لا تصلح لشيء مهمّ في الحياة العملية، وبما أنها لا تنتج لا معارف ولا تطبيقات، فيمكننا التساؤل؛ لكن لم تصلح الفلسفة؟ ويمكننا حتى أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل من الصدفة أن لا تصلح الفلسفة سوى لتعليمها الخاص فحسب، ولا لشيء آخر؟ وإذا كانت لا تصلح فقط إلا لتعليمها الخاص، فما يعني ذلك يا ترى؟ سنحاول الإجابة عن هذا السؤال الصعب. ترون كيف تسير الأمور مع الفلسفة. فيكفي أن نفكّر في أقلّ وجوهها( وهنا كون الفلاسفة هم جميعهم تقريبا أساتذة فلسفة)، حتى تنبجس، دون أن تترك لنا الفرصة لاستعادة أنفاسنا، أسئلة غير منتظرة ومدهشة. وقد قدّت هذه الأسئلة على نحوٍ يُلزمنا بطرحها دون أن نمتلك وسائل الإجابة عنها: فحتى نجيب عنها علينا القيام بمنعطف طويل. وهذا المنعطف ليس شيئا آخر سوى الفلسفة ذاتها. على القارئ إذن أن يتحلّى بالصبر. فالصبر فضيلة فلسفية. لنلق نظرة خاطفة، حتى نتقدّم، على هؤلاء البشر: أساتذة الفلسفة. لهم أزواج وزوجات مثلي ومثلك، وأطفال إذا ما رغبوا في ذلك. يأكلون وينامون يتنفسون ويموتون مثل الجميع. يمكن أن يحبوّا الموسيقى والرياضة وممارسة الفلسفة أو لا. اتفقنا: فليس هذا ما يجعلهم فلاسفة.
إنّ ما يجعلهم كذلك، هو أنهم يعيشون في عالم لوحده، في عالم مغلق: مكوّن من أعمال كبرى في تاريخ الفلسفة. ويبدو أن ليس لهذا العالم من خارج. فهم يحيون مع أفلاطون وديكارت وكانط وهيجل وهوسرل ومع هيدجر، الخ. ماذا يصنعون؟ أتحدّث عن أفضلهم بالطبع: يقرؤون ويعيدون قراءة مؤلفات كبار الكتاب، ويعيدون قراءتها باستمرار، بمقارنتها فيما بينها، وبتمييزها عن بعضها البعض عبر التاريخ، لفهمها جيّدا. إنه لأمرٌ مدهش مع ذلك، هذه الإعادة الدائمة للقراءة. فما من أستاذ رياضيات أو فيزياء الخ قطّ، سيعيد باستمرار قراءة كتاب في الرياضيات أو الفيزياء، فلن ” يجترّوها” على هذا النحو. إنهم يقدمون المعارف، ويفسرون أو يبرهنون، نقطة وانتهى الأمر، ولن نعود إلى ذلك. ومع ذلك فإنّ ممارسة الفلسفة هي العود اللانهائي إلى النصوص. يعرف الفيلسوف ذلك جيدا، و فوق هذا يفسّر لك لماذا! هو أن الأثر فلسفي لا يفصح عن معناه، عن رسالته، في قراءة واحدة؛ وهو مفعم بالمعنى، وبالطبيعة نبع لا ينفد ولانهائي، وله دوما قول جديد بالنسبة إلى من يعرف كيف يؤوّله. ليست ممارسة الفلسفة مجرد قراءة، وليست برهنة. إنما هي تأويل، تساؤل وتأمل: إنها تريد أن تقوّل الأعمال الكبرى ما تريد قوله، أو تقدر على قوله، وفي الحقيقة الإشكالية التي تحملها أو بالأحرى التي تشير، بصمت، صوبها. وبالنتيجة: هذا العالم بلا خارج هو عالم بلا تاريخ. مكوّن من مجموع الأعمال الكبرى التي كرّسها التاريخ، رغم كونه عالم بلا تاريخ. وذلك بدليل أن: الفيلسوف يستدعي، لتأويل فقرة من كانط، أفلاطون كما هوسرل، كما لو لم يكن هناك 23 قرنا بين الأوّلَين وقرنا ونصف بين الأول والأخير، كما لو من غير المهمّ وجود السابق واللاحق. فجميع الفلاسفة، بالنسبة إلى الفيلسوف هم معاصرين. يلبّون نداء بعضهم بعضا من خلال الصدى، لأنهم لا يجيبون في الأصل إلاّ عن نفس الأسئلة، التي تصنع الفلسفة. من هنا كانت الأطروحة المشهورة ” الفلسفة أبدية”.
ومثلما نرى، فحتى يكون من الممكن إعادة القراءة الدائمة، وفعل التأمل غير المنقطع، يجب على الفلسفة أن تكون في نفس الوقت لامتناهية ( أي ما “تقوله” لا ينضب) وأبدية ( كل الفلسفة كامنة في كلّ فلسفة). تلك هي قاعدة ممارسة الفلاسفة، أريد آن أقول أساتذة الفلسفة. وإذا ما قلتم لهم، في هذه الظروف، إنهم يعلمون الفلسفة، فخذوا حذركم! إذ سيلفتون النظر إلى أنهم لا يعلمونها مثل الأساتذة الآخرين، الذين يحملون لتلاميذهم معارف للحفظ، أي نتائج علمية ( مؤقتا) نهائية. فالفلسفة لا تُتعلّم بالنسبة إلى أستاذ الفلسفة الذي فهم جيّدا كانط. ولكن ماذا يصنع إذن أستاذ الفلسفة؟ إنه يعلّم تلاميذه التفلسف، بتأويل النصوص الكبرى أمامهم أو المؤلفين الكبار للفلسفة، بان يلهمهم الرغبة في التفلسف ( يمكننا أن نترجم تقريبا هكذا الكلمة الإغريقية فيلو- صوفيا philo-sophia). وإذا ما التمس في نفسه قوّة أكثر، أمكنه أن يتقدّم درجة ويمرّ إلى التأمّل الشخصي، أي إلى مخطّط فلسفة أصيلة. وهذا دليل حيّ على أن الفلسفة تنتج ماذا؟ الفلسفة، ولا شيء آخر، وأنّ كل هذا يجري في عالم مغلق. لا شيء يثير الدهشة إذا كان عالم الفلاسفة مغلقا: طالما كانوا لا يفعلون شيئا للخروج منه، وطالما كانوا، على العكس، ينفذون شيئا فشيئا إلى باطن المؤلفات، ويحفرون هوّة واسعة بين عالمهم وعالم البشر، الذين ينظرون إليهم من بعيد مثلما ينظرون إلى حيوانات غريبة…ليكن، ولكن سيقول القارئ بأننّا وصفنا وضعية قصوى، وميلا أقصى يوجد بالتأكيد، ولكن الأمور لا تسير دوما على هذا النحو. وبالفعل، فالقارئ معه الحقّ: فما وقع وصفه، هو شكل خالص نسبيا، هو النزعة المثالية، والممارسة المثالية للفلسفة. لكن يمكن أن نتفلسف على نحو آخر تماما. والدليل قائم في التاريخ، فبعض الفلاسفة، لنقل المادّيين، تفلسفوا على نحو آخر تماما، وأن أساتذة الفلسفة يحاولون أيضا الاقتداء بهم. فهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من عالم مغلق على ذاته. هم يخرجون منه لسكنى العالم الخارجي: فيريدون أن يقوم بين عالم الفلسفة (الذي يوجد) وبين العالم الواقعي، تبادل مثمر. يتنزّل هذا بالنسبة إليهم في مبدآ الفلسفة ذاتها: بينما يعتبر المثاليون أنّ الفلسفة هي قبل كلّ شيء نظرية، يرى الماديون بأن الفلسفة هي قبل كل شيء تطبيقيّة، تتأتّى من العالم الواقعي وتُنتج، دون معرفة بذلك، آثارا ملموسة في العالم الواقعي. لاحظوا أن الفلاسفة الماديون يمكن لهم وبالرغم من معارضتهم العميقة للمثاليين، أن يكونوا لنقل ” على اتفاق” مع خصومهم في عدّة نقاط. مثلا في أطروحة:” الفلسفة لا نتعلّمها”. لكن لا يعطون لذلك نفس المعنى. إنّ التقليد المثالي يدافع عن هذه الأطروحة بإعلاء الفلسفة على المعارف، وبدعوة كلّ واحد إلى أن يوقظ في نفسه الإلهام الفلسفي. أما التقليد المادّي فلا يسمو بالفلسفة على المعارف، إنما يدعو البشر إلى البحث في خارج ذواتهم، في الممارسات، عن المعارف والصراعات الطبقية، – ولكن دون الإعراض عن الأعمال الفلسفية- لتعلّم التفلسف. لنضرب مثالا آخر، يتمسّك به المثاليون تمسكّهم بأبصارهم: وهو السمة التي تميز الأعمال الفلسفية، كونها معين لا ينضب، والذي يميّز بالطبع فلسفة العلوم…يوافق الماديون على الإقرار بأنه لا يمكن ردّ أثر فلسفي إلى حرفيّته المباشرة، ولنقل لسطحه، إذ هو مفعم بالمعنى. بل يذهب المادّي أبعد من ذلك: فيعترف، وهو في ذلك كالمِثالي بأنّ هذا الامتلاء بالمعنى يعود إلى ” طبيعة الفلسفة”! ولكن لما كانت المادية تحمل فكرة مغايرة للفلسفة عن المثالية، فإن هذا الامتلاء بالمعنى لأثر فلسفي لا يعبّر لديها عن الطابع اللانهائي للتأويل، بل عن التعقيد الأقصى للوظيفة الفلسفية. وإذا كان أثرا فلسفيا ما هو بالنسبة إليها ممتلئا معنى، فذاك لأنه يجب عليها، حتى توجد كفلسفة، توحيد عدد كبير من المعاني. هناك فارق: لكن نتائجه ثقيلة. لنضرب مثلا أخيرا: الأطروحة المثالية الشهيرة بأنّ كل الفلسفات هي كما لو كانت معاصرة لبعضها بعضا، وأنّ الفلسفة ” أبدية”، أو أنه ليس للفلسفة تاريخ. يمكن للمادية، بالرغم من مفارقية هذا الإقرار الشديدة، أن ” توافق ” بتحفّظ. وبتحفّظ، إذ أنها تعتقد أنّه ثمّة تاريخ يحدث في الفلسفة وانه تقع حوادث ونزاعات وثورات واقعية تغيّر ” مشهد” الفلسفة. غير أنّ الماديّة تقول بطريقتها، ردّا تقريبا على هذا التحفّظ، بأنّه ” ليس للفلسفة تاريخ “، من حيث أن تاريخ الفلسفة هو معاودة لنفس النزاع الجوهري، ذلك الذي يقابل النزعة المادية بالنزعة المثالية في كلّ فلسفة. يوجد فارق: لكن تبعاته جسيمة. نحتفظ من هذه الأمثلة السريعة بأنّه إذا كانت الفلسفة واحدة، فإنه يوجد، على أقصى حد، نوعين مختلفين متقابلين من التفلسف، وممارستين متناقضتين من الفلسفة: الممارسة المثالية، والممارسة الماديّة. لكننا نحتفظ بالرغم من الوجه المفارقي لهذا الواقع، بأنّ المواقف المثالية تطفو على المواقف المادية والعكس بالعكس. كيف يمكن للفلسفة أن تكون واحدة، وتسلّم نفسها لتوجّهين متناقضين، التوجّه المثالي والتوجّه المادّي؟ كيف يمكن لخصوم فلسفية أن يكون لهم شيء ما مشترك، بما أننا نرى أن بعضهم يتعدّى على بعض؟ ومرّة أخرى، نحن نطرح أسئلة دون القدرة على أن نقدم لها أجوبة مباشرة. يجب أن نمرّ بالمنعطف الكبير. فالصَّبْرَ إذن، صَبْرٌ ولكن سرعان ما تحصل المفاجأة. إذ ماذا لو وُجدت “طريقة أخرى في التفلسف” غير التي للأساتذة المثاليين، أي ممارسة للفلسفة، هي أبعد عن أن تسحب الفيلسوف من العالم، تضعه في العالم، وتجعله أخا للجميع البشر- وماذا لو وجدت ممارسة، هي أبعد من أن تجلب الحقيقة للبشر من أعلى، في لغة غير قابلة للفهم بالنسبة إلى العمّال، ممارسة تعرف كيف تصمت وتتعلم من البشر، ومن ممارساتهم ومن آلامهم وصراعاتهم، أفلا يمكن أن تقلب الفرضية التي تبنّيناها رأسا على عقب؟ لا. فقد سألنا بالفعل أناسا مختلفين في العمل والموقع الاجتماعي. فحدّثونا جميعهم عن أساتذة الفلسفة. هذا طبيعي: الفلسفة تدرّس في الثانوي والتعليم العالي. إنهم أي هؤلاء المُسْتَجوبين، يطابقون في تواضعهم واختلافهم الفلسفة مع تعليمها. ماذا يفعلون، غير إعادة القول على طريقتهم بما تصرّح به المؤسسات الموجودة في مجتمعنا، من أنّ الفلسفة هي ملكية أساتذة الفلسفة؟ إنهم لم يتجرؤوا، وهم متخوفون من هذا الأمر الواقع للنظام الاجتماعي، ومبهورون بصعوبة فلسفة الفلاسفة، على المساس بهذا الحكم المسبق الفلسفي. إنّ تقسيم العمل اليدوي والعمل الفكري ونتائجه العملية، وهيمنة الفلسفة المثالية ولغتها بالنسبة إلى العارفين، قد أبهرتهم أو أحبطتهم. فلم يتجرّؤوا على قول: لا، ليست الفلسفة خصّيصة أساتذة الفلسفة. لم يتجرّؤوا على القول، مع الماديّين ( مثل ديدرو ولينين وقرامشي):”كلّ إنسان فيلسوف”. يتحدّث الفلاسفة المثاليون للجميع وباسم الجميع. يعتقدون أنهم يمسكون بحقيقة كل الأشياء. أما الفلاسفة الماديون فهم على خلاف ذلك صامتون: يعرفون كيف يسكتون، للاستماع إلى البشر. هم لا يعتقدون في ملكية حقيقة كل الأشياء. ويعرفون أنهم لا يمكن أن يصيروا فلاسفة إلا تدريجيا، بتواضع، وأنّ فلسفتهم تأتيهم من خارج: فيصمتون حينئذ ويستمعون. وأنه ما من حاجة للذهاب بعيدا لمعرفة ما يسمعون، حتى نلاحظ أنه يوجد لدى الشعب، والعمال الذين لم يتلقّوا تعليما فلسفيا، ولم يكن لهم قطّ ” معلمّا ” يتبّعونه في فنّ التفلسف، يوجد ضرب من الفكرة عن الفلسفة، دقيقة جدّا حتى نقدر على إثارتها والحديث عنها. وهو ما يعني، مثلما يؤكّد ذلك المادّيون بأنّ ” كل إنسان فيلسوف”، حتى لو كانت الفلسفة التي يتمثّلها غير دقيقة، نشكّ في ذلك! فلسفة كبار الفلاسفة والأساتذة. ما عساها تكون هذه الفلسفة ” الطبيعية”(العفوية) لدى كلّ إنسان؟ لو طرحتم السؤال على من تعرفون، على الناس “العاديين”، فقد يستغربون، بتواضع، لكن سينتهون إلى الاعتراف:” نعم، لديّ فلسفة خاصّة بي”. ماذا؟ أي طريقة في ” النظر إلى الأشياء”. ولو دفعتم بالسؤال قدما، فسيقولون:” يوجد في الحياة أشياء أعرفها جيّدا، عن تجربة مباشرة: مثلا، عملي والناس الذين أعاشرهم والبلدان التي زرتها أو التي حصّلت عنها معلومات في المدرسة أو في الكتب. لنسمّي ذلك كله معارف. لكن توجد في العالم أشياء كثيرة لم أرها ولا أعرفها. وهذا لا يمنعني من أن أكوّن عنها فكرة. وفي هذه الحالة، فأنا أملك أفكارا تتجاوز معارفي: مثلا عن أصل العالم، وعن الموت والألم والسياسة وعن الفنّ وعن الدين. بل أكثر من ذلك: لم تأت هذه الأفكار من فوضى مبعثرة يمينا وشمالا ومنفصلة عن بعضها البعض وغير متماسكة. لكن لا أعرف لماذا، تتوحّد هذه الأفكار شيئا فشيئا، بل يحدث شيء غريب: هو أننّي جمعت كل معارفي، أو هكذا تقريبا، تحت غطاء هذه الأفكار العامّة، وتحت وحدتها. فأكون عندئذ قد صنعت ضربا من الفلسفة، رؤية لمُجْمل الأشياء، لتلك التي أعرفها، كما للتي لا أعرفها. إنّ فلسفتي هي معارفي موحّدة تحت غطاء أفكاري “. وإذا ما تساءلتَ: فيم تصلح هذه الفلسفة؟ أجابك:” الأمر بسيط، لتوجيهي في الحياة. إنما بمثابة بوصلة: تشير إليّ بجهة الشمال. لكن أنت تعرف، أن كل منّا يصنع فلسفته الخاصّة.” هذا ما سيقوله إنسان عاديّ. لكن سيضيف مُلاحظ ما النقاط التالية. سيقول بأنّ كلّ فرد يصنع فعلا” فلسفته الخاصّة”، لكن يجتمع،على صعيد التجربة، أغلب هؤلاء الفلاسفة، فلا تكون بينهم سوى فوارق شخصية حول أساس فلسفي مشترك، انطلاقا منه ينقسم الناس في” أفكارهم”. سيقول بأنه يمكننا أن نصنع ضريا من الفكرة عن الأساس المشترك لهذه الفلسفة ” الطبيعية/ العفوية” لكل إنسان، حينما نقول مثلا عن أحدهم، بحسب الطريقة التي يتحمّل بها المعاناة أو المحن التي تؤلمه كثيرا، وأنه يأخذ كلّ مناحي الوجود ” بفلسفة” بمنحى فلسفي؛ أو إذا ما استقامت حياته، أن يعرف كيف يستفيد من خيراتها دون إسراف. وفي هذه الحالة، فهو يُقيم مع الأشياء، سواء كانت سيئة أم حسنة، علاقات مقدَّرَة متبصّرة ومتحكّم فيها وحكيمة: فنقول عنه حينئذ بأنّه ” فيلسوف”.
ماذا نجد في عمق هذه ” الفلسفة”؟ لقد فسّر قرامشي ذلك جيدا حينما تحدّث عن: فكرة معينة عن ضرورة الأشياء (علينا الاضطلاع بها)، وبالتالي معرفة معينة، من جهة، وطريقة معينة في استخدام هذه المعرفة في المحن أو أفراح الحياة، وبالتالي، حكمة معينة من جهة أخرى. إنه إذن اجتماع سلوك نظري معين وسلوك عملي معا: أي حكمة معينة. نجد إذن في هذه الفلسفة “العفوية” للبشر العاديين، مبحثين كبيرين يخترقان كامل تاريخ فلسفة الفلاسفة: تصوّر معيّن لضرورة الأشياء، لنظام العالم وتصوّر معيّن للحكمة الإنسانية تجاه سيرورة العالم. من سيقول بأنّ هذه الأفكار ليست بعدُ فلسفية؟ غير أنّ ما هو ملفت للانتباه فعلا هو أن في هذه التصوّر طابعه المتناقض والمفارقي. إذ، هو في الأصل، جدّ فعّال”active: يفترض بأنّ الإنسان يستطيع شيئا ما قبالة هذه الضرورة للطبيعة والمجتمع، ويفترض تفكيرا عميقا وتركيزا على الذات، وتحكّما كبيرا في الذات في الحالات القصوى للألم أو في الحالات اليسيرة للسعادة. لكن، في الواقع، حينما لا يكون هذا السلوك ” مهذّبا” ومتحوّلا، بواسطة الصراع السياسي مثلا، فإنّه يعبّر غالبا عن اللجوء إلى الانفعال passivité. إنه جيّد، لو أردنا، نشاطا للإنسان، لكن قد يكون انفعاليا بعمق ومحافظا. إذ لا يتعلّق الأمر، في هذا التصوّر الفلسفي ” العفوي” بالتصرّف موضوعيا في العالم، مثلما يريد ذلك بعض الفلاسفة المثاليين، أو ” تغييره” كما يريد ماركس، بل بقبوله، بتجنّب كلّ إفراط فيه. إنه أحد معاني كلمة التقطت من فم ” إنسان عادي”: ” لكلّ فلسفته الخاصّة”، في عزلته ( ” كلّ في ذاته” ). من أجل ماذا؟ كي يتحمّل عالما يدمّره أو يمكن أن يدمّره. وإذا ما تعلّق الأمر فعلا بالتحكّم في مسار الأشياء، فليس بالخضوع له أو بقبوله ” بفلسفة”، بل للخروج منه في حال أفضل من الحرص على تغييره. وباختصار، إذا ما تعلّق الأمر بالتلاؤم مع ضرورة تتجاوز قوى الإنسان، وأنه يجب عليه العثور على وسيلة للقبول بها، بما انه لا يستطيع فعل شيء لتغييرها. هو نشاط إذن، لكنه انفعالي؛ نشاط إذن لكنه خاضع. لا أفعل شيئا هنا سوى تلخيص فكر فيلسوف ماركسي إيطالي هو غرامشي عن هذه المسألة. ويمكنكم النظر، على أساس هذا المثال، إلى كيفية تفكير فيلسوف ماديّ. فهو لا “يروي لنفسه حكايات”، ويتمسّك بخطاب حماسيّ، ولا يقول ” كلّ البشر ثوريون”، بل يترك الناس يتكلّمون، ويقولون الأشياء كما تكون. نعم، يوجد أساس للخضوع للاستسلام لدى الحشود الكبيرة التي لم يحصل لها وعي بالصراع أو حتى لدى من كانوا مقهورين، لكنهم عرفوا الفشل. يتأتى هذا الاستسلام من أقاصي التاريخ الذي كان دوما تاريخ المجتمعات الطبقية، وبالتالي من الاستغلال والقمع. لأفراد الشعب، وهم صنيعة هذا التاريخ، أن يثورا؛ ولما كانت الثورات منهزمة دوما، فليس لهم سوى الاستسلام والقبول ” فلسفيا” بضرب من ” الفلسفة”، بالضرورة التي يتقبّلونها. وهنا سيظهر الدين.”
لويس التوسير “الطريق إلى الفلسفة لغير الفلاسفة”،نص أعده جورج م.غوشكاريان، وتمهيد لغيوم سيبارتان – بلان. سلسلة ” بيف”.puf 2014 سلسلة ” آفاق نقدية”.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






