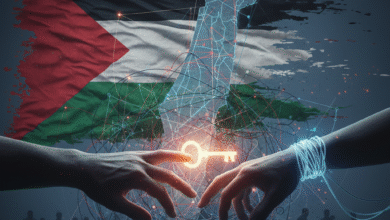أطبقَ النقادُ على فكرةِ مُؤدَّاهَا أن ميلاد الشِّعر مقرونٌ بالإشعاعِ الإنسانيِّ الذي تصدِّرهُ الأنا المبدعة، فالشَّاعرُ هو نجلُ المنطقةِ الخضراءِ التي تخلو من مكائد الشرِّ ومجازات الهرطقاتِ المشبوبةِ بمعاني الإكراهِ، كما أنَّ الشُّعراءَ غالبًا ما يكتوون بآلامٍ وجودية، واستيهاماتٍ عاطفية تكونُ مصبُّها القصيدة التي تُبرزُ هذهِ الحروقات النفسية في هيئة صورِ شاعريةٍ ضاغطةٍ باللَّمساتِ الأسلوبية، والرموز المتحدَّرةِ من ذاتيتهِ المؤثَّثة بالخيال، التي بفضلها صَار الشَّاعرُ يبحثُ عَن مساربَ آمنة تندفعُ بهِ نحو العوالم اللَّامحدودة المزجاة بفواصلِ الإدهاشِ، وتغريبةِ الإيقاعِ ورهافةِ الاستعاراتِ.
بينما تكادٌ تخبو هذهِ الميكانيزمات في الشِّعرية الإسرائيليَّة، فلا حرية للشّاعر في اجتراحِ واحتهِ الفكريَّة والفلسفيَّة التي يصبو لتحقيقها بواسطةِ سحر اللُّغةِ، ويفاعةِ البلاغةِ، ورحيقِ الإيقاعِ، ذلك أنَّ الشَّاعر في دولةِ الكيانِ ليس أمينَ وجدانهِ وليس بمقدورهِ توزيع آهاتهِ وآلامهِ بين تضاعيفِ القصيدةِ حيثُ يُطلبُ منهُ تقديمَ قرابينِ الولاءِ لأجل استمرار دولةِ الكيانِ مع العمل على استثمارِ عتادِ القصيدةِ خاصةِ الرمز في إعطاءِ شرعيةٍ تامةٍ لِجناياتِ السَّاسةِ والجندِ على الشعبِ الفلسطينيِّ، ناهيكَ عن البحثِ عن المدائحِ الموفيةِ إلى تدعيمِ الحركةِ الصهيونيةِ وتقويضَ كل رؤية معارضة لهذا الائتلاف الذي يطمحُ إلى نقلِ الشخصيةِ اليهوديةِ نحوَ مرافئ القوةِ ومنصَّاتِ الاستبداد دون الارتكانِ إلى البواعثِ العاطفيَّة والإنسانيَّة التي كانت بمنزلةِ الواقيِّ الجماليِّ الذي يحميِّ القصيدة من الغرقِ في دنسِ الجريمةِ والاضطهادِ كما يفعلُ شُعراء دولةِ الكيانِ.
فمحلُّ الرمز للقصيدةِ كمحلِّ القطبِ للرَّحى، فهو مقودُهَا الرَّكين لاستفراغِ رؤية الشَّاعر ضمنِ دلالاتٍ بعينِها لا تحيدُ عن قصديتهِ أو تنحرفُ عن مذهبهِ الذي تولَّى تصديرهُ بنفسهِ دون حاجتهِ لمنجزِ غيرهِ، وهيَ البساطُ الذي يضمنُ تدفُّقَ الرؤى الشَّاعرية نحو مناخاتِ الاعتدال بلا إصرار على المداومةِ في إرباكِ القراءِ بما لم يألفُوه، أو انتهاكِ خطِ أفقِهم الرحب القمينِ باستقبال المفاتيحِ التَّأويليَّة التي تكفلُ الولوج إلى عتماتِ القصيدة بغية إنارةِ مراكزها الكبرى وسبر مظانِها الأساسيةِ.
لقد درجَ الشُعراءِ العبريُّون على الانصهارِ في عماءِ التاريخِ ودهليز النص التوراتيِّ وتجاذباتِ المشهدِ السياسيِّ بغيةَ رسم ملامحِ القصيدة التمجيديَّة، التي تقتلعُ كينونةِ الشَّاعر لصالِحِ تكريسِ فكرةِ صهيونية الدولةِ عبرَ ربطِ حريَّتهِ الإبداعيَّة بمساقاتٍ إيديولوجية حتمية يؤطِّرُها الرمز كقصيدة يهوذا عمِّيحايِّ المحاطة برمزياتٍ منحوتةٍ من جداريات التاريخِ والدِّينِ والسِّياسةِ:
هربتُ ذات مرَّة.. لا أذكر لمَ…ومن أيِّ إلهِ.
لذَا سأسَافرُ في حياتي كمَا يونس.
في جوفِ الحوتِ المظلمِ.
وسويَّنا الأمر بينَنَا.
أناَ والحوت.
وكلانَا في أحشاءِ العالمِ.
أنا لَن أخرجَ وهو لن يقضِمنيِّ”[1].
استحالت القصيدة إلى أمشَاجٍ من الرُّموزِ المختلفةِ ضمن حيِّز شعريِّ مضطرب يحيل إلى اضطراب السِّيرة اليهودية وتأرجحِها بين سلَّةٍ من المتناقِضاتِ التاريخيَّة، من أمة مشتتة إلى أمةٍ تمارس الشتات، من أمةٍ تشتكيِّ قساوةِ الشُّعوبِ عليها.. إلى أمةٍ تمارس كل أنواعِ القَمعِ والتنكيلِ…
ولا مندوحة أن تقعَ هذهِ الرموز ضمن هرمية متدرجة تبتدىء بالدينيِّ فالسياسيِّ فالتاريخيِّ ذلك أن نصاب هذهِ التضافريَّةِ يهفو إلى تطويقِ دولةِ الكيانِ بمزيدٍ من التبريراتِ السَّاعيةِ إلى تقديسِ الأنساقِ التدميريَّةِ لتهشيمِ كياناتِ الشعوبِ التي كانت سببا في محنةِ اليهودِ وشتاتِهم، فالسَّفرُ المحايثُ لسفريةِ يونس عليهِ السلام ليسَ محضَ اقتناصٍ مجازيٍّ، بل هو دعوة لليهودِ للهجرةِ في كبدِ الصَّمتِ وعتمةِ النسيانِ دونِ إحداثِ رجَّةٍ سياسية أو فتنةٍ دينيَّة، وهذا إسقاط نبهٌ لمجرياتِ الهجراتِ اليهودية في أرضِ فلسطين، أمَّا إصرار الشاعر على البقاءِ في بطنِ الحوتِ في إ طار تسويةٍ تضمن أن لا يخرجَ هو من بطنهِ ولا يقوم الحوت بقضمهِ في علاقيَّة حميميَّة تكسر السَّائد التاريخيِّ، والمتواتر الدينيِّ فهو بلا شك هندسَة تقريبيَّة لقوامِ الحركات الصهيونية التي تعتمدُ السريَّة والغموض في عملها دون البوحِ بأسرارها وآليةِ اشتغالها وهذا لصناعة الفوضى في ربوعِ الدُّول العربية التي تكنُّ العداء لدولةِ الكيانِ الغاصِب.
علاوة على هذا فبطن الحوتُ يمثِّل: “الخفَاء، الاندسَاس، العماء، التواري، الاحتِجاب” وهيَ أنساقٌ تعليليَّة عبرها يتَّضحُ النهج الإغتياليِّ للجهاز الاستخباراتي الإسرائيليِّ الذي يفتكُّ بضحاياهُ في عماءِ الظلمةِ أو بالاندساسِ في الحشودِ وفي المقراتِ الإدارية والترفيهيَّة فتجارةُ الموتُ هيَ المصدر الوحيد الذي يُخوَّل لدولةِ الكيانَ الاستمرارَ والبَقاءَ واجتنابِ ضرباتِ المقاومةِ المُزلزلة.
والشَّخصية الإسرائيلية كلَّما تعاهدَها الجزعُ وطاردَها الرُّهابُ والوجلُ طلَّقَت الأمكنة الجماليَّة وتشَاحنَت مع الطَّبيعةِ فألبستها لبوس الدمِّ والعار والخرابِ لأنها الموبوء بالأسقامِ لا يقتدرُ على اقتصاصِ مكامِنِ الحكمةِ المتزهدةِ عن طرقِ أبوابِ القوةِ والبطشِ، وهذا ما يلهج بهِ الشَّاعر الإسرائيليِّ “لأسيتيك مانجر”:
أمَّا الثَّاني فيهيلُ على رأسهِ التُّراب.
والرَّمادُ يصرخُ في غضبٍ.
على العنفِ قامَ عرشُكَ.
رداءُ مملكتِك ملوَّثُ بالدَّم.
وسيلوِّثه دمهُ أيضًا”[2].
فضحت الرَّمزية الثاويةِ في قطر النَّص الشعريِّ خواءَ الذَّات الشَّاعرةَ اليهودية من منابتِ المجاز الخصب المتولِّدِ عن نقاءِ السَّريرة وصفاء الوجدان، فالنص اغتدَى على شاكلةِ الخطاب التوراتي الملوَّث بخضابِ الدمِّ ما يعكسُ نشوبَ أزمةً نفسية تعتمل دواخل الذاتِ الشعرية الإسرائيليَّة التي استبدلت حميمية الأمكنةِ بذاكرتِها السَّارية في كنفِ السَّلام بسردياتِ العنفِ والخرابِ ما يُبرهنُ على أنَّ الشعريَّة الإسرائيليَّة مجرد كينونةٍ انفعاليَّة تحركها النَّزعَات المنزاحةِ عن قوامِ الشَّعريةِ والفن، بمعنَى أنها ترتهنُ في دعايتِهَا الفكريةِ والأدبية إلى مستبطناتِ الحركةِ الصهيونيَّة بنسقِها العدائيِّ وشططهَا الفكريِّ.
لقد استباحَت الرمزية السَّوداويَّة ساحِل القصيدةِ وسلبتها إهابَ الشِّعريَّة فيهَا، وجرَّدتها من سُحنتِها الأسلوبيَّة لتستحيلَ إلى ركامٍ من العقدِ النفسيَّةِ حيثُ لا مفرَّ من سلطةِ الحقيقةِ ومواعظِ التاريخِ إلا من خلالِ الالتِجاءِ إلى خطابٍ هستيريِّ يكادُ يعريِّ سوءة دولةِ إسرائيل وهو الخوفُ والوجل من المُستقبلِ في ظل هشاشةِ الرؤيةِ وخواءَ الكيانِ من الدعائمِ الإنسانيةِ والديموقراطيَّة الكافيةِ لاستمرارهِ.
والشِّعرية الإسرائيليَّة مترهلة البناءِ، باهتة المعاني، تفترسُها إيديولوجية القتل والكراهيةِ، تشتغلُ على إذكاءِ جذوةِ العنصريةِ والاستجارةِ بشخصياتٍ إرهابيَّة تمارسُ التدمير والوحشنة بطرقٍ تصعقُ الفطرةَ السليمةِ كما في تجربةِ الشَّاعرةِ الإسرائيليَّة “نعميِّ شِيمر”:
ماذا علينَا ليذبحوا بعضهم.
ليذبحَ أحدهم أخاهُ.
هذَا ما قالهُ الجِنرال روفائيل إيتان.
وهو يتحدَّثُ عن الحربِ العراقيةِ الإيرانيَّة.
لقد قالها بيغن ذات يومٍ.
كلابًا تقتُلُ كلابًا.
فلماذَا نتدخَّلُ نحنُ.
ولماذَا لا نكون سُعداء[3].
لا مناصة أن تصير هذهِ القصيدة جناية بلاغيَّة، وفضيحة أدبيَّة وجراءةً في وجهِ العدالةِ، فهيَ تخدشُ المنظومةَ الأخلاقيَّة بمزيدٍ من العبوَّاتِ اللُّغوية الناسفةِ لفكرةِ اعتدال الشعر والأدبِ في دولةِ الكيانِ، وبالتالي استودَعت القصيدة في طواياهَا رموزًا متعاليَّة تشرئبُّ لتسويغِ نزواتِ اليهوديِّ وهو يتمتعُ بقتالِ العربِ فيما بينهم، أو تعاركِ الجيرانِ كواقعةِ الحربِ العراقية الإيرانيَّة، كما تحتدم الشعريةُ بفيضٍ من الشَّحناتِ العنصرية من خلالِ تشبيهِ العربِ بالكلابِ المتهارشة في تعريةِ صريحةٍ لأدواتِ الكتابة الشعرية عند نعميِّ شيمر التي تتخذُ من معجمِ الكراهيةِ مادة لها في تشقيقِ الاستعاراتِ المفخَّخة التي تتبدَّى في شكل علاقةٍ طردية :كلما زادَ بُكاءُ العربِ استدامت سعادةُ إسرائيل.
ومن المخزيِّ في هذا السِّياقِ أن تلوذَ الشاعرةُ بشخصياتٍ دموية في سبيلِ منحِ القصيدةِ شهادةَ الانفصالِ عنِ براءةِ الصورةِ، وتحنانِ اللغةِ، فروفائيل إيتان وزير الأركان السَّابق سنة1983 بلغت بهِ الوحشية أن تغافل عن إدانةِ الضالعينِ في مجزرةِ صبرا وشتيلا، بل تعاهد أن يمنح الضوء الأخضر لضباطهِ في كلِّ طلعةٍ عسكريَّة حتى يأتوهُ برؤوسِ المقاومةِ وأجنَّة النساءِ الفلسطينيات المذبوحاتِ عل نُصبِ الغدرِ والتشفيِّ، أما بيغن فلا يقلُّ بربريةً عن إيتان فهو المؤسس لحركةِ أرغون الاستئصاليَّة التي مارست التَّهجير والتعذيب في حقِّ أبناء فلسطين، ضف إلى ذلك فهوَ المتسبب الأول في مجزرة دير ياسين الأليمَة سنة 1948.
ومن حقِّ المتلقي أن يُسائل جناة الكتابة وهم يدوٍّنون هذهِ الألفاظ التي يُحظرُ أن تدلجَ ميدان الشِّعرية، فالشَّاعرُ هو نبيُّ السلام الحالم بإشاعةِ ترانيمِ الحبِّ ونواقيسِ المودَّةِ وإلَّا فلن تصلح هذهِ الأسطر لإدراجِها في مَساراتِ الأدبِ وركبِ القصائدِ الباعثةِ علَى مغازلةِ الحسِّ وإغناءِ الوجدانِ.
بلغت القسوةِ بالشِّعريَّة الإسرائيليَّة أن تستعملَ تراكيبَ قاسية ومبانيَّ بغيضة الدلالةِ لتحريضِ الجنود اليهود على الفتكِ بأطفالِ المخيماتِ العربيَّة لأنهم في نظرِهَا زرعٌ نابتٌ سُقيَ بالدمِ ومستقبلا سيهتكُ بدولةِ الكيانِ لذا فالأجدى نحرهُم وهم في الطفولةِ الغضَّة قبل أن يبلغَوا أشدَّهُم، ويستويَ عودَهم، وهذا ما يلفظ بهِ الشَّاعر أفريم سيدوم:
يا أطفاَل صُور وصيدَا.
إنيِّ أتَّهمكم.. ألعنُكم.
لأنَّكم مخرٍّبون…
إرهابيُّون صغار…
لو أنكم تلاميذُ مجتهدون.
تذهبُون إلى المَدارسِ.
لو أنَّ لكم شِفاهً صغيرة.
لقدَّمتُ لكم ألعابًا
وقوالِب شكولاتَا وهدايَا جميلة.
لكنَّكم مخرِّبون.
إرهابيُّون صِغار[4].
كثرت المعايب الدِّلالية والصوراتية والرمزية في هذا النص لدرجةِ أنه من الاستحالةِ بما كانَ تصنيفُه ضمن روافدِ الأدبِ وحيويةِ الشِّعرِ فكيفَ لشاعرٍ مثل أفريم سيدوم أن يدهسَ أحلام الطفولةِ بخطابٍ بذيء تفوحُ من تلابيبهِ رائحة الفُجرِ ورغيبة الانتقامِ، ممَّا يوحيِّ بتصلُّبِ المخيالِ الشعريِّ الإسرائيليِّ وارتباطهِ بالمِخيالِ التوراتيِّ الذي لا يتردَّدُ في قتلِ الأطفالِ باعتبارهم غنائم حربٍ يستلزمُ افتراسُها فالإجهاز عليهم وهم ديدانٌ ضعيفة أفضل من مجابهتهم مستقبلًا وهم ثعابينَ ضخمة هكذا يتم تسويغ القتلِ العشوائيِّ في دولةِ الكيانِ، ولنقرأ ما جاءَ في سِفر التَّثنية، الإصحاح الأول: أهلكُوا كل ما في المدينة –يعني أريحا – من رجلٍ وامرأةٍ وطفلٍ وشيخٍ حتى البقر والغنم والحمير بحد السَّيف، وأحرقوا المدينة بالنَّار مع كلِّ ما بِهَا.
فالشِّعرية عندَ مؤسِّسِها رومان جاكبسون ينبغي أن تنأى بنفِسها عن الذوبانِ في محيطِ الخطاباتِ العدميَّة الأدب وإلا بدَّدت أنساقَها المجازية وقيدَت أبنِيتَها وفقَ تيارات إيديولوجيَّة تتكسَّبُ من تحطيمِ الآخر المعارض لها في المقصدِ والرؤى كما في أنموذج أفريم سيدوم، بينما الشِّعرية الحقَّة التي لا يعتورُها شيءٌ من هذا القبيلِ فهي تسعَى إلى اصطناع خطاب شعريِّ كونيِّ يحتضنُ أنفاسَ كلِّ من عاضلهُ الحزنُ وأعياهُ الضَّيم.
ولئن أصرَّ أفريم سيدوم على إخفاءِ ملمحِ الطفولةِ من يومياتهِ المحتدمةِ بالمخاوفِ وهيستيريا الفنَاء فإنَّ الشاعر اللبنانيِّ إيليا أبو ماضيِّ قَد استطاعَ أن يضخَّ معانيِّ الرحمة في أوداجِ قصيدتهِ، التي نراهَا تهيمُ حبًّا بالأنوار الملائكيَّة النابعةِ من قناديلِ الطُّفولةِ:
إِنَّني كُلَّما تَأَمَّلتُ طِفلاً خِلتُ أَنّي أَرى مَلاكاً نَجِيّا
قُل لِمَن يُبصِرُ الضَبابَ كَثيفاً ِ إنَّ تَحتَ الضَبابِ فَجراً نَقِيّا
اليَتيمُ الَّذي يَلوحُ زَرِيّاً لَيسَ شَيئاً لَو تَعلَمونَ زَرِيّا
إِنَّهُ غَرسَةٌ سَتَطلُعُ يَوماً ثَمَراً طَيِّباً وَزَهراً جَنِيّا”[5]
فكيفَ تُقارنُ هذهِ القوافي اللطيفةِ التي ترتكنُ في قيامِها على نشيدِ اليتامى بمغازلتِهم وإطرائِهم ودمجِهم في قاطرةِ الحياةِ بتقلباتٍ نفسٍ مريضة وذاتٍ شهوانيَّة يعتملُها الجبنُ والخوارُ من أطفالِ المقاومةِ، يُربِكها هاجسُ الموتُ والطَّردِ من أرضٍ اُغتصبت بالقهرِ، فوجَّهت قصائدها وهيَ مكرهة للنَّيلِ من طفولةِ العربِ، كونَ الابتسامةِ الصَّادرةِ مِن ثغرها تزعزعُ فؤادها الهشِّ ووجدانها المحطَّم.
تأسيسًا على ما سبقَ تتضحُ مداراتُ القبحِ الإسرائيليَّة بناءً على افتعالِ شعريَّةٍ مترهِّلة الدِّلالة، معدمة الجماليَّةِ، مُضبَّبَة الرُّؤى والأحاسيس، لا تنفك في توتير الرمزِ بمزيدٍ من الأحقاد التاريخيَّة، والانحرافاتِ الدينيَّة للمضيِّ نحو طمسِ آثارِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وتلفيقِ الحقيقةِ بلغةٍ شاعرية مُنسحقةٍ لا تؤمنُ بالتعايُشِ السِّلميِّ ولا بالاقترانِ الحضاريِّ.
الكاتب: معطى الله محمد الأمين، الجزائر.
[1] صالح العياري، في الشعر العبريِّ والصهيوني المعاصر، دار طلاس للدارسات والنشر، ط1، دمشق، ط1، 1987، ص132.
[2] صالح العياري، المرجع السَّابق، ص 163
[3] عن ملحق معاريف الإسرائيليَّة، الصَّادرة بتاريخ/ 23/ 9 / 1982 ترجمة: خليل السواحريِّ
[4] صالح العيَّاري المرجع السَّابق، ص 179، 180
[5] إيليا أبو ماضي، الدِّيوان، دار العودة، ص 821
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.