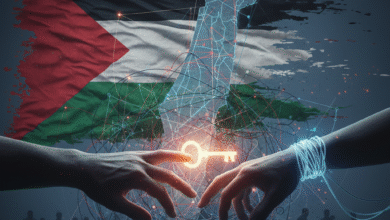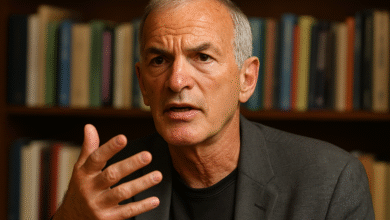باتَ من الواضِح جدَّا أنَّ صناعة الأدب في دولةِ الكيانِ تَخضعُ لتحيُّفاتٍ عرقيَّة شديدةَ التَّطرُّفِ، المُرادُ منها تشويه الأنا العربية وتقديمِها في هيئةٍ مسترذلة وصورةٍ قميئةٍ يَعافُها المتلقيِّ الغربيِّ.
ولا مراءَ أن يكون هذا التَّوجه السَّائد في دولةِ الاحتلالِ هو المسارُ الأليقِ بالكتاب الصهاينة، ذلكَ أنهم يعملون زورًا وتلفيقًا لتحريفِ صورةِ العربيِّ عن مسارهَا بغيةِ مغالبتهِ ثقافيًّا وتطويقِهِ بسلَّةٍ من المجازاتِ الصَّائرةِ في نهجِ الافتراءِ الغليظِ، الذي يصبو لزعزعةِ النفسيةِ العربيَّة حتى يطمئنَّ العالم إلى التمفصلاتِ الصوراتية بينَ أنا يهوديَّة تطفو مثاليَتُها في محيطِ الأدبِ واستعاراتِه الصَّادةِ عن الحقِ وأخرى عربيَّة تمَّ خندقتُها عسفًا في مجاهلِ الدِّلالاتِ السَّوداوية.
لقد انتهجَ الأدب الإسرائيلي مسلكِ القصَّةِ لتكوينِ رؤيةٍ قاتمةٍ عن العربيِّ منذُ نكبةِ 1948 وبدايةِ الشتاتِ الفلسطينيِّ حيثُ لم يتردَّد في تسويقِ صورة الذاتِ العربية التواقةِ لاعتصار الآخر المختلف عنه عقائديًا في دوامةِ من الإقصاء والإكراهِ البدنيِّ والنفسيِّ، كما تمَّ استحضارُ الأدوات الأسلوبيَّة الوافية لتسريدِ مناقصِ العربيِّ في تحجيرهِ للأنثى وإرهاقِ كاهلها بالواجباتِ المنزليةِ الشاقةِ، علاوةً على تغليفِ حياتهِ اليوميَّة بقصصِ الغفلنةِ والاستغباء والانجرار وراء الوهمِ بطقوسٍ متكرِّرة تسلبهُ حريَّة الإرادة.
1/ قصة لطيفة العربية واسترضاءِ الرجل اليهوديِّ.
نالَ الأديبُ اليهودي موشي سميلانسكي {1874- 1935} تقديرًا كبيرًا في الأوساطِ الأكاديمية في دولةِ الكيانِ وهذا نظيرَ سلعتهِ السَّرديةِ الباثةِ على تطويحِ العربيِّ في مزالقِ الرذيلةِ، كقصةِ لطيفةِ الفتاة العربيةِ المراهقةِ التي دأبت العمل في حقلِ اليهوديِّ الشاب خواجة موسى، لكنَ الهواجسَ بدأت تخالجُ وجدانها منذ أن علمت أن أباها لن يتردد في تزويجها بابنِ شيخٍ عربيِّ، كما جرت عليهِ عاداتهم الاجتماعية، فاقترحت على موسى أن يعتنق الاسلامِ بغية الظفرِ بِها بيدَ أن موسى سخر من طلبِها واقترح على لطيفةٍ أن تعتنقَ اليهوديَّة فقال لها مُخاطِبا: “لطيفة اعتنقي أنت اليهوديةِ وسوفَ أتزوجك أنا”[1].
هُنا تتلعثم لطيفة وتُجيبُ بأنفاسٍ متقطِّعة: إنَّ أبي سيقتُلنا نحنُ الاثنينِ”[2].
الأكيدَ أنَّ النطق بهذا القرارِ من قبلِ لطيفة هو محاولةُ اصطناع ذات عربيَّة تنتهكُ قداسَة الحبِّ فتدميِّ متعاطيهِ بسيوفِ التطرفِّ والإسرافِ في تخوينِ المرأةِ إذا استقرَّت على حبيبٍ بمحضِ اختيارهَا دونما المرورِ على سلطةِ الأبِّ.
ثم ينتقلُ الخِطابُ إلى مسرحٍ مفتوح تُدار في واجهتهِ حواريةٌ تزوَّرُ عن الحيادِ، لإثباتِ نقاوةِ الرجلُ اليهودي وطهارةِ عاطفتهِ من نزواتِ التملكِ الأنثوي حينَ تسألُ لطيفة الخواجة موسى عن سلوكياتٍ فجَّةٍ يأتيها الرجل العربي في مقابلِ استعاضةِ الرجلِ اليهودي عنِ إيتائها بدافعِ النخوةِ ونقاءِ السريرةِ وشرفِ الرومانسيةِ التي ولجَها من صميمِها:
لطيفة: هل صحيح أنَّكم تتزوَّجون بواحدةٍ فقَط يا خُواجة.
الخواجة موسى: نعم يا لطيفة.
لطيفَة: ألا يضربُ الرِّجال عندكم النساءَ.
الخواجة موسى: وكيفَ يضربُ الرجل المرأة التي يُحبها وتحبُّه.
لطِيفَة: وهل تتزوَّج النِّساء ممن تُحبِبنَ.
الخوَّاجة موسى: بالتأكيد.
لطِيفَة: عندنَا يبيعون الفتيات مثل الدواب”[3].
أمست الحواريةُ مذهَبًا أخلاقيًا مُتنافر الأقطابِ بين رجلٍ عربيِّ يعوزُ للكلمةِ المهذَّبة، والحسِّ الرومانسيِّ الشفيعِ بمعاشرةِ المرأةِ معاشرة حسنة، فهو لا يهتم بالوفاءِ والارتكانِ لزوجةٍ واحدةٍ تُثنيهِ عن التعدد، لذلك نعاهدهُ في الحواريةِ لعوبًا بالنساءِ فيستبدلهن كقطعِ الغيارِ، تنعدم في قواميسه الاجتماعيَّة دلالات الحب والانصهارِ العاطفيِّ، قنوطٌ، سريع الغضبِ فيشعلُ لهيبَهُ في المرأةِ وجسدها الذي اغتدى أرضًا ملغمةً بفعلِ انحرافاتهِ المتكرِّرة.
بينما صارت هذهِ المآخذُ في حكمِ النواهيِّ التي يستنكف الرجل اليهوديُّ مُباشرتها أو الاقترابِ من دائرتِها الممغنطة بالشرور، الأمر الذي استمال لطيفة وجعلها تحلمُ بزواجٍ متفرد عنِ نوازع العربيِّ وسُلطتهِ النَّهمة في ابتلاعِ حقوقِ المرأةِ.
ولا تنفكُّ القصة في تعويمِ التُر اثِ العربيِّ في بحيرةٍ طاميةٍ من الشُبهاتٍ بالالتجاءِ إلى معاينةِ بعضِ الصورِ التاريخية القاتمةِ حيثُ البدويُّ يتفسح في الأسواقِ يبيعُ ويشتري في الجواريِّ بحثًا عن الاستزادةِ في الأرباحِ وكأنَّ المرأةَ كما يحلو للطيفةٍ تشبيهها هي دابةٌ في عينِ العربيِّ لا أكثر.
إنَّ هذا التَّعبير الموجَّه يكادُ يواريِّ عورةَ اليهوديِّ في قهرهِ للأنثى واستعدائِها حيثُ لم يتردَّد مُطلقًا في تطويقِ رقبتِها بمزيدٍ من الخطايَا والآثامِ ونعتِها بالرزيَّة السَّوداء التي تُغضبُ الربَّ، فضلا عن هذا فالمرأة لم يتم تشيُؤَتِها إلا في عصرِ استبداد الكهنوتِ اليهوديِّ فمثلا نعثر في التلمود اليهودي القسم الثالث فصل النساءِ فتوى تقولُ “إنَّ أرملة الأخ المتوفَى الذي لم يُنجب تُلحقُ بأخيه فيتزوجها، ثم يُنسبُ الولدُ إلى أخيهِ المتوفَى”[4] .
رواية مِينوتور والتفزيعُ من البدونةِ العربيَّة.
في روايةِ مينوتور الصادرة سنة 1980 والمأخوذةِ من الأسطورةِ الإغريقية والتي تُبرزُ شابًا مفتول العضلات برأسِ ثورٍ، يخوض الكاتبُ الإسرائيليِّ بنيامين تموز عراكًا إيديولوجيًا محمومًا هدفهُ الإيقاعُ بشخصيةِ البدويِّ العربيِّ في مُقابلِ الإشادةِ بالشاب الإسرائيلي آليكس، وعن أسبابِ اختيارِ العنوانِ المقتبسِ من الميثولوجيا الإغريقية، فهو ولاريب الرغبة في منحِ الثقافة اليهودية جوهر التفاعل مع الإغريقِ كحضارة منفتحة تتمظهرُ في مبنى الروايةِ عبر الصداقة المزدانةِ بطيفِ الحبِّ بين أليكس ونيكوس الإغريقي الذي يجمعهما أيضا الغرام بالفتاة الإنكليزية ثي في مقابل التحذير من زمالةِ البدوي العربيِّ الذي نجح أليكس حين بلغ الرابعة عشر من عمرهِ الإجهاز عليهِ ليُظهِر للقارئ شأوهُ البطوليِّ وهذا ما يبوء بهِ المقطع السردي الآتي:
في إحدى اللَّيالي وهو واقفٌ على حافةِ المزرعةِ ويرمقُ بنظرهِ المنحدر الذي امتد حتى مُخيَّم البدو في نهايةِ الوادي، فجأة ظهر شخص بين أخاديد الأرضِ بالقربِ من الشخصياتِ الذابلةِ، كان هذا الشخص بدويا شابا في حوالي العشرين من عمرهِ، للحظةِ تبادلا النظرات دون أي كلامٍ ثمَّ بدأ البدويُّ يشتمه بأحط الشتائم، تلكَ الشتائم التي اعتاد أن يقولها لأولئكَ الذين يحتقرهم ويكرههم، فقد شتم آليكس مطولا، وقال له إن أجله قد حلَّ وأن مآله الموت، لكن قبل أن يقتله سيغتصبه ثم يدفنه في الأرضِ”[5].
كما جرت عليهِ العادة يبدو السردُ منحازًا لصالح الشابِ الإسرائيلي الذي لم ينبُس بشقِ كلمة حين التقى البدويَّ الأعرابيَّ إماءةً إلى عذوبةِ أخلاقهِ أما الأعرابي فراح يقتطع من معجمهِ أحط الشتائمِ وأرذلها وأسخطِها بيدَ أن المقزز في الحوارِ هو محاولة توصيفِ العربي في هيئةٍ كائنٍ شهوانيِّ منسلخٍ عن آدميتهِ فيتوعَّده بالاغتصابِ قبل اغتيالهِ في تراجيديا سوداء تنخرهُا آثام العربي التي استودعها في لسانِهِ قبلَ فعلهِ.
قال البدويُّ: لقد انتظرتك هنا منذ ثلاثَةِ أيام فأقسمتُ أن أغتصبكَ وأقتُلك كأيِّ كلبٍ، تعالَ إلى هنا يا ابنَ العاهرةِ”[6].
تندفعُ تهديداتُ البدوي كسيلٍ جارٍ على منحدرٍ تليِّ مشكلا هزيزًا لا طائلَ منهُ في ظلِّ ثباتِ الشابِ اليهودي الذي أعرض عن افتعالِ نفسِ أسلوبِ البدويِّ في التنطعِ اللساني والتشدق البلاغيِّ، فيجعلُ من الصمتِ قرينَهُ وعضدهُ الذي سيخرسُ ثرثرةَ البدوي للأبد:
“وبرأسهِ نطحَ أليكس الرجل العربيِّ وشلَّ حركتهُ، ثمَّ اعتلَى الرَّجل بعدَها فأوقعهُ على الأرض وأخذَ يَخنُقهُ.”[7]
يمورُ السرد هنا بالكثير من الدلالاتِ المبطنةِ التي يُحاولُ الرِّوائيِّ تمريرها، فالكلام من غيرِ فائدةِ والتهديدات التي ساقها البدوي للشاب اليهودِيِّ أليكس هي التعريضُ بالعقليةِ البدويةِ العربيةِ التي تُجيدُ صناعةَ البيانِ والبلاغةِ الراسيةِ على تضخيمِ الأنا، في حينَ أنَّ مفعولهَا في الميدانِ غيرِ مفعَّلٍ البتة، في حينِ يرمزُ الصمتُ الذي تحلَّ به الشاب اليهودي طيلة أطوارِ المناظرةِ إلى الحكمةِ اليهوديةِ وثباتِها في المِحنِ والنوازلِ، فهيَ تستعيضُ عن الكلامِ المجرد بالأداءِ الموفي إلى نتيجةٍ عملية تُجسِدها صرعُ أليكس للرجل العربيِّ البدويِّ.
كما يسعى السَّارد هنا إلى الهزءِ من الشَّخصيةِ العربيةِ وتحميلِها عوار الجبنِ والضِّعةِ والهوانِ فبالرغمِ من فارقِ السنِ إلا أنَّ المراهق اليهودي اقتدر على مغالبةِ الرجلِ البدويِّ، وكأنها تقضيبةٌ إيديولوجية تنحو إلى تقريظِ الدولةِ الإسرائيلية على حداثةِ عهدها كونُهَا تُقيمَ بنيانها على دعائم حداثية واقتصاديَّة متينة بخلاف المدائن العربية التي يُطوقُها التَّخلف جرَّاء ميلانِها إلى اللَّوذِ بالتَّاريخِ وأرشيفهِ الصَّائر في مساراتِ الفناَءِ والانقراضِ
قصة الأسير وعزاءُ الرَّاعي العربيِّ الأخير.
تُنبئُنا الروايات التاريخية عن عناءاتِ الرعاةِ في الحروبِ والنزاعاتِ، فهم الحلقة الضعيفة التي تكتوي أضلعها بسُعارِ العنفِ ونيرانِ الضيمِ الذي يُخلفه المنتصرون دونَ أدنى شفقةِ، كمَا في قصةِ الراعي للأديب اليهودي ليزهار سميلانسكي التي كتبها سنة 1948، تنقدح شرارة الحدثِ من خلالِ دورية إسرائيلية تجولُ في القرى العربية فتعثرُ على راعٍ عربيِّ، فتقوم بتعصيبِ عينيهِ ثم تمارس عليهِ كل أنواعِ الإذلالِ: ركل، بصق، صفع، كتعويذةٍ على وحشيةِ الجنديِّ الإسرائيليِّ التوَّاقِ إلى رهبنةِ العربيِّ لئلا يفكر مستقبلا في نزاعهِ أو محاربتهِ، وبينما يستمر الجنود في إهانةِ الراعيِّ يطلبُ قائد الدَّوريةِ من جنودهِ مضاعفة الإجرامِ فتغدو الدورية كضباعٍ متوحشة تودُّ ترسيخ بصمتِها بمداد الدم الأحمر، هكذا يُخاطبُ قائد الدورية جنوده: “يجبُ أن نقبضَ على أحدِ الرعيانِ أو على الأقلِ نختطف أبناءهم أو نَحرقَ شيئًا مَا”[8].
ولكأن القصة تُطالبُنا بأن نقيمَ قراءات ترابطية بين الحاضر والماضيِّ، أينَ يُظهرُ الجنديُّ الإسرائيلي شجاعتهُ المزعومةِ في التنكيلِ بجثةِ راعٍ أعزل أو إهانةِ امرأةٍ عزلاءِ بيد أن هرميةَ جسارتهِ تُسقط تِباعًا كلَّمَا ولجَ معركة حربية، ولو كانت غير متكافئةِ الطَّرفينِ.
وتظهرُ القصَّة شراهة الجنديِّ الإسرائيلي وهو يحملقُ في الخرافِ التي سيتذوَّق لحمهَا ويتمتع بإدامِها: أي طبقٍ لذيذ سيكونُ ذاك[9].
بينما هم يقودونَ الراعي المربوط بعقالهِ تستمرُّ الضحكات وتتداعى القهقهات، وخلال عملية الاستجواب التي تتداخل فيها الوحشية الجسدية بالقهر النفسيِّ، لا يسأل الراعيِّ إلا عن سيجارة يرمِّمُ بها وجدانهُ الخرب، وكأنَّه غير معنيٍّ بالحرب الجاريةِ: فيهِ سيجارة.. فيه سيجارة[10].
أطبق الراوي على الراعي العربيِّ سمات البلاهةِ والغفلةِ للإحالةِ إلى جهلهِ وعدم درايتهِ بالأحداثِ الدائرةِ حولهُ وهذا بلا شك يخالفُ الحقائق التاريخيَّة التي تمعنُ في بسالةِ الراعيِّ وحملهِ السلاح منذ أول موضعِ قدمٍ لليهودي الضَّال بأرض فلسطين.
كمَا لا ينفك الراوي في تصوير الراعي في هيئةِ رجلٍ عميلٍ تستهويهِ الوشايةِ، فحينَ يسأله الجنود أين رفاقك العرب لماذا ليسوا متواجدين هنا بالقريةِ، فيجيبُ الرَّاعي بسرعة: إنهم في العمل.
لقد جنحت هذهِ المروية السَّردية إلى نسفِ مآثر العرب عمومًا في كونهم أمَّة لا تعبأ بمصيرهَا الأمني والحضاري والسياسيِّ فكيفَ بالجندي الغازي يشقُّ الطَّريق ليعلو مآذنَهَا ويسيطر على قراهَا ويسيَّج أرضهَا بينما هي في العملِ غير متطلعةٍ لرفعِ السلاحِ وردِّ الخطر.
قصة السيِّد ماني وتميمة السُّخرية من العَرب.
يدلج القاص الإسرائيلي يهو شواع وهو من مواليد القدس سنة “1936” لحرمةِ التاريخ ارتضاءَ تسميمِ ِ المناخِ النضالي للعرب من خلالِ تلفيقهِ لقصة عنوانها السيد مانيِّ ضمن مقاربات التسوية الأممية التي تنص على ترسيمِ ِحدودِ الدَّولتينِ، وقبل ذلكَ يتورَّط السيِّد ماني مع القضاءِ الإنكليزي الذي اتهمه بالتحالفِ مع العرب والأتراكِ عقبَ اِنتصارهم في الحربِ العالميةِ الأولى.
وبناء على العريضةِ التي تقدم بها قاضٍ إنكليزي تبيَّن أن السيد ماني كان يقومُ بتحريضِ العربِ للنيلِ من الاحتلالِ الإنكليزي، فكان يُخاطبُ العرب واليهود على السَّواء: استيقظوا.. خُذوا هويتكم.. هذهِ الأرض هويتكم… هذهِ الأرضُ لنا ولكم ضد الإنكليز”[11].
وتظهرُ مخاتلات السيد ماني في سبيلِ إيهامِ العربِ وإحجامِهم عن الحقيقةِ حينَ يخرج من جيبهِ خريطة فلسطين ومقصًّا فيجتزئ لليهود السَّاحل والبحر ،ويترك للعربِ النصف المكون من سلاسلِ الجبالِ والأردن، تعكسُ هذهِ الواقعة حالةَ الهُزءِ والكوميديا التي تحاول الأطرافِ اليهودية صناعتَها للتهكم على سيرورة التفكير العربيِّ، وكأنَّنا أمام حكايةِ الأرعنِ والفلاحِ الذي اتفقَ معه يومَ زراعَةِ الجزر أن يأخذ هو ما فوقَ الأرضِ والثَّاني يأخذ ما تحت، فوافقَ الأبله الأرعن على القِسمةِ دون إعناتِ للنَّظر أو إشغالٍ لإحداثيات الفكرِ المتطهِّر من أدرانِ الغباء.
ويفتعلُ الراوي مذهبًا راديكاليا في السُّخرية من حماقةِ العربِ فهم بنظرهِ كالأولادِ الذين إن غضبوا من تملُّكِ اليهودي البحر والسَّاحل تباكوا وأظهروا الشَّتائم واللَّطائم، لكنَّه يستعيدُ رضاهم بمجردِ إعادةِ قصِّ الخريطةِ مرةٍ أخرى ومنحِ العرب البحر والسَّاحل.
وتزدحِمُ الأنساق الحكواتيَّة برائحتها العنصريَّة النتنة التي دأب اليهود تعاطيها نكاية في العربِ وانتقَاصًا من زادهم التاريخيِّ والحضاريِّ كقولِ الراوي: اليهودي يعرفُ كيف يحملُ القدس في قلبهِ وينتقل بها في العالم…”[12]
وبالتالي فهو يقرُّ بحتميةِ اليهود في احتواء بيتِ المقدس، وبعثِ مكتنفاتهِ إلى العالمِ أجمعِ في طمسٍ علنيِّ لفضل الأديانِ الأخرى عليهِ، وفي سياقٍ مجاور نلفي الراوي يحتقر لباس العرب بقولهِ: “وفي جبال السامرةِ لا توجد قرى فلاحين مسلمين متعصبين وفلاحاتِ مقنَّعاتٍ وحافياتٍ”[13] فهو بذلكَ يود إقناع القارئ بوميضِ الحضارةِ التي تشيع بين اليهود السَّامرةِ عكسَ الهمجية والابتعادِ عن الذوقِ الشكلي السَّليم في قرى العربِ.
ختامًا تبدو صورة العربيِّ في الأدب العبري كمرآةٍ متشظِّية هشَّمَها الغلُّ الإسرائيلي الطَّافح بأدواتِ المجاوزةِ والهيمنةِ، ومن ثمة فإنَّ كلَّ شظيَّةٍ تحملُ دمغة أدبية ماكرةً ما، تتراوحُ بين الهزءِ والسخريةِ من الشخصية العربية والعوراتِ الكبيرةِ التي تتخلل طبائِعهَا تارةً، والتَّحذيرِ من جمودِ عقلهِ وانسياقهِ للتطرفِ والإرهابِ تارةً أُخرى حينَ يستصعبُ عليهِ إيجاد الحلولِ المواتية لمشكلاتهِ.
[1] جيلا رامراز، العربي في الأدب الإسرائيليِّ، تر: نادية سليمان، إيهاب صالح، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2000، ص40
[3] جيلا رامراز، المرجع السابق، ص41.
[4] المشنا، القسم الثالث، ناشيم: النساء، تر: مصطفة عبد المعبود، دار طيبة الجيزة، ط1، 2008، 44
[5] جيلا رامراز، المرجع السابق، ص228
[6] جيلا رامراز، المرجع السابق، ص 229.
[8] صلاح حزين، صورة العربي في الأدب الإسرائيلي ما بعد 1948، مجلة مشارف، العدد:15، أبريل 1997، ص141
[11] عمر شبانة، لمن ترسم الحدود، 11 قصة عبرية إسرائيليَّة، مجلة الدراسات الفلسطينيَّة، المجلد:8، العدد”:30، ص 157.
__________
الكاتب: معطى الله محمد الأمين من الجزائر.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.