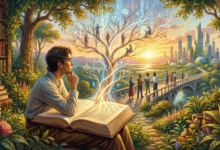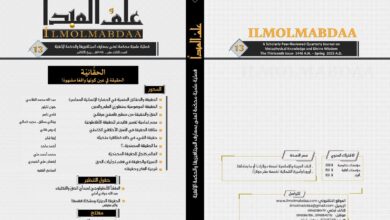نقاشات وسجالات حول أَصل الأخلاق؛ بين اسبينوزا وكانط وشوبنهاور ونيتشه ودوركهايم وبرغسون وفرويد

حينما نتحدث عن الإنسان، نتحدث بشكل مباشر عن مجموع الشروط التي تشرطه وتحده أثناء الفعل والسلوك، هذا الأخير هو ما يجعله مميزا عن الحيوان العادي الذي لا يفعل وينفعل بشكل غريزي فقط، ولهذا نجعل من الفعل الأخلاقي والقيمي الفعل المائز للإنسان كإنسان والذي يرتقي به من مستوى البهامة La bête إلى مستوى القيمة الغائية Une valeur de finalité
ولعل معنى كل هذا أن للفعل الإنساني بعد بمثابة شرط غائي هو البعد الأخلاقي والقيمي، حيث يصبح للإنسان شرطًا يشكل مُثُلاً أخلاقية سامية هي التي تعمل على توجيه وعقلنة سلوكاته كما تنظمها في خيط ناظم يجمع علاقته مع الآخرين.
لهذا تشكل الأخلاق مجموع القيم والمعايير والمبادئ والسنن والقواعد والأطر التي تتضمن القيم الإيجابية والمثل العليا السامية التي تشكل المستوى الأول الكابح للنوازع الشريرة والعدوانية Agressivité المتأصلة لدى بني البشر، ففي مقابل الإنسان كائن أخلاقي وقيمي بطبعه، هناك إنسان ذئب لأخيه الإنسان بتعبير توماس هوبز، أو إنسان مريض بالعدوانية بتعبير سيغموند فرويد، كما أننا نحاول دائماً أن نشترط في علاقتنا ونفترض الغير الذي هو أنا ليس أنا بتعبير جون بول سارتر، أن نفترض وجوده بمعنى أن نفعل الخير لأجله، ونتجنب الشر والإذاية لأجله أيضاً.
ولهذا إن كان طموح هذا الإنسان هو التحرر من كل الدوافع الغريزية التي تغرزه وهي فطرية فيه، كان عليه الدخول إلى هذا العالم الميتافيزيقي بمعنى المتعالي، والذي هو عالم مجرد سامي نطلق عليه إسم عالم الأخلاق والقيم أو عالم مملكة الغاياتRoyaume des finalité بتعبير كانط، وذلك كي يغدو هذا المتوحش-الإنسان كائناً أخلاقياً قيمياً، مع مراعاة كونه كائناً عاقلاً طبيعياً بتعبير كل من أرسطو وكانط ورسو.
ولكل هذا نجد أن القيم الأخلاقية هي الفرامل الحقيقية التي تفرمل وتكبح نزوة الإنسان من خلال منحه القواعد المعيارية الملائمة للتصرف، وتجيب عن سؤال كانط ماذا يجب علي أن أفعل ؟ ب يجب عليك فعل كذا وكذا وكذا … إلى آخره، كي لا تسقط في هيمنة الأهواء والنزوات وما قد يصدر عنها من عنف تجاه غيرك من جنسك.
لهذا يعمل مبحث الأخلاق والقيم على حماية الإنسان وتماسك المجتمع وتلاحمه، والحفاظ على الوجود، من خلال تأكيد بعض القيم وترسيخها، وتحديد الواجبات التي على فرد القيام بها سواء نحو ذاته أو نحو مجتمعه الذي يحتوي أغياره.
وفي حقيقة الأمر فإن كل ما يجب على المرء القيام به، قد يتحول هذا الذي يجب عليه، وما يلبث أن يصير تلقائياً لدرجة تصبح هذه الواجبات جاثمة على أفعاله مثل العادات؛ حيث يقول الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون في هذا الصدد : “إن الواجب يَجْثُمُ على إرادة الأفراد جُثُومَ العَادَةِ.”
بل قد يشعر في بعض الأحيان-وليس دائماً- تجاهها وهو يعيش [أي الإنسان] تجربته المعيشة بلغة هوسرل، بضغط هذه الواجبات وإكراهاتها، فيتجه صوب بناء ما قد يطلق عليه واجبات تكميلية أو تنضاف إلى السابقة، يضفي عليها صبغة الذاتية والعقلية، فيعمل جاهداً إلى الالتزام بها التزاما شرطياً لأنها ملزمة له، وذلك من خلال الوعي السَّؤُولُ والمريد بها.
كما قد يحاول هذا الإنسان في بعض الأحيان إلى جعلها واجبات متوافقة والكون، وتتفق والإطلاق ضديداً أو مجاوزةً للنسبية وشروط المجتمع المحلي الذي يشعر بفخر الإنتماء إليه.
وقد ناقش واختلف معظم الفلاسفة إن لم نقل جلهم وخاضوا نقاشات وسجالات وجدالات سرعان ما تحولت إلى حروب وعراكات فكرية، سنحاول عرض أوجه منها في هذا المقال، وكلها تصب في حقل الأخلاق والقيم وعلاقتها بالواجب والحرية والإرادة والرغبة والمجتمع ورهان تحقيق السعادة.
ذلك أن خلق التوازنات وتحقيق رضى النفس وراحتها أو تحقيق الهدوء والسكينة والطمأنينة وبلوغ السعادة باعتبارها غاية من غايات كل إنسان، ذلك أن هذا الأخير يحاول دائماً تمثل سعادته حسب مجموعة من الشروط سيكولوجية واجتماعية وثقافية ودينية وسياسية وإديولوجية وابستيمولوجية وتكنولوجية أيضاً، رغم أنني في الحقيقة أتحفظ على كل ما هو اجتماعي عبر التأكيد عليه ومراعاته نظراً لخطورته.
ذلك أننا في حقيقة الأمر، حينما نتحدث عن لفظ الحرية، نجد أنفسنا نتحدث عن لفظ جد ملتبس وغامض وغير واضح ودقيق بلغة ليبنتز، ولا يخلو من هذا الجدل، ذلك أن النقاش الفلسفي منذ بداءته انقسم إلى تيارين رئيسين، تيار يحتفي بالحرية وقوة الإرادة، وتيار يعتبر أن الإنسان خاضع للحتميات والاشراطات، وسنشير إليها في مقتضب المقال.
لكن ما يهمنا حالياً هو أن ننفتح بلغة برغسون على أفق وآفاق الفعل الإنساني مفترضين أنه فعل أخلاقي صرف، وننظر إليه من وجهة نظر القيم الإيجابية مع غض الطرف عن الشيم السلبية، وذلك من خلال التركيز على الخير والواجب والإرادة والسعادة والحرية وكل هذه تشكل نبيل الصفات والمثل العليا السامية والقيم التي تهفو إليها النفس الإنسانية.
كما أننا سنحاول أن نعيد النظر كذلك، في تلك النظرة السلبية والسالبة والتشييئية والمغرضة للأخلاق والقيم والتي تنظر لهذا الحقل نظرة لا تقل من احتقار وتنقيص واستهجان وظلم وتهميش، وهو ما يطرح علينا إعادة التساؤل في الحقيقة عن القيم وقيمة القيم بلغة المهدي المنجرة طيب الله ثراه، بل والتساؤل كذلك عن أصول كل أحكامنا وتصوراتنا الأخلاقية والقيمية ومدى مصداقيتها ودورها كذلك في تقييم وتقويم الفعل الإنساني وإبراز جوانبها المتعددة والمختلفة، خاصة عندما أصبحنا نتحدث عن أخلاقيات بصيغة الجمع بدل أخلاق بصيغة المفرد.
بنفس الإيقاع تقريباً سننطلق بادئين بأن تاريخ مبحث الأخلاق هو تاريخ البحث في قيمتي الخير والشر، أو الفضيلة والرذيلة، حيث كان يعتقد قديماً أن مصدرا كل الأخلاق والقيم إنما الآلهة، حيث كان الخَيِّرُ بائِناً والشَّرُّ بائناً أيضاً، وبلغتنا الحالية : “الحَلاَلُ بَيِّنٌ والْحَرَام بَيِّنٌ”، وكان من يفعل الخير يفعله لإرضاء الإله ومن يفعل الشر والإذاية فهو ظالم لنفسه، وهكذا يخبرنا الدكتور نجيب بلدي قائلاً :
” وقفت الفلسفة القديمة عند الفضيلة والفضائل، واهتمت بتعريفها وبإثبات أساسها في العقل والنظر، وإثبات غايتها وتمامها في الحكمة العقلية. ” [1] ، وهكذا ففي حقيقة الأمر كانت الفضيلة والفضائل يتم محاكاتها بأفعال وتصرفات الآلهة، فالإله فاضل وفضيل ويبتغي الخير والفضيلة والاعتدال بما هو حكمة عقلية إلهية، يجب علينا كذلك نحن البشر أن نطمح لذلك.
ويضيف أيضاً : ” لكن الفلاسفة المحدثين [مع كانط بالضبط] كانوا أشد انتباها لأوامر الضمير الأخلاقي فتحدثوا عن الواجبات، ونادراً ما تحدثوا عن الفضيلة.
ففضيلة القدماء موقف إنساني تام وكامل لا يحتاج فيه المرء إلى شيء غيره.. ” [2]، سينتبه كانط فيلسوف الواجب الأخلاقي، إلا أن مفهوم الفضيلة والخير مفهوم كامل ومتكامل وتام لا يحتاج إلى أي شيءٍ، وأننا إذا تحدثنا عنه، لن نأتي بأي جديد يذكر، حيث سنظل ندور مكاننا، لهذا سيقوم بثورة كوبرنيكية عظيمة، هذه المرة في حقل الأخلاق والقيم، بمجاوزة الحديث عن مفهوم الفضيلة والخير إلى الحديث عن مفهوم الواجب الأخلاقي. هكذا ” أما الواجب فهو يوحي بشيء مطلق أي بأمر صادر لجميع الناس بدون تخصيص في الزمن أو المناسبة أو الغرض، إنه أمر وأمر فحسب. ” [3]، هكذا فبما أن مفهوم الفضيلة والخير مفهوم كامل ومتكامل وتام، ونسبي أيضاً، حيث أن مفهوم الخير يتغير ويتحول ويصير من مجتمع إلى آخر، يجب مجاوزته إلى مفهوم قد يوحي بشيء مطلق أي بأمر صادر يصدق على جميع البشر بدون استثناء، وما كان لهذا الأمر المطلق الكانطي أن يكون سوى: أمر ذاتي داخلي قطعي تمت صياغته بشكل صوري مجرد، وقد وضعه كانط باعتباره المبدأ الأخلاقي الأسمى، وصاغه كالآتي:
“تَصَرَّفْ على نَحْوٍ تُعَامِلُ مَعَهُ الإِنْسَانيَّةِ في شَخْصِكَ، كما في شَخْصِ غَيْرِكَ، دائماً وأبداً، كغَايَةٍ ولَيْسَ مُجَرَّدَ وَسِيلَةٍ بِالبَتَّةِ”. وقد ورد في كتابه أسس ميتافيزيقا الأخلاق. ذلك أن كانط والذي يعتبر فيلسوف أو مبدع مفهوم الواجب الأخلاقي بلغة دولوز بإمتياز، حيث نجد له تصريحاً شارخاً وصارخاً يعلن فيه بقوله: “أيها الواجب! أيها الاسم الأعظم والأسمى، أنت الذي ليس من ميزاتك أي إطراء أو لطف، بل تطالب بالامتثال دون أن تلجأ إلى التهديدات لإثارة الاشمئزاز والرعب بغية زحزحة الإرادة؛ وإنما تكتفي باقتراح قانون يسري في النفس تلقائيا، وقوة تدفع إلى الاحترام (إن لم نقل تدفع دوماً إلى الطاعة)، والتي تنحني أمامها الميول رغم أنها تعمل على مواجهتها في الخفاء.” [4].
بهذا يكون الواجب الأخلاقي هو أمر مطلق ذاتي قطعي يتأسس على العقل العملي الخالص والمحض الذي يستلزم منا القيام بمجموعة من السلوكيات والتصرفات والأفعال تلك المتعلقة بقيم أخلاقية حقيقية مثلى كالاحترام والصداقة والإعجاب والامتثال والالتزام بالقانون، فهو بمثابة واجب عسكري ووازع ينبعث أو مصدره الضمير الباطني ويملي على الشخص نوعاً من الالتزام وذلك بقصد القيام بمجموعة من الأفعال الأخلاقية والقيمية الفاضلة دائماً، والتي تتأسس أو تقعد للاحترام وحدوث الإعجاب والتقدير.
لهذا سنجد أن إريك فايل الذي يمكن عده من المتخصصين في فلسفة الأخلاق يصرح معلقاً على كانط : “يشكل الواجب المقولة الأساسية والوحيدة للأخلاق (…).
لا يحتاج أحد منا إلى مصنف في الأخلاق ليتعلم بأنه يمنع عليه القتل والسرقة، وبأن عليه إرجاع الأمانة إلى أصحابها.” [5]، وتجذر الإشارة هنا إلى أن كانط أيضاً قد صرح في مقام آخر من كتابه أسس ميتافيزيقا الأخلاق إلى أنه ليكون المرء كائناً أخلاقياً لا يحتاج منه ذلك لا إلى فلسفة أو علم أو أية معرفة بالأخلاق.
كما أن كانط بالمناسبة هو الفيلسوف الذي يرفض وبشدة، إن لم نقل أنه يوجه نقوداً لاذغة لكل الأهواء والنزوات والميولات والغرائز والشهوات والرغبات والنزعات والأحاسيس والمشاعر والانفعالات ويضفي عليها صفة أو خاصية الشرطية التي هي صفة تشرطها وتضع لها حداً يحدها، حيث يقول في هذا الصدد : “إن كل الموضوعات التي تتعلق بها الميول أو تتجه نحوها ليست لها إلا قيمة مشروطة.” [6] .
عكس كانط تماماً، وفي حقيقة الأمر تعمدت مقابلة كانط بفيلسوف الرغبة المتعارض معه، أقصد هنا فيلسوف الإنسان بوصفه كائناً راغباً باروخ اسبينوزا الذي وضع تعريفاً شهيراً للرغبة يقول فيه : “أعني بالرغبة إذن كل المجهودات والاندفعات والشهوات والأفعال الإرادية لدى الإنسان، وهي تتغير وفق تغير حالات الإنسان ذاته، كما أنها تكون في الغالب متعارضة مع بعضها البعض، إلى حد أن الإنسان يصبح موزعاً في اتجاهات مختلفة تجعله لا يعرف إلى أين سيتجه.” [7]. بل وأكثر من ذلك لا يستحي اسبينوزا بقوله الإنسان كائن راغب بإمتياز، بل يضيف بأن الرغبة هي ما تحدد ماهية وحقيقة وجوهر الإنسان الثابت، الشيء الذي يمقت منه كانط، وحاول فيما سبق الرد والتعليق عنه، لكن سيضيف اسبينوزا قائلاً وبأسلوب ساخر هذه المرة : “الرغبة هي الشهوة مع وعي بذاتها.
وبالتالي يتقرر بعد كل ذلك أننا لا نسعى إلى شيء، ولا نريده، ولا نشتهيه، ولا نرغب فيه، لأننا نعتقد أنه حسن؛ بل نحن، على العكس من ذلك، نحكم على شيء بأنه حسن لأننا نسعى إليه، ونريده، ونشتهيه ونرغب فيه.” [8]، هذه الرغبة التي هي شهوة مع وعي بذاتها تصبح لدى اسبينوزا هي المحدد الأصلي لحقيقة وهوية الإنسان الذي بالنسبة إليه كائن راغب بإمتياز، وهكذا “إن الرغبة تتعلق عموماً بأفراد الإنسان من حيث أنهم يَعُونَ شهواتهم، ولذلك يمكن تعريفها كما يلي: “الرغبة هي الشهوة المصحوبة بوعي بذاتها”. ” [9]، هكذا نكون قد حددنا ماهية وحقيقة الإنسان لدى اسبينوزا وبينا كذلك رفض كانط لكل هذه الرغبات.
بعد جدال/سجال كانط/اسبينوزا، سيدخل على الخط فيلسوف التشاؤم الألماني أرثور شوبنهاور حيث يدافع هذه المرة عن أطروحة تناقض كل من اسبينوزا وكانط، وتجذر الإشارة هنا أن اسبينوزا أسبق زمنيا من كانط، إلا أننا وضعنا كانط أولاً ناقداً ورافضاً لكل الميولات والرغبات التي يعتبرها ميوعات مشروطة، في مواجهة مع اسبينوزا الذي يعرف الانسان بالكائن الراغب، وكلاهما في مواجهة خصمهما اللذوذ، أقصد هنا شوبنهاور الذي يقول إن : ” كل رغبة تنشأ عن نقص، أي عن حالة لا ترضينا؛ إذن الرغبة ألم، طالما أنها رغبة لم تتم بإشباعها. والحال أنه لا وجود لإشباع دائم للرغبة؛ وليس الإشباع إلا نقطة انطلاق لرغبة جديدة. ” [10]، وبهذا يواجه شوبنهاور كلا من خصميه اللذوذان اسبينوزا وكانط ويعتبر أن “الرغبة نقص دائم”.
وهكذا أصبح لدينا ثلاث تصورات مهمة كالآتي:
- اسبينوزا: “الإنسان كائن راغب”.
- كانط: “رفض كل الميولات والرغبات والنزعات والغرائز والشهوات والأفعال والانفعالات”
- شوبنهاور: “الرغبة نقص دائم”
لكن هذا لا ينسينا إحدى التصورات الغريبة الأطوار صراحة لموقف فيلسوف التشاؤم الألماني أرثور شوبنهاور الذي يعتبر أن “الذَّاتُ الْحَقِيقِيَّةِ […]، وهي التي لا تعرف في قَرَارَاتِهَا غَيْرَ شَيْئَيْنَ : أَنْ تُرِيدَ أَوْ لاَ تُرِيدَ.”[11]، وهكذا يصبح المرء أمام قرارين متناقضين في الحقيقة، ف “إما أن تريد أو لا تريد” وتفضيل أحدهما أو اختيار على الآخر مسألة صعبة جداً، إن لم نقل مستحيلة، ذلك أن المرء يفضل أن يحتفظ بهما معاً على ألا يتركهما معا، أو يختار أو أن يفضل الأول عن الثاني، أو الثاني عن الأول، هكذا الإنسان هو كائن التناقض Être contradictoire.
لكن بعد اسبينوزا وكانط وشوبنهاور ننتقل الآن إلى الفيلسوف المطرقة، أو صاحب جينيالوجيا الأخلاق الذي يعتبر كانط مجرد قسيسا ورجل دين يدعوا لأخلاق المسيحية والذي بالمناسبة دخل معه في صراع وجدال وسجال حاد جداً بخصوص الأمر المطلق، حيث يخبرنا العظيم نيتشه أنه في إطار أو سياق علاقة “الدائن والمدين” نشأت كل أحكامنا وتصوراتنا الأخلاقية، وذلك عندما قال :
“بفضْلِ الْعِقَابِ المُوَجَّهِ لِلْمُدِينِ ينال الدائن حَظَّهُ من حَق السَّادَةِ، ذلك أنه يشعر في نهاية المطاف بذلك الإحسَاسِ المُشَرِّفِ النَّاجِمِ عن تمكنه من احْتِقَارِ وإِهَانَةِ مَخْلُوقٍ [ ضعيف أي الْمُدِينُ لَهُ] باعتباره شَيْئاً <<أَدْنَى مِنْهُ>>، […] من خلال رؤية هذا المخلوق [الْمُدِينُ لَهُ دائماً] مُحْتَقَراً وَمُهِيناً، والتَّعْوِيضُ إذن دَعَوَةٌ لِمُمَارَسَةِ القُسْوَةِ، كما أنه يعطي الحق في ممارستها.
في نطاق قانون الالتزام هذا [أي في سياق علاقة الدَّائِنُ بالْمُدِينِ لَهُ] يكمن أصل كل التَّصَوُرَاتِ والأَحْكَامِ الأخْلاَقِيَّةِ مثل << الخَطَإِ >> و << الضَّمِيرِ >> و << الوَاجِبِ >> و << قُدْسِيَّةُ الْوَاجِبِ >> ، ومثلها مثل كل شيء عظيم فوق هذه الأرض، فقد رَوَتْهَا في بدايتها دماءٌ كثيرة ردحا طويلاً من الزَّمَنِ. ينبغي أن نضيف أن هذا العالم من التصورات لم يفقد يوماً ما رائحة الدَّمِ والتَّعْذِيبِ (حتى الأمر المطلق الذي يقول به كانط نجد فيه أَثَراً من الْقُسْوَةِ). ” [12]، وهذا نقد عميق للأمر الأخلاقي الكانطي الفارغ بلغة شوبنهاور والقاسي بلغة نيتشه، فيكون بذلك نيتشه قد وجه بمطرقته الضربة القاضية عبر دق آخر نعش لأخلاق كانط المسيحية وهدمها من الأساس الذي يختص نيتشه بحفره دائماً.
لكن لا يجب علينا أن ننسى أنه رغم صورية وتجريدية كانط، إلا أن لديه تصور خاص للسعادة حيث يرى “أن مفهوم السعادة مفهوم غير محدد بدقة، فرغم وجود رغبة لدى كل إنسان لكي يصبح سعيداً، فليس بوسع أي شخص أن يُفْصِحَ عَمَّا يَرْغَبُ فيه وعَمَّا يُرِيدُهُ بِكَلِمات دقيقة ومضبوطة.” [13]، وهذا في حقيقة الأمر إقرار على استحالة السعادة الحقيقية، أو أنه إعلان صريح على أنه لا وجود للسعادة ولا يمكن أن توجد اللهم في حياة أخرى، أما هنا فهي غير ممكنة، وعلى المرء أن يحاول وفقط أن يكون جديراً بالسعادة دون ادعاء امتلاكها، وهذا الموقف السلبي للسعادة، سيرفضه العديد من الفلاسفة الذين دخلوا في نقاش حاد وجدال وسجال مع كانط ولعل أبرزهم فيلسوف فن عيش الحياة سينيكا الذي صرح قائلاً : ” يمكن إعتبار إنسان ما سعيداً، فقط إذا كان خالياً من الرغبات والخوف. “، وهكذا يمكن للمرء أن يكون سعيداً ويظفر بالسعادة والهناء التام، لكن شريطة تخلصه من الخوف والرغبات والنزعات والغرائز والشهوات والأفعال والانفعالات والنزوات والميولات عموماً.
أما عن الفيلسوف الفرنسي إيميل شارتييه المعروف بالاسم المستعار آلان، والذي اشتهر بعقلانيته الفذة، ويكتب الأحاديث يقول : ” إذا بحثت عن السعادة في العالم الخارجي وخارج ذاتك عموماً، فلن تجد شيئاً يحمل خاصية السعادة. “، حيث تصبح السعادة لديه لصيقة الذات الداخلية للإنسان، وسيرد الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو قائلاً : ” كل إنسان يريد أن يكون سعيداً، ولكي يغدو كذلك، عليه أن يبدأ أولاً بمعرفة ما هي السعادة. “، ولهذا فالبحث عن دلالات مفهوم السعادة، وتحديدها بدقة، قد يجعلنا نصل إلى حقيقة السعادة وبهذا نصبح سعداء.
أما الفيلسوف الألماني أرثور شوبنهاور الذي بالمناسبة الخصيم العنيد لكل من كانط وهيغل، بل اعتبر أن الأمر المطلق الكانطي أمر فارغ، سيقول : “إن السعادة بوصفها إشباعاً [لرغبة ما أو لكل أنواع الرغبات]، كما يرى معظم أنواع الناس، ليست في الحقيقة وفي ماهيتها، سوى شيء سلبي.
(…) بل نقصد كل أنواع الرغبات، والتي بسبب إلْحَاحِيَتِهَا، [على إشباعها]، تزعج راحتنا، بل إنها هذا السَّأْمُ الذي يقتلنا.” [14]، وعلى خطى سينيكا سيعتبر شوبنهاور أن السعادة المشبعة للرغبات هي سأم يقتلنا، وليست في حقيقتها سوى شيء سلبي !
ولهذا نجد أن كانط سيعتبر أن مفهوم السعادة عبارة عن مثال أسمى، لا وجود له في الواقع ولا يمكن أن يوجد، نقرأ معه: “إن السعادة تصور بلغ من عدم التحديد مبلغا لا يستطيع معه شخص أبداً -رغم الرغبة التي لدى كل إنسان في الوصول إلى أن يكون سعيداً- أن يقول في ألفاظ دقيقة ومتلائمة ما يرغب فيه وما يرومه على الحقيقة.
(…) ذلكم لأن السعادة هي مَثَلٌ Idéal أعْلَى، لاَ لِلْعَقْلِ، بلْ لِلْخَيالِ.” [15].
حيث السعادة تندر بأنها غير موجودة في هذا العالم، بل هي تندرج في عالم الخيال أو مثال للخيال Idéal imagination.
سننتقل الآن إلى مفهوم الواجب الأخلاقي والنقاشات المثارة حوله حيث يقول برغسون عنه بالمناسبة أن : ” الالتزام بالواجب حرية. ” أما الفيلسوف إيميل شارتييه أو المعروف بالاسم المستعار آلان سيقول عنه أن : “أصعب ما في الواجب هو القيام به”، لكن رغم كل هذا لا ننسى أن برغسون يعتبر: “أن الواجب يَجْثُمُ على إرادة الأفراد جُثُومَ العَادَةِ.”، وقبل عودتنا إلى برغسون الذي سنتطرق إلى تصوره بشكل مفصل، نذهب أولاً إلى التعرف على التصور السوسيولوجي للواجب الأخلاقي، والذي نفترضه كتوطئة أو أرضية لفهم تصور هنري برغسون، وذلك من خلال عرض تصور إيميل دوركهايم أولاً الذي صرح بقوله :
“لقد رأينا أن المجتمع هو الغاية الأسمى لكل نشاط أخلاقي.
أولا لأن هذه الغاية تتجاوز وعي الأفراد. وثانياً، لأن تلك الغاية تحمل سلطة أخلاقية تفرض الاحترام:
1- المجتمع يتجاوز وعي الأفراد، فهو بمثابة هدف متعالٍ. […]، المجتمع وحده هو الذي يعتبر شيئاً آخر غير القوة المادية، إنه قوة أخلاقية كبيرة… […].
2- ولكن المجتمع أيضاً هو سلطة أخلاقية في الوقت نفسه.” [16]، هذا التصور السوسيولوجي للواجب الأخلاقي والذي يعطي قيمة وأولوية للمجتمع على حساب الفرد، أو على حساب الذاتية الكانطية القطعية والآمرة.
ولكي لا نذهب بعيداً عن إيميل دوركهايم، ونبقى ندور في وسط متنه الفلسفي، سنجده يعبر في مقام آخر عن نفس تصوره تقريباً حيث يعبر عنه قائلاً : “في كل مرة نَتَدَبَّرَ فيها لِنَعْلَمَ كَيْف يَجِبُ علينا أن نَسْلُكَ؟ نجد صوتاً يتكلم فينا وَيُهِيبُ بِنَا قائلاً: هذا هو واجِبُكَ. (…) . أما تلك الحقيقة، فهي الْمُجْتَمَعُ الَّذِي بَثَّ فينا، حين عَمِلَ على تَكْوِينِنَا خُلُقِياً (عبر التربية الخُلُقِيَّةِ)، تلك المشاعر التي تملي علينا سلوكنا بلهجة آمِرَةٍ صَارِمَةٍ، أو تَثُورَ علينا بمثل هذه القوة عندما نأبى أن نمتثل لأوامرها.
فضميرنا الأخلاقي لم يَنْتُجِ إِلاَّ عن المجْتَمَع ولاَ يُعَبِّرُ إلاَّ عَنْه، وإذا تكلم ضميرنا، فإنما يردد صوت المُجْتَمَعِ فينا. ولا شك في أن اللهجة التي يتكلم بها خير دليل على السلطة الهائلة التي يتمتع بها.” [17]، وفي حقيقة الأمر نعتبر أن إيميل دوركهايم أجاب عن السؤال الكانطي ماذا يجب علي أن أفعل؟ بإجابته عن سؤال آخر قريب منه كيف يجب علي أن أسلك؟ فيجيب أننا نسلك وفق الطريق الذي اختاره لنا المجتمع!
وهو نفس التصور تقريباً الذي يدافع عنه الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون، لدرجة أننا حينما نقرأ هذه الفقرة، يصعب علينا تحديد من قالها أ دوركهايم أم برغسون الذي عبر قائلاً : “إن المجتمع هو الذي يرسم للفرد مناهج حياته اليومية. (…) فالمجتمع قد رسم لنا الطريق، فما يسعنا، إذ نجده مفتوحاً، إلا أن نَتَّبِعَهُ ونسير فيه.” [18]، وفي حقيقة الأمر فإن كتابه منبعا الأخلاق والدين الذي نشر سنة 1932، والذي يشكل بالمناسبة آخر ما كتبه هنري برغسون ، والذي يتناول فيه، وبطريقة تحليلية، لحظتين يشكلان أساسين في تطور كل من الأخلاق والدين، لن نتطرق لهذا الأخير، لأنه ليس موضوع بحثنا، بل سنكتفي بالإشارة إلى الأخلاق، حيث تشكل اللحظة الأولى لحظة الانغلاق، بينما تشكل الثانية لحظة الانفتاح. وفي الفصل الأول من الكتاب المعنون ب الإلزام الأخلاقي، والمخصص في الأساس للأخلاق، يعالج “برغسون” كلا من الأخلاق المنغلقة التي هي أخلاق تخضع لضغط المجتمع وواجباته المحدودة وذات طابع سكوني ثابت والتي تصبح مجرد عادات وتقاليد وطقوس وسلوكات وتصرفات تقليدية عند الأفراد.
أما الأخلاق المفتوحة في تلك الأخلاق التي تنتمي إلى المجتمع المفتوح والذي تسود فيه أخلاق لا تخضع لواجبات المجتمع فقط، بل تتجاوزها نحو أفق فلسفي أرحب وأوسع، نحو أفق الإنسانية جمعاء.
ولهذا يتساءل هنري برغسون في نفس الكتاب قائلاً :
“ماذا عسى أن تكون عليه طفولتنا لَوْ تُرِكْنَا وشَأْنَنَا آنَذَاكَ؟”
ويجيب : “كنا سننتقل من متعة إلى أخرى، لكننا كنا سنواجه الْمَنْعَ كحاجز غير مَرْئِيِّ وغير مَلمُوسٍ.” [19]. ويعتبر هذا السؤال الفلسفي الذي يتبين أنه سهل وواضح وبديهي، لكنه في عمقه لا يخلو من معاني ودلالات تحمل في طياتها احالات ثقيلة المعنى والحمولة، وتعبر عن حقيقة الفعل الأخلاقي والقيمي الإنساني.
لكن رغم قوة التصور السوسيولوجي للواجب الأخلاقي، إلا أن هناك تصور سيكولوجي يعتبر هو الأقوى منه، والذي يحمل أيضاً دلالات وحمولات ثقيلة المعاني، وهو الذي يمثله الطبيب والمحلل النفسي النمساوي سيغموند فرويد الذي سيعبر عنه في رائعته القَيِّمَةُ التي عنونها ب “قلق في الحضارة”، حيث نقرأ لديه :
” إن الإحساس بالذنب، وقساوة الأنا الأعلى، وصرامة الضمير الأخلاقي، كلها شيء واحد.
إن الإحساس بالذنب هو تعبير عن إدراك الأنا لكونه خاضعاً للمراقبة من طرف الأنا الأعلى، كما أنه تعبير عن مقدار التوتر القائم بين ميولات الأنا ومتطلبات الأنا الأعلى، وكذا عن القلق النفسي التي يتولد في النفس أمام هذه الهيئة النقدية [يقصد الأنا الأعلى] التي تشمل كل علاقات الفرد.
أما الشعور بالحاجة إلى العقاب فهو تعبير عن الدوافع الكامنة في الأنا الذي يصبح مَازُوشِياً (مُتَقَبِّلاً للتَّعْنِيفِ) بسبب شدة تأثير الأنا الأعلى الذي أصبح سَادِياً (مُمَارِساً للتَّعْنِيفِ).
وبعبارة أخرى فإن الأنا يستعمل جزءاً من الطَّاقَةِ النَّفْسِيَّةِ الدَّاخِليَّةِ الهَدَّامَةِ التي هي كامنة فيه، من أجل إقامة علاقة شَبَقِيَّةٍ [شبقي Erotique: ويقصد به كل ما يتعلق باللذة الجسمية وخاصة اللذة الجنسية.] أو عِشْقِيَّةٍ مع الأنا الأعلى.
(…) مشاعر الذنب هاته هي إذن التعبير المباشر عن القلق الذي تشعر به الذات أمام السلطة الخارجية، وشاهد على وجود توتر بين الذات وبين هذه السلطة الخارجية، وهي كذلك إحدى بقايا أو علامات وجود صراع أو أزمة بين الحاجة إلى أن يكون المرء محبوبا من طرف هذه السلطة الخارجية وبين ذلك الاندفاع نحو إشباع وتلبية حاجات الدوافع الغريزية التي يؤدي حرمانها من الإشباع إلى توليد ميل نحو العدوانية. ” [20].
تحتاج منا هذه الفقرة لوحدها مقالاً آخر لنشرحها فيه نظراً لأهميتها وراهنتيها، لكن سنحاول فقط الإشارة إلى الدلالات التي تحملها بإشارة سريعة، حيث:
■ يرجع الإحساس بالذنب والقساوة إلى الضمير الأخلاقي الذي يشكل الأنا الأعلى في جهازه النفسي الشهير.
■ مراقبة الأنا الأعلى لكل تصرفات الأنا.
■ هناك توتر قائم بين الأنا والأنا الأعلى الذي يشكل كما قلنا ضمائرنا الأخلاقية.
■ الأنا الأعلى هي هيئة نقدية تشمل كل علاقات الفرد سواء مع ذاته أو مع الآخرين.
■ الشعور بالحاجة إلى العقاب هو شعور الأنا الذي يصبح مازوشيا متقبلا للعنف، وبهذا فالمازوشية هي شعور ورغبة بالعنف ينمو لدى الفرد عندما يتعرض لضغوط الأنا الأعلى.
■ الأنا الأعلى يشكل مصدر ضغط وإكراه وإلزام على الفرد ويمارس عليه نوعا من التعنيف الداخلي دائماً
■ الأنا الأعلى له طاقة نفسية داخلية كامنة فيه، تجعله يضغط على الأنا من أجل إقامة علاقة جنسية معه.
■ مشاعر الذنب هاته هي المسؤولة عن كل أنواع القلق.
■ هناك أيضاً توتر قائم بين الذات والسلطة الخارجية(المجتمع) .
■ رغبة المرء في أن يكون محبوبا من طرف السلطة الخارجية أي المجتمع.
■ الميل نحو إشباع وتلبية الحاجات الغريزية التي يؤدي حرمانها إلى ميل نحو العداونية.
على سبيل الختم، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي كان عبارة عن نقاش نقدي وجدال وسجال حول أصل الأخلاق التي لازالت، إلى الآن، إحدى المباحث الأساسية التي اهتمت بها الفلسفة، وهو بالمناسبة مبحث نظري صرف ومعياري، تكمن وظيفته في تحديد مجموع المعايير والقيم العليا الموجهة للفعل الإنساني الذي قلنا في مقدمتنا أنه فعل أخلاقي وقيمي محض، ولعل أبرز هاته النقاشات الفلسفية بين كل من اسبينوزا وكانط وشوبنهاور ونيتشه ودوركهايم وبرغسون وفرويد، حاولت جاهدةً إلى هدف ورسم غايات أو محركات هذا الفعل، حيث مع كانط كان الفعل الأخلاقي فعلٌ ذاتي داخلي قطعي وخالص، ومع دوركهايم وبرغسون أصبح الفعل الأخلاقي فعلاً اجتماعياً بإمتياز، عكس فرويد الذي جعل منه فعلاً داخلياً لاشعورياً يحكمه ويشرطه الأنا الأعلى الذي هو نفسه الضمير الأخلاقي.
ولهذا نقول إن الأخلاق، عندما تضع معايير وقواعد الفعل الأخلاقي والقيمي، وتحدد غاياته وحدوده، فإنها تتيح، أو ينبغي عليها أن تتيح للإنسان، وداخل شرطي الإلزام الداخلي والالتزام الخارجي، بأن يختار بنفسه ولنفسه أسلوب حياته الأخلاقية الخاصة به لنفسه، ما دامت هذه الحياة في ذاتها مجرد تجربة ونمطاً للعيش.
البيبليوغرافيا:
[1]-[2]-[3]- نجيب بلدي، مراحل الفكر الأخلاقي، القاهرة، دار المعارف، 1960، ص. 42.
[4]- Kant, Critique de la raison pratique, traduction française. F. Picavet, PUF, 1976, p. 91.
[5]- Eric weil, Philosophie morale, Vrin, 1992, p : 85.
[6]- E, Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduction française. Victer Delbos, Librairie Delagrave, Paris 1971, p 48.
[7]- Spinoza, Définitions des sentiments, traduction française, R.guillois, Pléiade, Gallimard, 1954, p 526.
[8]- Spinoza, L’Ethique, traduction. française, Guérinot, Vrin, 1993, proposition 7 et scolie de la proposition 8, de la 3 éme partie.
[9]- باروخ اسبينوزا، علم الأخلاق III و IV، ترجمة جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر – تونس، بدون تاريخ، ص: 172.
-[10] A. Schopenhouer, Le monde comme volonté et comme représentation, PUF, 1996, p 323.
-[11] Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, traduction française Bourdo, MGF, 1966, p: 943.
[12]- فريدريك نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ترجمة محمد الناجي، أفريقيا الشرق-المغرب، 2006، ص : 56، بتصرف.
[13]- Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduction française. Victor Delbos, éd.CERES 1994, p94.
[14]- أرثور شوبنهاور، العالم بوصفه إرادة وتمثلاً، ترجمة بوردو، م.ج.ف. 1966، ص: 403.
[15]- إمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1970، ص: 102-104، بتصرف.
[16]- E. Durkheim, Sociologie et philosophie, PUF, 1963, pp. 77-78.
[17]- إميل دوركهايم، التربية الأخلاقية، ترجمة محمد بدوي، دار مصر للطباعة والنشر، بدون ذكر تاريخ، ص 87-88، بتصرف.
[18]- هنري برغسون، منبعا الأخلاق والدين، ترجمة سامي الدروبي، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، 1984، ص : 46-56.
[19]- H. Bergson, Les deux sources de la moral et de la religion, PUF, 2003, p 21.
-[20] S. Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, 1980, p. 79.
محمد فرَّاح، حاصل على شهادة الإجازة في التربية: تخصص التعليم الثانوي التأهيلي-الفلسفة، من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط عن جامعة محمد الخامس بالرباط.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.