سؤال المكان: القيمة المعنويَّة والموضوعيَّة للانتماء والهويَّة
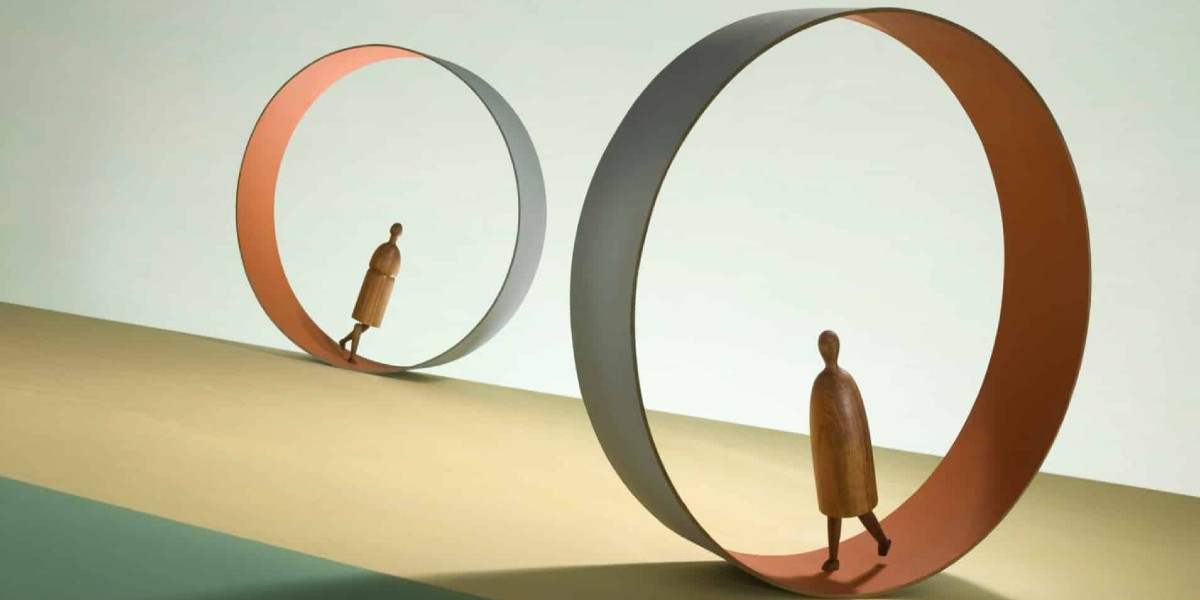
أدبيات المكان:
تُوجد مجموعة واسعة ومتنامية من الأدبيات، التي تستكشف طبيعة الفروق الدقيقة في العلاقات العاطفية للناس في “المكان”، التي تشمل كتابات عن “الإحساس بالمكان” و”الارتباط بالمكان” و”هوية المكان”. وتُشير مراجعة هذه الأدبيات إلى أنه في حين يتم تعريف هذه المفاهيم ومناقشتها على نطاق واسع من الناحية النظرية، فإن تطبيقها في البحث لا يشمل بشكل كامل جميع الأبعاد المهمة، التي تقترحها. وبالتالي، يركز البحث التجريبي، المتأثر بمفهوم “المنزل”، على البيئات السكنية والتأثير الإيجابي والنظرة غير المسيسة للتجارب الفردية، ويهمل غيرها. وقد حَدَّ هذا من فهمنا لظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، التي تتطلب دمج الحجم الكامل للتجارب الإنسانية بشكل أفضل في الخطاب الحالي حول العلاقات بين الناس و”المكان”.
وبالتالي، نرى أنه من الضروري التركيز على العديد من نقاط القوة في الأدبيات، التي تتطلب مزيدًا من التحقيق، لأن العلاقات العاطفية للناس بـ”الأماكن” تشمل مجموعة واسعة من الإعدادات والعواطف الجسدية. كما أن علاقات الناس بهذه “الأماكن” هي ظاهرة ديناميكية دائمة التغير، وعلى هذا النحو، يمكن أن تكون عملية واعية حيث يكون فيها الناس صانعين نشطين لحياتهم، ولأن علاقات الناس العاطفية بهذه “الأماكن” توجد داخل بيئة اجتماعية وسياسية أكبر من التصورات المُتَسَرِّعَة.
ولعقود من الزمان، استكشف علماء من مجموعة متنوعة من التخصصات العلاقات العاطفية للناس بـ”المكان”. فظهرت العديد من المفاهيم الرئيسة، كما أسلفنا، في هذه الأدبيات، ولا سيما “الإحساس بالمكان”، ومُضافًا إليها “مرفق المكان”، و”الاعتماد على المكان”. وعلى هذا الأساس، تُعَرَّفُ هذه المفاهيم على نطاق واسع؛ على سبيل المثال، بالوظيفة، أو الأهمية، إذ يوصف “الإحساس بالمكان” بأنه عملية تجريبية تم إنشاؤها بواسطة الإعداد، جنبًا إلى جنب مع ما يجلبه الشخص إليه. ويُعتبرُ “ارتباط المكان” مُعَادِلٌ لارتباط الناس بهذا “المكان”. وفي الوقت نفسه، يوصف الاعتماد على “المكان” بأنه القوة المُتَصَوُّرَة للارتباط بين الشخص و”الأماكن” المحددة، التي تُعَرِّف “هوية المكان” على أنها “أبعاد الذات”، والتي تتطور فيما يتعلق بالبيئة المادية. وفي حين أن كل هذه المفاهيم تتناول علاقات الناس بهذه “الأماكن”، فإن العلاقة الدقيقة بينهما لا تزال غير واضحة، لأن البعض ما يزالون يجادلون بأن “الإحساس بالمكان” و”تبعية المكان” و”هوية المكان” هي أشكال من التعلق بـ”المكان”.
ويؤكد آخرون أن “الإحساس بالمكان” أوسع من “التعلق بالمكان”. فيما لا يزال آخرون يشعرون أن “ارتباط المكان” يركز على تقييمات “الأماكن”، بينما تهتم “هوية المكان” أكثر بالطريقة، التي تشكل بها “الأماكن” أصول “الهوية”، لأن “ارتباط المكان” يطور ويدعم “هوية المكان”. وتميل بعض الأدبيات أيضًا إلى التركيز على “المكان” كمصدر للجذور والانتماء واقتناص فرص الراحة، وتوضح بذلك تعقيد ومرونة علاقات الناس بـ”الأماكن” من خلال الكشف عن كيف أنها، كعلاقات ديناميكية، ستشمل بالضرورة مجموعة من “الأماكن” والمشاعر والتجارب. هذا هو المنظور، الذي تؤكد عليه الأبحاث الحديثة، التي قد لا يتسع المجال لإيراد الكثير من تفاصيلها في هذه العُجَالة، فيما تُشير ما بين أيدينا من هذه الأدبيات إلى أن العلاقات مع “المكان” يمكن أن يكون لها طبيعة سياسية مشتركة وواعية، وربما متنازع عليها. وبقدر ما تتناول هذه المفاهيم العلاقات العاطفية بـ”الأماكن”، يحدونا أمل في أن نتمكن من مراجعة كل هذه الأدبيات، وفي هذه المجالات المذكورة هنا، في سلسلة قد تمتد من المقالات، حتى نستطيع فحص وفهم واقعنا المتغير بصورة أفضل.
ذاكرة الأماكن:
وبما أن تركيز جهود التخصصات الثلاثة؛ التاريخ والاجتماع والنفس، ينصب على “ذاكرة الأماكن”، فإن السؤال الملح، الذي يمكن أن يطاردهم، يتعلق بدور السمات المادية المحفوظة لـ”الأماكن”، التي تحتضن “التذكارات الحضرية” المُسَاعِدَة في استعادة “ذاكرة المكان المفقود”. وهذا أقرب إلى جدلية تدور بين “مُرْفَق المكان” و”هوية المكان”، خاصة وأن “المكان” بهذا التفريق هو المفهوم الأساس في علم النفس البيئي. ومع ذلك، في حين أن هناك إجماعًا بشأن تعريف “المكان” الموهوب بالمعنى، وكيف يختلف عن مفهوم “الفضاء” ذي الصلة بذات “المكان”، هناك اتفاق أقل بكثير حول كيفية تعريف وقياس روابط الناس مع “الأماكن”، كـ”ارتباط المكان”، و”هوية المكان”، و”الشعور بالمكان”، و”الاعتماد على المكان”، وما إلى ذلك من ضروب المتعلقات، التي تضخم الإحساس بفقدها المؤقت. فـ”الذكريات” البشرية هي في الأساس “ذكريات اجتماعية”، لأن ما نتذكره غالبًا ما يكون أقل نتاجًا للتجارب الشخصية المباشرة وأكثر من اندماجنا في الهياكل الاجتماعية، كالأسرة، القبيلة، والعشيرة، والأمة “الوطن”، إلى آخر هذه التفريعات والتركيبات، التي يمكن أن نصفها بـ”الأطر الاجتماعية”، بينما يستخدم علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي مصطلحات “الذاكرة الجماعية”، أي الذاكرة المشتركة بين الجماعات، أو المجتمعات. لذلك، فإن “ذاكرة المكان” هي في الغالب ظاهرة اجتماعية، وهي على هذا النحو، تعتمد بشكل أكبر على عوامل خارج الفردية، مثل الأيديولوجية السائدة، أو محتويات وسائل الإعلام والكتب المدرسية أكثر من اعتمادها على العوامل النفسية المتباينة بشكل فردي، أو خارج إطار العلاقات الاجتماعية.
ويختلف “الإحساس بالمكان” عن “التعلق بالمكان” من خلال النظر في السياق الاجتماعي والجغرافي لـ”روابط المكان” واستشعار “الأماكن”، مثل الجماليات والشعور، الذي يمنحنا الدفء في المسكن. وتعتبر الحالة الداخلية والأصول المحلية مهمة نحو تطوير إحساس أكثر تجذرًا بـ”المكان”. وكثيرًا ما تُستخدم ثلاث سياقات لدراسة تطور “الإحساس بالمكان”، منها؛ الوضع السكني في “المكان”، أي الحواس السطحية والجزئية والشخصية والثقافية لـ”المكان”؛ والمرحلة العمرية، كما هو الحال في التطور عبر دورة الحياة، باستخدام نموذج إريكسون وفيلانت الديناميكي؛ وتطوير رابطة الزوج البالغ، الذي أثرت نشأته في “المكان” على مشاعر الجذور والصلات بالأرض الموروثة. ويميل المجتمع الحديث، بسبب المستويات العالية من التنقل السكني، إلى تطوير المزيد من الإحساس الجزئي، أو الشخصي بـ”المكان” بين أعضائه. وكانت المراحل المتتالية في تطور “الإحساس بالمكان” أكثر وضوحًا بين أولئك الذين نشأوا فيه وقضوا معظم حياتهم هناك.
أصول العلاقة:
تتعمق علاقتنا بـ”المكان” فيما يعنيه لنا كقيمة معنوية وموضوعية، وبأن يكون أكثر من مجرد مساحة مادية ما، إذ نستكشف من خلال تجاربنا كيف تصبح الأماكن مشبعة بالمعنى، وكيف تُشَكِّلُنَا، وتَتَشَكَّلُ من قَبْلِنَا ومن قِبَلَنَا، وكيف ترتبط بهويتنا وشعورنا بالانتماء. وباستعراض بعض الأفكار المركزية في فلسفة “المكان”، فإننا لا بد أن نلحظ قيمة الفضاء مقابل هذا “المكان”، حيث يُنظر إلى الفضاء على أنه أكثر موضوعية وقابلية للقياس، في حين أن “المكان” يتضمن طبقات من التجربة الإنسانية والتاريخ والثقافة، أو كل ما يصف “الذاكرة”. فقد نفكر في “المكان” على أنه مجال بسيط، أو أنه مجرد مساحة مُنْبَسِطَة، ولكن إذا كان مجالًا لَعِبَ فيه الأطفال لأجيال، فإنه يصبح مكانًا غارقًا في الذكريات والأهمية الثقافية. لذلك، يتدخل دور التجربة بقوة في إعادة التعريف، بمعنى أن تجاربنا في مكان ما تُشَكِّلُ كيف نفهمه. وعلى سبيل المثال، قد يبدو شارع النيل الضاج بالحركة، ومظاهر “التَسَكُّع” في الخرطوم، مثلًا، مثيرًا لشخص ما، ومزعجًا لشخص آخر، وفقًا لتجربة كل منهما الشخصية فيه.
ولذلك، يمكن أن تكون الأماكن مركزية لعلاقتها بإحساسنا ببعض متعلقات الذات، إذ نَتَعَرَّفُ على مسقط رأسنا، أو موقع مقدس مهم لنا، أو مقام ديني، أو مقهى مفضل، أو كل ما يعطي “المكان” صلة بـ”الهوية”. وتؤكد هذه الفلسفة على الخَلْق الواعي لـ”الأماكن”، التي تعزز ترابط المجتمع وتصنع المعنى وتحقق الرفاهية، ولما في ذلك من أهمية التذكير بصناعة المواضع في ذاكرتنا الجماعية. ومن هنا، يمكن أن يؤدي استكشاف فلسفة “المكان” إلى إثراء تقديرنا للمواقع من حولنا؛ المألوفة والجديدة. كما أنه يشجعنا على التفكير في القصص، التي يحملها هذا “المكان”، أو ذاك، والدور، الذي يلعبه في تشكيل حياتنا وحياة الآخرين.
لهذا، فالعلاقة بين “المكان” و”الذاكرة” هي مجال رائع من مجالات الفلسفة وعلم الاجتماع، حيث يستكشف المفكرون كيف يتشابك كلا “المكان” و”الذاكرة” لتشكيل هويتنا وتجربتنا في العالم، كحقيقة انتماء بأبعادهما المعنوية والموضوعية. فإذا أخذنا “الأماكن” كحافظة لـ”الذاكرة”، سنجد أن مؤرخًا فرنسيًا هو بيير نورا يقدم لنا مفهوم “مواقع الذاكرة”، أو “الأماكن المادية”، التي تبلور وتجسد الذكريات الجماعية. ويمكن أن تكون هذه المعالم الأثرية الكبرى، أو حتى الشوارع العادية، مهمة لأنها تحمل معنى ثقافيًا وتاريخيًا لمجموعة كبيرة من الناس. فـ”الذاكرة” المتجسدة في “المكان”، كما يجادل الفيلسوف جيف مالباس في حقيقة أن “الذاكرة” مرتبطة بطبيعتها بهذا “المكان”، لأنها، أي “الذكريات”، ليست مجرد صور ذهنية، بل إنها متشابكة مع التجارب المكانية، التي مررنا بها أثناء تشكيلها. ولا يمكننا أن نتذكر حدثًا بشكل كامل من دون أن نتذكر أيضًا “المكان”، الذي حدث فيه. و”الأماكن” بهذا المعنى هي، التي تشكل “الهوية”، فيما يرى علماء الظواهر مثل إدوارد كيسي “الأماكن” كنوع من “النخب”، مع طبقات من “الذكريات” والتجارب. وتساهم هذه الطبقات في إحساسنا بـ”الذات”، إذ يمكن أن تؤدي إعادة زيارة منزل الطفولة إلى فيضان من “الذكريات”، وتذكيرنا بِمَن كُنَّا، وتشكيل مَن أصبحنا. وهذا يحيلنا إلى مفهوم “الذاكرة الغريبة والمكانية”، الذي يصفه سيغموند فرويد بأنه يُصْبِحُ شيئًا مألوفًا، ويبدو غير مألوف بشكل غريب.
صدى الذكريات:
كثيرًا ما تُثير “الأماكن” مثل هذا الشعور المهاجر إلى أعماق البدايات، حيث تظهر “الذكريات” مرة أخرى بطرق غير متوقعة، أو كصدى لنداء قديم، مما يدفع إلى التفكير في الماضي والحاضر معًا في بارقة، أو طرفة خاطر واحدة. وهذه ليست سوى بعض الطرق، التي يستكشف بها الفلاسفة العلاقة بين “المكان” و”الذاكرة” و”الهوية”. ويمكن أن يساعدنا فهم هذه العلاقة على تقدير قوة “المكان” في تشكيل حياتنا وذكرياتنا؛ مرتبطة بكل تفاصيل هويتنا. ولذلك، فإن العلاقة بين “المكان” و”الذاكرة” و”الهوية” هي مفترق طرق رائع للبحث الفلسفي، رغم أنه مجال فكري معقد ومتطور باستمرار، مع عدم وجود إجابات سهلة لكل ما يُطرحُ حولها من أسئلة. ولكن من خلال التفكير في هذه الأسئلة، نكتسب فهمًا أعمق لأنفسنا والعالم من حولنا، حتى قبل محاولة الإجابة عليها. فـ”الذاكرة” هي الأساس لـ”الهوية”، إذ يعتقد العديد من الفلاسفة؛ مثل، مثل جون لوك وتوماس ريد، أن ذكرياتنا هي حجر الزاوية في إحساسنا بالذات.
ومن خلال تَذَكُّر تجاربنا السابقة، نخلق سرديةً لمن نحن وكيف أصبحنا، فيما يُعرف بـ”الذاكرة الذاتية”، التي هي ما يستمر معنا مع مرور الوقت. ومع ذلك، علينا أن نُمْعِنُ النظر في “موثوقية الذاكرة”، إذ يمكن أن تكون “الذكريات” معيبة، أو حتى ملفقة. ونشاطر مفكرين آخرين؛ مثل ديفيد هيوم، في التساؤل: هل يمكن لسجلٍ متغيرٍ باستمرار، وربما غير دقيق، أن يحدد حقًا من نحن؟ إذ إن بعض “الذكريات” جزئية، أي ليس كل شخص لديه “ذاكرة” كاملة لماضيه، فهل هذا يعني أنهم يفتقرون إلى “هوية” متماسكة؟
إن “الأماكن” تعمل كحاويات لـ”الذاكرة”، ومن خلال ذلك يمكن أن تكون هذه “الأماكن” محفزات قوية لـ”الذكريات”. وكما أسلفنا، يمكن أن تثير زيارة منزل طفولتنا، أو مكان عطلة مفضل، طوفانًا من المشاعر و”الذكريات”. وهذه “الذكريات”، بدورها، تعزز إحساسنا بـ”الذات” المنتمية لـ”المكان”. فـ”الأماكن” بلا شك هي تشكيل لـ”الهوية”، لأنها هي المحاضن، أو الملاذات، التي نعيش فيها ونقضي الوقت في التَشَكُّل لما نحن عليه. ونعلم يقينًا أن التنشئة الريفية تعزز منظورًا مختلفًا عن حياة المدينة؛ ونحن نتاج المنزلة بين المنزلتين، حيث تعرضنا “الأماكن”، التي اختلفنا عليها، لثقافات وقيم وتجارب مختلفة، وكلها تساهم في هويتنا. وإذا كانت القرية والمدينة في مهب صراع الوجود في السودان الآن، ونستشعر الغبن والحزن لفقدان خصوصيات ما ألفنا من معالم “المكان”، فماذا يحدث لهويتنا عندما يستمر انتفاء الصلة بهذا “المكان”، وبين غيرنا ممن ساكنونا الجيرة والتجربة ومقابسات الوجدان؟ إن النزوح بسبب الحرب، أو الهجرة، أو التشريد من “الأماكن”، يمكن أن يكون مقلقًا للغاية، مما يجبر الأفراد على إعادة تقييم إحساسهم بمتعلقات “الهوية”.
وغالبًا ما ترتبط معاني هذه “الهوية” بذكرياتنا بـ”أماكن” محددة، وغالبًا ما تُعيد تَذَكُّر تجربة سابقة إلى الأذهان المساحة المادية، التي حدثت فيها، وكأنها كانت “مكان” اكتشاف “الذات” وأهم أشراط “الهوية”. فنحن، في بعض الأحيان، نُسافر إلى “أماكن” جديدة خصيصًا لتكوين ذكريات جديدة، واكتشاف جوانب من أنفسنا لم نكن على دراية بها من قبل، لأن “المكان” المُشَكِّل لهويتنا وضع لها إطارًا تُعَرَّفُ من خلال مكوناته الغالبة، وقد تُفيد المقاربة والمقارنة فهم هذا الإطار بشكل أفضل.
رؤية الذات:
يحب الفلاسفة، وتلامذتهم، أن يفخروا بأنهم عقلانيون، مدفوعين بقوة العقل والحجة والمنطق، لا منطق القوة وضعف الحجة وغياب العقل. وقد علمتنا “كورونا” حدود منطق القوة المادية، وأننا لن نتمكن من السفر بحولنا وقوتنا إلى بلد جديد، ولا حتى التنزه الحر في جوارنا المباشر، ولكن أمكننا العثور على طرقٍ جديدةٍ للتجول في داخل ذواتنا، لأن العقل والحجة والمنطق أرشدونا لذلك. ورغم أننا لم نجد من نُحِبَهُم بجوارنا، بسبب فروض التباعد، غير أننا استطعنا أن نطوف مع أطياف ذكراهم في بواطن وعينا. ومثلما كان لا يمكننا الذهاب إلى “مكان” مكتظ بمن يمكن أن يكونوا يحملون “فيروس” العدوى، ولكن أمكننا أيضًا اختيار فضاء لم نجربه من قبل؛ منحنا فرصة لاقتناص لحظة من الفرح المكبوت في مخابئ دواخلنا. لذلك، لم يكن من السهل مقابلة أشخاص جُدُد في محيطنا المباشر وقتئذٍ، ولكن أمكننا الحصول على أصدقاء افتراضيون، أو التواصل مع أشخاص جُدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المنقوصة الحس والمعنى.
ولذلك، تعودنا كبشر البحث عن تجارب جديدة، واجتراح أسئلة فضولية جديدة، والتعثر في إيجاد إجابات صحيحة لها، لأننا عِشنا ونعيش بعضًا من عمرنا مع أطفالنا، وأي شخص قضى وقتًا مع الأطفال يعرف مدى فضولهم، وجرأتهم على تكرار السؤال إلى ما لا نهاية، من دون انتظار لإجابات قطعية. وفي حاضرنا الكثير مما يحاصرنا من أسئلة بلا إجابات مقنعة، ولكن عدد الأشياء الجديدة، التي نصادفها يتراجع كلما تقدمنا في السن، رغم أن أدمغتنا البالغة لا تزال تجني ثمار الجِدَّة، ويشدها التطلع إلى المعرفة بأبعادها الجوهرية. لذلك، فإن أحكامنا “الاسترجاعية” للوقت تتأثر بشدة بازدحام ذاكرتنا؛ بما مضى وبما هو حاضر في وجداننا، وكما تقول باحثة إدراك الوقت روث أوغدن، أستاذة علم النفس في جامعة ليفربول البريطانية. “إذا صنعنا الكثير من الذكريات لفترة من الوقت، فسنشعر أنها كانت وقتًا طويلًا.” وإذا كنا لا نصنع أية “ذكريات”، كما هو الحال الآن، فإن هذه الفترة الزمنية، التي تمضي، سنشعر بها؛ عندما ننظر إليها بوعي، كما لو أنها كانت قصيرة، أو كما قد تتراءى لنا من فوق أفق “الخيال”.
بيد إن هذه الفكرة تقترح إطارًا تحليليًا لفهم ما يجعل “الأماكن” ذات معنى، لأنها مهمة، ووصف ما تعنيه هذه “الأماكن” بالنسبة لمن يرتبطون بها، بسبب المعاني المنسوبة تلقائيًا إلى “الأماكن”، التي يمكن تعيينها حول وبين الأقطاب الثلاثة لـ”الذات” والآخرين والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يُظْهِرُ هذا الإطار عددًا من الأبعاد الأساسية للمعنى؛ بما فيها التمييز والتقييم والاستمرارية والتغيير، التي تتلاقى إلى حد كبير مع المفاهيم النظرية لـ”المكان” في العلوم الاجتماعية. لذلك، لا يجب أن يقتصر النظر إلى “الأماكن الخاصة”، فيما يتعلق بأدوار ومعاني “المكان” في المجتمع المعاصر فقط، وإنما ما يرتبط منها بـ”الذاكرة الجماعية” لدى كل السكان وعلاقتهم بهوية “المكان” ومدى ارتباطهم بهذا “المكان”. وغالبًا ما تُظهر “الذاكرة الجماعية” تحيزًا عرقيًا قويًا، بنفس القدر من القوة في جوانب اللغة والدين، ولكن مع آليات أساسية مختلفة تكون مؤشرات التحيز فيها هي “الهوية”، مع لفيف والمتغيرات الديموغرافية الأخرى، التي يرتبط فيها “المكان” بـ”الهوية” العليا “الوطنية”، أو الدنيا “المحلية”. فمثلًا، تُحْدِثُ الحرب، التي يشهدها السودان حاليًا تحولًا متسارعًا في بنيات المجتمع المختلفة، ويرتبط هذا التحول بـ”المكان”، لأنه يعني هجرات جماعية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدنهم وبلداتهم وقراهم ومنازلهم، وما إلى ذلك، والتي سكنوها لأجيال. وتخضع هذه المدن والبلدات الفارغة لتغييرات سكانية متعمدة، حيث يستولى سكان جدد على منازل السكان السابقين، ويسرقون منها الممتلكات، وكل تفاصيل “الذكريات”.
صناعة الهويات:
لهذا، فإن ما يَمُرُّ به السودان، أو لهذه التجربة السياسية والاجتماعية الضخمة، عواقب نفسية هائلة، تتبدى الآن في شكل إجهاد جسدي جماعي بسبب الانتقال والاضطرار إلى مغادرة “الأماكن”، وحالة من عدم الاستقرار الوجداني بسبب الخوف على ضياع “الذكريات”. وتنتابهم مشاعر القلق المُمِض حول المستقبل غير المؤكد، آملين أن تكون التغييرات الحادثة ليست نهائية، وأن حلم العودة إلى ما سبق من “أماكن” لا يدفعون ثمنه باهظًا للاستثمار المعنوي والمادي في المغتربات الحالية؛ داخلية كانت أم خارجية. فهم على يقين أنه لا يمكن أن تتضاءل لديهم مشاعر الفقد من خلال الجهود الدعائية الضخمة، التي تبذلها القوى المناصرة للتمرد على الدولة والمجتمع، أو تلك الجماعات، التي تتكسب سياسيًا من استمرار الحرب. فقد كان هدف هذا التمرد الواضح هو قطع “الاستمرارية الوجدانية” للناس من هذه “الأماكن”، وفصم “الذاكرة”، من خلال خلق “هويات” اجتماعية جديدة، وكأنما تتم كتابة التاريخ الاجتماعي من جديد.
ولا شك أن هذا التاريخ الجديد سيكون انتقائيًا للغاية، وإقصائيًا بقوة السلاح، مع صفحات يجب أن تكون مفقودة “عمدًا”، غير أنه لا يمكن ملؤها بحقائق تتنكب خطوات المنهج السليم. وهذا لا يعني أن التاريخ “الآخر” لم يعد موجودًا، بل هو أكثر حضورًا من أي وقت مضى، وغالبًا ما تعززه أكثر مظاهر الوحدة التضامنية، التي تنتظم المجتمع الآن. وتؤكد ذلك مشاعر الوحدة الوطنية، التي التفت حول قوات الشعب المسلحة، ويتعاظم نفيرها الجماعي كل يوم. وكما هو معروف، يميل القمع السياسي والعنف إلى ممارسة تأثير عكسي على “الذاكرة الجماعية” من خلال توحيد المشاعر العامة حول الأحداث، التي تستهدف استئصال الجميع. ونتيجة لذلك، يتم نقل الخلافات والتباينات إلى مستوى أرفع من حالات التضامن والتآزر والتعاضد والتلاحم، في شكل وحدات حماية، أو في شكل مستنفرين متطوعين تحت إمرة القوة الصلبة المتاحة “الجيش”، من دون أن تفت من عضدهم أصوات القلة الخارجة عنهم.
ولهذا، فإن ما ينتظر قادة الرأي في البلاد هو مناقشة العواقب السياسية والنفسية للتغيرات الاجتماعية بعد الحرب، التي كانت إلى حد كبير تُعالج من قبل المؤرخين وعلماء الاجتماع، أي من قبل الباحثين الذين يكمن اهتمامهم الرئيس في دور السياقات التاريخية والاجتماعية في تشكيل مواقف الناس وسلوكياتهم. ومع ذلك، نادرًا ما تم التحقيق فيها؛ إن وجد، من قبل علماء النفس والسياسة، الذين هم في رأيي المعنيون أيضًا بإعادة فحص “سوية” الكثير من الحالات، التي اهتزت دواخلها بهول هذه الحرب. على أن ينصب التركيز في هذه المرحلة على القضية، التي لم يسبق أن تم بحثها من قبل، وتتمحور حول كيفية شعور السكان تجاه “مكان” إقامتهم الحالي؛ في الداخل كنازحين، أو الخارج كلاجئين، وأحاسيسهم بعد عودتهم للمدن، التي خضعت، بعد 15 أبريل 2023، لتدمير شبه كامل، وكيف يبنون ماضي مدنهم وأحيائهم والشوارع والمنازل، وكل “الأماكن”، والتي تؤطر ساحات “الفضاء” العام. وكيف يستردون أصول “ذكرياتهم”، مع استدراك أن ما يتم تذكره، أو معرفته عن الماضي الجماعي، بالنسبة للمؤرخين، يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك المصادر المكتوبة والشفوية والمادية، التي نالها من الحرق والنهب والتخريب الشيء الكثير. وتتشكل محتويات “الذاكرة”، في عُرف علماء الاجتماع، من خلال الأيديولوجيات الرسمية، التي تنتقل عبر وسائل الإعلام، ودروس التاريخ في المدارس والكتب المدرسية، والأساطير والأغاني المتداولة، والآثار المعمارية والحضرية، والقصص العائلية، وأخيرًا من خلال العديد من العوامل النفسية، التي يُعنى بها علماء النفس، والتي تسهل تلقائية الفضول وتحفز الاهتمام بتأثيرات “مكان” الإقامة الحالي بطبيعته المؤقتة، والتأقلم على العودة إلى واقع اختلف بأهوال الحرب، وتساعد على استعادة “ذكريات المكان” في الظروف المستجدة.
خاتمة المطاف:
باختصار، تدعو هذه المقالة لتتبع التطورات في الخطاب العلمي، الذي يوضح تطور فهمنا لعلاقات الناس العاطفية بـ”الأماكن”؛ في منعطف تاريخي يسود فيه القلق والحيرة، وتَسِمُهُ النزوح واللجوء والهجرة، وغربة “المكان” والأوطان. ورغم أخذنا لمنظور أوسع من مجرد توصيف العلاقات العاطفية بهذه “الأماكن”، إلا أن أننا حاولنا حشد مجموعة مقدرة من الإعدادات المادية والعاطفية الواصفة لـ”المكان”، باعتباره ظاهرة ديناميكية دائمة التغير، وموجودة في بيئة اجتماعية وسياسية أكبر. وعرضنا لوجهات نظر فلسفية حول العلاقات بين الناس و”المكان”، بالإشارة للأدبيات كنقطة انطلاق مهمة لفهم طبيعة الجوانب العاطفية لهذه العلاقات، لأنها توفر أساسًا نظريًا غنيًا للدراسة. إذ يركز علم الظواهر على معاني وتجارب “الأماكن” من خلال اكتشاف وصفي ونوعي للأشياء بمصطلحاتها الخاصة، ويحفر بعمق في الطبيعة الأنطولوجية للبشرية، ويعتبر “الوجود في المكان” أمرًا أساسيًا غير قابل للاختزال.
ومن جانب آخر، يوضح المنظور الظاهري لعلاقات الناس بـ”الأماكن” الطبيعة الديناميكية لهذه العلاقات في مستوياتها المختلفة. وفي الواقع، يُشير مصطلح “العلاقة” نفسه إلى عملية ديناميكية يتم من خلالها تجميع عوالم مختلفة معا بطريقة دائمة. وتصف مفاهيم الحركة والراحة واللقاء، والعلاقة المتبادلة فيما بينها، العلاقات، التي يجب وضعها كعمليات جدلية تشكل أساس كياننا. علماء الظواهر لديهم أيضًا ما يُمكن أن تكون فيه العلاقات مع “الأماكن” عملية واعية، ويُخَطَّطُ لها وفقًا لمتغيرات الحال العام. وقد قيل إن سياق حياتنا اليومية مألوف جدًا لدرجة أننا نرتبط به بشكل أساس بطريقة غير واعية.
وفي الواقع، فإن دور العادة والألفة عنصران حاسمان لإحساسنا بـ”المكان”. وقد ارتبط هذا أيضًا بالطبيعة المتجسدة لوجودنا؛ نظرًا لأن الانتظام والروتين جزء من طريقة وجودنا في العالم، فإننا في الواقع لسنا واعين دائمًا لحقيقة السياق السياسي للعلاقات بـ”الأماكن”، إذ لا تحدد الأدبيات المتعلقة بالتعلق بهذه “الأماكن” عادة العلاقات العاطفية في سياق اجتماعي وسياسي أكبر. ومع ذلك، لا يمكن النظر بشكل كاف في العلاقات العاطفية للناس مع “الأماكن” من دون إدراك الآثار السياسية الهامة لمثل هذه الظاهرة. وسؤال: من نحن؟ يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على “المكان”، الذي نجد أنفسنا فيه، وأين نشعر بالانتماء. ومع ذلك، ونظرًا لأننا جميعًا مجسدون ومدمجون في سياق مادي، فإننا مضطرون لفهم طبيعة علاقاتنا العاطفية بـ”الأماكن”، لأنها حاضنة القيمة المعنوية للانتماء.
_________
* الدكتور الصادق الفقيه: أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة صقاريا بتركيا، والأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن.
الثلاثاء، 9 أبريل 2024
صقاريا، تركيا
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.








