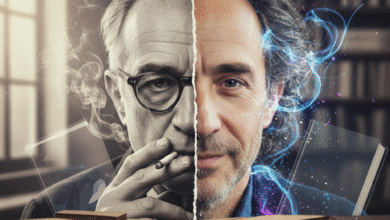النزعة الأكسيوميَّة في فصل المقال وراهنيَّة ابن رشد

إنَّ المتأمِّل في معظم كتب ابن رشد باستثناء الكتب التي شرح فيها أرسطو، سيكتشف ما تنوء به هذه الكتب من نزوع منهجي، ابتداء من كتابه ” فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتِّصال[1] ” وصولًا إلى كتابه ” الكشف عن مناهج الأدلَّة في عقائد الملّة “، فالأوَّل عبارة عن مقال منهجي يسطِّر الخطوط العامَّة للعلاقة التي يجب أن تقوم بين الدين والفلسفة، أمَّا الثاني فهو نقد منهجي لأدلَّة المتكلِّمين على عقائد الدين، وفي كلا الكتابين سلك ابن رشد طريق الاجتهاد لأنَّ مقارعة الدليل بالدليل لا تتسنَّى إلا به، ولأنَّ كل فلسفة تحمل بين طيّاتها، جهرًا أو همسًا، خطابًا في المنهج، فإنَّ ابن رشد بوصفه فيلسوفًا قد دأب على نقد الأطروحة السائدة في عصره، وهي الأطروحة التي حرَّمت الفلسفة أولا، وحرَّمت القياس ثانيا، وحرَّمت التأويل أخيرًا بذريعة أنها من المنتدبات المنقولة، وليست من العناصر المأصولة في التراث الإسلامي بتعبير المفكِّر المغربي طه عبد الرحمن، أي أنَّنا لا نجد لها تصريحًا ولا تلميحًا ولا إشارة ولا عبارة في القرآن والسنَّة.
وقد بيَّنا مع ابن رشد أنَّ هذا الادعاء خاطئ، فإن لم توجد الفلسفة بالعبارة والتصريح، فإنَّها موجودة بالإشارة والتلميح، وقد تبدَّى لنا ذلك من خلال وجوب النظر في الموجودات باعتبار هذا النظر تأمُّلًا يفضي إلى معرفة الله، والتأمُّل هو أداة من أدوات التفكير الفلسفي، لكن السؤال الذي يخامرنا هنا هو: لما كان الفلسفة تؤدِّي إلى الله، ولما كانت الشريعة كذلك تؤدِّي إليه، فهل هذا يعني أن ابن رشد قد وفَّق بين الفلسفة والدين ووصل، أم أنَّه فصم بينهما وفصل؟
الحقيقة أنَّ ابن رشد قد جمع بين الفقه والفلسفة، وهذا ما بيَّناه سابقا، كما جمع كذلك بين الحكمة والشريعة، لكنه لم يكن ينظر إلى هذا الجمع على أنَّه توفيق ووصل، ولم يكن ينظر إليه على أنَّه انفصام وفصل، فالجمع هنا يعني اتِّفاق واجتماع كلا الطرفين على المقصد والهدف، وهو الحقّ، أمّا الافتراق والفصل بينهما فيكتسي صبغتين:
الصبغة الأولى هي أن الشريعة توجَّه للعامَّة والخاصَّة، لأنَّها ترمي إلى الإقناع، فنوَّعت من طرق وسبل الخطاب لكي تتلاءم مع عقول وأصناف الناس، فلو كانت الشريعة تتبع طريق العقل وحده لما اقتنعت فئة من الناس تنساق مع طرق أخرى من الإقناع، ولأنَّ الأمر كذلك رأى ابن رشد الناس على ثلاث مراتب من جهة التصديق، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدليَّة، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابيَّة، وقد اشتملت الشريعة على كل هذه الأصناف من الخطابات، في حين إنَّ أصحاب البرهان هم فقط من لهم القدرة على التفلسف، وهم الراسخون في العلم، أو أهل الفطر الفائقة.
الصبغة الثانية هي أنَّ للشريعة بناء داخلي تختصّ به، كما أنَّ للفلسفة بناءً داخليًّا تحتجن به، وأنّ محاولة التوفيق بينهما قد يؤدِّي بنا إلى خلخلة وتشويه هذا البناء الداخلي والى خرق النظام المعرفي الذي يسم كلا من المجالين، وأنَّ عمليَّة الدمج هذه لا تتحقَّق إلا بالتضحية، إمَّا بأصول الدين ومبادئه، وإمَّا بأصول الفلسفة ومبادئها، وبهذا المقتضى، كان الفصل قضيَّة منهجيَّة أساسيَّة وضروريَّة، لحصن البناء وصون النظام .
إنَّ الخلط والدمج بين الفلسفة والدين هو خطيئة انزلق فيها أصحاب الكلام، إذ أنَّهم لم يحافظوا على هذا التعارض القائم بين المنطق البرهاني الذي تعتمده الفلسفة والخطاب الجدلي السوفسطائي الذي اعتمدوه هم، حيث لم يكن هدفهم بناء الحقيقة وإنّما التأثير في الخصم والرفس على آراءه، ونتج عن ذلك كما يقول ابن رشد أن أوقعوا الناس في شنآن وتباغض وحروب ومزَّقوا الشرع وفرقوا الناس .
إنَّ فيلسوفنا يتمسَّك بقضيَّة الفصل هذه، مؤكّدًا على أنَّ ما للفلسفة للفلسفة، وما للشرع للشرع، ولا يجب البحث عن الصدق في الفلسفة عن طريق الشريعة، ولا البحث عن الصدق في الشريعة عن طريق الفلسفة، فالقضايا الدينيَّة تفحص داخل الدين، والقضايا الفلسفيَّة تمحَّص داخل الفلسفة، لذلك ينبغي النظر إلى الدين والفلسفة كما يقول الجابري”كبنائين أكسيوميين، فرضيين استنتاجيين، بحيث يجب أن نبحث عن الصدق فيهما داخل كل منهما، لا خارجه، والصدق المطلوب هو صدق الاستدلال لا صدق المبادئ والمقدّمات، ذلك، لأن المبادئ والمقدّمات، في الدين كما في الفلسفة، مبادئ موضوعة، يجب التسليم بها دون برهان.
وهكذا إذا أراد الفيلسوف أن يناقش قضايا الدين فعليه أن يسلِّم أولا بمبادئ الدين، وإذا أراد الفقيه أن يناقش قضايا الفلسفة، أيَّة فلسفة، فعليه أولا أن يسلِّم بالمبادئ التي شيِّدت عليها الفلسفة ” [2]، وقد عمل ابن رشد بهذا الشرط، إذ أنّه لكي يصدر حكما فقهيًّا تجاه الفلسفة توغل إلى أعماق علم الفقه ينبش فيه، فكان فقيها في الحكم، فيلسوفا في الحجَّة، فلو أنَّه أصدر حكما بدون أن يكون فقيها لنعت بالجاهل، لكنه بفطنته ورزانته ورجاحته في الفصل نعت بالعاقل، ففي الفصل والتمييز دائما حكمة وسداد، وفي الدمج والخلط عادة خربطة وفوضى، ولهذا السبب، نجد أنَّ ابن رشد لا يعترف للغزالي بالعلم، ففضلا على أنَّه ” لم يلزم مذهبا من المذاهب في كتبه، بل هو مع الأشعريَّة أشعري، ومع الصوفيَّة صوفي، ومع الفلاسفة فيلسوف “، فقد شكَّك صاحب الفصل حتى في مدى اطلاع الغزالي على الفلسفة وأصولها، إذ أنَّه لم ينظر إلا في كتب ابن سينا، فلحقه القصور في الحكمة، فكان من نتيجة هذا القصور أن أخذ حجَّة الإسلام مقدَّمات هندسيَّة ليس لها شهرة تفعل فيها تصديقا وإقناعا في بادئ الرأي، فضرب بعضها ببعض، فكان كلامه ضعيفًا وخسيسًا، لأنَّه لم يقع به تصديق برهاني ولا إقناعي.
وإذا أردنا أن نفهم الخلاف بين ابن رشد والغزالي في مستوى آخر يطبعه الاختلاف، نفهمه ليس على أساس أن الأول متبحِّر ومتعدِّد المشارب والثاني غير ذلك، أو العكس، وإنما إلى سبب أعمق بكثير وهو نظرة كل منهما إلى الخطاب: فالغزالي ينظر إلى الخطاب في مفعوله، أما ابن رشد فيكتفي بالنظر إليه في تماسكه وانسجامه المنطقي، فالأول يهتم بنظام الخطاب، والثاني يهتم بانتظام الخطاب، ذلك أنَّ نظام الخطاب يلتفت إلى المفعول الذي يصدر منه، فلو كان الخطاب يؤدِّي إلى الضلال والآفات استغنينا عنه وحكمنا عليه بالزوال، وإذا كان الخطاب – مهما كان نوع هذا الخطاب – يؤدِّي إلى الحقّ والاستقامة قبلنا به وحكمنا عليه بالبقاء، فلا يهم أن يكون الخطاب برهانيًّا أو خطابيًّا أو جدليًّا، بل يكفي فيه أن يثمر مفعولا ينتفع به الدين. على عكس انتظام الخطاب الذي يقوم على التراص والتماسك الداخلي والمنطقي للخطاب، فحقيقة كل خطاب تتحدَّد من هذا الشرط من تماسكه، والخطاب المنتظم والمتماسك هو الخطاب البرهاني فقط، وهو الذي لا يقع تحت تصرف العامَّة من الناس، بل يحظى به الخاصَّة فقط، فالعامة لا تقتنع إلا بالخطاب الجدلي، لأنَّ هذا النوع من الخطاب صمِّم فقط لغاية الاقناع، ومن هنا دعا ابن رشد إلى ضرورة الفصل والعزل بين مستويات الخطاب.
وينطوي انتظام الخطاب عند ابن رشد على نزعة أكسيوميَّة واضحة، وهي النزعة التي تجلَّت في معظم كتبه، إذ أنه درس أولا فلسفة أرسطو بواسطة أرسطو نفسه، أي بالرجوع إلى آرائه وفحصها وردّها إلى الأصول التي بنيت عليها، وقد مكَّنه ذلك من اجتثاث التأويلات المتضاربة وتصحيح للتشوّهات التي تعرضت لها الفلسفة الأرسطيَّة في عصر الأفلاطونيَّة المحدثة، وفي عصر الفلاسفة المسلمين كذلك كابن سينا.
وقد درس ثانيا الطب في كتابه ” الكليات ” من داخل الطب، ودرس ثالثا الفقه الإسلامي في كتابه ” بداية المجتهد ونهاية المقتصد ” من داخل الفقه نفسه، حيث كان حريصا على عرض آراء المذاهب المختلفة مع تبرير كل منهما داخل منظومته الخاصة، ودرج على إصدار حكم على الفلسفة من داخل علم الفقه، لأن الأحكام لا تستنبط إلا من هذا العلم، وهو ما أعطاه الشرعيَّة أن ينافس بحكمه الذي استخلصه بالاجتهاد الفقهاء، ولو أنه تخندق في داخل الفلسفة فقط لما كان لحكمه شرعيَّة فقهيَّة، ولما جاز له أن يقدح في الأحكام الأخرى التي فسخت مع العقل علاقتها وحرمت الفلسفة، وإنَّ هذه النزعة حقا لأمر يعجب منه في أعمال ابن رشد .
ونعتقد أن هذه النزعة الأكسيوميَّة هي التي ضمنت لفيلسوف قرطبة الخلود إلى اليوم، إذ إنَّ نقاش راهنيته الواقعيَّة اليوم لا يمكن أن يقذفنا إلا إلى جوف مقال الفصل بوصفها مقالا منهجيا، فاليوم نجد أن مختلف المناوشات والسجالات والصراعات هي نتيجة الخلط بين الدين والفلسفة أو بالأحرى بين الدين والعلم، فلا معنى من أن نحشر الدين داخل قوقعة العلم، ولا معنى من أن نقحم العلم في الدين، ففي الحالتين يتضرَّر المجالين، ذلك أن الدين يقيني، والعلم نسبي، واليقين يرتبط بالإيمان، والنسبيَّة تتعلَّق بالتطور العلمي، فلا يمكن أن نلاقي اليقين بالنسبيَّة، وإلا كان الكلام الذي نخلط فيه كلاما فارغا لا يهتدي إلى أي مجال، أي أنه غارق في الفوضويَّة والعبثيَّة، والحق أنَّ مكمن اختلال العقل العربي في الخلط بين ثلاثة نظم معرفيَّة متمايزة، وهي عند الجابري: النظام المعرفي البياني الذي تحمله اللغة العربيَّة. والنظام المعرفي العرفاني أو الغنوصي الذي انتقل إلى الموروث الثقافي الإسلامي من الفكر الشيعي والفلسفة الإسماعيليَّة والأفلاطونيَّة المحدثة والتصوف . والنظام البرهاني الذي دخل الثقافة العربيَّة الاسلاميَّة مع الترجمة وانطلاقا من عصر المأمون خاصة، وينبني على الفلسفة والمنطق العقلي [3] .
إنَّ آفة العقل العربي الإسلامي تكمن في التردُّد بين البيان والعرفان والبرهان، وعدم الاستكانة والاستقرار على نظام واحد، بل قد تجد شخصا يدافع عن البيان عن طريق البرهان أو العكس، أو تجده يتحدَّث باسم البرهان وهو يسلك طريق العرفان، إن هذا التذبذب والتراوح قد أدى إلى تحنط وتخشب نبه له سابقا ابن رشد، وإننا اليوم ملزمون إلى الأخذ بوصيَّة الفصل التي خلفها إذا ما أردنا أن نهتدي إلى الحقيقة، ذلك أن الخلط لا يمكن أن يؤدِّي بنا إلا إلى التفرقة والشقاق.
[1] أبا الوليد ابن رشد، فصل المقال ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إشراف وتحرير محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربيَّة،بيروت، 2020، ص 85
[2] د . محمد عابد الجابري، نحن والتراث : قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، ط 6، بيروت، 1993، ص 238
[3] د، محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت، ط 7، 2016، ص 59
_______
*ابراهيم ماين: طالب باحث في شعبة الفلسفة بسلك الإجازة في المدرسة العليا للأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب ، حاصل على شهادة الدراسات العامة في شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب و العلوم الإنسانية في جامعة ابن زهر أكادير .
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.