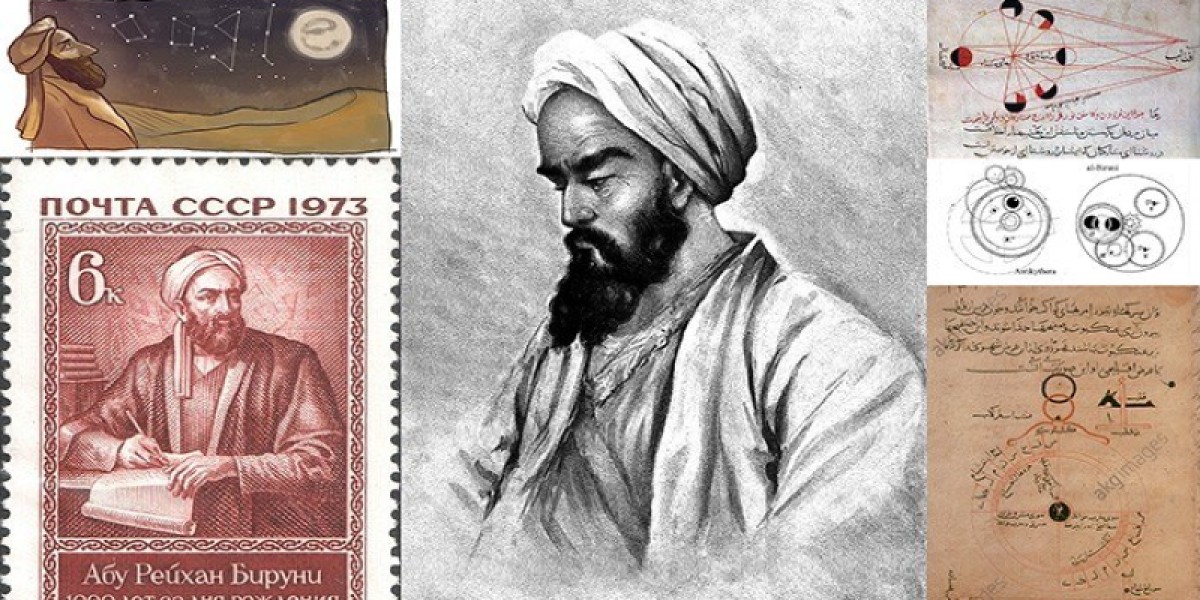مثلما فشلت كافة الأنظمة التربوية العربية في معالجة المشهد التعليمي المدرسي صوب الاجتياح الجانح لفيروس كورونا الذي يبدو أن كابوسه لن ينتهي بعد لفترات طويلة مقبلة، تواصل المؤسسات الدينية فشلها التاريخي في تجديد الخطاب الديني، نعم تجديد الخطاب الذي لا يقل أهمية عن معركة البقاء التي نمارسها بصورة يومية ونحن نواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي لم يعد مستجدا بل صار شريكا يوميا في ممارساتنا الراهنة.
ومنذ أزمة اجتياح فيروس كورونا أرض الوطن العربي وربما قبل الاجتياح أيضا والعقل العربي بحاجة ضرورية إلى التجديد وإعادة بنائه، هذا يأخذنا إلى أن ما تواجهه الكرة الأرضية من جائحة كورونا لهو حلقة أخرى من الهزة العنيفة لجائحة الأنفلونزا العالمية التي اجتاحت العالم في عام 1919 وقتلت ما يزيد عن أربعين مليونا من البشر، ومنذ ذلك الحين والعلماء في الغرب يتوقعون بحدوث جائحة أخرى ستحدث وتجتاح العالم ومن ثم ضرورة ترقبها والتعامل معها بشكل سليم وسريع لكن هي الجهالة نفسها حتى لدى المتخصصين من أهل العلم، ويظل الضحايا كما هم في عزلة عن الحدث والإحداثية أيضا.
وبالتحديد وكما يخبرنا جفري توبنبرجر Jeffery Taumenberger في بحثه المعنون بـ ” العثور على فيروس الإنفلونزا القاتل” أنه في يوم السابع من سبتمبر من عام 1918 وفي أثناء اشتعال الحرب العالمية الأولى توجه جندي في معسكر للتدريب خارج مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية إلى وحدة إسعاف شاكيا من الاشتباه في حمى شديدة، ولكن في اليوم التالي لوجود الجندي بالوحدة الطبية فوجئ الأطباء بدخول عشرات الجنود مصابين بنفس الحالة تقريبا، حتى جاء يوم السادس عشر من سبتمبر بلغ عدد المصابين 12604 حالة، مات منهم 800 جندي. ولم يكتشف وقتها علماء البيولوجي أو الطب أن ما حدث لم يكن طاعونا أو عدوى بل كان فيروسا قاتلا أشبه بجائحة كورونا الراهنة.
وكل ما يمكن تفسيره لثقافة الفيروس الجائح، هو أنه كائن يقع في منطقة رمادية بين الأحياء وغير الأحياء، وهذا ما وصف لويز فيلاريل Luis Villarreal الفيروس به في مقالته العلمية ” هل الفيروسات حية ؟ ” والذي تم نشرها بمجلة Scientific American بأن هذه الفيروسات لا تستطيع أن تنسخ نفسها بنفسها، لكنها بإمكانها الاستنساخ داخل الخلايا الحية وبالقطعية التأثير العميق والطويل في سلوكيات عوائها.
وظلت المشكلة العلمية العربية قائمة حتى لحظة الكتابة هذه، وهي الادعاء بإجراء بحوث للمستقبل، لكن الحقيقة الدامغة هي بحوث لا تخرج عن فلك المحاكاة أو التقليد لأبحاث أجنبية لا تنتمي لبيئاتنا العربية، أو هي بحوث تم إجراؤها بغرض الترقيات الجامعية التي أدرك أفراد المجتمع اليوم أنها وأصحابها طمسوا أيامنا بحقائق فاجعة لا يمكن السكوت عن خيباتها المتكررة.
وأنا لا أوجه اتهاما لعلماء العرب، مع الاستحياء الشديد عند استخدام هذا المصطلح ( علماء) لكن الحقيقة التاريخية أثبتت جمودا عربيا صوب فيروسات منصرمة مثل الإيبولا Ebola ، وسارس Sars، وهانتا Hantavirus وكانوا مثلنا تماما بانتظار معجزة علمية غربية تأتي لحل هذه المشكلات البيئية.
لكن هذا العالم بأجمعه لم يلتفت لما أشار به العالم وايت جيبز Wayt Gibbs من حدوث وباء عالمي مرتقب وأنه على العلماء ضرورة الاستعداد لمواجهته مع الدول والمنظمات العالمية، والحقيقة كما يقول أن الفشل لم يكن قصورا في التنبؤات بل القصور والتخاذل في سرعة التحرك لمواجهة الوباء العالمي الجديد، وربما هذا يدفعنا إلى محاكمة اللامبالاة والتنظيم البحثي السئ لكليات العلوم والطب والصيدلة بالبلدان العربية.
أنا أعتذر بالنيابة عن علمائنا الذين لم يخبرونا بأن النماذج الإلكترونية التي طالما اغتروا بمعرفتها لم تخبرنا بجهود احتواء الفيروس، وبأن فيروس كورونا الجائح سريع الانتشار لأن فترة حضانته سريعة وقصيرة أيضا.
وصاحب الهوس الإعلامي العربي الممزوج أحيانا بالكراهية والامتقاع والانحياز المؤقت ضد كل ما يخص مصر وشعبها وحكومتها وقت إعلان وزارة الصحة المصرية تزامنا مع منظمة الصحة العالمية بأن مصر خالية من فيروس كورونا الذي سينتهي قريبا حينما ترتفع درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية ، وبغير ادعاء متأخر بتوقع هزيمة كل القوى الداخلية والخارجية المعادية لمصر على وجه التحديد، فإن التعافي المصري على المستويين الاقتصادي والأمني هو مفاد هذه الهجمة المستعرة عليها.
ووسط ترقب إعلان نتائج جديدة بشأن وجود أية حالات مصرية مصابة بالفيروس العالمي المعد والمصنع وفق براءة اختراع أمريكية في العام 2015، يتوافد الصحافيون العرب والأجانب وأيضا بعض المهمشين المتواجدين على صفحات التواصل الاجتماعي بدعم وتمويل عربي من بعض الشخصيات والتيارات الدنيئة، ودعم آخر صهيوني من مؤسسات معروفة لدى الجهات الأمنية المصرية وكأن هناك محاولة جادة ومساعٍ قوية لإعلان دخول مصر في زمرة الفيروس. وثمة حجج أخرى اخترعتها العقلية العربية وحدها واتبعتها كتائب إلكترونية أكثر بلادة في الرصد والتحليل بأن الإعلام المصري الرسمي اعتاد التحلي بتعتيم الأخبار السيئة عن المواطن وكأن هذا المواطن غير متفاعل مع كافة مصادر المعرفة.
إنها خيبة العرب وملايين المصريين في تصديق استطلاعات الرأي الكاذبة والمخابراتية التي صدرتها لنا الولايات المتحدة الأميركية للعالم يقينا منها بأن الشعوب العربية وبعض الأقلام والعقول المنتمية لهذه البيئات أكثر تأثرا وتأسيا أيضا بكل ما هو وافد أجنبي لكن الحقيقة المؤكدة أن شيفرة مصر العصية على الفهم لا يمكن اختزالها في بعض الوجوه التي تظهر على قنوات تنظيم الجماعة الإرهابي أو هؤلاء الذين يدعون الليبرالية وهم في حقيقة الأمر ويقينه أعتى أنصار الراديكالية المتطرفة أيضا. بينما ذهبت برامج فضائية عربية كثيرة لا يمكن وصفها إلا بالفراغ والتربح الزمني ترصد وتسرد القصص الوهمية المريضة عن حقائق تحدث في مصر رغم أن الزعم باطل بتوكيد وجودهم خارج البلاد بل هم بالفعل خارج تفكير العباد في الداخل.
لكن على العقل المتأمل لهذا الفزع من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصبح يمتلك صك العالمية بعد أن امتلك صاحبه صك براءة الاختراع العلمي كما ذكرت في 2015، أن يرجع لمناقشة الحالة العلمية الأكاديمية في مصر تحديدا بكليات الطب والعلوم والصيدلة، تلك الكليات وإن كانت كليات العلوم بحاجة إلى إعادة تفكير في قرارات إنشائها بدول عربية لا تزال تحارب الأمية وتتصارع مع مقومات تفشي الجهل بها.
فلقد من الله علينا ـ بجامعاتنا المصرية والعربية العريقة البعيدة عن التصنيف العالمي للجامعات ذات الجودة ناهيك عن تلك الإشارات المرجعية الكاذبة أغلب الوقت ـ بنعمة نحمد الله عليها، وندعوه بألا يحرمنا إياها، وهي وجود عيادات طبية مزودة ومجهزة بأفضل وأجود وأحدث وأكمل الأدوات والمواد الطبية. وبالتأكيد تشرف كل عيادة طبية بتلك الكليات بطبيب أو طبيبة أكاد أجزم بأنه لا ولم يدخل غرفة عمليات منذ تعيينه بالعيادة الجامعية، وطبعاً هذا الطبيب منوط به الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس أنفلونزا كورونا، مستخدماً في ذلك أدواته الطبية التي تتطابق مع مؤهلاته العلمية.
ووسط تلك المخاوف المرضية السائدة حول الإصابة المتوقعة بفيروس كورونا، استوقفني طالب جامعي / ووجه لي سؤالاً بريئاً، وأقسم بالله أن السؤال برئ مثل صاحبه، وكان لماذا لا تتوقف الدراسة بالجامعات احترازاً لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقبيل الإجابة عن هذا السؤال الذي أراه بريئا، فكرت في أن مصر آمنة بفضل تدينها الضارب في القدم، نظرا لأن من مسببات الإصابة هو إصابة الشخص بنقص اكتساب المناعة الطبيعية، فقلت له إن عدم تعليق الدراسة بالجامعات له فوائد جمة وكثيرة، ومتنوعة عند البعض، فمنها أن بعض الطلاب يعيشون آلاف قصص الحب والغرام مع زميلاتهم بأروقة وساحات الدراسة، بدلاً من هوس البحث عن صداقات وهمية عبر الفيس بوك وخلافه، كذلك تصوير الفتيات لأنفسهن وهن يرقصن على أغاني المهرجانات العشوائية وإعادة تحميل هذه الفيديوهات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بغير هدف سوى تكريس ثقافة الذاتوية التي ستودي بهم حتفا إلى التوحد ومن ثم الإقصاء عن مجتمعاتهم. كما أن في حالة إغلاق الدراسة بالجامعات ستصبح الفرصة سانحة لأصحاب الفرق والجماعات الهدامة لاستقطاب عدد كبير من الطلاب الذين يعانون ثمة إحباطات عاطفية وسياسية ومجتمعية واقتصادية وأسرية؛ فيبثون فيهم أفكارهم الهدامة والتكفيرية للمجتمع وفئاته المختلفة.
كما أن البعض من الطلاب لن ولا يجدوا متنفساً لهم سوى الجلوس على المقاهي العامة أو في المقاهي الإليكترونية (سايبر) التي تعد خطوة أولى نحو الإدمان وضعف الاتصال المباشر مع الآخرين.
لكن هذا الطالب أدهشني حينما ذكر لي أن جميع الفوائد السابقة لا تنطبق عليه، ولا يطمح لتحقيقها، فهو طالب يحب قاعات الدرس، ويتنفس رائحتها، ويعشق الكتاب لأنه مصدر للعلم والمعرفة والحقيقة. وحينما سألته عن الموضوعات التي يدرسها في مادة الحضارة الإسلامية فاجأني بأنه يدرس كتابا للدكتور (فلان) وأشار إلى مذكرة صغيرة بيده، وهنا أيقنت أن هذا الطالب وزملاءه بالدرس الجامعي في خطر حقيقي أشرس من هؤلاء الذين تحدثت عنهم سابقاً. فمن الطبيعي أن تصبح المادة التدريسية في أيدي الطلاب الجامعيين مادة علمية إبداعية، تقدم لهم خلاصة البحث العلمي في حقل علمي معين، وطاقة منهجية وتربوية تحرض فيهم القدرات والطاقات الذهنية العقلية ليستوعبوا تلك الخلاصة أولاً، وليبدعوا ما يتممها ثانياً.
وعلى ذلك فمهمة المادة الدراسية تكمن في تكوين الشخصية الطلابية التي يجب أن تتسم بعدة سمات أبرزها العقلية النقدية المبدعة. لكن هذا بالطبع لا يحدث في أغلب جامعاتنا العربية الكبيرة جدا غير المصنفة عالمياً طبقاً لتصنيف جامعة شنغهاي ؛ حيث يسهم الكتاب الجامعي الأوحد في هيمنة العقل، أي جعل الطلاب ذوي بعد تفكيري واحد. وإذا أردت أن تعرف سبب تصدع التعليم العالي في مصر فاسأل عن مصدر المعرفة لدى هؤلاء الطلاب الذي لا يخرج عن مجموعة من الصحائف التي هي في الأصل جزء من رسالة الدكتوراه الخاصة بأستاذ المادة.
وإذا كان فيروس كورونا الراهن يتحور ويتخذ أشكالاً وصوراً وألواناً وكمامات أيضا، فإن الكتاب الجامعي أيضاً ينافسه في التمحور والتشكل، بدءاً من بصورة الكتاب التقليدية، ومروراً بأشكال المذكرة، والملزمة، وكراسة المراجعة النهائية، انتهاءً بالنشرات العلمية وأوراق العمل.
وثمة أمر ذي أهمية خاصة يدعنا نلح على ضرورة تنويع وتطوير شكل المادة العلمية، وعدم اقتصارها على صورة الكتاب الجامعي ذي الصفحات المحدودة، ذلك هو أن العمل والأداء العلمي ذاته يقتضي وجود رؤية متسعة للمعرفة، وخلق طبيعة جدلية تجاوزية تنطلق من أن الحقيقة العلمية لا يمكن أن يختزلها كتاب واحد، مهما كان مهماً وعميقاً.
إن الاهتمام بالاقتصار على كتاب واحد للطلاب بالجامعة في علم معين لهو جدير أن يخلق طلاباً ملفقين مبتذلين، ومفتقدين للتماسك المنطقي والعمق الفكري المنهجي. والتجربة الشخصية لي ولكثيرين من زملاء الدراسة والعمل الأكاديمي تبرهن على أن اقتصار الأستاذ الجامعي على كتاب واحد محدد لهو قتل لدوره النقدي التنويري الذي كان من الأحرى أن يمارسه، ولهو ـ أيضاً ـ تدمير لطاقات الطلاب المتجددة، فكيف يوجه الطلاب أسئلة تتعلق بصفحات هي فكر الأستاذ نفسه، وبعد ذلك يتساءلون لماذا لا ننافس الجامعات العالمية المبدعة؟.
ولعل أدق وصف قرأته بخصوص هذا الموضوع أن الطالب والأستاذ في ظل هيمنة الكتاب الواحد يشبهان حصانين كلاهما يسيران إلى الأمام فقط، ولا يريان الجانبين والخلف. ويا حسرتاه على طالب ساذج يصدق أستاذه حينما يؤكد له على أن هذه المذكرة هي عصارة الفكر في علم معين.
وإذا كان فيروس كورونا غير رحيم بنا وبأولادنا وبطلابنا، فعلى أساتذة الجامعات غير المصنفة عالمياً أن يتسموا بالرحمة، ليس هذا فقط، بل وبتطعيم عقول طلابهم بأمصال متعددة للمعرفة لمقاومة وضعية التخلف الراهنة، وذلك حتى لا يذهب مثل هذا الطالب بعيداً عن قاعات الدرس والمكتبة، ولا يجد أمامه سوى مصادقة فتاة دون هدف، أو الانتماء إلى جماعات هدامة، أو الجلوس على مقهى لمتابعة المنضمين حديثاً لمعسكر المنتخب في مباراته القادمة.
أما هؤلاء الأكاديميون الذين ينتسبوا لكليات العلوم والذين يتباهون بأبحاثهم المنشورة عالميا بمجلات معظمها إلكترونية، فهم كُثر، ولا شك أن أبحاثهم عظيمة الشأن وذات قيمة علمية عالية، في السويد ونيجيريا وطوكيو وجزر المالديف، لكن برجهم العاجي والعالي البعيد عن مطالب أمة جعلهم بمنأى عن الاحتكاك بمتطلبات الواقع، ويتحدثون دوما عن أساسيات العلم وضرورة اكتساب الطالب مبادئ علمية رصينة وإلزامية وهي بلا شك وبحكم تخصصهم ضرورية في بدء التعلم، لكنها بحق غير مرتبطة بمستقبل الوطن ورؤيته المعروفة إعلاميا برؤية مصر 2030.
وعشرات الجوائز العالمية ومئات التكريمات التي يظفر بها هؤلاء الأكاديميون بأبحاثهم التي تتوافق مع مجتمعات وبيئات مختلفة، لكن العلاقة بين تلك الأبحاث وآلاف الأطروحات العلمية في مجالات الكيمياء والفيزياء وعلوم الحيوان والجيولوجيا والأحياء وقضايا الوطن وهمومة مبتورة ومقطوعة ولا صلة بينهما. الأمر الذي يلزم التنبيه على أولئك العلماء الأجلاء أن يربطوا أبحاثهم بواقع فعلي أو بقضايا مستقبلية شديدة الصلة بمتطلبات الوطن، فالنصيحة التي أرجو من الله أن تصل إلى عقولهم أن المحك الرئيس للعلم هو الوظيفية والنفع الحقيقي، اللهم انفعنا بما علمتنا.
ـ أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية (م).
ـ كلية التربية ـ جامعة المنيا.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.