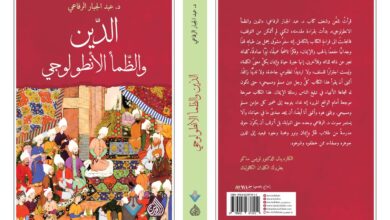علم الكلام الجديد في ضوء رؤية عبد الجبار الرفاعي
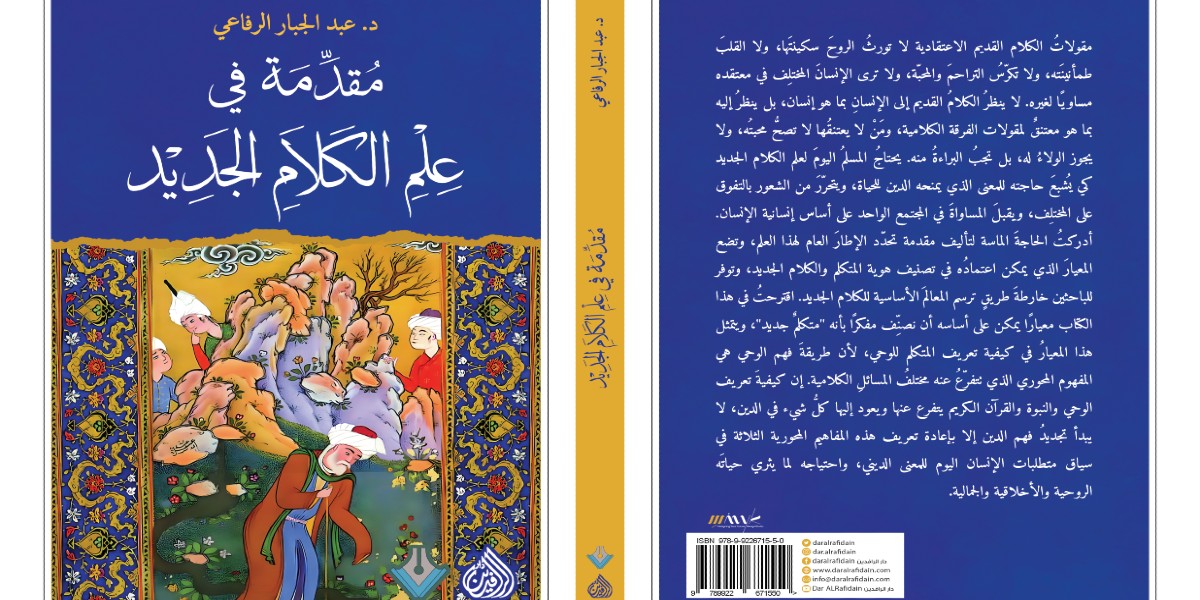
منذ أكثر من 30 سنة يعمل عبد الجبار الرفاعي على إعادة بناء علم الكلام وفلسفة الدين في المجال العربي. أصدر مركز دراسات فلسفة الدين الذي أسسه الرفاعي ببغداد أكثر من 300 كتاب. وأصدر الرفاعي مجلة قضايا إسلامية معاصرة قبل 26 سنة، وتخصصت هذه الدورية بعلم الكلام الجديد وفلسفة الدين، وصدر منها حتى اليوم 76 عددًا، أكثر الأعداد تتجاوز 400 صفحة. واعترافًا بالمهمة التي نهضت بها، وبوصفها الدورية الأهم المتخصصة بفلسفة الدين وعلم الكلام الجديد بالعربية، خصّص “المعهد البابوي في روما” التابع للفاتيكان كتابَه السنوي 2012 لهذه المجلة، وصدر الكتاب بالإيطالية والانجليزية والفرنسية، في 320 صفحة.
وعبد الجبار الرفاعي مُفَكِّر عراقيّ، مُتَخَصِّص في الفلسفة وعلوم الدين، ومن مؤسسي علم الكلام الجديد في العالم العربي، بلغت عناوين آثاره المطبوعة 50 عنوانًا، الأخيرة منها هي: «الدين والظمأ والأنطولوجي»، و«الدين والاغتراب الميتافيزيقي»، و«الدين والنزعة الإنسانية»، و«الدين والكرامة الإنسانية»، وكتاب «مقدمة في علم الكلام الجديد». أعماله تحاول التأسيس لمشروع فكري يقوم على فهم الإسلام فهمًا تجديديًّا؛ يخرج به عن سياقاته المأزومة والضيِّقة إلى سياقات أخرى هي أوسع وأرحب وأكثر تسامحًا ورحمانيّة.
وأخيرًا أصدر الرفاعي كتاب «مقدمة في علم الكلام الجديد». صدر في طبعته الأولى عن دار التنوير ببيروت ومركز دراسات فلسفة الدين ببغداد، ثم صدر في طبعة ثانية جديدة مزيدة ومنقَّحة عن دار الشؤون الثقافيّة ببغداد، وازداد حجمُ الكتاب في هذه الطبعة أكثر من خمسين صفحة، وهي أجود وأغنى، كما صدر أيضًا عن دار المصورات بالخرطوم، وهي نسخة مطابقة تمامًا لنسخة دار الشؤون الثقافية دون زيادة فيها، كما صدر أخيرًا سنة (2023) عن مركز دراسات فلسفة الدين ودار الرفدين في طبعة ثالثة جديدة، وهي مزيدة فصلًا جديدًا ومنقَّحة. اعتمدتُ في تلخيصي هذا على الطبعة الثالثة الواقعة في 234 صفحة، وهذه الطبعة مزيدة أيضًا بـ «مناقشة الرؤى الرسولية لعبد الكريم سروش»، وهو باب مزيد فيها.
هنا نحاول التعريف بعلم الكلام الجديد في ضوء رؤية الرفاعي في هذا الكتاب الرائد؛ وهو كتابٌ يحكي تجربة الرفاعيّ الذي انهمك منذ وقتٍ مبكِّر في الدعوة إلى التجديد الكلامي، ومحاولة ابتناء علم للكلام الجديد. وينبع اهتمام الرفاعيّ بالكلام الجديد من أنّه المنطلق الذي ينبغي أن يبدأ منه كلُّ مشروع فكريّ يروم التجديد. ولأهميّة هذا الكتاب تبنَّتْهُ جامعاتٌ ومعاهد تعليم ديني مُقَرَّرًا دراسيًّا في “علم الكلام الجديد” داخل العراق وخارجها، كما صدرت ترجمته إلى (الفارسيّة) صيف هذا العام، وترجمته (الكردية) تحت الطبع، ويُعْمَل على ترجمته ونشره باللغة (التركيّة)، ولغات أخرى.
يقول الرفاعيُّ: «انشغلتُ سنواتٍ طويلة في علم الكلام الجديد، وقرأتُ وسمعتُ البلبلةَ والغموضَ، والتشوُّشَ والالتباسَ في تعريفه، وتحديد موضوعه وأركانه ومرتكزاته، فأدركتُ الحاجةَ الماسَّةَ لتأليف مقدِّمة تحدِّد الإطار العام لهذا العلم، وتضع المعيارَ الذي يمكن اعتمادُه في تصنيف هوية المتكلم والكلام الجديد، وتوفِّر للباحثين والدارسين في علم الكلام وفلسفة الدين خارطةَ طريق ترسم المعالم الأساسيّة لعلم الكلام الجديد» (ص 20).
يقع الكتاب في خمسة فصول رئيسة في طبعته الثالثة الصادرة هذا العام 2023 عن دار الرافدين ببيروت ومركز دراسات فلسفة الدين ببغداد؛ يحمل الفصلُ الأولُ عنوانَ «ملخص لنشأة علم الكلام وتطوره وعجزه»، وهو كما يظهر تلخيص للأدوار التاريخية التي مر بها علم الكلام. ويحمل الفصلُ الثاني عنوان “تجديد علم الكلام” ويتحدث المؤلف في هذا الفصل عن أن منهجه هو التجديد وليس الاصلاح ولا الإحياء ويحدد تسعة أركان لتجديد علم الكلام، ويحمل الفصلُ الثالث عنوان «الكلام الجديد هو الفهم الجديد للوحي»؛ يضع فيه المعيار الذي يتميّز به الكلامُ الجديد عن غيره، مُفَرِّقًا بين مفاهيم كالإحياء والتحديث والتجديد، كما يناقش فيه عبد الكريم سروش في مفهومه حول الوحي و«الرؤى الرسولية». ويحمل الفصل الرابع عنوانَ «الفهم الجديد للوحي لدى مفكِّري الإسلام في الهند»؛ يتناول فيه الفهم الجديد للوحي الإلهي لمفكّرين كولي الله الدهلوي، وسيد أحمد خان، ومحمد إقبال، وفضل الرحمن. أما الفصل الخامس والأخير، فهو حوار أُجْرِيَ مع الكاتب في إطار التعريف بعلم الكلام الجديد، ويقع تحت عنوان «إيقاظ المعنى الروحي والأخلاقي للدين في الكلام الجديد»؛ يدور حول الغاية من ابتناء علم للكلام جديد؛ وهي ابتعاث تلك المعاني الجمالية والرحمانية في الدين، ونفي صورة الله المرعبة عن الله التي قامت في الكلام القديم.
مدخل
فرضَ علمُ الكلام التقليدي على الدين الإسلامي رؤيةً للعالَم أثَّرَتْ تأثيرًا بالغًا في تعطيل الاجتهاد والتجديد في الدِّين، ومن هنا جاءت الدعوةُ إلى الانتقال من الكلام القديم إلى الجديد استجابةً لأسئلةِ الإنسان المعاصر وقلقه واغترابه الروحيّ، وما دام هناك إنسان، فهناك أسئلة ميتافيزيقيّة كُبْرَى، وتحدِّيات روحيّة ينبغي الوفاءُ بها؛ يفرضها تطوُّرُ الوعي البشريّ واختلافُ الزَّمانِ والمكانِ التَّاريخيّ.
ينطلق الكلامُ الجديد بتعريف الوحي الذي تتفرَّع عنه المسائلُ الكلاميّةُ الأخرى، ومحاولة تقديم تفسيرٍ جديد له؛ شرط أن يكون التفسيرُ الجديدُ منحصرًا في إطار الدين الميتافيزيقيّ لا خارجًا عنه، ومن هنا يأتي المعيارُ الذي به يُعَرَّفُ الكلامُ الجديد والمتكلمُ الجديد من كونه يبتدئ أوّلًا بتبنِّي مفهوم جديد ميتافيزيقيّ للوحي. والآن، فلنُقم برحلة موجزة في تاريخ علم الكلام وتطوّره وعجزه أخيرًا.
رحلة تاريخية موجزة
نشأ علمُ الكلام بين المسلمين مبكِّرًا لعوامل تاريخيّة كثيرة، وتصدّرت مسألةُ «الإمامة» العواملَ الباعثةَ على إنشاءِ الكلام، فكانت السياسةُ وراء ولادة الكثير من المعتقدات والأفكار التي تشكَّلت منها المذاهبُ بعد ذلك، وظلَّتْ تلعب هذا الدور دائمًا.
غذَّتِ الصِّراعاتُ اللاحقةُ بين المسلمين مسائلَ هذا العلم، وعملتْ على تطوُّر نقاشاتِه وتَشَعُّبِها. وبعد انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربيّة، واستيعابه لمجتمعات وإثنيّات أخرى متعدِّدة، كانت لها أديانُها وثقافاتُها وتراثها، دخل كثيرون منهم الإسلامَ وهم مُحَمَّلُون بهذه الترسُّبات الكامنة في أعماقهم، فكان لها عظيمُ أثر في إثراء هذا العلم وتعدُّد أبوابه ومذاهبه.
وفي فترةٍ لاحقةٍ استهوى علماءَ الكلامِ المنطقُ الأرسطيُّ وفلسفةُ اليونان وامتداداتُها؛ وذلك بعد انفتاح المسلمين على التَّرجمة. دخل الكلامُ في مرحلة لاحقة دوائرَه المغلقة، فأضحى عاجزًا عن استيلاد مسائل جديدة أو استخدام مناهج أخرى في البحث والتأويل، وظلّ يعالج المسائل نفسها التي عالجها السَّلَفُ، يبتدئ من حيث ينتهى، وينتهي من حيث يبتدئ.
بلغ الكلامُ ذروتَه في القرن الرابع الهجري، واستوت الفرقُ والمذاهبُ وتنوّعَت وتعدَّدَت، وحاولتْ هذه المذاهبُ على تكاثُرِها أن تكون لها مقولاتٌ كلاميَّة في السياسةِ والإمَامَةِ؛ وكُتِب لهذه المذاهبُ التي طوّرَت لنفسها نظريّةً سياسيّة تسوِّغ مسلكها السياسيّ عقديًّا البقاء في تاريخ الإسلام وعالَمه، أمّا غيرها فلم تلبث إلا وانطفأتْ مبكِّرًا.
إشكاليَّة المُسَمَّى
أطلقُ الدَّارسون على ذلك العلم الذي يدرس العقيدة أسماءً عديدة؛ من بينها «الفقه الأكبر» الذي يدرس الاعتقاداتِ في مقابل «الفقه الأصغر» الذي يدرس العمليّات، كما أُطْلِقَ عليه اسمُ «أصول الدِّين»، لأنّه يتمحور حول بيان أصول هذه الديانة، وأُطْلِقَ عليه اسمُ «التوحيد»، فهو العلم الذي يدرس مسألةَ توحيد الله؛ تسميةً للكلِّ بأشرف أجزائه، كما أُطْلِقَ عليه مُسَمَّى «العقائد»، فهو العلم الذي يدرس عقائدَ الإسلام ويعمل على بيانِها، وأمَّا عن أشهر أسماء هذا العلم، وأكثرها تداوُلًا وانتشارًا فهو مسمّى «علم الكلام».
للدارسين آراء متعدِّدَة حول السبب وراء هذه التسمية، فمن قائل إنّ عنوان مباحثه كان قولهم «الكلام في كذا»، أو لأنّ صفة الكلام كانت أشهرَ مباحثه وأكثرَها جدلًا، أو لأنّه يُورِثُ القدرةَ على الكلام، أو لأنَّه من العلوم التي تُعْلَم وتُتَعَلَّم بالكلام، أو لأنَّه مشتقّ من الكَلْمِ الذي هو الجرح، أو لأنَّ الكلامَ ضدُّ السكوت، وكان المتكلمون يتكلمون حيث ينبغي الصمت، إلى غير ذلك من أسباب متكاثرة أوردوها وتخالفوا فيها أيضًا.
تيّار الظاهريّة وفشوّ التقليد
وُلِدَ التفكيرُ الكلاميّ غريبًا في مجتمع فكريّ يناهضُ وجودَه، ولا يراه شيئًا، وأُلْصِقَتْ به مختلفُ التُّهَم، ووصفهم أئمةُ الفقه الأوائل – كما ورد عنهم – بالبدعة وأقسى الألفاظ وأشنعها؛ وبذلك تغلغلتْ الأفكارُ المناهضةُ لعلم الكلام وعيَ المسلمين، وأُودِعَتْ أمثالُ هذه العلوم قفصَ الاتِّهام على الدّوام، ورغم ذلك اشتدّ عودُ الكلامِ وتبلورت مسائلُه مبكِّرًا.
توفَّرَتْ هوامشُ من الحريّة الفكريّة والدينيّة أدَّتْ إلى نشوء الفرق الإسلاميّة الكبرى كالمعتزلة والأشاعرة والماتريديّة والشِّيعة، وضمَّتْ كلُّ مدرسةٍ أجيالًا من المتكلِّمَةِ المجتهدين الذين اشتغلوا بتطوير هذا العلم وترسيخ مدارسِهم الكلاميَّة وتدعيمها بشتّى الوسائل والأدوات. بدأ مُتَنَفَّسُ الحرية هذا يذبل شيئًا فشيئًا حينما طغتْ روحُ التكفير بعضَ المتكلمين والفقهاء.
تعاون الخليفةُ المتوكِّلُ مع الفقهاء في فرض حصار فكريّ على المتكلمين، وألزم غيرَه برؤية عقديَّة بِعَيْنِهَا مَنَحَهَا المشروعيَّةَ، وحظر ما عداها. وفي مرحلة لاحقةٍ جاءتْ وثيقةُ «الاعتقاد القادريّ» – نسبةً إلى الخليفة القادر بالله – مُتَبَنِّيةً رؤية الحنابلة في العقيدة، مستهدفةً بعضَ المتكلِّمين، مُسْتَحِلَّةً دماءَهم. واتَّسع نفوذُ الاعتقاد الظاهريّ بمرور الأيام، مناهضًا أيَّ محاولة للعقلنة العقائديّة، مُقْصِيًا كلَّ ما يخالفه من رأي.
يُطْلِقُ علمُ الكلام – في أصله – للإنسان حريةَ التفكير في العقيدة، ولا يرى جوازَ التَّقليد؛ استدلالًا على ذلك بالنقل والعقل، ولم يقُلْ بجواز التقليد في العقيدة أحدٌ إلّا تيَّار أهل الظاهر المناهض للمتكلِّمين. ضحَّى تيارُ الظاهريّة الاعتقاديّة بروح الشريعة ومقاصد الدِّين الكُلِّيَّة، مُغَيِّبًا العقلَ، مُتَجاهِلًا كلَّ عصرٍ وما يحفل به من تغيُّرات شتّى.
ورغم ما حفلت به مدوّنات الكلام القديمة من تحريم للتقليد العقائديّ، إلّا أنّ الأتباع قلَّدُوا مؤسِّسي ومجتهدي الفِرَق والمذاهب العقديّة وتابعوهم في آرائهم جيلًا بعد جيلًا دون أيّ محاولة لنقدها أو الخروج عليها؛ وبذلك تعطَّل الاجتهادُ الكلاميُّ من قِبَل أهلِه كذلك.
ركود الكلام
اصطبغ الكلامُ بألوان الثقافات المحلِّيَّة في المجتمعات الإسلاميّة، ولم يتحرَّر أبدًا من تأثيرات الموروث، ففي القرن الأول وحتى القرن الثالث، كان التفكيرُ الكلاميُّ يدور مع ما يتسجدّ من أسئلة واستفهامات، لكنّه مع بداية القرن الثالث انتهج نهجًا جديدًا، دُشِّنَتْ فيه مرحلةٌ جديدة؛ اشتغل فيها المتكلِّمون بابتناء المباني، وتأسيس المذاهب والفرق الإسلامية الكبرى.
عصفتْ بالكلام عواصفُ لم تمنعه من المُضيّ قدمًا، بل وظهرتْ في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع أهمُّ مدونات الكلام؛ مثل «المغني» للقاضي عبد الجبار في القرن الخامس الهجري، و«التجريد» لنصير الدين الطّوسي في القرن السابع الهجريّ؛ الذي أصبح نموذجًا يرتسمه الباحثون.
لم يشهد التأليفُ في علم الكلام أعمالًا إبداعيّة أخرى بعد «التجريد»؛ ما كان إيذانًا بركود هذا العلم وانسداد سُبُلِهِ منذ هذا الحين. لكن، ظهرتْ إرهاصاتُ انبعاثٍ جديد نهاية القرن الثالث عشر، وتبلورت أسئلةٌ جديدة استفاق بها الفكرُ الكلاميّ، واستهلّ جماعةٌ من الأعلام محاولةَ إحيائِه واستدعائه في العصر الحديث، ومن ثَمَّ العمل على إعادة بنائه وتجديده.
أسباب عجز الكلام القديم
عُمِّمَتْ المقولاتُ الكلاميّةُ القديمةُ على جميع العصور؛ ما جعل الكلامَ عاجزًا عن مواكبةِ الحياة الراهنة بمشكلاتِها المستجدَّة، وتحدِّياتها الجديدة؛ ويمكن إيجازُ مظاهر هذا العجز في المحاور الآتية:
- مرجعيّةُ المنطق الأرسطيّ
رغم رفض المتكلِّمين للفلسفة وطرائقها إلا أنّهم قبلوا المنطق الأرسطيّ واستعملوه أساسًا يبنون عليه مقولاتِهم الكلاميّة، بل وصار المنطقُ مرجعيةً يَحْتَكِمُ إليها المتخالفون حول المسألة الواحدة؛ كلٌّ يُدَعِّمُ كلامَه مستخدمًا قواعدَ هذا المنطق وطرائقه في الاستدلال وإقامة الحجّة. ظلّ المنطقُ الأرسطيّ جامدًا عند ما قاله أرسطو منذ زمن بعيدٍ، ولم يَعُدْ قادرًا على مواكبة تطوُّرات العصور المتتالية التي انقلبتْ عليه حديثًا، ورفضتْه منهجًا للتفكير.
- الفصام بين النظر والعمل
تغلَّبَتْ بالتّدريح النزعةُ التجريديّةُ الذهنيّةُ على المنحى الواقعيّ في علم التفكير الكلاميّ، وانجرّ إلى عالم ذهنيّ مُجَرَّد؛ يُفَكِّرُ في مسائل بعيدة لا تواكب مشكلاتِ الإنسان الواقعة، وجعل يُدَقِّق في مسائل افتراضيّة ومحاججات بعيدة عن آمال الإنسان وآلامه في الحياةِ المُعَاشَة. أدَّى هذا إلى تغليب النَّظَرِ على العَمَل، وحالة انفصاليَّة ما بين النَّظر والعمل، وهيئة فكرية تغلب فيها الحكمةُ النظريّة الحكمةَ العمليّة، بل وتعمل على الحطِّ من شأنها.
- شيوع التَّقليد
تراجعَ دورُ العقل بالتدريج وشاع التَّقْلِيدُ الذي يرفضُه المُتَكَلِّمَةُ أصلًا، إذ جعلتْ أقوالُهم تُبْتَنَى على الإيمان بمسلَّمات قَبْلِيَّة يقومون بالاستدلال عليها بمقدِّمات يقينيّة؛ ما أدّى بهم إلى منهج جدليّ لا طائلَ وراءَه، فتراجع لذلك دورُ العقل وشاع التقليدُ في أصول الدين، وصار الأتباع يُسَلِّمون بمقالات شيوخهم، ويدعِّمونها بالحجج، دون مراجعة أسُسِها، أو التفكير خارج مساقاتها، ودخل الكلامُ معهم مرحلةً من السبات العميق.
- إهمال الإنسان
لم يدرس المتكلِّمون الإنسانَ، ولم يُدْرِجُوا في مقالاتهم بحوثًا تتناول همومه واحتياجاته، ولم يتعاملوا معه على أنّه المقصد الأسمى وراء الوحي الإلهيّ، بل انشغلوا بالغيبيّات والمقالات السياسيّة التي أنهكتِ الإنسان، وانتهكتْ كرامتَه التي تُعَدُّ مقامًا وجوديًّا خُصَّ الإنسانُ به إلهيًّا.
- غياب الضمون الاجتماعيّ عنه
لم يقتصر الكلامُ القديمُ على تجريد الكلام والابتعاد به عن الجانب العمليّ منه، بل تَفَرَّغ فيه التوحيدُ عن مضمونه العمليّ، وغدا الاعتقادُ أقربَ إلى التصديقات الذهنيّة التي لا يُرَى لها تطبيقٌ سلوكيّ في عالم الواقع.
- التربية على الخوف
صوّر الكلامُ القديمُ الإلهَ في صورة مرعبة؛ جعلت الإنسانَ معه عبدًا مُسْتَرقًّا خانعًا ذليلًا، تُصَادَرُ حقوقُه وحريَّاتهُ. واحتجب بذلك لاهوتُ الرحمة، وتنمَّطَتْ علاقةُ الإنسان بالله، فقامت على أساس من القهر والخوف، لا الحبِّ والرغبة.
- ترسيخ اللاهوت الصراطيّ
يُجَادِل كلُّ متكلِّم عن مذهبه الكلاميّ، ولا يكتفي بذلك، لكنّه يقوم بحصر الحقَّانيّة في مقولات فرقته فحسب، محتكرًا صورة الله، ومحاولًا استملاكَه، واصمًا المخالف بالابتداع في الدِّين أو الكفر أو درجة تكون بينهما؛ ما أدَّى إلى حالة اصطراعيّة بين أتباع الفِرَق… كُلٌّ يحاول فرضَ نفسه على الآخر بكلِّ طريقة ممكنة، وصارَ العَيْشُ المشترك بين المختلفين عقديًّا أمرًا مستحيلًا.
- إهمال الرّوح
أورد المتكلِّمون مقالاتِهم بأسلوب رياضي، أو منطقيّ، أو فلسفيّ، أو علميّ، وجانبوا الجانبَ الروحي والعاطفي في محاججاتِهم، فنتج عن ذلك إيمانٌ جافٌّ يُهْمِلُ الروح، ولا يُلْقِي بالًا بانفعالات الإنسان وعاطفته وشعوره الداخليّ، ولهذا ابتُعِثَ التصوّف علمًا مستقلًّا؛ ردًّا على هذا الإهمال والضياع الروحي للمسلمين الذي ساهم فيه المتكلِّمون.
- الافتقارُ إلى المَضْمُون الأخلاقيّ
عرفنا أنَّ الكلامَ لا يعتبر الحكمةَ العمليّةَ كثيرًا؛ ومن هنا جاء إهماله للمضمون الأخلاقيّ، فلا نعثر في مدوّنات الكلام على مختلف فِرَقِها ومذاهبها مبحثًا يتناول ماهيّةَ القيمة الأخلاقيّة مثلًا، ولا نجد ما يمكن أن يُلَمِّح إلى مباحث تتعلق بالفضيلة والسعادة، رغم امتلاء القرآن بمناقشة هذه القيم وتركيزه عليها في مواضع كثيرة.
- عدم التمييز بين المقدس واللامقدس
كان التمييزُ قائمًا بين النص الأوَّل (القرآن والسنّة)، والنّص الثاني (شروح النّص الأول)، لكن حدث بينهما خلطٌ بالتدريج، إذ ارتقت بعضُ الشروحات والتفاسير الدينيّة مقامًا مُقَدَّسًا وهي في أصلها أفهامٌ بشريَّة.
ولم يكن المتكلّمون بِدْعًا من هذا الأمر، إذ كانت لهم مقولات وشروحات خاصّة بهم في ضوء العصر الذي عايشوه والمعارف التي يعرفونها، ثم جاءَ أتباعُهم -في عصور التقليد والانغلاق- غارقين في التفسيرات والشروح وشروح الشروح والحواشي؛ لا يأتون بجديد، ولا يتعاملون مع هذه النصوص بروح النَّقد، بل حصروا فيها الأقوالَ، وعاملوها كأنَّها نصوص مقدَّسة.
- تجاهُل العوامل المؤدِّية إلى نشأة الفرق
تجاهلَ الكلامُ الظروفَ والعواملَ التي نتجت عنها الفرقُ والمذاهبُ الكلاميَّةُ ولا سيّما العامل السياسيّ، وكأنّها نشأت في سياق منفصل عن زمانها وبيئتها وتاريخها الخاص.
- الاعتماد على الطبيعيّات الكلاسيكيّة
من المشكلات التي مُنِيَ بها الكلامُ أن اعتمد على علوم الطبيعة لدى القدماء، وأوردوا مسائلَها القديمة في مدوَّناتهم متعاملين معها على أنَّها حقائق نهائية، وما زاد في الأمر من سوء أن استمرّت هذه الطبيعيّات مبثوثةً في كتب المتكلِّمين وثناياها، مختلطةً بغيرها؛ يُكَرِّرها الخَلَفُ ويتناقلونها جيلًا بعد جِيلٍ.
ماهيّة الكلام الجديد
محاولات إحيائيّة: بين التجديد والإصلاح
قارب القرنُ الثامن عشر على الأفول، وحدث اللِّقاءُ الأوّل بين الشرق والغرب منذ مدّة طويلة في مصر حينما غزاها نابليون عام 1798م، فكانتِ الصدمةُ الحضاريةُ أوقعَ من الصدمةِ العسكريّةِ، ثم كان أن ابتُعِثَ رفاعةُ رافع الطهطاويّ إلى فرنسا، فانبهر بفنون وآداب ومعارف الفرنسيِّين مدوِّنًا ما رآه وتعلَّمه هنالك في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، ومن ثَمَّ عاد إلى مصر مفعَّمًا بطاقة الترجمة، مساهمًا في نقل ما اقتدر عليه من العلوم والفنون والمعارف الحديثة.
وحدث الأمرُ نفسُه في شبه القارّة الهنديّة حيثُ استحوذت الدهشةُ على النّخبة المفكِّرة هنالك، فدعا سيد أحمد خان المسلمين في الهند إلى الأخذ بمكاسب الحضارة الغربية، وأصدر من أجل ذلك مجلة «تهذيب الأخلاق»، وأسَّس «جامعة عليكرة الإسلاميّة» تحقيقًا لهذا المطلب؛ ما أدّى إلى عاصفة من جدلٍ ومناظرةٍ أيقظت الفكرَ الكلاميَّ الكامنَ، وانبرى جمالُ الدين الأفغاني وأكبر حسين الإله آبادي للردِّ على مقالات أحمد خان وآرائه بخصوص هذا الأمر.
سرتْ عاصفةُ التجديد والإصلاح العالَم الإسلامي أجمع، واختلط الإصلاحُ بالتجديد، والتجديدُ بالإصلاح، واتّسمت الحركاتُ الإصلاحيّة برفض التعصب والتحجُّر، ومحاكاة شيء من الإصلاح اللوثري في المسيحيّة، أما التجديد فاتّسم بالإبداع والابتكار، والإتيان بما لم يكن مألوفًا من قبل، واستخدام أدوات منهجيّة حديثة لم تكن مستخدمةً في السابق.
دار النِّقاشُ بين الباحثين حول مفهوم التجديد الكلاميّ، فرأى البعضُ أنّه يعني دمجَ المسائل المستجدَّة، واستيعابها في إطار المنظومة الكلاميّة القديمة، فيما ذهب غيرُهم إلى أنَّ التجديد الكلاميَّ يعني تجديدًا في المباني، والمسائل، واللغة، والموضوعات، والمناهج، والأهداف، وإذا طالَ التجديدُ هذه الأبعاد، فلا شكّ ستشهد الهندسةُ الكلاميّةُ لعلم الكلام تجديدًا مستمرًّا، وسيظهر الكلامُ في حُلَّة ولباسٍ آخر جديد.
ما يُؤْخَذُ على الرؤية السابقة للتجديد أنّها لا تضع حدًّا فاصلًا بين علم الكلام وفلسفة الدين، إذ تتماهى فيها الحدودُ وتتداخل، ورغم ذلك تبدو هذه الرؤية تصوُّرًا أجلى وأظهر من أيّ رؤية أخرى لتجديد علم الكلام. وحتى تتضح الصورةُ، ويقوم هذا العلمُ على قدم وساق، ويتمايز عن غيره، يمكن وضعُ تعريفٍ لعلم الكلام الجديد أنّه «الفهم الجديد للوحي»؛ ما يجعل هذا التعريفَ معيارًا يتمايزُ به الكلامُ الجديد عن غيره.
تأسيس الكلام الجديد
لا يُمْكِن القول بنسبة تأسيس هذا العلم لرجل واحدٍ؛ ذلك أنّ حركةَ التجديد في معارف الدين مخاضٌ عسير، فلا يمكن لتجديدٍ أن يكون بمجرَّد قرار تصدره مؤسَّسة، أو كتاب يكتبه إنسان، وهكذا كان تجديدُ الكلام مشروعًا أسهمتْ فيه مؤسسات كثيرة، ورجال كثيرون عملوا على تأسيسه وتطويره.
تميّزت الفترةُ ما بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين بالدّعوة إلى إحياء علم الكلام القديم، لكنّ مصطلح الكلام الجديد لعلّه لم يظهر إلا على يدَي شبلي نعمان في كتابه «علم الكلام الجديد»، لكن لا يمكن الجزم بأن شبلي نعمان هو أوّل من نحت هذا المصطلح، ولعلّه مُسْتَعَار من سيد أحمد خان.
اتَّخَذ علمُ الكلام الجديد فيما بعد مسارًا مُخْتلفًا مع محمد إقبال، إذ حاولَ في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» ابتناءَ فلسفة بديلة للدِّين تغتني بما تستوعبه من معارف الآخر، وقام بتحليل جوهر الدِّين مستنطقًا الموروث الإسلاميّ للعرفان، ومستعينًا بحشد من الفلاسفة والمفكِّرين الغربيِّين؛ ما يشى بموقف إيجابيّ من الفلسفة ومعارف الغرب الحديثة. كما قام بمعالجة الوحي، والنبوة معالجةً جديدة؛ ما يضع مساهمته في إطار الكلام الجديد.
تكاملتْ رُؤى محمد إقبال لدى فضل الرّحمن، رغم أنّه لم يُحاكِهِ في تفكيره، وإن كانت رؤاه قد اغتنت وتطوَّرت بأفكار إقبال وطريقته. دعا فضل الرحمن للعودة إلى القرآن، مستندًا عليه في أفكاره ورؤاه، محاولًا تخليصه وتنقيته من إكراهات التاريخ وتسلُّطاته، واضعًا يديه على مقاصد القرآن وكُلِّيَّاته، والقضايا المحوريّة فيه، منتهيًا إلى آراء كانت غريبة على بيئته الدينيّة.
أعاد التفكيرُ الدينيُّ في إيران إنتاج مقولات إقبال، وعمل على تطويرها وتنميتها، ولا سيّما رأيه في خَتْم النبوَّة، إذ كان يرى الوعيَ البشريَّ الإنسانيَّ قد وصل إلى مرحلة من الكمال المعرفيِّ الذي أهَّلَهُ إلى الانفراد بنفسه، وعدم الحاجة إلى الاعتماد على مِقْوَدٍ يُقَادُ منه (النبوة).
أما مصطلحُ «علم الكلامِ الجديد»، فقد ظهر أصلًا في إيران نتيجةَ ترجمة كتاب شبلي نعمان سابق الذِّكر، وبدأ ظهورُه في أُفُقِ التفكير الفلسفيّ والكلاميّ لدى محمد حسين الطباطبائيّ، وشروح تلميذه مرتضى المطهّري الذي كتب تصوّرات أوّليّة بشأن التجديد الكلاميّ، مستعملًا مصطلح «الكلام الجديد» باحثًا الجانب الوظيفيّ من علم الكلام.
محاولات التجديد الكلامي بين إيران والعالَم العربي
صدر كتاب «أصول الفلسفة والمنهج الواقعي» للطباطبائي، وقام المطهري بشرحه، ورغم كون الكتاب يُعْنَى بالفلسفة أكثر، إلّا أنّ البحث فيه قد انصبّ على بيان مسألة المعرفة والإدراك، وتفسير حقيقة المعرفة الإنسانية ومصادرها وحدودها، مُعْتَمِدًا في ذلك على نقد الاتِّجاه التجريبيّ في الفلسفة الغربيّة الحديثة، والاتِّجاه المادِّيّ؛ فوقع في نوع من الالتباس في فهم الفلسفات الغربية الحديثة وتياراتها، نتيجة افتقاره إلى معرفة اللغة التي دُوِّنَت بها هذه الفلسفات، واضطراب ترجماتها التي عاصرتْه.
كما صدر كتابُ «فلسفتنا» لمحمد باقر الصدر وهو أَلْصَقَ بـ «علم الكلام» منه إلى «الفلسفة»، إذ نسج الصدرُ فيه على منوال الطباطبائي؛ محاولًا تدوين علم كلام فلسفيّ، التبس لديه تفسير بعض اتجاهات الفلسفات الغربية الحديثة وآراء الفلاسفة، فوقع فيما وقع فيه الطباطبائي من التباسات لنفس السبب السالف. كما حاول الصدرُ في كتابه «الأسس المنطقيّة للاستقراء» التّحرُّر من تقليد أرسطو، وفكّر في آفاق لا تقرر مقولاته في «فلسفتنا»، واعتمد فيه على توظيف منهج الاستقراء القائم على حساب الاحتمالات، وحاول أن يعالج ثغرة اليقين في الاستقراء الناقص.
وإذا انتقلنا إلى العالم العربي، نجد بعض المحاولات المبكِّرة للدّعوة إلى التجديد الكلامي لدى أمين الخولي الذي يرفض حصر الاجتهاد في المجال الفقهيّ فحسب، فكما تستجدُّ قضايا فقهيّة معاصرة على الفقيه المعاصر معالجتها معالجةً جديدة، كذلك تستجد احتياجاتٌ معنويّة وروحية وباطنة لدى الإنسان تجعل الحاجةَ مُلِحَّة إلى الاجتهاد الكلاميّ أيضًا، فالتطوّر سنّة شاملة؛ تفرض سلطانها على المعاملات والعبادات، والعقائد كذلك، ولذلك يرفض الخوليّ أيَّ قراءة لاتاريخيّة للتراث الإسلامي بشتّى ضروبه ونواحيه.
وحاول محمد عبد الله دراز في كتابه «الدين: بحوث مُمَهِّدَة لدراسة تاريخ الأديان» معالجةَ الفكرة الدينيّة من الناحيتَين: الموضوعيّة والنفسيّة، كما ناقش العلاقةَ بين الدِّين والأخلاق والفلسفة وسائر العلوم، كما ناقش نشأة الدين، والحاجة إليه، ومنابع الإلهام الإنسانيّ فيه، مستندًا في ذلك كلِّه على معطيات المعرفة الإنسانيّة الجديدة، مستفيدًا من تحصيله العلمي والمعرفي الجديد.
وأوردَ فهمي جدعان مصطلح «كلام جديد» في كتابه «أسس التّقدُّم عند مُفَكِّرِي الإسلام في العالَم العربي الحديث» في خضمِّ مناقشته «التوحيد المُتَحَرِّر»؛ الذي يعني ضرورةَ وجود علم كلاميّ يُعالج التوحيد من جهةِ كونه علمًا مُحَرِّرًا للإنسان، صافيًا ممّا قد يعلق به من شائبة أو كَدَر.
يبدأ التجديد الديني بتجديد الكلام
لا يمكن للدِّين أن يتجدَّد مواكبًا حركةَ العصر الحديث إلّا عن طريق تجديد الكلام الإسلامي، والانتقال عن دوائر الكلام القديم المغلقة، فتجديد الفقه مثلًا يُبْتَنَى على تجديد الكلام، إذ تُعَدُّ المقولاتُ الكلاميَّةُ مسبقاتِ الفقيهِ اللاهوتيّةِ ومُسَلَّماتِه العقليةِ، فلا يمكن الانتقالُ عن القراءةِ الفقهيَّة المغلقة للنصوص ما لم يسبقْها تجديدٌ في البنية العميقة لإنتاج تفسير النصوص والمنحصرة في الكلام وحده لا غير.
تتجلّى أهميّةُ الكلام الجديد في أنّه يعمل على التمييز بين الإلهي والبشري، ويضع حدودًا بين الوحي الإلهيّ والعقل البشريّ، كما يكشف عن أقنعة المقدّس إذا ما تدثّر بها الدنيويُّ؛ ما يؤدِّي إلى تحديدِ مجالات المقدَّس الذي يعمل فيها، ومعرفة مجالات الدنيويّ التي يدور فيها. كما تتجلّى أهميتُه في إطلاق نزعةِ التَّفكير الحرِّ في العقيدة، وتقويض الانغلاق الذي عَمِلَ على تكريسه تيّارُ الظاهريَّةِ الاعتقاديَّة عبر الزَّمان.
هذا غير أنّه ينشد التعبيرَ الجماليَّ عن الدين ويعمل على تكريسه، نفيًا للقُبح، ونبذًا لتفسيراتٍ موغلة في الوحشيَّة؛ تبتعد بالدين عن سياقاته الرحمانيّة. ولأنّه لا جوابَ أبديًّا للأسئلة الميتافيزيقيّة كان لزامًا على علم الكلام الجديد أن يتأسس، وأن يكون له وجود، وأن يصير المنفذ الوحيد للكلام إذا أُرِيدَ له النفاذ إلى عصرنا الحاضر وهمومه ومشكلاته الراهنة.
انحصار التجديد الكلامي في الفهم الجديد للوحي
الكلام بين التجديد والتحديث
حرص بعضُ الباحثين المتحمِّسين للتراث على عدم استخدام مصطلح «الكلام الجديد»، مُفَضِّلين بدلًا منه «الكلام الحديث»؛ تخلُّصًا من الحمولة الدلاليّة التي تحملها كلمة «الجديد»، وما تشي به من قطيعةٍ مع الكلام التقليديّ القديم، إذ «الكلام الجديد» يعني تخطِّي ما كان يُبْتَنى عليه الكلامُ القديمُ من مناهج وأدواتٍ للفهم وتحصيل المعارف؛ كالمنطق الأرسطيّ، وسطوة الطبيعيّات الكلاسيكيّة، والرؤية القديمة للعالَم والإنسان.
إن مجرّد التّسمية تفرض سلطانَها على طريقة الباحث في التفكير، فالباحث الكلاميُّ الجديد يعرف قصورَ الفكر الكلامي القديم، ويحاول ابتناء آخر على أنقاضه، أما الباحث الكلاميّ الحديث، فإنه لا يرنو إلّا إلا بسط المسائل الكلاميّة القديمة في صورة مدرسيّة حديثة ربّما، مع استيعاب المسائل التي استجدّت بأدوات ومناهج البحث القديمة كما يفعل من يمكن تسميتهم بـ«الأشاعرة الجُدُد» من تسويق للأشعريّة مرّة أخرى عن طريق تكريسها، وإلباسها حُلَّة جديدة لا تخلو من إغواء.
مضمون قديم تحت مُسَمًّى جديد
ظهر تعبير الكلامُ الجديد – كما تقدَّم – مع شبلي النعماني في كتابه «علم الكلام الجديد»، وكان أوَّل من يؤلِّف كتابًا تحت هذا المُسَمَّى، لكنّه تناوَل مسائل الكلام التقليدي هي هي دون تغيير، متبنِّيًا المناهج والأدوات القديمة نفسها دون أي تغيير ظاهر، كما أدرج في كتابه مسائل جديدة لم تُبْحَثْ من قبل؛ كمسألة الانتحار، وحقوق المرأة، والحقوق العامّة للشَّعب… إلخ.
تبنّى شبلي النعماني نفسَ المنطق الدفاعيّ للكلام التقليدي، فلم يخرج عن القديم قيد أنملة إلّا فيما أورده من مسائل جديدة عالجها بمناهج قديمة، لذا كان وفيًّا كلّ الوفاء للقديم؛ ما يدعو إلى القول بأنّه تبنّى اسمًا جديدًا، لكن بمحتوىً ومضمون ٍتقليديّ قديم. ولعلّه أخذ هذا المسمى عن أحمد خان الذي نجد في آثاره خروجًا على التراث الكلاميّ القديم دون الإشارة إلى ذلك.
وأصدر إسماعيل حقِّي الإزميلي كتابًا بعنوان «علم الكلام الجديد» باللغة التركيّة العثمانيّة، لكنّ الكتاب لم يُتَرْجَمْ إلى العربية أو غيرها من اللغات حتى اليوم، ولم يُعْرَف عن مؤلِّفه أنّه من روَّاد التجديد، ولو كان يحمل اتِّجاهات أو رؤىً تجديديَّة خارج نطاق القديم لطارت شهرتُه في الآفاق كغيره من الكتب، لكنّ هذا لم يحدث.
ذهنيّة تراثيّة
أكثرُ مُفَكِّري الإسلام اليوم مقلِّدون في العقيدة لأئمّة الفرق، لأنّهم يرون العقائدَ ثابتةً لا اجتهادَ فيها. تنبني هذه الرؤية على أنَّ كلَّ الحقيقة الدينية تمّ الكشفُ عنها، ولا يمكن الإتيانُ بجديد، بل كلّ جديد هرطقة دينيّة، وشبهة ينبغي الإتيان عليها رفضًا وردًّا.
ولعلّه لا نجد دعوةً صريحةً إلى التجديد في العقائد إلّا لدى أمين الخولي الذي رأى سُنَّةَ التَّطَوُّر سُنَّةً عامّة جارية تشمل العقائد بجانب العبادات والمعاملات، ورغم هذه الدعوات التجديدية المحمومة التي أطلقها، إلّا أنه لم يفصح عن رأيه في مقولات الكلام، ولم يمارس التجديد عمليًّا.
بناءً على ذلك، لا يمكن وضع محمد عبده في خانة الكلام الجديد، لأنه كان يُفَكِّرُ بذهنيّة كلاميّة قديمة، وعلم الكلام لديه كما ظهر في (رسالة التوحيد) هو الكلام القديم ذاته، إذ صاغ القديم ببيان مدرسيّ جديد، مُطَعِّمًا إيَّاه ببعض الرّؤى العقلانيّة التراثية من هناك وهنالك، كافًّا عن الخوض في مسائل لا يرى طائل من ورائها كمسألة الصفات وعلاقتها بالذات. يفتقر كلامُ محمد عبده إلى الفهم الديناميكيّ للوحي، ولا يبتكر منهجًا آخر للبحث الكلامي، ولا يوظِّف أدواتٍ جديدة في الفهم.
جاءَ طه عبد الرحمن مستأنفًا أبا حامد الغزالي، لكن بلغة تبتكر معجمها الاصطلاحيّ الخاصّ الذي تنفرد به، محاولًا الإفادة من المنطق الحديث وفلسفة اللغة. يفكِّر طه عبد الرحمن بذهنيّة تراثيّة لا يتحول عنها إلا بمنحوتاته اللغويّة؛ ما يحمل على القول أنّه لم يأتِ بكلام جديد أيضًا، وإن أتى بمُبْتَكَرَاتٍ اصطلاحيّة جديدة، وإن حاول الاستفادة من معارف وفلسفات وأدوات حديثة.
مِعْيارُ الكلام الجديد وأركانه
يقول الرفاعي: يلتبس مفهومُ التجديد بمفهومَي الإحياء والإصلاح في اللغة العربية. للإصلاح الدينيّ عند روَّاد النهضة العربية أكثر من معنى، وإن كانت تلتقي على رفض التعصّب والتحجّر، ومحاكاة شيء من حركة الإصلاح الدينيّ اللوثريّ في المسيحيَّة، وفتح باب الاجتهاد في الفقه بالعودة إلى أدوات النَّظر وأصول الفقه الموروثة. بدأ هذا النمطُ من الفهم للإصلاح مع الطهطاوي مرورًا بالأفغاني، وتلميذه محمد عبده الذي كان أول عالِم مسلم يسعى لتدشين محاولات جادَّة في إعادة تفسير القرآن، وتقرير التوحيد ببيانٍ حديث، وإصدار فتاوى تصغي لإيقاع العصـر. إصلاح محمد عبده توقف عند المسائل الفقهية وتفسير بعض الآيات القرآنية من دون المساس الجوهري بالمقولات العقائدية، والقضايا الإيمانية النظرية الداخلة في نطاق “علم العقائد” أو “علم الكلام”. يتبنى الرفاعي التجديد وليس الإصلاح ولا الإحياء، ويشرحه بقوله: أعني بالتجديد إعادةَ فهم الدين وتحديد وظيفته المحورية في الحياة، وإعادةَ بناء مناهج تفسير القرآن الكريم والنصوص الدينية، وبناءَ علوم الدين ومعارفه في ضوء الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع ومختلف المعارف الحديثة.
أدركتْ جماعةٌ من المصلحين والمفكِّرين منذ القرن التاسع الأثرَ شديدَ السُّوء الذي تسبَّبَتْ فيه بعضُ العقائد كالقضاء والقدر، فقاموا بانتقاد مفهومِها الشَّائع لدى المسلمين، وبالتّدريج اتَّسَعَت دائرةُ النَّقد والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في علم الكلام، وظهر ما سُمِّي بـ «الكلام الجديد» في الإسلام الهندي.
ونظرًا لتبنِّي كثيرين مصطلح «الكلام الجديد» رايةً لآرائهم وأفكارهم ومقولاتهم الكلاميّة، التبس الكلامُ الجديدُ بغيره، فليس كل ما يُكْتَب تحت مُسَمَّى «الكلام الجديد» كلامًا جديدًا في حقيقة أمره، لذا فالمعيار الذي يمكن اعتباره مقياسًا لتمييز الكلام الجديد من غيره، وعلى أساسه يمكن تصنيف أحدُ المتكلمِّين بأنه متكلم جديد، هو الإتيان باجتهاد كلاميّ جديد يتبنّى مفهومًا جديدًا للوحي الإلهيّ ضمن نطاقه الميتافيزيقي لا خارجه.
الكلام الجديد الذي يُعْنَى بابتناء مفهوم جديد للوحي كما يرى الرفاعي يقوم أساسُه على تسعة أركان أساسية، هي:
- تفسيرُ الوحي تفسيرًا ديناميكيًّا، لا يكون النبيُّ فيه الجانبَ السلبيَّ المنفعل، بل يكون فيه متفاعلًا معه، متأثِّرًا ومؤثِّرًا فيه.
- نفي الصورة المرعبة لله في الكلام القديم، ومحاولة ابتناء صورة أخرى رحمانيّة مُفَعَّمَة بالرأفة الإلهيّة.
- ابتناء صلة بين العبد والله تقوم على أساس من المحبة، لا على أساس القهر والخوف.
- إيقاظ المعنى الروحيّ والأخلاقيّ والجماليّ الكامن في النصوص المؤسِّسَة.
- إعادة تعريف الدين بصورةٍ يكون فيها منبعًا لما يُثْرِي حياةَ الإنسان بالمعنى الذي يتطلّبه وجودُه.
- الانفتاح على تعدُّد قراءات القرآن بتعدّد الأحوال، والأزمان، والبيئات، والثقافات، والأشخاص.
- الاستفادة من معطيات الفلسفة الحديثة، والعلوم الإنسانية المعاصرة، والأدوات الجديدة في الفهم والتأويل.
- دراسةُ المتخيّل الديني وتحليلُ كيفية تشكله وروافد تغذيته ومديات حضوره في إنتاج المعنى الديني ضرورةٌ تفرضها عملية التجديد، فمَنْ يمتلكُ وسائلَ إنتاج هذا المتخيّل يمتلكُ السلطةَ ويمتلكُ التحكُّمَ بحاضر الناس ومستقبلهم في مجتمعاتنا. المتخيلُ الديني يُستثمَر لترسيخ السلطة الروحية وتمدّدها، ويُستغَل لإضفاء المشروعية على السلطة السياسية ويعمل على تضخُّمِ هيمنتها وتغوّلها.
- لا يبدأ التجديد بالتراث لينتهي بالتراث كما يفعل بعضُ من يكتبون ويتحدثون عن التجديد، ولا يبدأ بالواقع ويصور لنا التراثَ وكأنه يستجيب لكلِّ ما يتطلبه الواقع من دون اكتراث بأن أكثر ما في التراث يتنكر له الواقع، كما يدلّل على ذلك نحوُ قرنين من إخفاق هذه الدعوة وتهافتها.
في ضوء فهم الوحي فهمًا ديناميكيًّا جديدًا لا يتنكَّر لأصله الغيبيّ، يمكن التحرُّر من مأزق القراءة اللاتاريخيّة للسنة والسيرة النبويّة، ويمكن الوقوفُ على ما هو محلِّيٌّ خاصّ بثقافة الجزيرة العربية، وما هو عالميّ يشتمل البشرَ جميعَهم، وبين ما هو وحيانيّ من قول النبي وفعله وتقريره، وما هو شخصي في سلوك النبيّ، وبلغة حاسمة: يمكن التمييز بين الثابت والمتغير في الدِّين.
مسَارَان جديدان في فهم الوحي
نلتقي في علم الكلام الجديد بمسارَين في تفسير الوحي وفهمه:
- مسار يفسِّر الوحي بوصفه ظاهرة وقعت في التاريخ.
يرى هذا التيّارُ الوحيَ مُنْتَجًا ومُنْتِجًا ثقافية، وموقفه ملتبس حيال المضمون الميتافيزيقي للوحي. يمثِّل هذا التيّار باحثون مثل: محمد أركون، وحسن حنفي، ونصر حامد أبو زيد، وعبد المجيد الشرفي، وغيرهم.
- مسار يفسِّر الوحي بوصفه ظاهرة ميتافيزيقيّة.
يرى هذا التيارُ الوحيَ حالةً يعيشها النبيُّ؛ نتيجةَ تسامِي الإنسان (النبيّ) بروحه، أو تنزيلٍ إلهيٍّ عليه. يعتمد هذا التيارُ آثارَ العُرَفَاء لبيان البعدِ الميتافيزيقيِّ للوحي، والعلوم الإنسانية الحديثة لبيان بعده البشريّ. يمثِّل هذا التيارَ باحثون مثل: أحمد خان، ومحمد إقبال، وفضل الرحمن، ومحمد مجتهد شبستري، وعبد الكريم سروش، وغيرهم.
مناقشة الرؤى الرسولية لعبد الكريم سروش
عرض
يرى سروش في كتابه: «كلام محمد رؤى محمد» -الصادر عن دار: أبكالو للنشر والتوزيع، من ترجمة: أحمد الكناني- أن ما ورد في القرآن من مشاهد القيامة؛ كتنازع أهل الجنة الشراب، وسلخ جلود أهل النار ونضوجها مرة أخرى، وحوادث الأنبياء الكثيرة وقصصهم؛ كانشقاق البحر لموسى، وغيرها من الآيات الشبيهة لم يكن النبي فيها ناقلًا لأخبار تلقاها تلقِّيًا مباشرًا، ولكنه شاهدها في أحلامه ورؤاه، وقام بروايتها كما رآها، لذا فهذه الآيات في حقيقتها ليست إلا مجموعة من الأحلام والرؤى التي اختبرها وعاينها النبيُّ ووقعت له، وشاهدها مشاهدة مباشرة في منامه، لذا فإنه في مثل هذه الآيات يروي عن نفسه مشاهداته الخاصة، ولا يروي عن غيره.
يناقش سروش على سبيل المثال رأي الطباطبائي في المراد من السماء التي تسكنها الملائكة بأنها عالم ملكوتي، ذو أفق أعلى نسبةً إلى هذا العالم المشهود، فيقول: «ولو تنبه صاحب (الميزان في تفسير القرآن) إلى أن رمي الشياطين بالشهب كان في عالم الرؤيا لما احتاج إلى كل تلك التأويلات، ولذهب إلى خبير في الأحلام والأنثروبولوجيا يدله على معنى أن شخصًا في تاريخ وجغرافية الحجاز، ومن ثقافة تلك الحقبة، يرى في المنام أن الشياطين تقذف الشهب» (كلام محمد رؤى محمد، ص 87).
ولأن هذه الآيات والأخبار ليست إلا أحلام النبي ورؤاه، فإنها لا تستخدم لغة الأدب في الإيضاح والتعبير عنها، ولا تستخدم الاستعارات والمجازات والكنايات والتشبيهات، لأن لغة الأحلام -المختلفة تمامًا عن لغة الأدب- لا تحمل إلا معانيها الحقيقية، والتصورات التي عاينها الرائي كما شاهدها واختبرها، ومن ثَمَّ فإن لغة الأحلام لا تنتظم في سياق منطقي، فلا تحكمها الضروات المنطقية، ولا تجري عليها أحكام الطبيعة بصورها المختلفة.
يقول سروش: «لا بد من الإذعان إلى أن تلك الفوضوية ليست من فعل الأعداء ولا غفلة الجامعين، ولا هي دون علم صاحب الوحي، وإنما راوي السور المبتنية على الرموز والرؤى غالبًا ما يفتقر إلى المنطق والتسلسل فيفقد الانسجام والانتظام؛ هذا هو دأب المنام، ولا وجود لليقظة فيه» (كلام محمد رؤى محمد، ص 107).
نقد الرفاعي لسروش
يعرض الرفاعيُّ هذا الفهم الجديد للوحي على أنه نوع من التجديد الكلامي ومثال له إلا أنه لا يكتفي بالاعتراض عليه بل ويناقشه أيضًا. يبتدئ الرفاعي مناقشته لمفهوم «الرؤى الرسولية» لدى سروش من كيفية تفسيره للوحي من الأساس، فالإنسان لا يمكنه بلوغ مرتبة النبوة إلا عن طريق التسامي بكينونته الوجودية الذي يؤهله للتحقق بالكمال الاستثنائي اللائق بهذا المقام الإلهيّ… ولا يمكن أن تكون الرؤى والأحلام وسيلةً يتكامل بها، ويتأهل من خلالها الإنسان لأية مهمة حياتية، فكيف بمرتبة النبوة، وكيف يُتَصَوَّر أن يتحمل النبي مسؤولية الرسالة أو بعضها عن طريق رؤى وأحلام يراها في منامه؟!
يقول الرفاعي: «لا تكتسب النبوة مقامَها السامي من الأحلام، ولا يمكن أن يكتسب إنسان إمكاناته الوجودية وقدرته على تحمل الرسالة الإلهية في المنام. يلزم من القول بالأحلام النبوية أن تكون مهمة النبي في إبلاغ الرسالة وتلقِّيها أهون من مهمة رجل العلم والسياسة والعسكر والتجارة…» (ص 149).
يرى الرفاعي أن مرتبة النبوة تشبه إلى حد كبير استضافة الغيب للإنسان، واستضافة الإنسان للغيب؛ يكون المُضيف فيه هو الله، والضيف هو النبي، وفي ظلال هذه الضيافة يتلقى النبيّ الوحي ويتحمل مسؤولية البلاغ والإبانة، لذا فإن «الوحي ليس شعورًا نفسانيًّا باطنيًّا، وليس حوارًا تستبطنه الذاتُ… الوحي حقيقة من حقائق الغيب؛ هذه الحقيقة ينكشف فيها الإلهيُّ للبشريّ، ويتجلّى فيها للإنسان ما هو إلهيّ. شهود الإنسان للإلهيّ لا يتحقق إلا إذا تكامل الإنسانُ في طور وجودي يفتقر إليه غيرُه من البشر؛ ذلك ما يؤهله أن يكون نبيًّا» (ص 149)، لا الرؤى والأحلام التي يشاهدها ويختبرها في المنام، ثم يأتي ويحكيها في صورة لغوية لا يحكمها سبب ولا منطق.
يرى الرفاعي إذن أن الوحي حالة أنطولوجية تتحقق للإنسان ويتلبس بها إذا ما تكاملت كينونته الوجودية، فالنبي ليس كالشاعر ولا المبدع أو المخترع الذي قد تؤثر الرؤى والأحلام في فنه وعلمه وإبداعه بوجه من الوجوه، لكنه المتحقق بمقام وجودي استثنائي للإنسان. يقول: «الشاعر إنسان موهوب يتميز بقدرته على الإبداع، مرتبة الشاعر الوجودية -وهكذا مرتبة الرسام والمخترع- هي مرتبة غيرهم من الناس. النبي مثل غيره من الناس في حياته ومعاشه وطبيعته البشرية، إلا أن مرتبته الوجودية ارتقت، فاصطفاه الله للنبوة…» (ص 150).
إن الوحي إذن كما يرى الرفاعي صلة وجودية بين عالمَي الغيب والشهادة يمكن من خلالها أن يكون النبي شاهدًا للغيب تجلِّيًا يتجلى الإلهيُّ فيه، فــ«النبي من جهة الوحي يشهد عالم الغيب، وبوصفه بشرًا يحتفظ بحضوره في عالم الشهادة، أي يحتفظ بطبيعته التي يشترك فيها مع الكلّ» (ص 150).
إنه يمكن باستنطاق القرآن التعرف على الوحي بوصفه منتميًا إلى عالم الغيب؛ ومن ذلك قوله تعالى: « إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا» (المزمل: 5)، فالقول الثقيل توصيف رمزيّ، إذ القول لا يمكن وصفه بالثقل المادي طبقًا لقوانين عالم الشهادة، لكنه ثقيل على النفس ثقلًا لا يمكن معه أن يتحمله أي إنسان عادي إلا إذا تكامل وجوده تكاملًا يمكِّنه من التلقِّي والبلاغ عن الله.
ينتهي الرفاعي في مناقشته تلك إلى أن «الوحي بعدان، بعد إلهي، وآخر بشري، لا يمكن دراسة البعد الإلهي الغيبي في الوحي في ضوء المناهج العلمية المعروفة لدراسة الطبيعة ومن يعيش فيها. النبي لا يفقد بشريته عندما يتلقى الوحي… [فــ] إنكار البعد البشري في شخصية النبي هو ما يفعله الغلاة وبعض المتكلمين القدماء. محمد نبي مبعوث برسالة إلهية… إنسان يعيش حياته البشرية كما يعيش الناس… إنسان يمتلك بصيرة نورانية، وعبقرية فذَّة… تجذرت في ذاته الرحمةُ الإلهية بوصفها ضمير النبوة» (ص 153).
الفهم الجديد للوحي لدى مفكِّري الإسلام في الهند
بين التعدديّة الدينية والأحادية
يتنافس في الإسلام الهنديِّ تياران؛ تيار تعدُّدِيّ، يؤمن بالتعددية الدينية، ولا يقولُ باحتكار الطريق إلى الحقّانيّة والنجاة، ويتقبّل الاختلاف في الفضاء الديني، ويتعايش مع مختلف التجارب الدينية. وفي مقابل هذا التيار تيارٌ آخرُ أحاديّ، لا يتقبّل تعدّد التجارب الدينية، ويؤمن باحتكار الطريق إلى الله، وهو شديد الوفاء للرؤية الكلامية والفقهية القديمة، مُقْصِيًا كلّ اجتهاد آخر لا ينسجهم وفهمهم للدين.
تنتمي مدرسةُ وليّ الله دهلوي، وأحمد خان، ومحمد إقبال، وفضل الرحمن للتيّار التعدّدي في الإسلام الهنديّ الذي كان حضورُه في المجال العربي قليلًا، إذ كان الحضورُ الأكبرُ لتيّار الانغلاق والأحادية الدينيّة ولا سيّمها في ممثِّلها الأكبر؛ أبي الأعلى المودودي الذي كثَّف كتاباته وأحاديثه وجهوده للتفسير السياسيِّ لآيات القرآن الكريم، وكرّس حياتَه من أجل إقامةِ دولةٍ دينيّةٍ تتأسَّس على التُّراث القديم.
تبنّت أدبياتُ الإسلام السياسيّ في المجال العربي أفكارَ المودودي، بل وقام بعضهم على شرحها وتثبيتها في محاكاة مستمرة للغتها ومنطقها كما يُلْمَسُ ذلك في آثار سيد قطب الذي استقى عنه أفكارَ الدولة الدينية، والمجتمع الجاهلي، وبغضَ الفلسفة والعلوم الإنسانية، فأصبح لا يستطيع التفكير خارج أفقه ورؤاه المغلقة حول الدين والله والعالَم.
المودودي: الفهم السياسي للدين
تلخّص رسالةُ المودوديّ: «المصطلحات الأربعة في القرآن» قراءته السياسيّة لعقيدة التوحيد التي لا يراها تتحقّق خارج الدولة الدينيّة المتخيّلة في رأسه، إذ إنشاءُ البشرِ دولةً على الأرض يُعَدُّ ضربًا من الشِّرك والعدوان البشري على الله؛ وعلى هذا المنوال يقوم على تأويل أفكارِ «الإله، الرب، الدِّين، العبادة» تأويلًا سياسيًّا يخرج عن سياقاتها القرآنيّة، والميتافيزيقيَّة؛ محيلًا بذلك الإسلامَ أخيرًا إلى دين بلا روح، وبلا قلب، وبلا عقل.
وجَّهَ وحيد الدين خان نقدًا صوب المودودي وأفكاره، إذ ميّز بين الدِّين بوصفه نظامًا دستوريًّا قانونيًّا وسياسيًّا، وبين الدِّين بوصفه علاقة بين الله والإنسان، والتي يراها أصلَ الدّين، ناقضًا أن يكون الدينُ نظامًا سياسيًّا على غرار الأنظمة الدنيويّة الأخرى.
وحيد الدين خان ناقدًا المودودي
أدرك وحيد الدِّين خان مبكِّرًا ضرورةَ إعادة بناء التفكير الكلاميّ، إذ يرى طريقة الكلام وأسلوبه قد تغيَّرا بتغيُّر الزمان، ومن ثم علينا الإتيان بكلام جديد قادرًا على تحدِّي العصر الحديث والتعامل معه.
ورغم هذه الرؤى المنفتحة والناقد، إلّا أنّه لم يستطع التحرّر تمامًا -في كتبه كـ«الإسلام يتحدّى»، و«الدين في في مواجهة العلم»- من القديم، وظلّ يفكّر داخل النظام التراثيّ غير خارج عنه، لذا لا يصح وضعه في زمرة المتكلمين الجدد، لأنّه لم يحقِّق المعيارَ الذي طُرِح سابقًا من ضرورة تقديم فهم جديد للوحي.
ولي الله دهلوي: إرهاصاتُ تجديد كلامي
بدأت إرهاصاتُ تجديدٍ كلاميٍّ أوَّليَّة تظهر مع ولي الله دهلوي الذي عمل على ترسيخ أُسُسِ الإسلام التعدّدي الذي لا ينفي الآخر، ولا ينبذه. وكان يمتلك رؤيةً تتَّسع لعبور التراث؛ رؤيةً تحاول إعادة فهم القرآن فهمًا مباشرًا دون وساطة، وحاول فهم السنةِ في ضوء آفاقها التاريخيّة.
ويمكن العثور على إرهاصات الكلام الأولى في آثاره التي أشارت إشاراتٍ مبكّرة لدور النبي التفاعليّ في تَلَقِّيه للوحي، ونفي حصر معنى الوحي بانفعال النبي، وسلبيته إزاءه، إذ يرى الدهلوي أنّ الكتابَ الإلهيَّ يُرْسَل أوّلًا في قلب الرسول بصورة خفيَّة، ثم إذا ما انطبعتِ الرسالةُ الإلهيّةُ في نفس الرسول كما وُجِدَتْ في عالم السماء؛ ينطلق الرسولُ في العالَم ناطقًا بها، مُعَبِّرًا عنها.
ورغم هذه الرؤى غير المنغلقة للدهلويّ، إلّا أن تيّار الجمود والدعوة إلى السلفيّة استأثر بتراثه، فاستحالَ معهم فكرًا شائها، يخلو عن كلّ أشكال التفكير العقليّ الحُرّ، ويكرِّس للتقليد، واستدعاء الفهم التراثي مرة أخرى.
سيد أحمد خان: مَلَكَةُ النّبوة
كان علمُ الكلام الجديد أكثرَ تَعْبِيرًا عن نفسِه في فكر سيد أحمد خان الذي رأى النبوةَ مَلَكَةً طبيعيّة في النفس الإنسانيّة، ولا يأتي النبيَّ الوحيُ الإلهيُّ من خارج، لكنّه نشاطُ العقلِ الإلهيِّ في النفس الإنسانيّة.
لذا فالوحي ليس إلّا ذلك المعنى الذي قام في نفس النبي بالفعل الإلهيّ، ولهذا يُعَدُّ القرآنُ ألفاظَ النبيِّ؛ صاغها بلغته العربية اعتمادًا على المعاني الإلهيّة التي قامت في نفسه. على كُلٍّ، أثارت آراءُ أحمد خان الكلاميّة عاصفةً من الجدل، أيقظت الفكر الكلامي من سباته العميق.
محمد إقبال: التجربة الدينية بين العرفاء والأنبياء
استأنف محمد إقبال طريقة تفكير سيد أحمد خان، وترسّمَ منهجَه التأويليّ، فسعى إلى زحزحة علم الكلام القديم، فتمحورت جهوده حول ابتناء فلسفة للدين جديدة. ويُعَدّ كتابُ إقبال: «تجديد التفكير الديني في الإسلام» أولَ نصّ حديث في علم الكلام الجديد، لكن تأثيره لا يزال هامشيًّا في الدراسات الدينية بالعربية.
صاغ إقبال مفهومًا جديدًا للوحي يتمحور حول التجربة مميِّزًا بين تجربة الأنبياء وتجربة العرفاء التي تتَّحد في فحواها، لكنّ تجربة النبي تمنحه إرادة تغيير العالَم، أما تجربة العارف، فيبقى في فضائها.
ناقش إقبال كذلك مفهوم الحاجة إلى الوحي، ورأى أن الحاجة إلى الوحي تختصّ بمرحلة من الوعي البشري قد تجاوزها الآن، إذ لم يعُدِ الإنسان بحاجة إلى مِقْوَدٍ يُقَادُ منه.
فضل الرحمن: الفهم الديناميكي للنبوّة
جاء فضل الرحمن في أعماله مُطَوِّرًا آراءً اجتهادية جريئة، إذ يرفض مفهوم الوحي لدى الكلام التقليديّ، ويصوغ مفهومًا تجريبيًّا له يتفاعل فيه النبيّ ميكانيكيًّا، وتُعَادُ معه روحانيته.
إنّ القرآن – لدى فضل الرحمن – كلّه كلمة الله، وكلّه كلمة محمد أيضًا على الحقيقة، إذ تتجلّى فيه شخصية النبي كما يتجلّى فيه اللهُ للناس، ونستمع فيه إلى صوت الله بأصداء روح النبي.
القرآن كلمة الله بمعنى أنه يخلو عن الخطأ والزور، لكنه في نفس الوقت جاء على لسان النبي محمد، فهو الناطق به. نجد لدى عبد الكريم سروش صدى لفكر فضل الرحمن فيما أسماه «بسط التجربة النبوية»، إذ يصور النبي كالنحلة التي تعيد تكوين الرحيق عسلًا.
__________
*كاتب ومترجم مصري، ومعلِّم لغةٍ عربيَّة للناطقين بغيرها. له ترجمات ومقالات منشورة في بعض الصُّحف والمجلات. تخرج في جامعة الأزهر، كلية الدعوة الإسلامية عام 2014م، ثم التحق بجامعة القاهرة، وتخرج في كلية الآداب، قسم الفلسفة عام 2018م.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.