الويفي في البرَارَك (دور الصفيح) يطيح بهرم ماسلو للاحتياجات
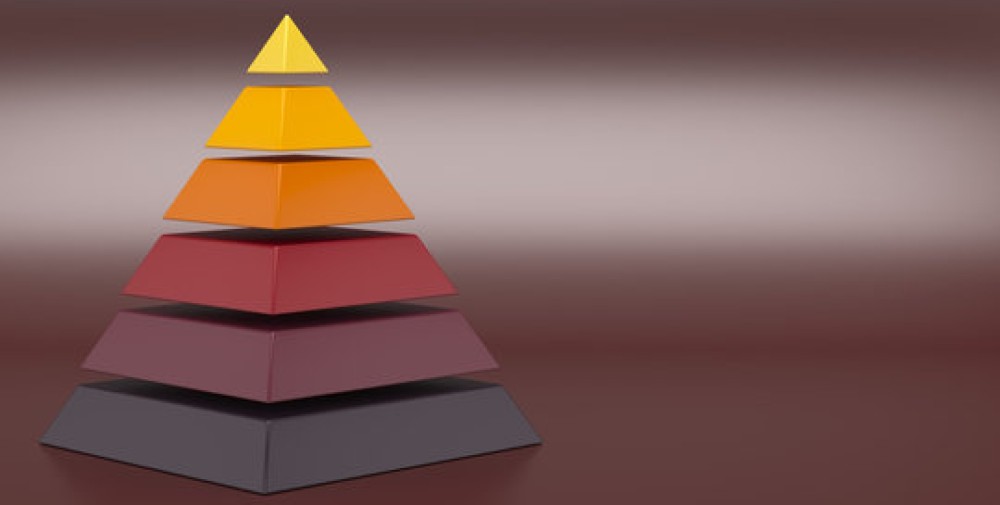
لم يعد اليوم هرم ماسلو للاحتياجات pyramide de maslow des besoins يشمل سيرورة احتياجات الفقراء ويعكسها، فببساطة، حاجاتهم لم تعد تتأطر وفق الترتيب الذي كان قد اقترحه ماسلو في الستينيات. إن الويفي اليوم ينبغي أن يتم إدراجه ضمن الاحتياجات الفيسيولوجية (الغذاء، الشراب، الويفي، الجنس، النوم…) التي تأتي في مقدمة ما يبحث عنه الإنسان في بداية وجوده، إن امتلاك الويفي اليوم في حياة الناس سابق عن امتلاك ما صنفه ماسلو ضمن احتياجات الأمان والاحتياجات الاجتماعية، وقد يكون سابقا حتى عن امتلاك إيواء لائق وتوفير مأكله ومشربه، ولعل عبارات مثل:”نقصها من حوايجي وكرشي وندخل لولادي الويفي”، دليل على ذلك، قد تسكن الأسرة في “براكة” من قزدير وتتقاسم جميعها غرفة أو غرفتين ومرحاضا في الهواء الطلق ولا تعبأ بذلك وتنسى وضعها، ولكنها لا يمكن أن تنسى امتلاك هاتف ذكي، وشبكة أنترنيت “ويفي” بصبيب عال تفاديا لأي انقطاع أو توقف متكرر قد يفسد اللحظة، فالناس تستطيع أن تدفع ثمن صبيب عال يؤجل لقاءهم بواقعهم، دون توقف قد يعود بهم إلى استشعار واقعهم ولو دقيقة واحدة، مستعدة أن تعاني في واقعها الحقيقي (في البراكة)، أهم شيء ألا يحدث ذلك في عالمها الافتراضي، لقد “أصبحت الحقيقة مكلفة جدا” (ريجيس دوبري) إن الذات تهرب من انتمائها الطبقي إلى عالم يتساوى فيه الجميع –نسبيا- بامتلاك الجميع حساب باسم حقيقي أو مستعار أحيانا، وصور وأصدقاء وفضاء حر لقول ما تشاء، وتقديم نفسها بالصورة التي تشاء نقلها إلى الآخر، والتباهي وتقاسم ما تعيشه حقيقة أو زورا، والتنطع والتبرقع بما تفتقده، فلا أحد يمنعك من الكذب والخداع والانتماء لطبقة غير طبقتك، والتعبير عن آراء ومبادئ وسلوكات وقيم لا تطبق منها شيئا، ولا تملك منها سوى الاسم المجرد.
إن الناس تهرب من إحساسها بالفقر إلى إحساسها بالغنى، لا يريدون أن يتحسسوا مأساتهم ومعاناتهم، وتتظاهر باللامبالاة التي تمنحهم مظهرا قويا وحياة لا مثيل لها إلا في المدينة الفاضلة، ولكن خلف هذه اللامبالاة معاناة رهيبة لا يريدون أن يعرف الناس أنهم اعترفوا بمأساتهم ومشاكلهم وبدأوا يبحثون لها عن حل، فالناس، بشراء الويفي، تهرب من عالم طبقي موحش إلى عالم تنتفي فيه هذه الطبقية، تهرب إلى عالمها الواقعي الحقيقي المثالي، وتترك معاناتها في عالمها الذي من المؤكد أضحى بالنسبة إليها هو “العالم الافتراضي”، يتعلق الأمر بكينونة جديدة فيما يزيل التهميش والإقصاء والحرمان والانتماء وأشياء أخرى، كينونة ترتب للناس انخراطا بصفات وأدوار ومبادئ جديدة، وتضمن للذات أن تقدم نفسها للآخر من جديد وفق علاقات وصفات جديدة للتداول والتواصل، فضاءات تحتفي بذات هاربة تبحث عن نمط حياتي ينسيها التهميش…، ويقذف بها في استيهامات جديدة.
يحكي سعيد بنكراد في سيرته الذاتية “وتحملني حيرتي وظنوني” قصتين تستحقان التأمل لتمثل هذا الانتقال وفهم صيغ وشكل حضور الذات في الإيقاع التكنولوجي الحديث، يصف أجواء دفن أحد الأساتذة، فيقول: “عندما وُضع الجثمان بجانب القبر الذي سيوارى فيه، أخرج ابنه، وكان في العشرين من عمره أو أكثر قليلا، آلته الفوتوغرافية وبدأ في التصوير. لقد تابع عملية الدفن بدقة متناهية وبرغبة من يريد التقاط أكبر عدد ممكن من الصور لجثمان والده وهم يضعونه في القبر. وكان يُنوع من اللقطات، وكان يقف فوق حجرة، وينحني على ركبتيه ويميل يمينا أو يسارا لكي يختار الزوايا. كان شبيها بفوتغرافي محترف يشتغل مع وكالة إخبارية. لم يبد عليه أبدا أنه كان حزينا… فأبوه لم يكن طاعنا في السن، ومات في غفلة من الجميع، وكان من المفروض أن تكون لحظة الفراق حزينة ومؤثرة، وكانت حزينة عندنا نحن أصدقاءه، ولكن الابن كان مأخوذا بالتصوير وحده”.
إنها قصة تقول كل شيء، فقد لا يكون موت أبيه حدثا، ذلك أن الحدث الحقيقي هو عندما يعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لا يشعر بالفقد إلا حينما يتقاسمه معنا، ونضع نحن تعاليق مسكوكة، يكفي أن تكتب الكلمة الأولى فتقترح عليك لوحة المفاتيح تتمة العبارة، التي لا تقِّل نفاقا عن المنشور “أحيانا”. أما القصة الثانية فيحكي ويصف صراخ ولغط الناس في مشهد مأساوي بسبب وفاة رجل في القطار بسكتة قلبية يقول: سيثيرني موقف طفل صغير كان برفقة أمه، ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره. فعندما تأكد الناس من موت الرجل وانفضوا من حوله، طلب هذا الطفل أمه مده بالهاتف لكي يلتقط للميت صورة وقال لها: خليني أماما نزوميه. (سعيد بنكراد). وهذا دليل آخر على أن الكثير من الناس قد يشعرون ب”الوحشة والغربة في عالم بلا ويفي. لم يعد الناس يتعرفون على أنفسهم في وقائع الحياة الفعلية، فهذه وقائع ناقصة تشكو من غياب الوهم. لقد أدمنوا العيش في ظلمات الافتراضي” (بنكراد).
إننا لم نعد نعيش الأحداث كما كنا نفعل قديما في حضن الأسرة النووية أو الممتدة ومع الجيران والأصدقاء دون تصويرها، بل أصبحنا نصورها حتى وإن لم نعشها أبدا أو عشنا جزءا منها، لم نعد بإمكاننا الحكم على حياة الناس استنادًا إلى ما يمكن أن يقع فعلا في واقعهم، كما كان قديما، فهذه وحدة قياس متجاوزة وأصابها عطب زمني، بل أضحى لزاما الاستناد إلى ما يمكن أن يُصَور ويقال في فضاءاتهم، “فلا وجود لفواصل بين السلوك الفعلي وبين ما يبنى في المتخيل، ولا وجود أيضا لفواصل بين الأصل والنسخة، وبين الحقيقي والمزيف. إن المزيف ذاته أصبح حقيقة” (بنكراد).
لم يعد الويفي وسيلة عارضة في الحياة، فالناس تنفر من ضيق حيّز الحرية وهزيمتها في واقعها، ولم يعد يوجد على هامش احتياجاتهم وأحلامهم ورغباتهم، بل أصبح هو ما يحدد جوهر حياتهم، يمنحهم انتصارات وهمية في الافتراضي على أعدائهم في الواقع.
__________
* سفيان الضاوي، المغرب.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.








