اختناق التنوير نتيجة حتمية
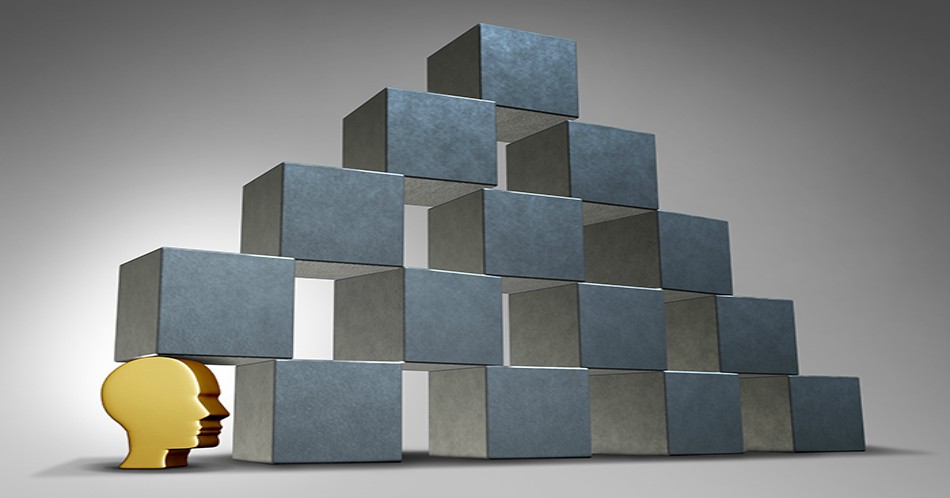
يقف بعض المهتمين حائرًا أمام عقم وعجز جهود التنوير منذ أكثر من قرنين عن التأثير في الواقع العربي البائس، ولكن الحيرة تزول حين ندرك الطبيعة التلقائية للإنسان، ونعرف الكيفية التي تتكون بها عقول الناس تلقائيًّا، ونتعقَّل أن الإنسان كائن ثقافي، ونستوعب حقيقة أن كل جيل يرث بشكل تلقائي ثقافة الجيل الذي قبله بانتظام تلقائي صلب، وأن الثقافات كيانات متمايزة نوعيًّا، وأن المجتمعات محكومة بحتمية ثقافية حاسمة، وأن كل القوى المهيمنة في المجتمع ترعى هذه الحتمية وتحميها، وتملأ نفوس الأجيال بإجلال السائد وتقديسه والولاء له والبراء، مما يُظَن أو يُتَوَهَّم أنه يتعارض معه، وأن لكل فرد بنية ذهنية ووجدانية تختلف عن كل الآخرين، فمن السهل أن يتبادلوا المعلومات والأخبار والمعارف، لكن لا يمكن أن تتطابق تصوراتهم وأفكارهم ورؤاهم تطابقًا تامًّا حتى وإن ساروا متحدين.
فالمواقف تقوم على محاولات التوافق وليس التطابق. إن كل هذه العوامل وغيرها تجعل رفض التغيير حتميًّا وتلقائيًّا، لأن التنوير يستهدف تغيير الواقع؛ فهو يتحرك باتجاه مضاد لما هو أثير ومخالط للنفوس، ومتجدد التأكيد، وكثيف التغذية، وعميق في الوجدان، ومستقر في العقول، ومتجذر في التاريخ، وراسخ في الواقع، ومألوف ومتوارث وسائد ومستحكم. إن التنوير يحمله أفراد عُزَّل لا يملكون سوى الفكر النيِّر، مقابل مجتمعات فخورة بثقافاتها المتجذرة، وقوية بكياناتها المتماسكة، لذلك لم يكن غريبًا أن تختنق كل جهود التنوير في العالم العربي خلال القرنين الماضيين.
إن الأصل في كل الثقافات أنها ترفض وتقاوم بشكل تلقائي أيَّ فكر طارئ مغاير، حتى أوربا لم يؤثر فيها التنوير ويتحقق التغيير النسبي إلا بعد حروب طويلة دامية، فقد انقسمت المجتمعات الأوربية معه وضده، فانحازت فئاتٌ مهمة وفاعلة إلى صف التنوير، وبقيت فئات أخرى تقاومه بشراسة؛ فالانتصار النسبي للتنوير لم يتحقق إلا بعد مقاومات عنيفة، فلو لم تصادف ثورة مارتن لوثر هوى الأمراء الألمان كذريعة للتحرر من الإمبراطورية المقدسة، ومن سلطة الكنيسة الكاثوليكية وقرارات البابا التعسفية لما كان لها أن تنتصر، ليس هذا فقط، إذ لم يكن ذلك وحده هو العامل الذي جعل أوربا تتقبل التنوير حتى وإن جاء التقبل ببطء وتلكؤ، وإنما تضافرت عوامل كثيرة انتهت بأوربا والغرب عمومًا إلى هذا التحرر النسبي من أغلال التاريخ، والانفكاك من بعض القوالب الثقافية الموروثة. وأهم هذه العوامل الإيجابية أن الثقافات الأوربية هي في الأساس تفريعات للثقافة اليونانية بفكرها الفلسفي وعقلها النقدي، كما أنها قد ورثت الثقافة الرومانية بتراثها القانوني العريق، وإرثها السياسي الفريد، ولكن على رغم كل هذا، وعلى رغم مرور القرون على التحرر النسبي للغرب، فإن الشعوب الغربية ما زالت كغيرها من الشعوب تقاد فتنقاد، فالكتل البشرية في كل الأمم ما زالت تعيش بوعي زائف، وسيبقى أكثر الناس في كل الأمم إمَّعات مهما نالوا من تعليم مهني، فالناس في كل المجتمعات هم مجرد ركاب في سفينة التغيُّر والازدهار، أو في سفينة التحجر والانحدار.
مفارقة صارخة
إن الواقع البشري ينطوي على مفارقة صارخة بين ما يملكه من إمكانيات عظيمة وقدرات هائلة في كثير من جوانب الحياة، وبين عجزه الفاضح عن معالجة مشكلاته، فنحن غالبًا تخدعنا الإنجازات الحضارية الهائلة في المجالات العملية والمهنية، وفي مجالات الوسائل والأدوات والتنظيم والمؤسسات والنُّظُم، فنتوَهَّم أن البشرية أفرادًا ومجتمعاتٍ وأممًا، قد قطعت مراحل متقدمة جدًّا من سلامة التفكير وعُمْق الإدراك، وأنها قد تجاوزت التفكير البدائي التلقائي، وأنها قد بلغت مستوى الرُّشد القائم على التحقُّق الموضوعي في كل أمورها، ولكن بقراءةٍ فاحصةٍ للتاريخ الإنساني، وبالتأمل العميق في ما يجري في العالم تنجلي الحقيقةُ المفزعة، وهي أن البشرية في شكل عام ما زالت من الناحية الفكرية والأخلاقية تعيش في مستوى بدائيّ سحيق غارق في التخلف والبؤس.
وأمام هذه المفارقة الصارخة بين التطور الحضاري المذهل في وسائل وأدوات الحياة وفي القدرات العملية، مقابل التخلف الشديد لعموم الناس ولأكثر القيادات الثقافية والسياسية في العالم في الجوانب الفكرية والأخلاقية والحكمة، قياسًا بما تحقق من إنجازات عظيمة، إن فهم هذه المفارقة الصارخة لا يتحقق إلا بقراءة تاريخ الحضارة قراءة فاحصة، حيث نجده يجيب عن هذه المفارقة بأن يؤكد الحقائق الآتية:
الأصل في المجتمعات أنها تبقى منتظمة في ما وجدتْ نفسها عليه، فالاستمرار تلقائي، أما التغيير فهو ضد هذا الانتظام التلقائي الحتمي، أما التطورات الحضارية المتحققة في كل المجالات فقد تمخَّضَتْ عنها عقولُ عدد محدود جدًّا من الرواد الخارقين الذين تحرَّكوا عكس التيارات السائدة خلال التاريخ البشري كله، إنهم منذ طاليس وديمقراطيس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرخميدس ودافنشي وكوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن ومونتاني ومارتن لوثر وديكارت وكانْت وفراداي ودالتون وباستور وآينشتاين وأمثالهم من الأفراد الرواد الاستثنائيين، وكلهم لو اجتمعوا لن يتجاوز عددُهم عدَدَ ركَّاب طائرة كبيرة، أو عدد ركاب قطار كبير، إنهم يمثلون نشازًا في الكثرة الهائلة من البشرية العمياء، لكننا نغفل عن هذه الحقيقة الكبرى الصادمة، ونتحدث عن أن الإنسان بطبيعته طَلْعةٌ يَقِظٌ، وأنه متشوِّفٌ تلقائيًّا إلى أن يعرف، والتاريخ البشري والواقع كلاهما يؤكد العكس تمامًا، فالمندفعون خلال التاريخ البشري كله للاكتشاف، والمشغوفون بالمعرفة، والمستغرقون في محاولة الفهم الموضوعي العميق، هم أفرادٌ معدودون يمكن إحصاؤهم بأسمائهم، وهم في نصاعة تفكيرهم، ورفيع اهتمامهم، وعُمق تركيزهم، وفي النتائج التي يتوصلون إليها يكونون مغايرين تمامًا للأنساق الثقافية السائدة في كل العالم.
إن الأفكار الريادية الخارقة في كل مراحل التاريخ قد جاءت كومضات خاطفة وسط ظلمات حالكة، وكلها من دون أي استثناء قد قوبلتْ بالرفض والمقاومة، وهو رفضٌ قد يمتد قرونًا، كما هي حالة اكتشاف أن الأرض ليست مركز الكون، فقد بقي هذا الاكتشاف مطمورًا أكثر من ثمانية عشر قرنًا حتى أعاد الاكتشاف كوبرنيكوس، ومع أن معظم الاكتشافات لا يمتد رفضها كل هذا الامتداد؛ إذ تجد من يستقبلها بالقبول بعد تلكؤ قد يطول أو يقْصُر حسب الحالة الثقافية السائدة، ولكن المؤكد أن الرفض يحصل دائمًا بشكل تلقائي، أما القبول فلا يأتي إلا متأخرًا، وقد لا يأتي أبدًا كما في الثقافات الشديدة الانغلاق. وفي الكتاب الذي لم أنشره بعدُ بعنوان «الريادة والاستجابة» قَدَّمتُ شواهد متنوعة على ذلك من التاريخ والواقع، ستكون كافية لمن يرغب في الاستبصار.
حين تَدخُل فكرةٌ رائدة، أو حقيقةٌ علمية فارقة، أو تنظيمٌ اجتماعي جديد متطور إلى ثقافة أي مجتمع، فإنها لا تدخل عن طريق الفهم العام، وإنما تصير جزءًا من ثقافة المجتمع بواسطة الممارسة والمعايشة والتكيف والتعود، فعموم الناس في المجتمعات المزدهرة لا يدركون سبب أو أسباب ازدهارهم، فهم محمولون في مرْكبة التحضُّر أو مركبة التحجُّر من غير أن يعرفوا كيف تكوَّنت هذه المركبة الاجتماعية العامة، فقد تبرمجوا بما هم عليه تبرمُجًا تلقائيًّا بواسطة التكيف والتعود، وليس بواسطة التفهُّم والإدراك، فالأفراد في المجتمع كقطرات الماء في النهر الزاخر، فلولا هذه القطرات لما كان النهر لكن لا أهمية لأية قطرة إلا بكونها ضمن النهر.
التعلّم بمختلف مراحله، والتخرُّج من الجامعات، أو حتى إنهاء دراسات عليا في أي مجال، هدفه تكوين المهنيين من الممرض إلى جراح القلب، أو أستاذ الجامعة أو الباحث العلمي، فكل هذه المسارات لا تدل على تطور نوعي للوعي الفردي، فالوعي النقدي الفاحص المنفصل عن تفكير القطيع لا علاقة له بالتعليم الجمعي بمختلف تخصصاته ومستوياته، بل التعليم المقنَّن يكرس الوعي السائد.
تجسيد الأفكار الريادية الخارقة يرتبط باتجاه حركة المجتمع، فإذا كانت حركة المجتمع باتجاه الازدهار، فإن الأفواج الذين تخرجهم الجامعات والمعاهد يتولون تجسيد الرؤى والأفكار الريادية التي تقبَّلها المجتمع، إذ يعمل كلُّ فرد في مجال اختصاصه. إن إنتاجهم يمثل قطرات الماء التي يتكوَّن منها نهر الازدهار، ولكن الأفراد أنفسهم الذين أسهموا في تشييد الازدهار في مجتمع تتجه حركته في اتجاه النمو، لو عملوا في مجتمعات متخلفة فسوف يكون عملهم محكومًا باتجاه حركة المجتمع، وبذلك فقد يكون إسهامهم في تكريس الواقع وليس تغييره، أي في تكريس التخلف واستحكام أركانه وإغلاق منافذ الرؤية فيه.
الثقافة السائدة
إن استيعاب هذه الحقائق يجعلنا ندرك أن التعليم في أي مجتمع محكومٌ بالثقافة السائدة وليس حاكمًا لها، وأن أفراد كل بيئة يتبرمجون بثقافتها تلقائيًّا فيبقون محكومين بها، وتظل تتحكم بهم وتهيمن على اتجاههم وتفكيرهم ووجدانهم، وتحدد قيمهم واهتماماتهم، فالبرمجة التلقائية هي التي تحدد هوية الفرد حسب البيئة التي ينشأ فيها، فالإنسان لا يولد بماهية أو هُوية محددة، وإنما يتقولب تلقائيًّا في طفولته قبل بزوغ وعيه.
إن كل إنسان يولد بقابليات فارغة مفتوحة مطواعة، فيتشكل عقله ووجدانه بالأسبق إلى قابلياته، ثم يظل هذا الأسبق يتحَكَّم به مهما نال من تعليم، فهذا الأسبق يصير هو الذات عينُها، وهو المعيار المهيمن لتقييم كل ما هو مغايرٌ له. إن الفرد لا يفكر إلا من خلال هذا الأسبق، فهو لا يرى أيَّ شيء إلا بواسطته، فمن المحال أن يفكر المرء بتغيير ذاته إلا بهزة فكرية مزلزلة توقظه من سباته، وتخرجه من غبطته الغافلة، وتفصله عن التيار السائد، وهي حالة لا تحصل إلا نادرًا، أما عموم الناس فيبقون مأسورين بما تبرمجوا به في طفولتهم، فلا يرون الحياة والدنيا إلا من خلال هذا التبرمُج التلقائي.
أما التعليم الذي يضطرون لقضاء ربع قرن وهم يكابدونه فيبقى محصورًا في المجال المهني والعملي فقط، وكما يقول الدكتور فاخر عاقل في كتابه (سيكولوجية الإدراك): «إن المعلومات المبدئية تكون إطارًا ومفتاحًا للمعلومات التالية، وإذا كانت المعلومات التالية مخالفةً للمعلومات الأولى فإنها تُلوى لتناسب المعلومات المبدئية». إن الناس يجهلون عن أنفسهم هذه الحقيقة الأساسية، مع أنها أهَمُّ من ركام الحقائق الجزئية التي تمتلئ بها أذهانهم ويهتم بها التعليم.
إن هذه الحقيقة المحورية التي أكدها الدكتور فاخر عاقل قد باتت من الحقائق التي يكررها العلماء والباحثون، فهذا الطبيب المشهور العالم إدوارد دي بونو يقول بوضوح في كتابه (تعليم التفكير): «تقوم المعلومةُ الأولى بتغيير حالة العقل بشكل يجعل المعلومةَ الثانية ترتبط بها أو توافقها، وبهذه الطريقة يتم بناء الأنماط». ولأن الدماغ البشري لا يملك آلية للتحقُّق فإنه يعتمد المعلومات الأسبق كمعيار للحكم على المعلومات التالية مهما كانت الأولى خاطئة، ولأن مسائل العلوم التي يتلقاها الدارسون في التعليم لا تأتي ولا يمكن أن تأتي إلا متأخرة أي بعد أن تكون البنيات الذهنية والوجدانية قد تَشَكَّلَتْ في مرحلة الطفولة المبكرة، فإنه لا يكون لها أي تأثير إيجابي في تصحيح ما تبرمجت به القابليات بشكل تلقائي من دون أي تمحيص.
التعليم في المجتمعات المتخلفة
إن التعليم في المجتمعات المتخلفة يكرس التخلف، ويعمق أسبابه، ويزكي البيئة الحاضنة له. إن التعليم محكومٌ بالأوضاع القائمة؛ فإذا جاء ضمن ثقافة حرة ومنفتحة ونامية، فإنه يُمدُّ المجتمع بالطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تدفعه للمزيد من التقدم والازدهار، فكل تقدم هو تمهيدٌ لتقدم أعظم، أما إذا جاء التعليم ضمن ثقافة مغلقة ومتخلفة ومرعوبة من الأفكار المغايرة، فإنه يكرس الانغلاق، ويرسخ التخلف، ويوصد العقول، ويشحن العواطف بالرفض العنيد الأعمى لمقومات التقدم الطارئة.
إننا نتوهَّم أن تعميم التعليم، ونشر المدارس، والإكثار من الجامعات، وإغداق الإنفاق عليه، وتوفير فرص التعليم للجميع يؤدي تلقائيًّا إلى تهيئة المجتمعات لتحقيق التقدم والازدهار، لكننا نغفل عن أن التعليم محكومٌ بالثقافة السائدة، وليس بالعلوم الطارئة، ونتجاهل بأن المجتمعات محكومة بثقافاتها التلقائية المتوارثة، وليست محكومة بطلاءات مجلوبة من خارجها.
إن المجتمعات تتناسل ثقافيًّا بشكل تلقائي، وترفض ما يغاير تصوراتها وقيمها ومألوفاتها، فالأطفال يتبرمجون تلقائيًّا بالثقافة السائدة قبل أن يلتحقوا بالتعليم، فتنغلق قابلياتهم عن قبول ما لا يتفق اتفاقًا كاملًا مع البرمجة التلقائية، لذلك ينبغي أن يدرك رجال التربية والتعليم والمسؤولون عن التنمية هذه الحقيقة الأساسية، وأن يتفهموا التغيرات النوعية التي طرأت على الحضارة البشرية.
____
* ملف العددان ٤٨١ – ٤٨٢ نوفمبر – ديسمبر ٢٠١٦م – كتاب الفيصل.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




