مناهجنا التعليميَّة وإرثنـا الثقافيّ؛ بيـن مسلَّمـة الاعتقاد وضـرورة الانتقاد
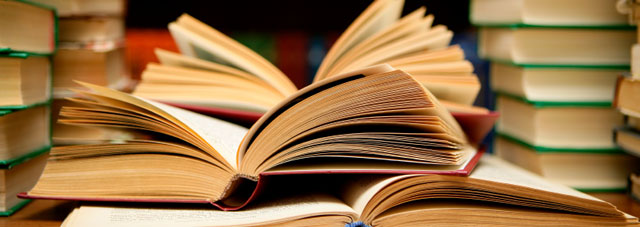
“لا نمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرُّر ممَّا هو ميِّت أو متخشِّب في كياننا العقليّ وإرثنا الثقافيّ. والهدف: فسح المجال للحياة كي تستأنف فينا دورتها وتعيد فينا زرعها… ولعلّها تفعل ذلك” د. محمد عابد الجابري
ما أحوجنا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى إجابات عن أسئلة باتت أزليَّة الطرح، أرَّقت الأذهان لسنوات؛ سؤال الهوَّة بيننا وبين الآخر، وسُبُل اللحاق بركب الحضارة والعلم والتقدُّم، وغيرها كثير. إنَّه السؤال ذاته الذي يعيدنا إلى الذات، فنكون بصدد الجلد تارة، واستئناف البكائيَّات على مجد مفقود تارة أخرى. ولنا أن نسائل قراءتنا لواقع مجتمعاتنا العربيَّة الإسلاميَّة في سياقاتها وشروط إنتاجها وممكنات وآفاق تحوّلها وانعطافها في ظلّ فكر حداثيّ نقديّ متَّقد. حتى لا نكون أمام مجتمعات لا الماضي فيها يمضي ولا الآتي يأتي، فلا يبقى فيها لقديم أمل في أن يتجدَّد، ولا لحاضر شرف الانفتاح واستشراف المستقبل. هي كذلك مجتمعاتنا العربيَّة، وما يتطلّبه الوقوف على أعتاب حقيقة نهضتها من استحضار عناصر هي بالنسبة لها، بمثابة الماء والهواء لكلِّ كائن، فحينما تحضر الثقافة والهويَّة والعلم والحضارة والعقل والتراث والمعتاد والمعتقد والمنتقد، آنذاك فقط تكون الذات العربيَّة على المحكّ، لنكون أمام ثنائيَّات تؤمن بثقل التاريخ لتجد لها امتدادًا في ذاكرة القديم والجديد، الطبيعة والثقافة، الأصالة والتجديد، الاعتقاد والانتقاد. ولن يتأتَّى لنا ذلك إلا بتناول التفكير النقديّ ومناهجنا التعليميَّة في ظلِّ ثقافة عربيَّة إسلاميَّة والتساؤل حول ما إذا كانت هذه الثقافة اليوم تتحمَّل النقد، وما وإذا كان بإمكان الفكر العربي المسلم أن يستعيد الجوانب العقلانيَّة في تراثه ويوظِّفها توظيفًا معاصرًا؟
عادةً ما يُقال المناسبة شرط. ولنا أن نؤسِّس لشروط تحمِّلنا عبء الخوض فيما يكتنفه غموض المنطلق لكل ناظر متأمِّل في العقل العربيّ، وما يصاحبه من استحضار مقولة إنَّه إذا كان “العقل الغربيّ” يعاني من غلوّ في استعمال معاول الهدم والانتقاد التي لا تبقي ولا تذر، فإنَّ “العقل العربيّ” يعاني من الانقياد لأوثان فكريَّة، وأصنام ثقافيَّة تلقاها بالاعتياد، وتحتاج لهذه المعاول النقديَّة لتختبر “الاعتقادات” التي ينقاد إليها واعتاد عليها. وهو ما يدفعنا إلى إثارة الآسن من أسئلة هذا الاعتقاد، وكيف لنا أن نؤصّل من داخل ثقافتنا لحداثة فكريَّة، لا فقط التبجُّح بأنَّ لنا قصب سبق واقعيّ أو مزعوم بفلاسفتنا ومفكِّرينا في هذا المجال أو ذاك، أو الاكتفاء بالنفخ في سِيَر أسلافنا بمنطق التمجيد والتفاخر. وهنا لا يتضارب الانتقاد مع الاعتقاد بقدر ما يكون الأوَّل وسيلة لاختبار الثاني، لا غاية في حدّ ذاته. فالانتقاد الذي نحتاجه هو الذي يختبر اعتقاداتنا لا بغرض التدمير وحسب، وإن كانت فلسفة الهدم لتكون أحيانًا أهمّ من فلسفة البناء عند نيتشه؛ لأنَّه لربما ما بني لم يكن قد بني على أساس. فيكفي أن يستعيد العقل عرشه ليكون مدعمًا ومكمِّلًا للإيمان بضرورة الانحياز لشرطنا الحضاريّ ووجودنا الثقافيّ كمرجعيَّة وهويَّة، حتى نضمن تعزيز جوانب اختلافنا وائتلافنا مع الآخر وقبوله بما يحفظ لهويّتنا الثقافيَّة ألقها الحضاريّ ويضمن نفسها التجديديّ، لا أن نقبع في مستنقع الاعتياد ونبقى حبيسي تراثنا غائبين عن تطلّعات واقعنا وآفاقه من جهة ولا منقادين معلنين موتنا وأفولنا الحضاريّ.
عندما يذهب الجابري بالقول إنّه “لا يمكن تحقيق النهضة من خلال الاعتماد على الماضي وحده، وإنَّه من الخطأ الجسيم، كذلك الاعتقاد أنَّ هذه الذات يمكن أن تنهض بالتخلِّي الكلِّي عن ماضيها والإعراض عنه والانضمام إلى تراث غير تراثها أو الارتماء في حاضر يتقدّمها بمسافات شاسعة، فالإنسان لا يمكن أن يبدع إلَّا داخل ثقافته وتراثه، والإبداع بمعنى التجديد الأصيل لا يقوم إلَّا على أنقاض قديم تمَّ احتواؤه وتمثّله وتجاوزه بأدوات فكريَّة معاصرة تتجدَّد بتجدُّد العلم وتتقدَّم بتقدّمه.” فحينها نكون وكأنّنا أمام نصّ للمفكِّر عبد الكبير الخطيبي ” النقد المزدوج” حيث الدعوة إلى نقد الذات والآخر مسائلًا الهويَّة بالقول في مستهلّ كتابه “لا يمكن للهويَّة الأصليَّة التي تقوم على الأصول اللغويَّة والدينيَّة والأبويَّة أن تحدِّد وحدها العالم العربيّ. فهذه الهويَّة قد تصدَّعت وتمزَّقت بفعل الصراعات والتناقضات الداخليَّة. ثم إنها تجد نفسها مرغمة على التكيُّف مع مقتضيات الحياة العصريَّة والتفتُّح على العالم”. وهنا تبدو وتتجلَّى ضرورة النقد لا كمجرد فعل يقف عند حدود التعرية والتفنيد لثقافتنا الإسلاميَّة من الداخل ومناهجنا التعليميَّة، وإنّما بممارسة فعل التجديد من داخل تلك الثقافة بإعمال ملكة نقد الآلة المنتجة للمعرفة أولًا وقبل كلّ شيء؛ أي العقل العربيّ. حيث هنا يطرح السؤال هل يمكن بناء نهضة بعقل غير ناهض، عقل لم يقم بمراجعة شاملة لآليَّاته ومفاهيمه وتصوّراته ورؤاه؟
إنَّهُ السؤال الذي يمنحنا مساحة الفهم الجيِّد ومجال ومآل التفكير النقديّ في مناهجنا، وما إذا كانت هناك مساحة لهذا التفكير، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرَّد شعارات يعيش معها المثقَّف العربيّ أزمنة ثقافيَّة متعدِّدة في زمن ثقافيّ عربيّ واحد كما يقول الجابريّ ” سمته حضور القديم، لا في جوف الجديد، يغنيه ويوصله، بل حضوره معه جنبًا إلى جنب ينافسه ويكبّله”. ولعلّ المخرج من كل هذا يكمن في استدخال فعل النقد في مناهج التعليم للدفع بالفكر العربيّ في اتِّجاه العقلنة وتصفية الحساب مع ركام يستتر في زيّ المسلَّم به من المعقول والمقول، بدل الاكتفاء بنقل معارف وأفكار وسلوكات جاهزة من جيل لآخر دونما تمحيص أو نقد، وأحيانًا بالتقليد الذي استعلى واستعمى ليكرِّس منطق الغلبة والتبعيَّة للأنا في ثوب القديم حينًا وللآخر حينًا أخرى. وهذا ليس تعاليًا عن واقع مجتمعيّ، ولا تغريدًا خارج السرب كما تغرِّد خطابات مناهجنا وتقفز على معطى التجديد والتنوير، لتلوذ بالفرار إلى الماضي ملتمسة منه الحلول والأجوبة، واضعة الطلّاب تحت شرط التلقين والقوالب المعرفيَّة الجاهزة، ليتمّ بذلك إعادة إنتاج ما يمكن تسميته بالجهل المقدَّس حسب تعبير ” أوليفييه روا”، حيث طرد العقل مع سبق الإصرار، وكأنَّه في حالة تلبّس منافية للطريقة العموديَّة في التلقين وثمرة للحرِّيَّة في التفكير والنقد.
أن تكون علاقة القارئ العربيّ بتراثه علاقة تذكُّر وفقط، لا علاقة نقد وبناء، وأن يتلقَّى هذا القارئ تراثه منذ ميلاده ككلمات ومفاهيم، كمعارف وحقائق، كل ذلك بدون نقد، عندما يفكِّر، يفكّر بواسطته ومن خلاله فيستمدّ منه رؤاه واستشرافاته، معناه عدم قدرة ثقافتنا على تجاوز كل ما من شأنه أن يكون مرجعيَّة تراثيَّة ضيِّقة أو مذهبيَّة تحدّها حدود المجال والزمان، نحو ثقافة ومعرفة تنتصر للمشاع الإنسانيّ.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






