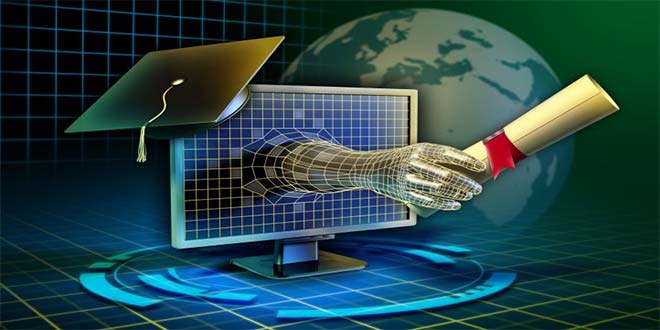هو معلِّم … فانحنوا للرسول

*سناء حديب
انت وما زالت مهنة التعليم من أرقى وأسمى المهن وأصعبها وتحتل المرتبة الثانية بعد المهنة العظيمة وهي دور الأمّ والأب.
لم تختصر العملية التعليمية على محور (من وإلى)، أي من المعلِّم أو الملقن إلى التلميذ-المتلقي كما عهدناها، منذ نشأة التعليم، بل صدرت العديد من النظريات والتجارب والفرضيات التي أعطت التعليم رونقًا جديدًا بأساليب وتقنيات، ودعمت المعلِّم حتى يستطيع أن يدرك مدى أهمية دوره ورسالته التي يؤديها وقدرته على التغيير وبناء جيل واعٍ وقادر على المواجهة ورفع صوته والتعبير عن رأيه، “فإذا أردت أن تغيّر العالم، فاحمل قلمك واكتب” . وتحوّل دور المعلِّم من الملقّن إلى المربي والمرشد، وهو من المساهمين الأساس بعد الأم والأب في تربية وتنشئة التلاميذ وزرع القيم والمعارف فيهم.
وتعممّت منذ وقت بعيد، في المنطقة العربية كافة، مناهج التعليم التقليدية التي تفتقر إلى التفاعل والحيوية داخل الصفوف في المدارس والجامعات، واعتبار التلميذ كائنًا ضعيفًا لا حول ولا قوة له، والمعلِّم هو السيد القادر على انتشاله من حفرته واليد الساحرة التي تستطيع أن تثبت أنها خرّجت أجيالاً وتفتخر بصناعة هذه العقول، ومع ترديد هذا القول:
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
ولكن ما نراه واقعًا، هو عكس الصورة الذهبية التي يعيش فيها المعلِّم، والفعل بعكس القول السابق. فالأجيال السابقة التي تخرجّت معها كل اللوم لسوء التربية وأسلوب التلقين الذي كان متبعًا من قبل أغلب المعلمين على مستوى عالمنا العربي، فقد كان المعلم هو ناقل للمعارف والمعلومات فقط وعلى التلميذ أن يحفظها عن ظهر قلب. وزاد العتب عندما اجتاحت مناهجنا وبرامجنا، أفكار وأساليب التعليم في الدول المتحضرة، إن كانت في الغرب – الأوروبي أو الشرق وخاصة اليابان، واستطاع المتعلّم أن يجد الفروقات الواضحة في هذه المناهج والنتائج التي وصلت إليها المدارس والجامعات غير العربية وما بقينا نحن عليه.
وكما ذكرت سابقًا، تُعدّ الأساليب والتقنيات والطرائق الفعّالة هي الأساس لتحويل التعليم إلى عملية تفاعل حيوي، وذلك من خلال المؤثرات البصرية والصوتية التي تدخل في الشرح داخل الصف أو التطبيق في الخارج واعتماد الأنشطة اللاصفية التي تنمي ذكاء التلميذ ويصبح الإبداع وخلق الأفكار من مميزات الأجيال الصاعدة. بالإضافة إلى البحوث المتواصلة في الجامعات ومتابعة كل ما هو جديد على صعيد العالم. فالمعلم أينما كان في المدرسة أو الجامعة، لم يعد فقط المستخدم للمناهج المطروحة بل الشريك الأساسي في تصميمها والناقد والداعي للتعديل والتغيير والتطوير فيها.
وللوصول إلى هذه التغيرات علينا الانطلاق بمسار طويل من التدريبات المستمرة وورش العمل التي لا تنقطع عن الهيئة التعليمية، والاطلاع الدائم على كل جديد في إطار تطوّر المناهج عالميًا وأخذ ما يناسب مستوى التلاميذ للعمل على تنمية قدراتهم أكثر.
كما أنه من المهم تبادل الخبرات بين المدارس والجامعات في البلد الواحد نظرًا لكثرة عددها وتنوع اختصاصاتها واختلاف أساليبها التعليمية وذلك من خلال اجتماعات وورش عمل مشتركة. “فكل من يتوقف عن التعلم يصبح كبيرًا، سواء كان في العشرين أو الثمانين من العمر وأي شخص يستمر في التعلم يبقى شابًا”.
ومن خلال هذا الإعداد المتقن، مع سلسلة تدريبات متكاملة ومتواصلة للمعلمين، ينعكس تلقائيًا على أدائه في الصف وطرق المعاملة حتى مع التلاميذ ويساعده في ابتكار أساليب جديدة ويكون بذلك التعليم قد انتقل من التقليدي إلى الحيوي بنشاط وفاعلية أكثر.
وفي جانب آخر، حتى تكتمل العملية التعليمية وتحافظ على مبدأ الحيوية، يجب اعتماد اللقاءات التوجيهية المستمرة مع الأهل، التي يتعرف أولياء الأمور فيها على طرق التدريس المعتمدة ويسهل بذلك المتابعة في المنزل، وعندها يُحاط التلميذ من كل الجوانب وتتوحد الأفكار في التربية بين المنزل والمدرسة. وبذلك نكون على سُلّم الصعود في صناعة التنمية المجتمعية التي تُعتبر الأسرة من مكوناتها الأساسية.
وفي النهاية إن تكامل العملية التعليمية بين مختلف العناصر: التلميذ – المعلِّم – الأهل، هو السبب الأساسي في نجاح التعليم الحيوي والوصول إلى نتائج واضحة في التغيير نحو الأفضل، فالتعليم هو مهنة البذل والعطاء يمنح فيها المتعلم العلم للأجيال ويهديها الوعي ويهبها الفكر لتثمر قيمًا وفكرًا وسلوكًا. والمعلِّم هو الرسول الأهم في نقل العلم والمعرفة وبيده أن يعطي ويغيّر ويبدع مع هذه العقول الناشئة، وهو الأجدر بالانحناءة لسمو الرسالة التي يحملها.