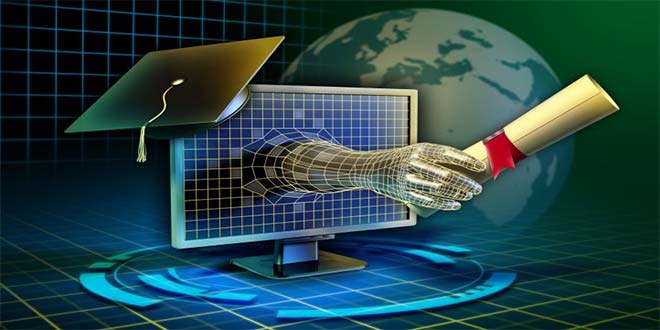متطرف على طبق من فضة

احتدت المناقشات في الآونة الأخيرة أثناء جلسات البرلمان السوري حول إلغاء مادة التربية الدينية، وبينما طالب بعض النواب باستبدال مادة الأخلاق بالمادة الدينية باعتبار أنها السبب في نشر ثقافة الطائفي، تمسك آخرون بتدريس المادة باعتبارها المصدر الأساسي لنشر الأخلاق.
وقبل أن نعلي أصوات الصراع، لا بد لنا أن نراجع الهدف وراء تدريس التربية الدينية في المدارس؟ و هل تنجح مناهجنا في الوصول لهذا الهدف؟ والأهم من ذلك كله.. من الموكل بتوصيل الطلاب لهذا الهدف المرجو؟؟
في مراحل التعليم الأولى والثانوية يعتبر الطلاب – بشكل ما – مدرس التربية الدينية مفتيهم الصغير، وبذلك يتعرض المدرس لكثير من الأسئلة والمناقشات والتي هو غير مدرّب على إجابتها أو حتى التعامل معها بشكل صحيح.
“لماذا نرتدي الحجاب في الصلاة، هل الله رجل؟”، سألت الطفلة معلمتها و لم تستطع الأخيرة سوى الاندهاش والتزام الصمت.
تنامت بداخل عقلي أسئلة حول الذات الإلهية، وخلق الكون، و وجدت أن أسئلتي تصطدم بالنص القرآني كثيرا، ولم أجد أمامي سوى معلمة الدين التي وعدتنا أن تستقبل حواراتنا الخاصة خارج وقت الحصة، ذهبت لها وما إن بدأت محاولاتي الجاهدة في شرح ما يدور بعقلى، حتى وجدتها تضحك في خبث و تقول لي : “بنيتي ..عادة في تلك المواقف نرشد الصبيان للعب الرياضة والبنات لأعمال الغزل والتريكو كي يفرغوا طاقاتهم”؛ تروي هذه القصة طبيبة شابة عن ما حدث معها في المدرسة الثانوية، ومن يومها تقريبا لم تثق في فتح خواطرها المتخبطة عن الإله مع أحد.
وليست فقط القدرة على تقبل الأسئلة وإجراء الحوار هي ما تنقص معلِّم التربية الدينية في العالم العربي، وإنما عدم إدراكه أن سلوكه العام وسلوكه داخل الدرس بالذات ينقل رسالة أعمق من الحديث:
“لم أشعر بتقبلي كإنسانة طبيعية كاملة، إلا في العقد الثالث من عمري، عندما انتقلت للدراسة في أمريكا، حيث الجميع مختلف عن الجميع”، جملة قالتها لي صديقتي الشيعية التي تعيش في مجتمع يغلب عليه المذهب السنيّ المتبني للفكر “الوهابي”، والذي يضع مناهج للتربية الدينية ترمي الشيعة بتهمة الكفر بشكل مباشر، قالتها بعد أن قصت علي كيف كانت المعلمات يعاملونها وزميلاتها الشيعيات باضطهاد واضح، ويحرضن باقي الفتيات على معاملتها بتلك الطريقة المهينة.
“معلّمتي في درس الدين كانت تحذرنا من تعاملنا مع زميلاتنا المسيحيات لأن مصيرهن المحتوم إلى جهنم و بالطبع كل من يصادقهن أيضا، كانت تهمس لنا بهذه الأحاديث عندما ننفصل عنهن في درس الدين، حتى إذا عدن للفصل ابتسمت لهن ابتسامة الرضا والنور والسلام”.
عدم الاهتمام بتدريب معلمي التربية الدينية وتأهيلهم لتدريس هذه المادة، بل وعدم اكتراث الجهات المعنية بالتعليم في العالم العربي لهذه المادة ولمناهجها ومتابعتها، جعل درس الدين مسرحًا ارتجاليًا بطولته وتأليفه متروكة للمعلّم، و كثيراً من المعلمين اتخذوا درس التربية الدينية تفريغًا لتجاربهم الشخصية، ونقلاً لإرث المجتمع، وطريقًا سهلًا للإحساس بالسلطة على الطلبة المنبثقة من سلطة الدين.
مثل هذه السلوكيات والمناقشات بين معلم التربية الدينية وطلابه، جعلت أفكاراً عميقة سلبية تترسب في أنفس الطلاب بدلا من أخرى إيجابية وحقيقية كان من المفترض أن يتم إنمائها بداخلهم، وتفرعت الأفكار السلبية ونمت حتى ترعرعت سلوكًا يوميًا بالغ العمق في مجتمعاتنا سبب كوارث عديدة نلهث وراءها كي نحاول اقتصاصها من المجتمع دون جدوى، ومن أهم هذه الأفكار:
الله ضد الإنسان:
المنطقة العربية هي أكثر مناطق العالم ذات تاريخ بدوي صحراوي، وعلى الرغم من أن الإسلام حاول تغيير مفهوم القبلية وطرح مفهوم “الأمة” إلا أن ضعف الدول الحديثة التي تكونت في المنطقة العربية، جعل الأفكار الصحراوية والقبلية تهيمن على الفكر العربي بل و تبتلع حتى الأفكار الحضارية القديمة التي كانت موجودة في بعض المناطق، هذه الهيمنة أصلت الفكر البطريركي الأبوي عند العرب، بل اعتبره الكثير منا جزء لا يتجزأ من الدين والإيمان.
وتتلخص الفكرة البطريركية في الشكل الهرمي السلطوي القامع لأي إبداع أو تطور أو تمرد في بناء العلاقات الاجتماعية والحياة الفكرية والسياسية أيضا، بدعوى أن الكبير يعرف أكثر ويسعى للحفاظ على المصلحة العامة للجميع فوق جميع الرقاب.
وانعكس هذا التفكير في علاقتنا مع الله بالتالي، فتحولت لعلاقة جبرية، نظن طوال الوقت فيها أن إرادة الله ضد إرادة الإنسان العابث المقصّر، وانتهج أغلب معلمي التربية الدينية في المدارس نفس النهج في زرع تلك الفكرة في عقول الأطفال والمراهقين الذين غالبا ما تصدمهم هذه الفكرة وتتضارب مع أسئلتهم وتطور نظرتهم للحياة، بينما تقف إجابات المدرس و الأبوين عند هذه النظرة الطفولية السطحية للعلاقة مع الإله.
ويتحول الخطاب في درس الدين بالضرورة بعد تعميق فكرة البابوية إلى تجذير العلاقة الميكافيلية النفعية مع الله، فإذا كان الله جابرًا قاهرًا ، فلا بد أن نشتري رضاه طوال الوقت بملء عدّاد الحسنات، ومحاولة تفريغ عدّاد الذنوب عن طريق الإحساس الدائم بالذنب، بينما يختفى تماما عن أفواه المعلمين فكرة حب الإله المطلق للإنسان، وأن صنائع المعروف هى من أجل الإنسانية التي يحبها الله، وإنما يتم الترويج لأعمال الخير من أجل جمع القدر الأكبر من النقاط للفوز برضا الله والجنة.
السلطوية على المجتمع في مقابل الدمج:
و تعتبر هذه الفكرة – رغم محوريتها – نتيجة للفكرة السابقة، حيث يعمق المعلم من خلال سلوكه وحواره الباباوي مع الطلاب فكرة أن تنمية تلك العلاقة النفعية مع الله تعطى لمن يصلون لله بعداداتهم الخاصة بالعبادات و المظاهر الدينية سلطة على المجتمع، باعتبار أن صاحب هذه التجارة هو الأقرب للإله وبالتالي تتقدم مكانته في الهرم البطريركي.
التقديس والحرية:
بما أن معلم التربية الدينية غالبا ما يعتقد ضمنيا أن مادته لا تحتاج للتفكير، والتحضير، والمراجعة، حيث يغلب الاعتقاد بأننا مجتمعات مؤمنة بالوراثة فيميل سلوكه إلى أنه ناقل فقط لهذا الإرث الذي لا يجب المساس بمقدساته، وينقل الكثير من معلمي الدين في المدارس أن التقديس هو من يحمينا من “خطر التفكير”، ومجاراة الأسئلة التي تسوؤنا وتهز من عقيدتنا.
و فكرة التقديس تؤصّل لفكرة ضمنية ضد الحرية، ويعزز السلوك العام للمعلِّم في درس الدين والسلوك العام في مدارس الوطن العربي هذه الفكرة القمعية التي مفادها أن التفكير، والسؤال الحر، وكل ما يعتمل في عقلك خارج المقدسات، هو ضد إرادة الله القامعة، ومنبعه هو النفس الأمارة بالسوء، أما الدين فهو هذه الأحكام، والتفاسير، والمقولات المحفوظة، وكفى.
عداء الآخر:
المجتمع الأبوي و السلطوية على الآخر و إيهام الذات أنها مسؤولة عن البشر مسؤولية القريب من الله الذي يعرف أكثر، كلها أفكار تشبع كراهية الأضعف، والأضعف هنا هو المرأة، والشاب، والطفل، والأقليات، ومن بداية تأصيل وتقديس فكرة أن المغضوب عليهم هم النصارى، والضالين هم اليهود، التي يتناقلها معلمو التربية الدينية عبر الأجيال وصولا إلى فكرة أن الشيعة أخطر علينا من اليهود ومرورًا بناقصات عقل ودين، وتسفيه الشباب، والفرقة الناجية، نصل في النهاية إلى نفس متقبلة وبشدة الانتماء إلى جماعات متطرفة لإفراغ كل هذه الطاقة ضد الآخر أيًّا كان هذا الآخر، و لكن كي أنجو بنفسي من كل هذه الفرق المنبوذة على أن أكون فوقهم جميعًا وأقواهم جميعًا.
العلم مقابل الخرافة:
لعل من أشهر الصراعات بين الدين والعلم هى نظرية “التطوّر”، والتي تجعل الطالب خصوصا في المرحلة الثانوية يصطدم بالصراع بين ما يقال في درس الدين وما يدرس في درس العلوم، وضمنيًا يُفهم أن العلم يُخالف الدين في المجمل، وتتطور هذه الفكرة معه بتطور الحوار عن نبذ تراكم المعرفة الإنسانية، ونبذ الحداثة، وتصدير فكرة طهر السلف، وارتباط الدين ارتباطًا شرطيًا بكل ما هو قديم، و”خرافي”، في أحيان كثيرة.
و يجد الكثير من الشباب أنفسهم نتيجة لهذه الفكرة على مفترق طرق بين ما يسمى “الدين”، وبين طريق العلم والحداثة والتطوّر، التي هي في الحقيقة سنَّة من سنن الله في الكون، فتجبره طريقة الخطاب في درس الدين أو خطبة المسجد على اعتناق أحد المسلكين.
نبذ قيمة الجمال:
في دراستي لعلوم النبات، لم أجد فائدة علمية صريحة لوضع أعضاء و أجهزة النباتات في شكل جمالي، كان يمكنها أن تؤدي وظيفتها البارعة وهي قبيحة أو حتى بشكل لا قبيح ولا جميل، ولكن جمال النباتات والكائنات عموما، مفصولاً عن الوظيفة، جعلني أفكر أن الجمال قيمة مطلقة غير مسببة وغير مقيدة، في حين أننا نتعلم منذ الصغر في درس الدين قيم النظام والنظافة والعمل… إلخ، حتى إذا جاءت سيرة الفن يتحول الحديث في أغلبه إلى نبذ الفن لاعتبارات مجتمعية وموروثة أيضًا، حتى إذا شب الطالب الذي يرجو الفن في مستقبله، إما أن يختار الفن المشوه بقيم أسموها قيم دينية محافظة، أو يختار طريق الفن بعيدا عن الدين تماما، وتزداد الفجوة شيئا فشيئا بين الدين والفن، وبين المجتمع – الذي يدّعي التدين – والفن أيضًا.
ليست هذه كل الأفكار التي ينقلها معلِّم الدين في المدرسة وحسب، ولكن هذا وسع لي ذكره، و لكنها تكفي لترفع الغطاء عن مشكلة علينا أن ننتبه لها، وهي تأهيل معلِّم التربية الدينية ليتعامل مع الطلاب بشكل فعال في غرس وتطوير مكوّن أساسي من مكونات الشخصية العربية ألا وهو علاقته بالله وبالدين، مكون إما أن يكون دافعًا أو مضللًا، الجهات المعنية بالتعليم عليها أن تنظر بعين ناقدة حقيقية لدرس الدين في المدارس ومراعاة تطور المرحلة العمرية والفكرية والنفسية للطلاب.
أما دورنا نحن كشباب تجاه أصدقائنا، وإخوتنا، وأبنائنا، ألا نجاري تيار مجتمعي ينظر للدين على أنه مهمل وسط المواد الدراسية الأخرى أو نجاري نظرة المجتمع للدين على أنه مجرد محفوظات وأحكام وشرائع، علينا أن نقرأ ونطور فكرنا نحن ونفتح القلوب والعقول لاستقبال الجديد حتى نستطيع مجاراة أسئلة ونقاشات وتغيرات الأجيال التي تلينا حول هذه القضية الهامة، وأن نفهم ونعي أن الهدف الأسمى للدين في حياة الإنسان هو حصوله على الحرية ومنحه السعادة، وليس أن يجيب دائما الإجابة النموذجية، وإلا نفعل ذلك نكن قد قدمنا للجماعات المتطرفة فردًا جديدًا على طبق من فضة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.