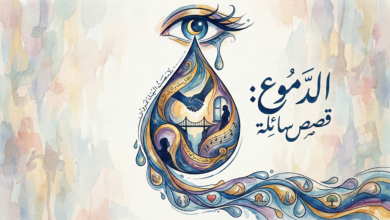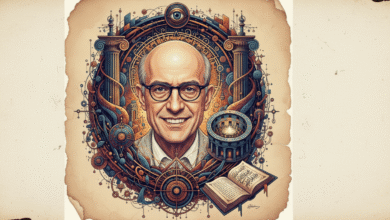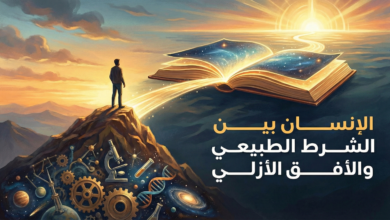من هو الحداثي بامتياز؟
الأسلوب العلمي كنموذج للحداثة: من دقة المختبر إلى تداعياتها الأخلاقية والوجودية

إذا بحثنا عن الشخص الحداثي بامتياز أو في نموذجه المثالي سيكون دون منازع هو: “العالم يشتغل في مختبره”، فطريقته في النظر للأشياء [شكه الدائم، عدم قبوله بالجاهز من الأفكار، فصله الذات عن الموضوع، عزله تكوين الشيء عن خلقه، تكميمه للظواهر قصد التحكم فيها، استبعاده للنظرة الغائية، سعيه للإجرائية والمردودية وتأكيده على الدليل المحسوس…]، هي لب الرؤية التي تسري في كيان المنظومة الحداثية. إن طريقة اشتغال العالم كما تبلورت بجلاء في القرن السابع عشر، لم تعد حكراً عليه وحده، بل طغت وتسربت إلى بنية التفكير البشري خلال القرون الأربعة الأخيرة، فأصبحت رؤية أكثر شموليةً، بل أصبحت “باردايما” كاسحاً تتودد له كل القطاعات الأخرى، بوعي أو لا وعي منها، نظراً لما تقدمه من نجاعة ومردودية. إنها باختصار الرؤية المسماة حداثية.
وهو الأمر الذي جعلنا نعرف الحداثة باعتبارها: “الأسلوب العلمي موجه لكل قطاعات الحياة”، كما جعلنا نستنتج أن أسُس الحداثة هي أسُس العلم نفسه بحيث تغدو مكاسب العلم هي مكاسب الحداثة وكذلك بالمثل تكون مآزق الحداثة وأوجاعها هي عينها مآزق وأوجاع العلم، ويمكن بيان بعض ملامح ذلك للقارئ كالآتي:
- يقوم الأسلوب العلمي أو الحداثة، على فصل الذات عن الطبيعة، وهنا نتذكر عبارة لأحد رواد الانطلاق الحداثي وهو العالم غاليليو غاليلي حينما قال: “عندما تلمسني الريشة وتحدث لي دغدغة، فهذا الإحساس ينتمي لذاتي وليس للريشة”. يروم غاليليو هنا إقامة الفصل بين ما ينتمي للذات وما ينتمي للعالَم الخارجي، إذ لا يجب بحسبه إسقاط ما هو إنساني على الطبيعة، فهذه الأخيرة صماء وعاطلة لا سبيل إلى فهمها إلا بتكميمها ووضعها في قوالب رياضية، وإرغامها على أن ترسل أرقاماً، بل هو نفسه القائل: “إن الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات” أما الاعتماد على الكيفيات [بارد، ساخن، حلو، مر، فوق، تحت…] التي نسقطها على الطبيعة ففيها تشويه للموضوع المدروس وإعطاء صورة زائفة عنه.
بهذا العزل سيتخرق العلم حينها الطبيعة، وسيضرب سؤال الغايات والمقاصد عرض الحائط، ليتم التركيز على السببية الصارمة، ومن هذا المنعطف، ستصبح أسئلة الخير والشر خارج اهتمام العلم، ليكون المكسب في المحصلة هو السيطرة على العالم باعتباره مجرد موضوع، والتحرر من سطوته، وهو ما سيصبح فكرة معممة تصيب جميع المجالات، هذا التعميم هو الحداثة في النهاية، التي تفيد التحكم في كل شيء والرقابة على كل شيء، لكن المأزق الذي ترتب على ذلك هو انتشار القسوة وغياب الرحمة، والشاهد على ذلك استباحة الطبيعة والعبث بها، من قبيل ما نعاين مع الأزمة البيئية، التلاعب الجيني ضمن نماذج أخرى من العبث بالطبيعة، ومن هنا دلالات استدعاء الأخلاقيات التطبيقية كعلاج.
2 . إذا كان الأسلوب العلمي، أو قل الحداثة، يسعى نحو الوضوح عن طريق تحليل الظواهر وتجزيء المركبات، فإن المكاسب تمثلت في خلق عالم شفاف، عالم من التكشف والتعري يطرد الأوهام ويزيح الأقنعة ويرفض الخداع، وما الحداثة في النهاية سوى كشف للغامض وإماطة اللثام عن المخفي وإبراز ما هو غير مرئي، وإخراج للمضمرات والدخول إلى اللاوعي لإظهار كل ما هو مسكوت عنه، وكل ذلك بالطبع طمعاً في إيقاف الزيف والتحرر من سطوته، لكن بالمقابل ولد ذلك، انزلاقاً خطيراً تمثل في إفقاد العالم سحره وقداسته، مما أدخلنا في هتك للحجب بلغ مبلغ الإباحية والمساس بأعز ما نملك وهي خصوصيتنا من جهة ومن جهة أخرى إفراغ الانسان في أحيان كثيرة من “حيائه”.
3 . إذا كان الأسلوب العلمي [أي: الحداثة] يطلب الحركية عوض الثبات، فالعلماء لا يهدأ لهم بال، ولا نظرية علمية تصمد طويلاً، إذ يظل البحث عن الحقيقة مطلباً لا حدود له، فإن المكاسب من هذا النهج تجلت في تكريس النسبية عوض المطلقية، مما فتح الباب لقيم التعدد والتسامح، وقيم التقدم الدائم، لكن في المقابل كان الثمن باهظاً وهو خلق أجواء من القلق وعدم الاستقرار. إذ عدم صمود “الصدق” لمدة طويلة أمر غير مريح للإنسان قط، فأن يعيش المرء بحقيقة وهمية وقوية، أفضل عنده ألف مرة من أن يعيش في ظل حقيقة مؤقتة ومهلهلة.
ــ إذا كان الأسلوب العلمي [أي: الحداثة] يقوم على فصل “تكوين” العالم عن “خلق” العالم، وفصل عالم الظواهر عن عالم الأشياء في ذاتها، فإن هذا ترتب عليه تكريس المحايثة أو لنقل “الدهرانية”، مما حجّم من دور الدين ليقتصر فقط على الأخرويات، بل والأكثر من ذلك إدخال البشرية في حمى الحس التاريخي، لتصبح كل ظاهرة تنتمي لهذا العالم لها تكوين معين وتشكل مرحلي يبدأ من مادة أولية، ولذلك نقول مع العلماء إن للجبل وللحيوان وللإنسان وللمرض تاريخا، بل للأفكار تاريخ أيضاً، ثم إنه لا شيء يتملص في الحداثة من قبضة التكوين المادي ولا شيء يأتي دفعة واحدة. الأمر الذي جني منه الإنسان مقدرة على التحكم في الظواهر ومن تم تحقيق المردودية والنجاعة، لكن هذا الأساس الفصلي بين الدنيوي والغيبي، بين التكويني والخلقي، جعل العالم، من جهة، يبدو وكأنه آلة( ساعة) كبرى تشتغل بقوانين لاعناية إلهية فيها، ومن جهة أخرى تم إبعاد القيم والآيات من رؤية العالم، فضاقت على الناس آفاقهم الواسعة. إذ الفرق شاسع مثلاً بين أن تكتفي بتحليل التفاحة والبحث في تكوينها، من قبيل وجود فيتامينات ومعادن وبروتينات وأملاح معدنية، وبين أن توسع من الأفق بالنظر إلى الآيات التي وراء الظواهر وذلك بجعلها نعمة إلهية مثلاً. إنه باختصار الفرق المنهجي ما بين المنطق المحايث والمنطق المفارق، منطق الظواهر ومنطق المعاني. منطق الفصل ومنطق الوصل، وما الحداثة في المحصلة سوى تغليب للمحايث على حساب المفارق.
4 . إذا كان الأسلوب العلمي [أي: الحداثة] يقوم على أساس البناء عوض الجاهز فإن هذا جعل كل شيء، ينحو نحو الصناعي (صناعة الحقيقة، المشاعر، الأخبار، السياسات، الحروب، الغذاء، الدواء، الجمال،الذكاء إلخ)، وهو أمر لا يمكن أن ننكر فوائده، إذ دفع بالحياة البشرية نحو فتوحات عجيبة وأحيان لا تصدق، جعلت الحياة مريحة وفيها الكثير من الرفاهية، لكن الأمر كان له ضريبة واضحة وهي سحق الطبيعي وجعله نادراً جداً، حيث انعكست الآية. على سبيل المثال: يكفي الذهاب لأي سوق تجاري بحثاً عن جناح الغذاء الطبيعي، لتجده منعدماً أو في زاوية صغيرة وبكميات قليلة وأسعار مرتفعة، ومن تم، تصبح الحداثة مجرد سحق للطبيعي وتملص من قبضته.
5 . إذا كان الأسلوب العلمي [أي: الحداثة] يتحرك بمنهج الشك و القابلية للتكذيب لا التحقق فقط، فهذا كان سلاحاً فتاكاً ضد الجاهز، بل خلق طموحاً لا يتوقف نحو الحلول الأفضل، وهو ما كرّس فكرة التقدم الدائم التي هي عنوان من عناوين الحداثة الكبرى، فالرؤية العلمية وضعت سياجاً مُحكماً لقبول الدخول إلى حظيرتها، فبدون مؤشرات ملموسة يمكن دحضها من طرف جماعة العلم، لن يسمح لأي فكرة بالمرور ولن يعترف بها قط، فالعلم عزل نفسه في جزيرة المرئي ومنع بإحكام وبأبواب موصدة دخول أي شيء غير محسوس وغير قابل للقياس أو تنعدم فيه المؤشرات الحاسمة. وهو الأمر الذي كانت له محاسن تمثلت في مزيد من الرصانة ومزيد من الدقة والموضوعية، لكن مع ضريبة غالية تمثلت في خلق أجواء من الإقرار، فإذا كانت كل نظرية مهددة بالسقوط، فهذا جعل إنسان الحداثة غير مطمئن لأرض صلبة وصدق ثابت يرتكن إليه، وهو ما أدى في المحصلة إلى غياب الأمان الوجودي.
كانت هذه بعض ما نراه الأسُس التي يشتغل في أفقها العلماء (فصل الذات عن الطبيعة، السعي نحو الوضوح، الحركية عوض الثبات، فصل تكوين العالم عن خلق العالم، البناء، صناعة الحقيقة،القابلية للتكذيب […]) والتي واضح أنها لم تعد حكراً عليهم، بل اكتسحت كل القطاعات في الحياة بشكل واضح تارة وبشكل مضمر تارة أخرى، هذا الاكتساح هو الحداثة نفسها، ولعل كثرة الإلف وانتشار هذا الأسلوب العلمي في صميم حياتنا، بحيث أصبح يؤثر فينا بلا وعي منا وفي خلسة من أمرنا، هو ما يجعلنا أحياناً ننسى أن نسميه الحداثة.
محسن المحمدي