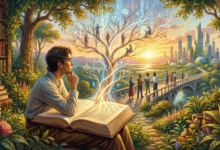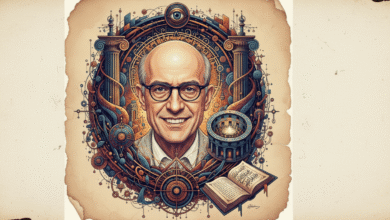تشريح النقد الثقافي ( الغذامي نموذجًا ) ( 2/2)
من سويفت وأرنولد إلى الماركسية والعدمية: صراع المفاهيم وتفكيك القيم في الفكر النقدي
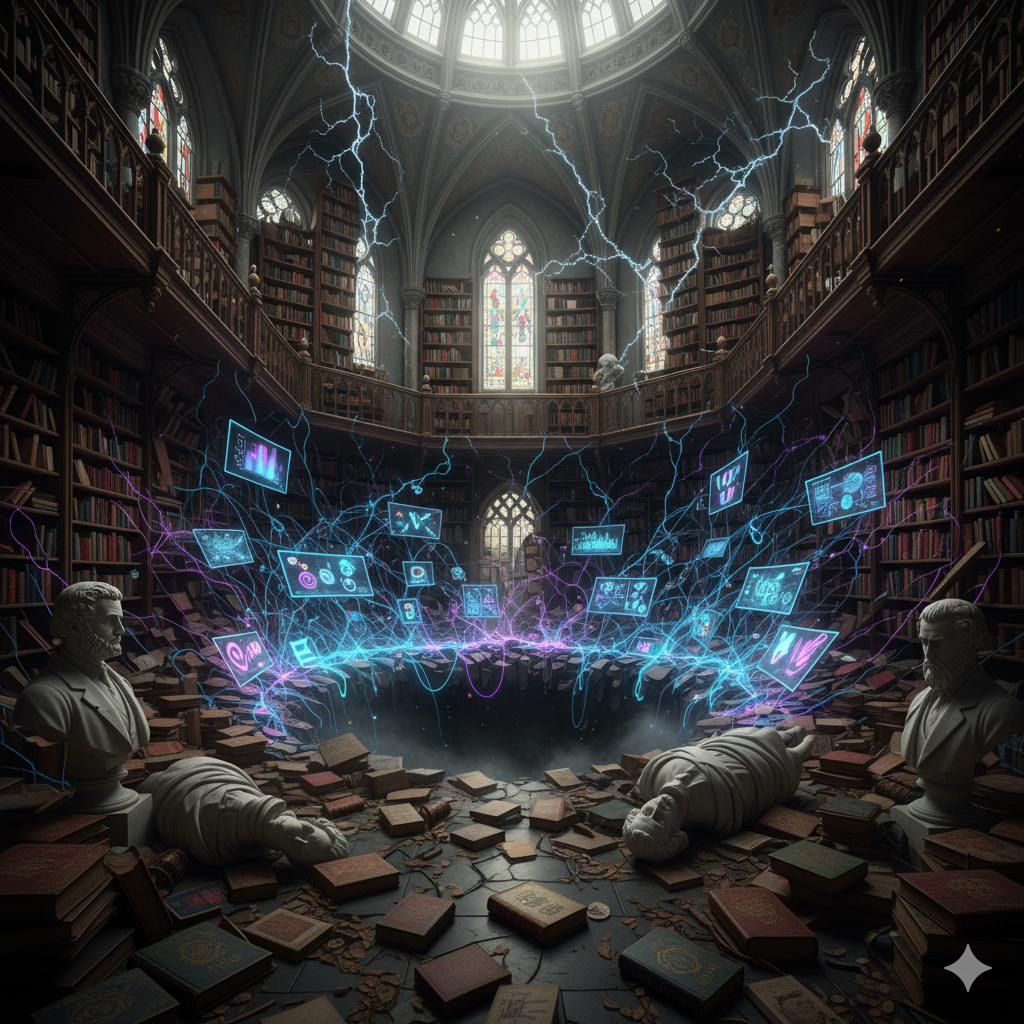
طوّر النقاد الثقافيون الذين ظهروا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مثل “جوناثان سويفت”، “جون روسكين”، وخاصة “ماثيو أرنولد”، النقد الثقافي كما نمارسه اليوم، معقدين بشكل كبير المفاهيم القديمة للثقافة والتقاليد والقيمة. فأما “جوناثان سويفت” فيسخر السمات التقليدية في أدب الرحلات البريطانية في القرن الثامن عشر، من أجل السخرية من النزعة القومية التي كانت حاضرة في بريطانيا خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك في روايته الأشهر “رحلات غوليفر”. يظهر “غوليفر”، بطل القصة، قدرة محدودة على النسبية الثقافية طوال الرواية؛ إذ يرى في الثقافات التي يصادفها من منظور عدسته التي تحمل طابع التحامل الشخصي. ويُصوّره “سويفت” على أنه راوٍ متحيّز ليُبرز عبثية ونفاق القيم الإمبريالية، حيث تُشكّل كل أرض يزورها تحديًا جديدًا لأيديولوجيته القومية.
كان “سويفت” نفسه ضحية للاضطهاد الاستعماري؛ فكونه أيرلنديًّا، اختبر بنفسه خضوع بلاده للإمبريالية الإنجليزية، وهو ما شكّل الخلفية التي استندت إليها المضامين المناهضة للإمبريالية في الرواية. خلال القرن الثامن عشر، استخدمت إنجلترا الفتوحات الإمبريالية لترسيخ مكانتها كقوة سياسية واقتصادية وأكاديمية عظمى. ويجسّد “غوليفر” القيم التي كانت سائدة في الدولة البريطانية الموحدة حديثًا، حيث يستخدمه “سويفت” كوسيط لانتقاد مظاهر القمع الكامنة في التوسع الإمبريالي للتاج البريطاني.
تكتسب أعماله أهمية خاصة في ظل التوجّه المتزايد نحو التحليل ما بعد الاستعمار، إذ تقدّم الانتقادات التي طرحها في “رحلات غوليفر” رؤية صارمة وصادقة للتحاملات المتجذّرة في مجتمع قومي استعماري. وبينما تتضمّن التحليلات الحديثة للأدب البريطاني في الحقبة الاستعمارية عادةً منظور ما بعد الاستعمار، تميل التحليلات التاريخية لأعمال “سويفت” إلى تجريده من الأبعاد السياسية، متجاهلة المنظور الاستعماري الجوهري الذي كتب من خلاله.
وهذا ما يدعونا إلى دمج التحليل الأدبي لرواية “رحلات غوليفر” مع نظرية ما بعد الاستعمار الحديثة، بهدف تحديد الغرض من سخرية “سويفت”، والتأثيرات التي تخلّفها هذه السخرية على مجال الدراسات الأدبية لما بعد الاستعمار.
تقوم رواية غوليفر على نقد الاستعمار البريطاني ونقد القومية البريطانية والغرور السياسي وتقرير النسبية الثقافية: كيف أن ما يبدو “غريبًا” في ثقافة ما قد يكون ” عاديًّا ” في أخرى مع شيء من النظرة التشاؤمية للطبيعة البشرية خاصة في الجزء الأخير من الرواية وهذا أمر طبيعي بما أن المؤلف إيرلنديٌّ خاضع هو ومجتمعه لقوة استعمارية طاغية لا يجد أحد منها فكاكًا ولا عنها خلاصًا، كل هذا بلا ريب يدخل في مسألتنا هذه من أوسع أبوابها ويعد أرضية صلبة له ومقدمات محترمة لما عرف بعد بالنقد الثقافي ونحن لا نجادل في أهميته ولا في دوره الكبير في تشريح المجتمعات ولا في تحديد مكامن المشكلات ولا في معرفة الحالة الاجتماعية السائدة ربما يندرج ذلك كله تحت علم النفس الاجتماعي ولكنه من باب النص الثقافي عندما نتعامل مع النصوص كأجساد ثقافية عندما يقوم الطبيب (الأديب الثقافي) بوضع سماعته الأدبية عليها لمعرفة ما هو أبعد من النص الظاهر وهو عمل جيد ولكنه يحرمنا من القيمة الجمالية، فالنقد الثقافي قد يكون هو عدو الجمال فأنت عندما يضع لك الطاهي طعامًا شهيًّا في أبهى صورة وأجمل تكوين وألذ طعم وتكون أنت نباتيًّا تأخذك الرأفة بالحيوان وتقوم بإلقاء محاضرة عن حق الحيوان في الحياة فهذا قد يكون حقًّا ولكنك ستحرم المجتمعين من سعادة حقيقية وفرها هذا الطاهي المحترف أما “أرنولد” فكان أحد الآباء المؤسسين الأوائل لهذا الاتجاه النقدي في القرن التاسع عشر رغم أن مصطلح “النقد الثقافي” لم يكن مستخدمًا في عصره بالشكل الذي نعرفه اليوم فتجد نقده للطبقة الوسطى الإنجليزية في كتابه “الثقافة والفوضى” (1869) عندما كانت بريطانيا تمرّ بتغيرات اقتصادية واجتماعية ضخمة نتيجة للثورة الصناعية، فظهرت طبقة وسطى قوية ذات نفوذ اقتصادي كبير، لكنها من وجهة نظر “أرنولد” كانت تفتقر إلى الذوق الثقافي والتفكير العقلاني.
في هذا الكتاب، ينتقد “أرنولد” “الطبقة الوسطى الفيكتورية”، ويصفها بأنها: مادية التفكير، تضع الربح والملكية فوق القيم الأخلاقية والجمالية. كما أنها محدودة الثقافة، تركز على العمل والتقدم الصناعي دون اهتمام بالفنون أو الفكر والقيم الجمالية. متمسكة بالتقاليد والدين شكليًا، دون تعمق في المعاني الروحية أو الأخلاقية. وأطلق عليها “البرجوازية الفوضوية”، لأنها- من وجهة نظره- تسهم في خلق فوضى اجتماعية وثقافية بسبب جهلها الثقافي وانعدام الحس الأخلاقي الراقي.
يرى “أرنولد” أن “الثقافة” هي الحل: أي “السعي إلى المعرفة، والاطلاع على أفضل ما قيل وفُكّر فيه في العالم”. ويدعو إلى أن تتجاوز الثقافة الانقسامات الطبقية، وأن تكون أداة لبناء مجتمع متناغم ، مؤمنًا بأن الثقافة قوة تتسم بالانسجام غير المتناقض وعدّها أداة لنقد المجتمع وإحداث التغييرات المطلوبة فيه وربط بين الذوق الأدبي والوعي الأخلاقي والسياسي فكانت أفكاره مهادًا لما عرف بالنقد الثقافي الحديث رغم أن رؤيته كانت نخبوية أخلاقوية مقارنة بالنظرة الراديكالية التي ظهرت لاحقًا.
وهنا سنضع مقارنة بسيطة بين النظرة التقليدية في النقد الثقافي والنظرة الراديكالية:
| الجانب | النظرة التقليدية (مثل أرنولد) | النظرة الراديكالية |
| الهدف | الارتقاء الأخلاقي والذوق العام | كشف علاقات الهيمنة والسلطة |
| الموقف من الثقافة | الثقافة تُهذّب وتُوحد | الثقافة أداة للسيطرة أو للمقاومة |
| من يحدد “القيمة”؟ | النخبة المثقفة | الجماعات المهمشة أو المتنوعة |
| الموقف من “الكانون” الأدبي | تقديسه | نقده، وتفكيكه، وتوسيعه |
أبرز منظّري النظرة الراديكالية:
“ريموند ويليامـــــــــــز”: الثقافة عنده ساحة صراع بين الطبقات.
“أنطونيو جرامشي”: مفهوم “الهيمنة الثقافية” وكيف تفرض الطبقة الحاكمة قيمها.
“ميشــيــــــــــــل فــوكـــو”: يربط بين المعرفة والسلطة، ويرى أن الخطاب الثقافي يتحكم في العقول.
“إدوارد سعيــــــــــــــــــــــد”: كشف الاستشراق كمثال على كيف تُنتج الثقافة الاستعمارية صورًا مشوهة للآخر.
“ستيـــوارت هــــــول”: أحد مؤسسي “الدراسات الثقافية” في بريطانيا، ركّز على دور الإعلام والهوية.
علاقة النقد الثقافي بالشيوعية
علاقة النقد الثقافي بـ الشيوعية علاقة معقدة ومتشابكة، تعود جذورها إلى تداخل السياسة بالفكر والثقافة، خاصة في القرن العشرين.
النقد الثقافي يهتم بتحليل الثقافة من حيث علاقتها بـالسلطة | الأيديولوجيا | لطبقات الاجتماعية | التحيزات العرقية والجندرية والاقتصادية.
أما الشيوعية، فهي نظرية سياسية واقتصادية تدعو إلى: إلغاء الطبقات | الملكية الجماعية | المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
بالتالي، فإن النقد الثقافي يلتقي مع الشيوعية في نقطة مركزية وهي “نقد البُنى الاجتماعية الظالمة التي تنتجها الطبقية والسلطة الاقتصادية”.
والكثير من منظّري النقد الثقافي (خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين) تأثروا بـ “كارل ماركس”، مؤسس الشيوعية العلمية من خلال بعض أفكاره.
البنية التحتية | الفوقية:
الثقافة (الفوقية) ليست مستقلة، بل تتشكل بناءً على الاقتصاد (البنية التحتية).
الوعي الزائف (False Consciousness):
الثقافة يمكن أن تُستخدم لخداع الناس وإقناعهم أن النظام القائم “طبيعي” أو “عادل”.
الصراع الطبقي:
يظهر ليس فقط في السياسة والاقتصاد، بل أيضًا في الأدب والفن والإعلام.
ومن المنظرين للنقد الثقافي الذين تأثروا بالشيوعية | الماركسية:
| المفكر | مساهمته في النقد الثقافي | علاقته بالشيوعية |
| أنطونيو جرامشي | طرح مفهوم الهيمنة الثقافية، وكيف تفرض الطبقة الحاكمة قيمها | شيوعي إيطالي، سجنته الفاشية |
| ريموند ويليامز | أحد مؤسسي الدراسات الثقافية، ركّز على الثقافة كصراع طبقي | متأثر بالماركسية |
| تيري إيجلتون | ناقد أدبي وماركسي، كتب كثيرًا عن العلاقة بين الأدب والإيديولوجيا | شيوعي فكريًّا |
| هربرت ماركوز / مدرسة فرانكفورت | نقد الثقافة الجماهيرية كأداة للسيطرة على الجماهير | تأثروا بالماركسية والنظرية النقدية |
سعى نقاد القرن العشرين إلى توسيع وتعقيد المفاهيم التقليدية للثقافة، فلم يكتفوا بالنظر إليها بوصفها مجموعة من القيم الرفيعة أو النتاجات الأدبية الراقية، بل عدوها منظومة ديناميكية تتشابك مع السلطة، والهوية، والصراع الطبقي، والإيديولوجيا. وقد فتح هذا التوجه المجال أمام دراسات متعددة التخصصات تسعى إلى تفكيك البنى الثقافية المهيمنة وتحليل الأبعاد السياسية والاجتماعية الكامنة خلف الخطابات الثقافية.
البروليتاريا (Proletariat) | (أسامة المسلم ) مشروع الغذامي ضد النخبوية:
في الفكر الماركسي (الشيوعي)، تُشير البروليتاريا إلى: الطبقة العاملة أو الكادحة، التي لا تملك وسائل الإنتاج، بل تبيع جهدها العضلي أو الذهني مقابل أجر.
في مقابلها تجد البرجوازية (الطبقة المالكة | الرأسمالية) التي تحتكر الثروة والسلطة.
“ماركس” دعا إلى تحرير البروليتاريا من الاستغلال الطبقي، من خلال ثورة تطيح بالنظام الرأسمالي وتقيم مجتمعًا بلا طبقات.
كيف تدخل البروليتاريا في النقد الثقافي؟
فضح النقاد الثقافيون احتكار الطبقات العليا للثقافة “الرفيعة”، مثل الأدب الكلاسيكي والفنون الجميلة واعترفوا بثقافة الطبقة العاملة (البروليتاريا) الذي يمثل الأدب البسيط الشعبي الذي هو في متناول الجماهير كجزء من مشروع الثقافة الإنسانية. وذلك بإعادة تعريف الثقافة باعتبارها ناتجًا جماعيًّا، وليس حكرًا على النخبة الأكاديمية أو الأرستقراطية.
النقد الثقافي: التحوّل من النخبوية إلى الشعبوية
في القرن التاسع عشر، كان يُنظر إلى الثقافة من منظور نخبوي (مثل ماثيو أرنولد)، أي أنها يجب أن “ترتقي بالناس”. في القرن العشرين، خاصة مع صعود النقد الماركسي، بدأ يُنظر إلى الثقافة على أنها: “أداة للصراع الطبقي”، وأن الثقافة الشعبية (ثقافة البروليتاريا) تستحق الدراسة والاحترام.
إذًا، النقد الثقافي تحوّل إلى موقف سياسي وأخلاقي منحاز للبروليتاريا ضد النخبة.
أبرز من مثّلوا هذا التوجه:
- ريموند ويليامز: رأى أن الثقافة “طريقة حياة كاملة” تشمل الطبقة العاملة نشأ من أسرة عمالية، واهتم بإبراز ثقافة المهمشين.
- أنطونيو جرامشي: ركز على مفهوم “الهيمنة الثقافية”، ونظرية “المثقف العضوي”، آمن بدور المثقفين في تمكين البروليتاريا ثقافيًا.
- ستيوارت هول: درس الثقافة الشعبية والإعلام وتأثيرهما على الطبقة العاملة، انحاز لتحليل الثقافة من منظور الهوية والطبقة.
ولذلك قد تجد ناقد ثقافي (الغذامي نموذجًا) ينتقد النخبة التي تحتكر الأدب “الكلاسيكي”، ويدعو إلى تدريس الأغاني الشعبية، أو الروايات البوليسية، أو روايات عوالم الجن (أسامة المسلم) أو سينما الشارع، فهو يتبنّى موقفًا بروليتاريًّا ضد النخبوية.
هذا الموقف الثقافي من الغذامي وأمثاله يحمل فكرًا شيوعيًّا بامتياز وهو من التأثر بالماركسية وهو في رأيي هدم للخالقية أو الواحدية في نفوس الناس وهو يجرنا إلى العدمية شيئًا فشيئًا ، ربما أقدم المواقف الفلسفية المرتبطة بما يمكن وصفه بالنظرة العدمية هي مواقف المتشككين الذين أنكروا إمكانية اليقين، ومن عادة المتشككين أن يشجبوا الحقائق المتوارثة والتقليدية باعتبارها تفتقد في كثير من أحوالها إلى المبرر العقلي، وقد لاحظ “ديموستنيس” (348- 322 ق.م) على سبيل المثال؛ أنه لا أسهل من خداع الذات فكل ما تريده هو ما تؤمن به تماماً حيث يفترض الطبيعة العلائقية للمعرفة من منظور شكوكي مرتبط بالعدمية التي تنكر إمكانية قيام معرفة حقيقية جوهرية وربما هذه النظرة تلتقي مع الفلسفة السفسطائية؛ فالظواهر تعتمد على الجوهر لتحقق وجودها، ولا يعتمد الجوهر على شيء آخر لقيام وجوده الحقيقي، ومن ثم فإن الجوهر هو الحقيقي وما سواه فهو وهم ولا تكتسب الأشياء وجوداً حقيقياً إلا بمقدار اقترابها من الجوهر وبدونه لا يمكن أن تكون على ما هي عليه، والإيمان بالجوهر يعني الإيمان بمبدأ الثابت في الواقع، وأن هناك كليات مستقرة وثابتة وراء الجزئيات المتغيرة والعرضية، ومن ثم لا يؤمن العدميون السفسطائيون ودعاة ما بعد الحداثة بوجود جوهر ما؛ فكل شيء متغير وعرضي وربما تصور “نيتشه” هذا الوضع كمتنبئ بتلاشي الحضارة الغربية عندما ينعدم الثابت وتكون المتغيرات في فضاء مفتوح، وغير محدد بلا مركز فإنها ستتبدد في النهاية وتضمحل؛ فالمركزية في الواقع درجات، فأعلى درجات المركز إذا تسمَّحنا في العبارة الذي يعتمد عليه كل شيء؛ هو الله الذي أمسك السموات والأرض أن تزولا ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ فاطر (41)، فالله كما وصف نفسه رفيع الدرجات فله الدرجات العلى وهو مرتفع الوجود لأن وجوده أزليٌّ لا عن عدم، وبه وجود كل شيء؛ فالمركز على معنى المرجع الذي يرجع إليه كل شيء، ويعتمد عليه والله هو الأمان للكون كله من الزوال والاضمحلال، ويأتي بعده الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعدون وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) فالوجود قائم على المركزية، أو الثابت، وعند انعدام المركز يكون الدوران في فراغ مما يعني الفناء التام، والانهيار الكلي، وهذا هو الوجه القاتم من العدمية.
وهذا ما يدعونا إلى استجلاب “نيتشه” العدمي وقارئه العتيد هايدجر ولا نشك أنهما أي “نيتشه” و”هايدجر” يتفقان في بعض الأمور ككون كل منهما مفكرًا راديكاليًّا كان لهما علاقة بالفاشية والنازية كمنظرين أو مؤسسين لها، أو منتمين إليها لكنهما يتركزان حول فكرة إرادة القوة أو العدمية الأوروبية.
فالغذامي الذي يرتدي ثوب الإنسان المفكر الأخلاقي بهذا الفكر يدعو إلى عدمية هائلة وهو لا يشعر مؤذنة بانطحان هائل للقيم.
وسنوضح هذا ببساطة شديدة في فترات انهيار القيم الكبرى مثل (الدين، الوطنية، العدالة، الفن الراقي…) واشتداد الصراع الطبقي، يحدث الآتي:
العدمية تنتقد القيم العليا المزعومة:
- تسخر من القيم المطلقة التي تسوّقها النخبة: كالجمال، الحق، الأخلاق. ترى أن هذه القيم تُستخدم أحيانًا لإخفاء الظلم الاجتماعي أو تبرير السلطة.
- الأدب الشعبوي يعبّر عن الإنسان “المطحون” في هذا الفراغ القيمي عندما يتحدث عن العامل الذي لا يجد قيمة لعمله، عن المثقف المهمّش الذي يُقصى لأنه لا يكتب بلغة النخبة، عن الإنسان الذي فقد معنى وجوده في عالم لا يرحم.
ربط بين المفهومين:
في ظل انهيار القيم العليا (العدمية)، واشتداد الاستغلال الطبقي (الواقع المادي)، يظهر الأدب الشعبوي كـصرخة احتجاجية ضد الأدب النخبوي، وضد المجتمع الذي يرفع شعارات مثالية بينما يسحق الإنسان العادي.
وهنا نتذكر:
روايات فيودور دوستويفسكي– خاصة “الجريمة والعقاب” و”الإخوة كارامازوف”– تجسّد صراعًا بين العدميّة والمثُل العليا في ظل بؤس الطبقات الدنيا.
روايات ألبير كامو– مثل “الغريب”– تجسّد شخصيات فقدت المعنى والقيم، وتمثّل البعد العدمي في صراع مع النظام الاجتماعي.
في الأدب العربي: بعض أعمال صنع الله إبراهيم وعبد الرحمن منيف تُظهر هذا الانسحاق تحت القيم الزائفة.
في ظل تصاعد العدميّة الأوروبية، التي تنكر وجود قيم مطلقة أو معنى سامٍ، يتقدّم الأدب الشعبوي ليملأ هذا الفراغ، لا من خلال تقديم بديل مثالي، بل من خلال الاعتراف بالبؤس، وتفكيك السلطة، وكشف الزيف القيمي في الخطاب الأدبي النخبوي. وهكذا، يتحوّل الصراع الطبقي من كونه اقتصاديًّا فقط إلى صراع داخل الحقل الثقافي ذاته، حيث تُهمّش أصوات وتُرفع أخرى باسم “الذوق” أو “الذرى الأدبية”.
فالحقيقة ليست كما يصورها الغذامي ومن معه إنها أكبر من ذلك كله ولكنهم لا يشعرون ولا يدركون مآلات هذا العمل وإذا كان الغرب يسعى بصورة كبيرة متسارعة إلى العدمية الهائلة فنحن في الشرق بحكم التبعية ننساق إلى القدر المخيف في غياب مفكرين لا يدركون هذا المآل ولا يحسون بهذا الخطر وهذا لا يعني أن لا نكتب بلغة مبسطة ولا سهلة ولكن المسألة تأخذ بعدًا أشد خطورة من ذلك عندما نهدم الواحدية الخالقية والواحدية الجمالية والواحدية العالية لنذهب إلى العدم الذي لن يبقي وطنًا ولا شعبًا ولا أمة صامدة في وجه التحديات والمخاطر التي تحدق بها من كل صوب لتهدد وحدتها ووجودها عندما تكون نهبًا لسبع كشّر عن أنيابه وأحكم قبضته لأن البقاء عندها لن يكون لنا إذا استوينا نحن والشيطان.
وفي هذا الصدد تجد “والتر بينامين”، الماركسي الألماني، ينتقد الأشكال الأدبية التقليدية التي تُعطي “هالة” جامدة للثقافة، وأشاد بالفنون الحديثة مثل الدادائية() والتقنيات الإنتاجية الجديدة كالراديو والأفلام التي توسع مفهوم الثقافة بعيدًا عن النخبوية.
أما “أنطونيو جرامشي”، الماركسي الإيطالي المعروف بدفاتره السجنية التي نُشرت لأول مرة عام 1947 تحت عنوان Lettere dal Carcere، انتقد المفهوم التقليدي للأدب، بل وأكثر من ذلك، المفهوم القديم للثقافة فلم يركز فقط على أهمية الثقافة بمعناها الواسع، بل شدد على ضرورة رعاية وتطوير ثقافة الطبقة العاملة أو البروليتاريا. “جرامشي” اقترح أن نرى المثقفين من منظور سياسي، والحاجة إلى نوع من المثقفين الذين أطلق عليهم “المثقفين العضويين الراديكاليين”، أي المثقفين المتصلين بشكل عضوي بالطبقات الشعبية والثورة. اليوم، العديد من النقاد الثقافيين الذين يدعون إلى “إضفاء الشرعية على فكرة كتابة المراجعات والكتب للجمهور العام”، أو “الانخراط في القراءة السياسية للثقافة الشعبية”، وعمومًا “إعادة السياسة إلى البحث العلمي”، يستشهدون بجرامشي كأحد المدافعين الأوائل عن هذه الأفكار.
الأهم من ذلك، ربط “جرامشي” الأدب بالأيديولوجيات التي تنتجها الثقافة، وطور مفهوم “الهيمنة” (hegemony)، وهو مصطلح يصف النظام الشامل والشبكي للمعاني والقيم– الأيديولوجيات– التي تشكل الطريقة التي نرى بها الأشياء، وما تعنيه، وبالتالي ما هو الواقع بالنسبة لغالبية الناس داخل الثقافة. “جرامشي” لم يرَ الناس، حتى الفقراء منهم، كضحايا عاجزين للهيمنة، أو كـ”روبوتات أيديولوجية غبية”. بل اعتقد أن للناس الحرية والقوة في النضال ضد الأيديولوجيا وتغيير الهيمنة. كما يشير “باتريك برانتلينجر” في كتابه آثار كروزو: دراسات ثقافية في بريطانيا وأمريكا (1990)، فإن فكر “جرامشي” لم تتلوث بـ”غطرسة المثقفين التي تنظر إلى الغالبية العظمى من الناس كزومبيات مخدوعة لا تملك من أمرها شيئًا أو ضحايا أو مخلوقات صنعتها الأيديولوجيا”.
من بين الماركسيين الذين جاءوا بعد “جرامشي” واستكشفوا العلاقة المعقدة بين الأدب والأيديولوجيا، كان للماركسي الفرنسي “لويس ألتوسير” تأثير كبير على النقد الثقافي. على عكس “جرامشي”، كان “ألتوسير” يرى الأيديولوجيا هي التي تتحكم في الناس، وليس العكس. جادل بأن الوظيفة الرئيسة للأيديولوجيا هي إعادة إنتاج علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع، وأن هذه الوظيفة تُنفذ حتى في معظم النصوص الأدبية، رغم أن الأدب يتمتع بدرجة من الاستقلالية النسبية عن “التشكيلات الاجتماعية” الأخرى. “ديف لاينغ” شرح موقف “ألتوسير” بقوله إن: “مجموعة العادات والأخلاقيات والآراء” التي يمكن إيجادها في أي عمل أدبي تميل إلى “ضمان إبقاء القوة العاملة (والأشخاص المسؤولين عن إعادة إنتاجهم في العائلة والمدرسة، إلخ) في موقع خضوعهم للطبقة السائدة”.
والحق في هذا كله أننا لا نستطيع أن نجعل الطبقات الاجتماعية بتشكيلاتها المتنوعة من طلاب وعمال ومسؤولين صناعيين أو طبقة موظفين أو ربات بيوت وغيرهم حتى الأدباء الذين يمثلون قمة الهرم الاجتماعي بمعزل عن الأيدولوجيا التي تشد قبضتها على كل شيء، ولكن السؤال من الذي يتحكم في الآخر؟ من الذي له كلمة الفصل الأخيرة في تحديد من له الزعامة أو توجيه الدفة المجتمعية أو السير بالقافلة أو وضع الأشياء في مواضعها ومن الأعلى والأسفل؟ والذي أعتقده أن العملية تفاعلية بحتة بين الأطراف كلها مع أن هناك في كل أمة وثيقة أخلاقية أو نصوصية حاكمة على كل شيء وفي داخلها تحصل التفاعلات بين مكوناتها تؤثر وتتأثر حتى تنهار الأمة أو تتشكل أمة أخرى بدستور جديد في صورة سياسية جديدة أو مرحلة حاكمة مؤذنة بنسخ كل ما كان وجعله في مكون آخر أكثر انفتاحًا أو انغلاقًا تقدمًا أو تأخرًا تحرريًّا أو مقيدًا ومن هذا الأدب النخبوي أو الشعبي والصراع بينهما ما هو إلا إرهاصات لشيء قادم لا محالة.
لكن في كثير من النواحي، يمثل “ألتوسير” مثالًا جيِّدًا على النقطة التي يختلف عندها الماركسية والنقد الثقافي، رغم أن النقد الثقافي مدين للأفكار الماركسية. فعلى الرغم من تأكيد “ألتوسير” على أن الأدب يتمتع باستقلالية نسبية، إلا أنه كان يقصد بالأدب “الأدب الجيد” فقط، وليس الأشكال الشعبية التي يحاول النقاد الثقافيون الحداثيون أن يضعوها إلى جانب “تولستوي” و”جويس” و”إليوت” و”بريخت”. الألتوسيرية تفترض أن الخيالات الشعبية ليست سوى “حمير نقل” بغير وعي، لأسفار الأيديولوجيا الثقافية، فتعيد إنتاجها في “أرحام أنثوية إنجابية”.
وقد نشرح هذا المقطع بشكل أفضل كما يلي:
“ألتوسير”، المفكر الماركسي البنيوي، كان يرى أن الأدب يتمتع باستقلالية نسبية عن البنية الاقتصادية والسياسية، أي أنه لا يخضع بشكل مباشر للسيطرة الأيديولوجية كليًا. لكنه كان يقصد بالأدب هنا “الأدب الجاد” أو “العالي” – مثل أعمال “تولستوي”، “جويس”، “إليوت” و”بريخت”. هذا الأدب، في نظره، قادر على تفكيك أو فضح الأيديولوجيا، أو على الأقل الإشارة إلى تناقضاتها، بشكل غير مباشر.
وهذا قد نتفق معه فأعرق الحضارات التي تقوم فيها الهيكلية التنظيمية من خلال فصل السلطات ووضوح المسؤوليات بين درجات الحكم المختلفة هي التي تستطيع أن تقاوم الذوبان في رأي المسؤول الأول وأنت ترى أن المثقف المدجج بكم هائل من الخبرة والثقافة والاستقلالية والاعتزاز بالذات، وهذا لا يوجد إلا في الأدب الجاد؛ هو وحده من يستطيع أن يقاوم الأيدلوجيا السائدة التي تسيطر على كل شيء من خلال تقديم أدب مقاوم أو مؤثر أما الأدب الشعبي فهو أدب الوجبات السريعة الذي ينفك عن كل قيمة عالية ويحاكي الأكثرية الرعاعية.
على العكس من “ألتوسير”، يحاول النقاد الثقافيون المعاصرون (مثل “رايموند ويليامز”، “جون فيسك” و”وستيوارت هول”) رفع مكانة الثقافة الشعبية– مثل المسلسلات، الأغاني، الأفلام التجارية، الروايات البوليسية وحتى الإعلانات– وجعلها جديرة بالتحليل، تمامًا كما تُحلّل الأعمال الأدبية “الكلاسيكية”.
لكن من المنظور الألتوسيري التقليدي، هذه الأشكال الشعبية لا تملك قدرة مقاومة الأيديولوجيا، بل تعمل على إعادة إنتاجها، حتى لو كان ذلك دون وعي من صُنّاعها أو جمهورها.
“حمير نقل” و”أرحام أنثوية إنجابية”
يوظف الكاتب هنا مجازين قويين: “حمير نقل”: أي أن الخيالات الشعبية تحمل وتنقل الأيديولوجيا من دون وعي أو مساءلة.
“أرحام أنثوية إنجابية”: في إشارة إلى أنها تُعيد إنتاج الأيديولوجيا باستمرار، وكأنها حاضن طبيعي لها، تساهم في استمرارها وانتشارها ذلك أن التوالد بطبعها أنثوي فمن هذا حمل توالد الأفكار على هذا.
لذا، في حين أن النقاد الثقافيين تبنوا فكرة “ألتوسير” بأن الأعمال الأدبية تعكس تشكيلات أيديولوجية معينة، وفكرته أيضًا بأن الأعمال الأدبية قد تكون بعيدة نسبيًا عن الأيديولوجيا أو مقاومة لها، إلا أنهم رفضوا الحدود الضيقة التي حدد فيها “ألتوسير” ماهية الأدب. في مقال “الماركسية والخيال الشعبي” (1986)، استخدم “توني بينيت” عرض “مونتي بايثون” و”Not the 9 o’clock News” لإثبات أن فكرة “ألتوسير” بأن جميع أشكال الثقافة الشعبية مجرد أشكال مادية للأيديولوجيا تحت الرأسمالية ليست صحيحة. فمجال الخيال الشعبي– بما يشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب– مليء بأمثلة لأعمال تقوم بما يسميه “العمل” الخاص بـ “التباعد”؛ أي أنها تفصل الجمهور عن الأيديولوجيات السائدة بدلاً من ربطهم بها.
وقد وصف منظّرون مثل “ريموند ويليامز”، “أنطونيو جرامشي” وأولئك المرتبطون بمركز الدراسات الثقافية المعاصرة في برمنجهام بإنجلترا، بالإضافة إلى مثقفين فرنسيين مثل “لويس ألتوسير” و”ميشيل فوكو” الثقافة بأنها ليست كمنتج نهائي بل كعملية تربط المعرفة بالمصالح والسلطة وهذا لا يختلف فيه أحد فليس هناك في هذه الحياة منتجات معلبة أو جاهزة لذلك حتى النصوص الدينية المقدسة يدخل فيها العامل البشري بقوة فلا يوجد نص يصل إلى الناس من غير فقيه أو مفسر أو محدث فالسمة البشرية سمة غالبة لأنه لا يوجد ملائكة يخبروننا عن الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الفقهاء هل يجتهد أم لا والصحيح أنه يجتهد، قال الأمين الشنقيطي:
” الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه- صلى الله عليه وسلم- ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسره لأسارى بدر [وأخذ الفداء منهم]، وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت…) الحديث. إلى غير ذلك.
وأن معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ النجم (3) لا إشكال فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى، ولا يتكلم بالهوى، وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ النجم (4)، يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى، ولا بكذب، ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى”.
وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) رواه البخاري (887)، ومسلم (252)، قال النووي:
“فيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار” انتهى. فأنت ترى أن الجزء البشري وجد في النبوة وهذا هو الأصل الذي تستقيم معه الخلافة في الأرض لأن الله أراد منا الاجتهاد في البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق ولكلٍ أجره، للمصيب أجران وللمجتهد إذا أخطأ أجر فإذا رأيت هذا علمت أن المسألة الأدبية أعقد من هذا وأعمق لأن الجزء البشري فيها أكبر فتتداخل المصالح والسلطة والأيدولوجيات والطبائع المجتمعية حتى الجوانب الاقتصادية والظروف المحيطة من حرب أو غيرها في تحديد ما هو الرائج أدبيًّا وما هو الأكثر قبولًا أو أشد جمالًا.
ينتقد النقاد الثقافيون الكَانُون () التقليدي ويركزون اهتمامهم على مجموعة متنوعة من النصوص والخطابات، متتبعين تفاعلاتهما من خلال مزيج انتقائي من الاستراتيجيات التفسيرية التي تشمل عناصر من الاقتصاد، علم النفس، الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، دراسات النوع الاجتماعي والتاريخ الجديد. في نقدهم للكَانُون التقليدي؛ يتجنب النقاد الثقافيون تفضيل منتج ثقافي على آخر وغالبًا ما يفحصون نصوصًا تُعتبر هامشية وغير مهمة في النقد التقليدي، مثل النصوص المرتبطة بأشكال مختلفة من الثقافة الشعبية. نقد ثقافي متعدد التخصصات في جوهره، أصبح النقد الثقافي والدراسات الثقافية أدوات مهمة في تأطير نشوء وأهمية الأدب ما بعد الاستعماري ومتعدد الثقافات.
ما هو النقد الثقافي؟
يناقش النقد الثقافي الفكرة التقليدية لـ “الثقافة الرفيعة”— مثل الأوبرا والباليه والفنون الكلاسيكية— ويوسع مفهومها ليشمل الثقافة الشعبية مثل البرامج التلفزيونية، والقصص المصورة، والأفلام والروايات العامية. يسعى النقاد الثقافيون إلى كسر الحاجز بين “الثقافة الرفيعة” و”الثقافة الشعبية”، ويدرسون لماذا تُعطى قيمة أكبر لبعض المنتجات الثقافية على حساب أخرى، غالبًا لأسباب سياسية.
بدلاً من مجرد إضافة الأعمال الشعبية إلى “الكانون” الأدبي التقليدي، يشكك النقاد الثقافيون في فكرة وجود “كانون” ثابت ومحدد. يركزون على وصف وربط المنتجات الثقافية ضمن سياقات اجتماعية، اقتصادية، وسياسية أوسع بدلاً من تقييمها وترتيبها.
النقد الثقافي مجال متعدد التخصصات يجمع بين التاريخ، علم الاجتماع، دراسات الإعلام وغيرها. يعارض الحدود الأكاديمية الصارمة التي تفصل بين الفنون والثقافة الشعبية، وغالبًا ما ينتقد الهياكل الجامعية التي تحافظ على الأفكار النخبوية حول الثقافة.
نشأ النقد الثقافي من التقاليد الفكرية الأوروبية وتأثر بشكل كبير بالفكر الماركسي والمفكرين مثل “ميشيل فوكو” كما سبق وذكرنا، الذي رأى أن الثقافة كمنتج لعلاقات السلطة المعقدة وليس فقط صراع الطبقات. ومن بين الشخصيات المهمة أيضًا “ريموند ويليامز” كما مر معنا الذي عد الثقافة عملية حية ومتغيرة، و”ميخائيل باختين” الذي أكد على تعدد الأصوات والصراعات داخل النصوص.
بشكل عام، النقد الثقافي هو نهج سياسي ديناميكي يدرس الثقافة كمجموعة معقدة ومتطورة من الممارسات المرتبطة بالسلطة والمجتمع، ويهدف إلى توسيع فهمنا لماهية الثقافة ومن يخدمها.
فالنقد الثقافي، كما يقدمه “ستيفان كوليني”، هو ممارسة فكرية ليست مجرد نقد للثقافة نفسها، بل هو استخدام للثقافة – وخاصة الأنشطة الفنية والفكرية – كعدسة لفحص ونقد المجتمع أو الخطاب العام السائد.
يركز النقد الثقافي على الثقافة بمعناها الأساسي، أي “الأنشطة الفنية والفكرية”، وهو تعريف يُعد الأولي والأكثر شيوعًا، لكنه ليس الوحيد.
غموض مفهوم “الثقافة”:
مصطلح الثقافة معقد ومثار جدل، وله معانٍ مختلفة في سياقات متعددة، مما يجعل من الصعب الوصول لتعريف واضح ومستقر.
تفسيران متنافسان للثقافة:
الثقافة كمجموعة من القيم الإيجابية:
هنا الثقافة تُعد مكانًا لتجمع القيم الحسنة، تقف في مواجهة “عدم الثقافة” أو الفوضى. هذه الفكرة تفترض وجود “ذات مثالية” تتحدث باسم المصلحة العامة. “كوليني” يرى هذه الفكرة قديمة وغير جذابة.
الثقافة كتكوين تاريخي محدِد للقيم والممارسات الاجتماعية:
هذا المفهوم، المرتبط بــ”أرنولد ويليامز” والدراسات الثقافية، يرى الثقافة كجزء من العلاقات الاجتماعية للمعاني، ويشمل الثقافة “الراقية” (الأدب والفلسفة) إلى جانب الثقافة الشعبية، دون خلطهما أو تبسيطهما.
رغم أن النقد الثقافي يتسم بالبعد والتأمل، إلا أن هذه المسافة ليست محايدة أو موضوعية بالكامل. فالنقاد المختلفون قد يكون لديهم توجهات سياسية متباينة (مثل توجه “إليوت” المحافظ مقابل توجه “هوجارت” الأكثر تقدمًا). هذا يعني أن النقد الثقافي، حتى في أفضل حالاته، لا يضمن وجود أجندة سياسية موحدة.
العلاقة بين الأدب والمجتمع:
الأدب والثقافة قد يعكسان الأيديولوجيات السائدة في زمنهما، لكنهما أيضًا قد يقدمان نقدًا أو رؤًى بديلة. هذه العلاقة معقدة ومتضاربة أحيانًا، فبعض الروايات الحديثة تطرح المسألة الاجتماعية بشدة وتنتقدها أو تعرض مكامن القصور فيها أو تصور الأزمة الحاصلة داخلها مع إبراز التناقضات الخطيرة في شكل شخصيات مرسومة بعناية ولكنها مع ذلك قد تظهر مقدارًا لا بأس به من جدوى الثقافة وكونها ذات أهمية في حياتنا اليومية، إننا في كثير من الأوقات نجعل الثقافة بمفهومها الواسع التي تشمل الأفلام والروايات البوليسية والإعلانات التجارية كمهدئات أو مكيفات أو مكملات لنقص نشعر به في حياتنا المليئة بالأخطاء، إننا في كثير من الأوقات نهرب من واقعنا المر إلى عالم آخر نحس فيه بوجودنا المطحون أو المطموس في عالم لا يرحم.
النقد الثقافي مقابل التاريخ أو النظرية:
يؤكد “كوليني” أن النقد الثقافي يختلف عن الدراسات التاريخية أو النظرية التي تدرس الثقافة، فهو نشاط فكري يُركز على الثقافة كأداة لفهم المجتمع والخطاب العام بطريقة نقدية.
النقد الثقافي هو نقد متأمل، ذو طموح سياسي معتدل، يستخدم الثقافة (الفنون، الأدب، الأنشطة الفكرية) كأداة لفهم المجتمع ونقد الخطاب العام السائد.
عندما تفكر في كلمة “الثقافة”، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ هل هي الأوبرا أو الباليه؟ أو ربما عرض لسيمفونية موزارت؟ هل تصور عبارة “حدث ثقافي” شابًا يرتدي الملابس الرياضية أو الكاجوال أم أشخاصًا في الستينيات من عمرهم يرتدون ملابس رسمية؟ معظم الناس عندما يسمعون كلمة “ثقافة” يتجهون فورًا إلى ما يُسمى “الثقافة الرفيعة”. لذلك، عندما يسمعون لأول مرة عن النقد الثقافي، يفترضون أنه سيكون أكثر رسمية، وربما “راقي” في موضوعه وأسلوبه.
لكن الحقيقة بعيدة تمامًا عن هذا التصور. أحد أهداف النقد الثقافي هو معارضة الفكرة التي تضع “الثقافة” بحرف كبير كمرادف فقط لـ”الثقافة الرفيعة”. النقاد الثقافيون يريدون أن يمتد مفهوم الثقافة ليشمل الثقافة الشعبية، ليس فقط الكلاسيكيات المعروفة. يسعون لتفكيك الحدود بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية، وكسر التسلسل الهرمي الذي تفرضه هذه الفروق. كما يحاولون كشف الأسباب السياسية غالبًا وراء تقدير بعض المنتجات الثقافية على حساب أخرى.
على سبيل المثال، قد يكتب ناقد ثقافي عن عمل كلاسيكي مُقدَّر وقد يراه في ضوء أشكال قراءة شائعة أخرى؛ وقد أشار بعض النقاد الثقافيين إلى أن مسرحية تاريخية لشكسبير ربما كانت في الأصل عملًا شعبيًّا يحبه العمال، ثم أصبحت لاحقًا “ثقافة رفيعة” تُقدرها النخبة المثقفة فقط، ثم عادت وشهدت شعبية جديدة بسبب نسخة فيلمية أنتجت أثناء الحرب العالمية الثانية وصُنفت كتصريح وطني عن عظمة إنجلترا في زمن الحرب.
في مواجهة التعريفات القديمة لماهية الثقافة، فإن النقاد الثقافيين غالبًا ما يتحدون أيضًا التعريفات القديمة لما يشكل “الكانون الأدبي”- أي قائمة الكتب التي يُعتقد أن كل شخص مثقف يجب أن يعرفها- لكنهم لا يفعلون ذلك بإضافة المزيد من الكتب أو الأفلام إلى هذه القائمة القديمة، ولا باستبدالها بقائمة “كانون مضاد”. بدلاً من ذلك، يشككون في فكرة وجود “كانون” ثابت في الأصل. هم يسعون لأن يبعدونا عن التفكير بأن هناك أعمالًا معينة هي الأفضل دائمًا والأمثل لتمثيل ثقافة معينة. يفضلون أن يكون نقدهم أكثر وصفًا وربطًا بين المنتجات الثقافية وسياقاتها بدلاً من تقييمها وترتيبها.
من هنا، لا يفاجئ أن نجد أن نقادًا ثقافيين بارزين كتبوا أن “دراسات الثقافة يجب أن تتخلى عن هدف إتاحة الوصول إلى ما يُمثل ثقافة ما”. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعرض الأعمال في سياق أعمال أخرى، أو ضمن سياقات اقتصادية واجتماعية أوسع (مثل قضايا حقوق المرأة، أو الطبقات المطحونة أو الأقليات وغيرها) التي تساعد على فهم العمل. والأهم من ذلك، أن النقد الثقافي يجب أن يعارض فكرة أن الثقافة هي كيان متكامل وثابت تم تكوينه بالفعل. الثقافة في الواقع هي مجموعة من الثقافات التفاعلية، الحية والمتطورة، ويجب أن يكون النقاد الثقافيون متطلعين إلى الحاضر والمستقبل. يجب أن يكونوا “مثقفين مقاومين”، ويجب أن تكون دراسات الثقافة مشروعًا تحرريًا.
ولكن، كما حذر الناقد ” ريتشارد جونسون”، يجب أن يسعى النقاد الثقافيون للحفاظ على النقد الثقافي بعيدًا عن التحول إلى تخصص جامعي جامد قائم على “قوائم” صارمة للأعمال المقبولة، لأن هذا يخلق بدوره أشكالًا من “الأرثوذكسية”.
وهذه ملاحظة هامة جدًا فالأرثوذكسية مصطلح ديني لا يشك فيه أحد ولكنه كمفهوم يتمدد في كثير من مجالات الحياة وأنواعها المختلفة فقد تجد الأديب الأرثوذكسي لا على أنه متدين ولكنه يحمل في داخله جينات دوغمائية وقد تجد الأب الأرثوذكسي أو الزوجة الـأرثوذكسية كل هذا ليس على معن ديني ولكنه من حيثية الحدة الفكرية والإقصائية في رفض الآخر في تحيز وانكفاء نحو الذات وهذا ما يجعلنا نحتاج إلى إذابة الفواصل الجامدة وفتح الحدود بين المكونات المختلفة لنخلق وعيًا وثقافة أكثر انفتاحًا وإنسانية عالية.
وهنا يأتي السؤال: من الأولى أو من الأجدر؟ أو من الأحق بالتواجد؟ الأدب الرفيع ( الجاد ) ( العالي )؟ أو الأدب الشعبي؟ ، الحقيقة التي لا مفر منها أن الابتعاد عن الدين أو إقصاء الفترة المدرسية وظهور الحقبة الصناعية خلق مجالًا واسعًا ومكانًا للأدب الشعبي عندما أصبح هناك الإنسان العملي المنتج الذي لا وقت لديه لقراءة النصوص العميقة وإذا نظرت للحياة وحركاتها اليومية الدائبة المتسارعة وانتشار محلات الوجبات السريعة أو ما يعرف بوجبات الهمبرجر فأنت تستطيع أن توسع النظر ودائرة المقارنة لترى أن المجتمع أصبح مستهلك للثقافة السريعة الجاهزة التي لا تحتاج إلى كلفة أثناء قراءتها فهذا الزمن المتسارع فرض قوالب جديدة وفتح المجال أمام نصوص شعبية لا تتسم بالجدية التي لم يعد يتقبلها هذا الزمان أو ما يعرف بما بعد الحداثة وهو ما أدى إلى شيوع الثقافة العامية لأن هناك ارتباط حقيقي بين امتداد النصوص الدينية في الناس وبين الأدب العالي وهذا الصراع هو امتداد لصراع الطبقات وتولد طبقات جديدة في المجتمع بين الطبقة البرجوازية (ملاك وسائل الإنتاج) وطبقة الأرستقراطيين (النبلاء)، هذا بالمثل تجده في الأدب حيث الصراع نفسه بين الأدب الشعبي الذي يتمثل في الأفلام والروايات البوليسية وبين الأدب الراقي (العالي) كل هذا حدث في التحولات الاجتماعية الكبيرة وهو جزء من العدمية التي ذكرناها وتسير نحوها المجتمعات وذلك بوجود أيدلوجية أخرى تسيطر على المفاهيم وتحدد الرغبات وتقيم الأشياء ولكنها أيدلوجيةٌ عدميَّةٌ ضارة بالمجتمعات كنتيجة حتمية لهذه الأفكار التي تولدت مع العلمانية والحداثة وما بعدها، مع أن العدم شيء ممارس في حياتنا وواقعنا بصور مختلفة، ويترقى إلى درجات أكثر كثافة ووضوحاً، ولو عدنا إلى “هايدجر” و”نيتشه” فسنجد شيئا مثيرًا بخصوص ربط “هايدجر” للتكنولوجيا بالميتافيزيقيا وتشابكهما تماماً في نظره؛ فلأن التنوير في نظره
قام مقام الميتافيزيقيا في قضية السيطرة على الوجود والكائنات فماهي فلسفة الميتافيزيقيا؟ إنها عبارة عن وضع تفسيرات معينة للحياة، ونمط معين للتفكير يتحرك من خلالها جميع الكائنات، حل محلها الميتافيزيقيا الحديثة (التنوير| الحداثة)، وأعظم أدواتها هي الآلة والتكنولوجيا التي تتطابق معها وتعمل على التحكم بكل شيء بل وتفسده في أحيان كثيرة.
وبالنظر لمحاضرات “هايدجر” عن “نيتشه” والعدمية فقد قدم بين عام 1935-1945 أعمق التأملات حول العدمية والحداثة وكانت ميزته أنه مقابل كم هائل من التفسيرات الخاطئة لــ”نيتشه”؛ فتح نافذة للتفكير من جديد لقد لاحظ أن مناقشة “نيتشه” للعدمية في جزء كبير منه كحركة مضاد للميتافيزيقيا؛ لكن “هايدجر” يركز على محاولة تجاوز العدمية وأنها الخطوة الكلاسيكية للعدمية هذا ما يصر عليه مرارًا وتكرارًا؛ ذلك أننا نفهم نوعين من العدمية يفهمها “نيتشه” الأول: الدمار والإبادة والانحلال التام والثاني: هو العدمية الكلاسيكية باعتبارها شرطًا للتقييم الجديد، وهو ما يعرف بالعدمية الكاملة وهي المرحلة أو النهاية التي يتم فيها إعادة تقييم كل القيم وإذا تحققت العدمية الكاملة؛ فإنه بالإمكان التخلي عنها وإيجاد تصنيفات جديدة للقيم والتقدير. ويمكننا في النهاية أن نقول إن “هايدجر” في دراسته المطولة لــ “نيتشه” التي امتدت من منتصف الثلاثينيات إلى أوائل الخمسينيات؛ اعتبر مواقف نيتشه هي النتيجة الحتمية للميتافيزيقا الحديثة وأن الرجل الأعلى أو الرجل الأخير تم الاستيلاء عليهما من قبلها في توجهها نحو الذاتية والعولمة في طريقها للعدمية.
خالد الغيلاني
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.