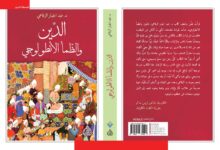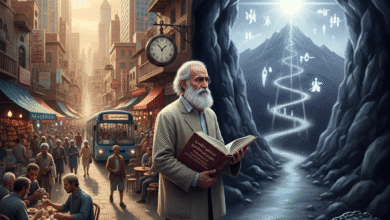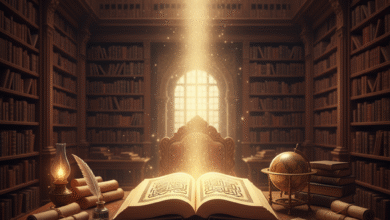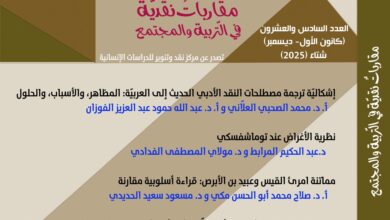صدر العدد الثالث عشر من مجلَّة “علم المبدأ”، وهي فصليَّة علميَّة محكَّمة تُعنى بمعارف الميتافيزيقا والحكمة الإلهيَّة، وجاء محوره تحت عنوان “الحقانيَّة … الحقيقة في عين كونها واقعًا مشهودًا”.
شارك في العدد مفكِّرون وباحثون وأكاديميّون من العالمين العربيِّ والإسلاميِّ، والعالم، وقد اتَّسمت أبحاثهم بالعمق، وقدَّمت طروحات ناقدة وجادَّة، وفي ما يلي موجزات عن مضامين هذه الأبحاث:
في “المفتتح”:
نقرأ لرئيس التحرير محمود حيدر مقالةً بعنوان “حقَّانيَّة المثنَّى كمبدأ أنطولوجيّ”، رأى فيها أنَّه “لدى الكلام على حقَّانيَّة الموجود الأوَّل يرتسم أفقٌ للتعرُّف على مشكل أنطولوجيٍّ مديد أفضى إلى اعتلالات تكوينيَّة عميقة في عالم الميتافيزيقا”، موضحًا أنَّ مسعاه هذا ابتُني على حقيقة وجود موجود بدئيٍّ منه كانت الموجودات كلُّها، ولكون هذا الموجود البدئيِّ هو الكائن الفريد الذي يجمع خاصّيَّتيْ الفرادة والتركيب في آن، ارتأينا نعتَه بالمثنَّى، ومتى أدركنا أنَّ الحقَّانيَّة هي الحقيقة في عين كونها واقعًا شاهدًا ومشهودًا عليه، كان السبيل إلى إدراك ماهيَّة المبدأ المنعوت بالمثنَّى.
في باب “المحور”:
جملةٌ من الأبحاث والدراسات المعمَّقة، يمكن إيجازها على الشكل التالي:
– كتب عبد الله محمد الفلاحي، أستاذ الفلسفة الإسلاميّة في جامعة “إب” باليمن، عن “الحقيقة والحقائق المنسيَّة في الحضارة الإنسانيَّة المعاصرة ( العدالة تمثيلًا)”، فاعتبر أنَّ ثمة مشكلة تتمثَّل بالتراجع والتغييب الممنهَج للحقائق المنسيَّة في الحضارة الإنسانيَّة المعاصرة، كالقيم الروحيَّة والأخلاقيَّة، فضلًا عن قيم أخرى، كالحريَّة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والعدالة في منظومتَي الفكر الدينيِّ والفلسفيِّ المثاليِّ.
– “الحقيقة الموضوعيَّة بمنظورَيْ العلم والدين النسبانيّة والواقعانيَّة في الأدب الغربيّ الحديث”، هو عنوان البحث الذي وضعه الباحث البريطانيُّ وأستاذ الفلسفة بجامعة “أوكسفورد” جون تايلور، حاول فيه الإجابة على الأسئلة المطروحة حول التفسيرات الواقعيَّة والنسبويَّة للعلم، وناقش مبرِّرات الاعتراض على الموقف النسبويِّ القائل بأنَّه لا يمكن فهم طبيعة الخلاف حول المعتقد الدينيِّ إلَّا من خلال فهم الحقيقة الموضوعيَّة، وهو ما يفتح الطريق أمام تفسيرٍ واقعيٍّ لهذا الجانب من الدين.
– عميد كليَّة الأديان بجامعة “المعارف” في لبنان، فادي ناصر كتب تحت عنوان “الحقُّ والحقيقة من منظور فلسفيٍّ عرفانيّ/ نقد الرؤية ومعاثرها”، فأشار إلى التراجع الكبير على مستوى التنظير المعرفيِّ الإنسانيِّ لناحية تقديم رؤى نظريَّة صحيحة وأصيلة حول «الإنسان الكامل»، والاكتفاء بنظريَّة «الإنسان حيوان ناطق»، وكذلك عدم قدرة الدراسات المعاصرة في العلوم الإنسانيَّة وما يتفرَّع منها كإجراء دراسات معمَّقة ومركَّزة حول العقل والنفس والرُّوح الإنسانيَّة. كما أشار إلى العجز عن تقديم الحلول المعرفيَّة الواقعيَّة لعلم «معرفة الإنسان»، ولعلم «الاجتماع الإنسانيّ».
– تحت عنوان “عدم تماميَّة تفسير هايدغر للحقيقة الأفلاطونيَّة”، يكتب كلٌّ من أستاذ الفلسفة بجامعة “أصفهان” في إيران سعيد بينائي مطلق، والباحث في دراسات الدكتوراه سيّد مجيد كمالي، حول نقد تفسير هايدغر لأفلاطون، فاعتبرا أنَّ نمط مواجهة وفهم هايدغر وأفلاطون في مسألة الوجود في النسبة إلى الزمان يختلفان بعضهما عن بعض اختلافًا جوهريًّا، وهذا الاختلاف انعكس على أُسلوب هايدغر في التفسير.
– في باب “المحور ” أيضًا، قدَّم المفكِّر والباحث المغربي ادريس هاني استقراءً نقديًّا حول “متاهة الحقيقة في النَّسَقَ الأخلاقيِّ الكانطيّ”، رأى فيه أنَّ الكانطيَّة أنجزت ثورةً كبرى في تاريخ الفلسفة الحديث، لكنَّه لفت إلى رأي آخر معارض يرى في المحاولة الكانطيَّة محضَ مسامحةٍ تحجب تسليمًا مضمرًا بكلِّ الأُسُس الميتافيزيقيَّة والَّلاهوتيَّة التي ناضل صاحب سؤال الأنوار وناقد العقل المحض في سبيل تقويضها.
– الباحثة الأميركيَّة في الفكر الفلسفيِّ والرئيسة السابقة لقسم الفلسفة في جامعة “أفلاسفو”، إيفا شابر قدَّمت بحثًا عنوانه “حقيقة الشيء في ذاته كظاهرة متخيّلة / كانط متوهِّمًا”، حيث رأت أنَّه يستحيل الاستغناء عن الكثير من الصور المتخيّلة باعتبارها أدوات منهجيَّة للفهم. فهذه الصور تلقى قبولًا في المنهجيَّتين الفلسفيَّة والعلميَّة.
– “ما الحقيقة المحمَّديَّة..؟ / مفهومها، ومعناها، ومقاصدها في العرفان الإسلاميّ”، بحث يقدِّمه الباحث والأكاديميُّ اللبنانيُّ أحمد ماجد، وفيه يسعى لتبيين مفهوم الحقيقة المحمَّديَّة، وكيفيَّة تطوُّره في السياق العلميِّ والتاريخيِّ للتصوُّف والعرفان الإسلاميّ.
– بدوره، كتب الباحث في التصوُّف والمعارف الإلهيَّة في سوريا محمد أحمد علي عن “العلم كتجلٍّ للحقيقة المحمَّدية”، وقد عمل فيه على تأصيل المفهوم ومكانته في العلوم والمعارف الإلهيَّة، عبر إجراء معاينة إجماليَّة لمجموعة من مصادر المعرفة في هذا الحقل.
– أستاذ فلسفة الدين في جامعة بغداد بالعراق إحسان علي الحيدري، قدَّم بحثًا عنوانه “النسبيَّة والحقيقة في فهم تجلّيات الحقّ/ دراسة مقارنة بين الفلسفة الغربيَّة والفكر الإسلاميّ”، أجرى فيه تحليلًا نقديًّا معمّقًا ومقارنًا لمفهوم «الحقيقة» بين الفكر الغربيِّ الحديث وما بعد الحداثة من جهة، والمنظور الإسلاميِّ من جهة أخرى. وهدف إلى تفكيك الأسُس الفلسفيَّة للنسبيَّة التي أصبحت شائعة في الخطاب المعاصر، وبيان تناقضاتها، وفي المقابل، بناء وتأصيل مفهوم الحقيقة في المنظومة المعرفيَّة الإسلاميَّة كبديل متماسك وقويم.
– أمَّا الصادق الفقيه، المفكِّر السودانيّ والأمين العام لمنتدى الفكر العربيّ في الأردن، فكان له بحث بعنوان “شرعيّةُ الفكر وحقيقته”، أضاء فيه على كيفيَّة تشكُّل الحقائق الأخلاقيَّة في عمليَّات التفكير من خلال النَّظر في الأدبيَّات والأفكار والمعارف، وبما يشتبك في المساحات الرماديَّة بين “الخير” و”الشرّ” حول الحقيقة.
في باب “حقول التنظير”:
– نقرأ للفيلسوف والعارف والمرجع الدينيِّ المعاصر عبدالله جوادي آملي، بحثًّا عن “المنشأ الأنطولوجيّ لمبدأيْ الحقِّ والتكليف”، تمحور حول معرفة الأصل الذي نشأت منه مباني الحقِّ والتكليف لدى علماء الإسلام، وكذلك لدى المفكِّرين غير الدينيين في العالم الغربيّ. كما رأى أنَّ المباني العقديَّة الناشئة من العقل والوحي والنصوص الدينيَّة، لا تتساوى مع العقيدة الناشئة من التجربة والعقل الأداتيِّ.
– ثمَّة بحثٌ آخر في هذا الباب للفيلسوف الأميركي الراحل والتر ستيس، حمل عنوان “الحقيقة الدينيَّة ومشكلة فهمها”. وقد سلَّط الضوء على قضيَّة شكَّلت محور سجال عميق في مجتمعات الحداثة خلال القرن العشرين المنصرم، هي قضيَّة التناظر المعقَّد بين الحقيقة الدينيَّة ومسلَّمات العقل الحديث. فهو يرى أنَّ ثمَّة نظرتين متناقضتين بَدَتَا للعالم في الأزمنة الحديثة: النظرة العلميَّة أو الطبيعيَّة للعالم، والنظرة الدينيَّة. رائياً أنَّ ماهيَّة الثقافة الحديثة تكمن في الصراع بين هاتين النظريَّتين.