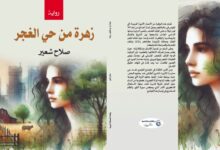قصيدة ابن العرندس: من دمعة إلى وثيقة روحانية
تحليل معمق لقصيدة أيقونية ربطت مأساة كربلاء بانتظار الظهور المهدوي

تتجلى عظمة الشعر عندما يتحول من مجرد كلمات إلى لغة حية للوجدان الجمعي. هكذا كانت قصيدة ابن العرندس، التي لم تبقَ حبيسة الدواوين، بل انطلقت لتصبح أيقونة في الأدب الحسيني. هذه القصيدة، التي يكاد لا يخلو منها مجلس عزاء، لم تكن مجرد رثاء، بل كانت جسرًا يربط التاريخ بالرمز، والألم بالغيب، حتى باتت تُتداول بوصفها نداءً روحانيًا يتجاوز الزمان. فما السرّ الكامن وراء هذه الأبيات؟ وكيف استطاعت أن تحفر مكانتها في الذاكرة الشيعية لتصبح منارة للانتظار؟
ابن العرندس: شاعر الحلة وحاضرة الوجع
هو جمال الدين، أبو الوفاء، محمد بن عبد الصمد الحلّي (ت 840هـ تقريبًا)، المعروف بـ ابن العرندس. وُلد في الحلة، التي كانت في عصره مركزًا أدبيًا وعلميًا مزدهرًا، وقد أثّر هذا المحيط الفكري في تكوينه، فجمع بين الفقه والأدب، وأصبح أحد أبرز شعراء القرن الثامن الهجري. تُروى قصة شهيرة عنه تقول إنه تعرّض للسلب في طريق عودته من زيارة كربلاء. هذه الرواية، وإن كانت تُتداول في المخيال الشعبي، إلا أنها ترمز إلى حالة من الضياع والتجريد دفعت الشاعر إلى الاستغاثة بأبي عبد الله الحسين (عليه السلام). من رحم هذه المعاناة، وُلدت القصيدة، لتكون صرخة استغاثة تجاوزت حدود السلب المادي إلى سلب روحي ومعنوي، وهو ما يفسر عمقها وتأثيرها.
القصيدة: تأويلٌ قرآني ونبضٌ عقائدي
تتجاوز القصيدة في بنيتها الرثاء المباشر لتُفعّل التأويل الباطني للقرآن الكريم. فالشاعر لا يكتفي بذكر مصيبة الحسين، بل يربطها بالرموز المقدسة. في بيته الشهير: “هُمُ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ وَالشَّفْعُ وَالْوِتْرُ”. يُوظّف الشاعر هنا لغة القرآن، حيث تُفسّر هذه الرموز في التراث الشيعي بأنها إشارات إلى النبوة والإمامة. التين والزيتون هما النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام علي (عليه السلام)، والشفع هما الحسن والحسين (عليهما السلام)، أما الوتر فهو الإمام المهدي (عجل الله فرجه)، الذي سيثأر لمظلومية جده. هذا التأويل يرسخ عقيدة الإمامة والانتظار، ويجعل من واقعة كربلاء حلقة وصل بين الماضي المأساوي والمستقبل الموعود.
الفن والبلاغة: قصيدة تناهض الزمن
من الناحية الفنية، تتسم القصيدة ببنية متماسكة على بحر الكامل، وروي بالراء المضمومة، وهو ما يمنحها إيقاعًا قويًا مهيبًا يتناسب مع موضوعها. لكن جمالها الحقيقي يكمن في بلاغتها التي وظفت الطباق، والجناس، والاستعارات القرآنية.
على سبيل المثال، في قوله: “أيُقْتَلُ ظَمْآنًا حُسَيْنٌ بِكَرْبَلا… وَفِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَنَامِلِهِ بَحْرُ”. يستخدم الشاعر هنا طباقًا بين “الظمأ” و”البحر”، وهو تناقض يزيد من وقع الفاجعة. أما في بيت آخر، فيقول: “فَمَا لِلسَّمَاءِ دُخَانٌ وَلَا لَهَا كَدَرُ… وَلَا لِلْأَرْضِ قَسَمٌ وَلَا لَهَا قَدَرُ”. يستخدم هنا الجناس الناقص بين “كَدَرُ” (التعكير أو الضياع) و”قَدَرُ” (المصير أو الحتمية)، ليعبّر عن الحزن الكوني الذي لم تره السماء والأرض، وهو ما يرفع القصيدة من مجرد رثاء إلى تصوير لفاجعة كونية.
القصيدة: بين العقيدة والوجدان
تعد القصيدة مرآة تعكس العلاقة المعقدة بين العاطفة والعقيدة في الفكر الشيعي. فهي خطاب وجداني يلامس روح المتلقي. إنّ نداءاتها للإمام المهدي، التي تتخلل أبياتها، تجعل منها وثيقة إيمانية تتجاوز الإطار الشعري، وتتحول إلى صلاة استغاثة وتوسل. هذا البُعد الصوفي في النص هو ما جعل الخطباء يحفظونها، لأنها تستنهض في القلوب الشوق للظهور، وتزرع الأمل بالثأر والعدل.
قصة الشيخ الكعبي: من البحث إلى الرمز
أشهر ما زاد القصيدة بريقًا هو ارتباطها بالخطيب الحسيني العراقي الشيخ عبد الزهرة الكعبي (1900–1974م). في بداية مسيرته الخطابية، كان الشيخ يسعى بشغف للحصول على قصيدة ابن العرندس، لما لها من تأثير عاطفي وروحي عميق في مجالس العزاء. يُروى أنّه توسل بالإمام الحسين (عليه السلام) مباشرة ليُوفَّق في العثور على نسخة من هذه القصيدة النادرة. وبينما كان الشيخ في خلوة صامتة أمام الحسين عليه السلام، إذ به يسمع صوت الحاج عبد الله الكتبي يناديه، حاملًا مجموعة من الكتب الجديدة. وعندما فتح الشيخ أحد الكتب، فوجئ بما لم يكن يتصور: قصيدة ابن العرندس التي طالما بحث عنها. طلب الشيخ شراء الكتاب، فأجابه الحاج عبد الله أن ثمنه هو أن يقرأ القصيدة بصوت مرتفع في الحال. بدأ الشيخ عبد الزهرة الكعبي بالقراءة، وعندما وصل إلى البيت: “أَيُقْتَلُ ظَمْآنًا حُسَيْنٌ بِكَرْبَلا…وَفِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَنَامِلِهِ بَحْرُ”. دخل رجل مهيب، ذو هيبة ونورانية، وعندما وصل إلى هذا البيت، وقف وتوجه إلى ضريح الإمام الحسين (عليه السلام) وكرر ثلاث مرات: “أيُقْتَلُ… أيُقْتَلُ… أيُقْتَلُ”. ثم اختفى فجأة، وبحث الشيخ والحاج عبد الله عنه فلم يجداه. هذه الحادثة جعلت الشيخ يعتقد أن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) كان حاضرًا في المجلس، وأضفت على القصيدة بعدًا روحانيًا عميقًا، من مجرد مرثية إلى نص يضمن حضور الإمام في المجالس الحسينية، مما أكسبها بعدًا أسطوريًا وروحانيًا فريدًا، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من تراثه الخطابي.
مكانة القصيدة بين العلماء
لم تقتصر مكانة القصيدة على العامة، بل حظيت بإشادة كبيرة من كبار العلماء والباحثين. فقد نقل الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه “الغدير” إعجابه الشديد بها، وذكرها الشيخ محمد مهدي المازندراني في “شجرة طوبى”، معتبرًا إياها من ذخائر الأدب الحسيني. هذه الإشادات لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كانت توثيقًا لمكانة القصيدة، واعترافًا بأنها ليست مجرد شعر، بل جزء من الأدب المرجعي الذي يجمع بين الفصاحة والاعتقاد.
الخاتمة: إرثٌ لا يزول وذاكرة حية
إن قصيدة ابن العرندس هي وثيقة تجمع بين الرثاء والرمز القرآني والعقيدة المهدوية. حضورها في المجالس الحسينية، وتداولها في التسجيلات الصوتية، وحفظها في كتب التراث، كلها شواهد على أن الشعر يمكن أن يتحول إلى ذاكرة حية ونبض لا يفنى. لقد استطاعت القصيدة أن تجعل من مأساة الحسين جسرًا نحو أمل الظهور، وتحولت إلى نداء يتردد في المجالس، بين العاطفة والاعتقاد، بين الدمعة والانتظار. وربما آن الأوان أن تُدرَس هذه القصيدة دراسة منهجية تكشف أسرار بلاغتها وعمقها، وتُظهر كيف يمكن للنص أن يظل خالدًا على مر العصور.
عبدالعزيز آل زايد
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.