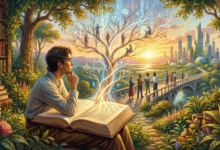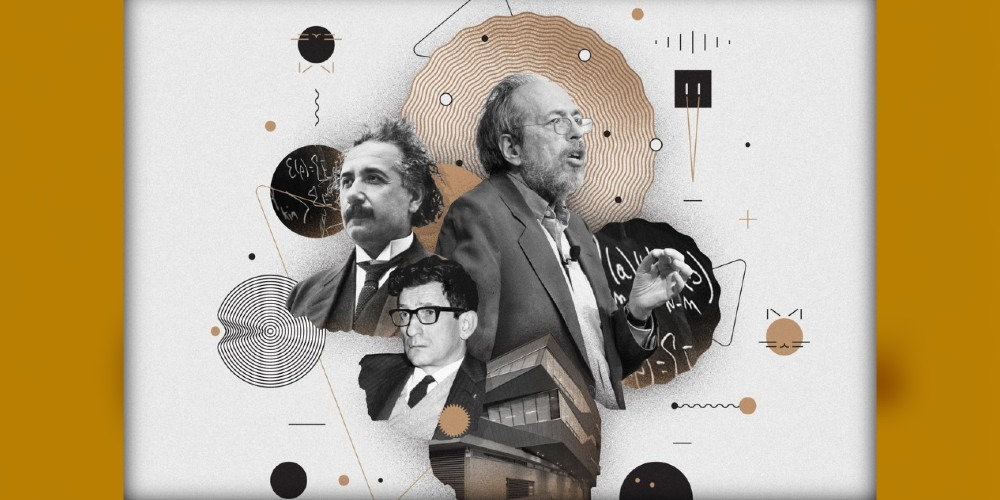الحركة وعلم الهندسة

تقديم
يكتسي موضوع الحركة (The Movement) في تاريخ الفكر الفلسفي-العلمي أهمية كبرى. ذلك، أنه موضوع قديم قدم التفكير الفلسفي-العلمي نفسه، إذ كانت أول نظرية علمية قدمت أهم تفسير لظاهرة سقوط الأجسام (Les Chutes des corps) في الفكر الفلسفي -العلمي القديم مع الفيلسوف اليوناني «أرسطو»[1]، غير أن التحولات العلمية للعصر الأوروبي الحديث ستجعل من هذا الموضوع علما قائما بذاته. لذلك، يقول العالم الإيطالي «غاليلي غاليليو» في كتابه «حوارات وبراهين رياضية حول علمين جديدين» ما يلي: «إننا نقدم علما جديدا بإطلاق، لموضوع مغرق في القدم، ولا يوجد شيء أقدم منه، إنه موضوع الحركة، والمتون التي خصصها الفلاسفة له، ليست صغيرة، لا من حيث العدد، ولا من حيث الحجم.»[2]. مما يتضح، أننا أمام علم جديد يختص بدراسة الحركة الثاوية في العالم-الوجود. وإذا كان الأمر كذلك، فما الجدوى من جعل موضوع في تاريخ الفكر الفلسفي-العلمي علما قائما بذاته؟ بل ما الأسس التي أدت إلى جعل موضوع الحركة علما له أسس ومقومات؟ وما علاقته بعلم الهندسة؟
——————————–
يمكن القول، في هذا الصدد، أن بداية العلم الحديث (فلكيا) كانت مع العالم البولوني «نيكولا كوبيرنيك»، انطلاقا من افتراضه لمركزية الشمس عوض الأرض[3]، كحل لمشكلة تحير الكواكب، الأمر الذي أدى إلى توحيد العوالم الأرسطية في عالم واحد له وحدة في مكوناته وقوانينه الأساسية التي ليس فيها تفاضل أو تراتبية في الوجود[4]. لكن، إذا كانت الثورة الكوبيرنيكية قد أدت إلى تداعي الكسمولوجية الأرسطية في حلتها السكولائية القائمة على ثنائية العالم، ومركزية الأرض والإنسان، وهيمنة الموضوع واستقلال الذات، مع ما يترتب عن ذلك في الحياة الاجتماعية والسياسية[5]، فإنها ثورة لم تلامس أحد الجوانب التي لها علاقة وطيدة بالكسمولوجية الأرسطية؛ أعني بذلك أنها لم تؤْثر نفسها على تغيير الأسس الفيزيائية للعالم. فالكسمولوجية والفيزياء في فلسفة «أرسطو» لهما ارتباط وثيق، من حيث إن الأسس الفيزيائية للعالم ما تحت القمر، تقوم على الأسس الكسمولوجية لعالم ما فوق القمر. بمعنى آخر، إذا كانت الحركة في عالم ما فوق القمر تتصف بالكمال والأزلية، فإن الحركة في عالم ما تحت القمر حركة طبيعية دائمة النمو والتطور سعيا نحو غاية هي الكمال، الأمر الذي يفيد أن هناك علاقة تشبيه واحتواء للأسس الكسمولوجية في مجال الفيزياء.
لهذا، إن الذي سيعطي لنظرية مركزية الشمس الكوبيرنيكية سندا أنطولوجيا يجعلها في حالة قطيعة مع الفهم القديم للعالم-الوجود، ليس سوى العالم الإيطالي «غاليلي غاليليو». فهذا الأخير كان له الفضل في تأسيس منظومة فكرية لمجال فلسفة الطبيعة، تنأى عن المبادئ التي كان يقوم عليها المجال نفسه في الفلسفة الأرسطية، لكن، حينما نعتبر «غاليلي» صاحب السند الأنطولوجي للنظرية الفلكية الكوبيرنيكية، فذلك يفيد أن «غاليلي» قد ذهب بالثورة الكوبيرنيكية إلى مداها الأقصى؛ أي تغيير المنظومة المعرفية للفيزياء الأرسطية التي لم يعد لها القابلية للتماشي مع الكسمولوجية الحديثة. لقد اكتفى كوبيرنيك بتقديم عناصر فلكية جديدة سمحت بتداعي الكسمولوجية الأرسطية في حلتها السكولائية، بينما «غاليلي» قد قدم الدعم الأنطولوجي لهذه العناصر، حتى تكتمل النظرية في بعديها الفلكي والفيزيائي.
يعتبر أرسطو في كتابه الطبيعة أن «من شأن كل محسوس أينا (مكان/محل)، ولكل واحد مكان ما.»[6]. مما يعني أن لكل جسم محسوس مكانا طبيعيا يحتويه في الفيزياء الأرسطية. وما دامت المنظومة الفكرية والمعرفية الأرسطية كانت قائمة على التفكير الذي يستند إلى المكان؛ أي فوق-تحت، تبعا لتقسيم العوالم في المنظومة الكسمولوجية، فإن حركة هذه الأجسام ستكون عمودية، لا أفقية. بمعنى آخر، إن حركة الأجسام ستأخذ طابعا مكانيا؛ أي فوق-تحت، لا بعدا زمانيا؛ أي قبل-بعد. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تحرك جسم من مكانه الطبيعي نحو مكان آخر، يجعله في حال شوق وحنين لمكانه الأصل. لذلك، يشير «أرسطو» في نظريته حول سقوط الأجسام إلى أن الذي يجعل الأجسام في حالة نزول إلى الأرض بعد رفعها إلى السماء هو الحنين والشوق إلى مكانها الطبيعي.
لكن، ما دامت الكسمولوجية الحديثة قد ساهمت في انهيار التراتبية الطبيعية للأجسام في العالم-الوجود، فإنه لم يعد لهذه الأجسام من سمات أو خصائص مرتبطة بالشوق والحنين إلى الأمكنة الطبيعية. فالعالم في المنظومة الفكرية والمعرفية الحديثة أصبح واحدا، غير متفاوت في بنيته وقوانينه، وفوضوي في أشيائه حسب تمثلاتنا، ومن ثم، في حاجة إلى إعادة بنائه نظريا، من حيث المعنى والمعقولية[7]. الأمر الذي سيؤدي إلى بروز فكرة أساسية بعد تخليص المادة من كل سمة أو خاصية طبيعية كالشوق والحنين؛ أعني فكرة عطالة المادة. فالمادة في الفيزياء الأرسطية كان تحتوي على بعض السمات والخصائص النفسية، والنفس هي الأخرى، تحمل سمات وخصائص جسمانية. فأرسطو يقول في «كتاب النفس» تبيانا لكون النفس تحمل خصائص جسمانية ما يلي: «ولنفترض مثلا أن آلة كالفأس كانت جسما طبيعيا، فإن ماهية الفأس تكون جوهرها، وتكون نفسها، لأن الجوهر إذا فارق الفأس، فلن يكون هناك فأس، إلا باشتراك الاسم. ولكن الفأس في الواقع فأس، إذ ليست النفس ماهية أو صورة جسم من هذا النوع، بل جسم طبيعي ذي صفة معينة؛ أي فيه بذاته مبدأ الحركة والكون.»[8]؛ مما يعني أن النفس جسم طبيعي يحمل مبدأ الحركة والكون في العالم. بل إن النفس كانت موضوعا فيزيائيا في الفلسفة الأرسطية، مثله مثل الحركة والتغير، لذلك، تحمل خصائص شبيهة بما يحمله الجسم؛ أي الغذاء والحس والحركة. يقول «أرسطو» في هذا الصدد ما يلي: «ولنكتف الآن بالقول إن النفس مبدأ الوظائف التي ذكرنا، والتي عرفتها في قوة التغذي، والحس، والفكر، وكذلك الحركة.»[9].
لكن، في الفيزياء الحديثة سيتم الفصل بين المادة (الجسم) والنفس (الفكر) فلسفيا، وبعد ذلك فيزيائيا. فالمادة التي كانت تحمل خصائص النفس مثل؛ الحركة، لن تعود كذلك في الفلسفة الديكارتية التي ستنظر إلى المادة كونها تحمل خاصية الامتداد فقط؛ أي أن لها طول وعرض وعمق. أما النفس فهي جوهر فكري خالص؛ بما يفيد أنها لا تحمل خصائص الجسم مثل؛ التغذي، والحركة…إلخ[10]. وإذا أصبحنا أمام فصل فلسفي بين المادة والنفس، فإن ذلك ستكون له تبعات في المجال الفيزيائي[11]، بحيث سيُنظر إلى المادة في كونها عاطلة عن الحركة، ولا تخفي بداخلها أسرارا أو كيفيات سحرية[12]، ما دامت سمة الحركة قد نُزعت منها. لذلك، يؤكد الفيلسوف الفرنسي «روني ديكارت» في سياق بيانه لفكرة كون المادة قد أصبحت عاطلة عن الحركة من تلقاء نفسها، بعد تخليصها من خصائص النفس، ما يلي: «لا توجد بالأحجار والنباتات قوة خفية ومتوارية عنا، كما لا تخفي أسرارا، كالتجاذب والتنابذ، فلا شيء يوجد بالطبيعة، إلا ويرد إلى أسباب جسمية محضة، لا دخل للأرواح أو الأفكار فيها.»[13].
وإذا أصبحنا أمام أجسام مادية عاطلة عن الحركة من تلقاء نفسها، فإن ذلك يعني أن حركتها لن تتم إلا من قبل جسم مادي آخر. بمعنى آخر، إن الجسم العاطل عن الحركة من تلقاء ذاته، لا يمكن أن يتحرك إلا إذا كان هناك جسم آخر قد دفعه للحركة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مفهوم السببية المعقولية في الفكر الفلسفي-العلمي الحديث، بحيث سنصبح أمام عالم لا يحدث فيه شيء من المظاهر والآثار، إلا إذا كانت لذلك أسباب مادية في العالم-الوجود. ولعل هذا التصور الذي ينظر لما يحدث في العالم-الوجود، كونه ناتج عن أسباب مادية، لا علاقة لها بأية قوى خفية، هو التصور الذي أطلق عليه في الفكر العلمي الأوروبي الحديث بالتصور الميكانيكي الآلي-للعالم[14]، الذي ينظر للأشياء الموجودة فيه، انطلاقا من مبدأين أساسيين؛ مبدأ المادة؛ الذي يفيد أن كل ما يوجد في العالم شيء مادي. ومبدأ الحركة[15]. الذي يقوم على مبدأ القصور الذاتي أو مبدأ العطالة (Le Principe d’inertie) بما يفيد أن الأجسام لا تمتلك نفوسا أو أرواحا تجعلها في حالة تحول من السكون إلى الحركة، أو من الحركة إلى السكون. وبمعنى أوضح، فالأجسام لا تتحرك من تلقاء نفسها، إنها عاطلة عن الحركة في العالم-الوجود، وإن تحركت في لحظة ما، أو سكنت في لحظة أخرى، فذلك مرده إلى سبب مادي مرتبط بجسم مجاور لها.
جدير بالذكر، أن اعتبار القرن السابع عشر قرن النظرة الآلية للعالم؛ أي أن التصور الميتافيزيقي للكون كان تصورا ميكانيكيا له[16]، يجعلنا أمام اعتبار أساس مفاده أن كل ما يوجد في العالم أجسام مادية، لا تتحرك من تلقاء ذاتها، بل بفعل جسم آخر. وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه؛ كيف نفهم مظاهر وآثار حركة هذه الأجسام في العالم-الوجود؟
————————————
ما دام العالم مؤلفا من مجموعة من الأجسام المادية، التي لا تتحرك من تلقاء نفسها، وإنما بواسطة جسم آخر كسبب مادي للحركة، فإن ما ينتج عن حركة الأجسام من مظاهر وآثار، لا يمكن فهمه إلا بواسطة الحساب الرياضي-الهندسي. ذلك، أن الآثار التي في إمكانها أن تتمظهر في العالم-الوجود، لن تكون سوى على شكل أشكال هندسية. فتحرك جسم من نقطة A إلى نقطة B سنكون أمام شكل هندسي يسمى مستقيما، وهكذا فيما يخص جل الحركات التي يمكن أن تتخذها الأجسام في سيرورة حركتها؛ أي أنها ستتخذ أشكالا هندسية مختلفة. لذلك، يشير «غاليلي غاليليو» في كتابه «اكتشافات وآراء غاليليو» إلى أن:
«الفلسفة [أي الفلسفة الطبيعية] مكتوبة في هذا الكتاب الكبير -أعني الكون- الذي يقف دائما مفتوحا أمام أنظارنا، لكن لا يمكن فهمه، ما لم يتعلم المرء أولا فهم اللغة وتفسير الحروف التي كتب بها. إنه مكتوب بلغة الرياضة، فحروفه المثلثات، والدوائر، والأشكال الهندسية الأخرى، التي بدونها يستحيل على الإنسان فهم كلمة واحدة؛ بل بدونها يتجول المرء في متاهة مظلمة.»[17].
وبهذا المعنى، سيصبح العالم-الكون كما لو كان كتابا مكتوب بلغة هندسية، لا يفقهه أحد ما لم يكن على دراية فصيحة بعلم الهندسة. لذلك، سيكون «غاليلي» مبدعا بحق لفكرة ترييض الطبيعة (Mathématisation de la nature) في الفكر العلمي الحديث؛ بما هي فكرة تتيح لنا إمكانية فهم الطبيعة التي تتبدى في مجموعة من الأشكال الهندسية الناجمة عن حركات الأجسام فيها، والتي لا يمكن فهمها إلا بصورنتها رياضيا. بيد أن القول بكون «غاليلي» مبدع لفكرة ترييض الطبيعة[18]، لا يفيد أنه أول من استخدم الرياضيات في فهم العالم، وإنما قولنا ذاك مبنيا على اعتبار أساس مفاده التالي؛ إذا كان «أفلاطون» -مثلا- قد أبرز أهمية الرياضيات في فهم العالم، الأمر الذي أدى إلى كتابة عريضة على واجهة أكاديمية «أفلاطون» تحمل عبارة «من لم يكن رياضيا لا يطرق بابنا»، فإن اهتمامه بها لم يكن مبنيا على الأسس نفسها التي بني عليها في التصور الفيزيائي الحديث. فإذا كان «أفلاطون» يعتبر بأن الرياضيات مدخل من مداخل فهم العالم المعقول؛ أي عالم المثل، المتجانس والمتكامل، فإن «غاليلي» ينظر للرياضيات في كونها مفتاح فهم الكون، لا العالم فقط.
———————————–
خلاصة
هكذا، إن علم الهندسة باعتباره العلم الرياضي الذي يهتم بدراسة الحركات البسيطة المتضمنة في بناء مجموعة من الأشكال الهندسية، سيكون هو العلم الوحيد الذي في مقدرته أن يساعد الدارس على الكشف عن أثارها ومظاهرها في العالم-الوجود. غير أن علم الهندسة هو العلم الذي لا يُعتمد عليه في بناء نظرية في مجال الهندسة فقط، وإنما هو العلم الذي يكون سبيلا لدراسة نتائج تأثير حركة جسم على جسم آخر في مجال الميكانيكا، وتفسير منشأ الكيفيات والأعراض الحسية التي تفرز انطلاقا من مقاومة جسم لجسم آخر في مجال فلسفة الطبيعة كذلك[19]. وبهذا المعنى، فعلم الهندسة له أهميته في بناء تصور عن المظاهر والآثار التي تنجم عن حركات الأجسام المادية في العالم-الوجود[20]. وبناء على ما سبق، يتضح أن اهتمام فلاسفة-علماء القرن السابع عشر الميلادي بعلم الهندسة، عائد إلى كونه العلم الذي في مكنته أن يساعد الدارس في فهم صورة الحركة المبتدية في العالم.
المصادر والمراجع
- أرسطوطاليس. الطبيعة. الجزء الأول. ترجمة إسحاق ابن حنين ومن معه؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمان بدوي. ط 1. (القاهرة: المركز القومي للترجمة (سلسلة ميراث الترجمة)، 2007).
- أرسطوطاليس. كتاب النفس. ترجمة أحمد فؤاد الأهواني؛ مراجعة الأب جورج شحاتة قنواتي. ط.2. (القاهرة: المركز القومي للترجمة (سلسلة ميراث الترجمة)، 2015.
- باعكريم، عبد المجيد. (2018)، تكوين مدرس الفلسفة ورهان الحداثة. موقع (https://www.couua.com)، نشر يوم 18 فبراير 2018، وقد تم الاطلاع عليه يوم 2021.06.05.
- البعزاتي، بناصر. مكانة ابن رشد في تطور الأفكار العلمي تصور الحركة. ندوة الأفق الكوني لفكر ابن رشد، دجنبر 1998، منشورات الجمعية الفلسفية المغربية، مراكش، ط.1، 2001.
- عابد الجابري، محمد. مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي. ط.1. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1976).
- كارو، فانسان. ابتكار الأنا. ترجمة عبد المجيد باعكريم. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2021).
- كانط، إيمانويل . نقد العقل المحض. تعريب موسى وهبة. ط.2. (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1987).
- كويري، ألكسندر. من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي. ترجمة يوسف بن عثمان؛ مراجعة محمد بن ساسي. ط.1. (تونس: منشورات دار سيناترا-معهد تونس للترجمة، 2017).
- لفاينرت، فريد. كوبيرنيكوس وداروين وفرويد، ثورات في تاريخ وفلسفة العلم. ترجمة أحمد شكل؛ مراجعة محمد فتحي خضر. ط.1. (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2019).
- يفوت، سالم. إبستمولوجيا العلم الحديث. ط.2. (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2008).
- يفوت، سالم. الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي. ط.1. (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1990).
- Baldin, Gregorio. Hobbes and Galileo: Method, Matter And The Science Of Motion. 1sted. (New York: Springer Publishing, 2020).
- Descartes, René. Discours de la Méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. 1eéd. (Paris: Librairie de la bibliothèque nationale, 1888).
- Galileo, Galilée. Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles. Trad. Maurice Clavelin. 1eéd. (Paris: Puf, 1995).
- Galileo, Galilée. Discoveries and Opinions of Galileo. Trans. With an introduction and notes by Stillman Drake. 1sted. (New York: Anchor Books Edition, 1957).
- Newton, Isaac. Principes Mathématiques de la philosophie naturelle. Tome I. Trad. Du Latin par Feue Madame La marquise Du Chastellet. 1eéd. (Paris: éditions Jacques Gabay, 1990).
- Peters, Richard.Hobbes. 1sted. (Londres: Penguin books, 1956).
- Tripp, Matthias. Le modèle mécanique comme paradigme épistémologique de la nature et de la pensé aux 17é et 18é siècles, in. Épistémologie et matérialisme. 1eéd. )Paris: séminaire sous la direction d’Oliver Bloch, 1986.(
[1] بناصر البعزاتي. مكانة ابن رشد في تطور الأفكار العلمية تصور الحركة. ندوة الأفق الكوني لفكر ابن رشد، دجنبر 1998، منشورات الجمعية الفلسفية المغربية، مراكش، ط.1، 2001، ص. 107.
[2] Galilée Galileo. Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles. Trad. Maurice Clavelin. 1eéd. (Paris: Puf, 1995), p. 125.
[3] من المتعارف عليه في تاريخ الفكر الفلسفي العلمي أن أول من قال بنظرية دوران الأرض، وثبات الشمس هو العالم «أرسطارخوس» الساموسي (230ق.م-310ق.م)، غير أنها نظرية لم تجد السند الرياضي والأنطولوجي، لكي تكون لها قائمة في تاريخ المعرفة العلمية. أنظر:
– فريد لفاينرت. كوبيرنيكوس وداروين وفرويد، ثورات في تاريخ وفلسفة العلم. ترجمة أحمد شكل؛ مراجعة محمد فتحي خضر. ط.1. (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2019)، ص. 15.
[4] ألكسندر كويري. من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي. ترجمة يوسف بن عثمان؛ مراجعة محمد بن ساسي. ط.1. (تونس: منشورات دار سيناترا-معهد تونس للترجمة، 2017)، ص. 44.
[5] عبد المجيد باعكريم. (2018)، تكوين مدرس الفلسفة ورهان الحداثة. موقع (https://www.couua.com)، نشر يوم 18 فبراير 2018، وقد تم الاطلاع عليه يوم 2021.06.05.
[6] أرسطوطاليس. الطبيعة. الجزء الأول. ترجمة إسحاق ابن حنين ومن معه؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمان بدوي. ط 1. (القاهرة: المركز القومي للترجمة (سلسلة ميراث الترجمة)، 2007)، ص.237.
[7] لذلك، يقول الفيلسوف «إيمانويل كانط» في كتاب «نقد العقل المحض» ما يلي: «إن العقل لا يدرك إلى ما ينتجه هو وفق خطة من وضعه (…) ثم، إن عليه أن يرغم الطبيعة على الإجابة عن أسئلته، وأن لا يترك نفسه ينقاد بحبال الطبيعة وحدها، (…)، إذ عليه أن يواجه الطبيعة لكي يتعلم منها، وإنما ليس بصفته تلميذا يتقبل كل ما يريده المعلم، بل بصفته قاض منصب يحث الشهود إلى الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليهم». أنظر:
– إيمانويل كانط. نقد العقل المحض. تعريب موسى وهبة. ط.2. (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1987)، ص. 33.
[8] أرسطوطاليس. كتاب النفس. ترجمة أحمد فؤاد الأهواني؛ مراجعة الأب جورج شحاتة قنواتي. ط.2. (القاهرة: المركز القومي للترجمة (سلسلة ميراث الترجمة)، 2015، ص.43.
[9] المرجع عينه، ص. 47.
[10] René Descartes. Discours de la Méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. 1eéd. (Paris: Librairie de la bibliothèque nationale, 1888), p.55.
[11] فانسان كارو. ابتكار الأنا. ترجمة عبد المجيد باعكريم. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2021)، ص.15.
[12] سالم يفوت. الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي. ط.1. (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1990)، ص. 101.
[13] نقلا عن: سالم يفوت. إبستمولوجيا العلم الحديث. ط.2. (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2008)، ص.64.
[14] برزت النزعة الألية الميكانيكية نتيجة لهيمنة الصناعات الآلية في بداية العصر الحديث، وأيضا، نتيجة لذلك الاعتبار الذي انطلق مع روني ديكارت في اعتبار أن الأشجار، والأحجار لا تحوي أسرار خفية، روحية، أو غيرها، بل ما يوجد هو أن هناك أسبابا طبيعية هي ما تنتج مجموعة من المظاهر والآثار في الواقع، وبناء على هذا الاعتبار، فحركة ما يوجد في العالم هي حركة ميكانيكية؛ بمعنى أن الأجسام لا تتحرك من تلقاء نفسها، وإنما من أجسام مجاورة، هي ما تحدث تلك الحركة الآلية الميكانيكية. وبالتالي إن العصر الحديث، ولاسيما، في القرن السابع عشر الميلادي قد كانت هناك هيمنة للنزعة الميكانيكية للعالم حسب الباحث «ماتياس بريس». أنظر:
-Matthias Tripp. Le modèle mécanique comme paradigme épistémologique de la nature et de la pensé aux 17é et 18é siècles, in. Épistémologie et matérialisme. 1eéd. )Paris: séminaire sous la direction d’Oliver Bloch, 1986(, p. 46.
[15] يتشابه العلماء والفلاسفة في القرن السابع في تحديدهم لمبدأ القصور الذاتي أو مبدأ العطالة، اللهم اختلافهم في التعبير فقط. بحيث نجد الفيلسوف «روني ديكارت» يقول في كتابه «العالم أو كتاب النور» ما يلي: «إن كل جزء من المادة بمفرده يستمر دائما على الحالة نفسها، ما دام التقاؤه بغيره لا يجبره على تغييرها.». (أنظر: رونيه ديكارت، العالم أو كتاب النور، ترجمة إميل خوري، دار المنتخب العربي، ط.1، 1999، 82.). أما «إسحاق نيوتن»، فيحدده في الشكل التالي: «كل جسم يبقى في حركة، ما لم يعقه جسم أخر، فيجعله في لحظة سكون». أنظر:
– Isaac Newton. Principes Mathématiques de la philosophie naturelle. Tome I. Trad. Du Latin par Feue Madame La marquise Du Chastellet. 1eéd. (Paris: éditions Jacques Gabay, 1990), p.18-19.
[16] سالم يفوت، إبستمولوجيا العلم الحديث، مرجع سابق، ص. 63.
[17] Galilée Galileo. Discoveries and Opinions of Galileo. Trans. With an introduction and notes by Stillman Drake. 1sted. (New York: Anchor Books Edition, 1957), p.237-238.
[18] إن مسألة ترييض الطبيعة تعد من الخصائص المهمة للفيزياء الحديثة، إذ بتعطيل المادة، أصبحت وكأنها قوى عمياء، بل هي كذلك، ومن ثم لا يمكن تقويضها إلا رياضيا، حيث اللغة الرمزية هي اللغة القادرة على نقل الظواهر من طابعها الملموس إلى طابعها المجرد، وهذا هو دور رجل العلم. أنظر:
– محمد عابد الجابري. مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي. ط.1. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1976)، ص. 251.
[19] Richard Peters.Hobbes. 1sted. (Londres: Penguin books, 1956), p. 83.
[20] كان الاهتمام بعلم الهندسة متواترا عند علماء القرنين السادس عشر، والسابع عشر الميلاديين، مثل العالم الفيزيائي (Marin Mersenne) (1588م-1648م) الذي يرى بأن معرفة الرياضيات ضرورية ليست فقط في مجال الطبيعة، بل حتى في مجال علم اللاهوت، والتفاسير المخصصة للكتاب المقدس، وأيضا، في تشريع القوانين. لذلك، ونظرا لكون هوبز كانت في تواصل مع «ميرسن»، وغيره من العلماء في هذا العصر، فقد كان هناك تأثير عليه فيما يتعلق بالاهتمام بالهندسة كما يشير الباحث «كريكوريو بلدين». أنظر:
– Gregorio Baldin. Hobbes and Galileo: Method, Matter And The Science Of Motion. 1sted. (New York: Springer Publishing, 2020), p.24.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.