دار الأرقم وتحوُّل السلطة في مكَّة؛ من دار الندوة وهيمنة القرابة القبليَّة إلى أخوة الشورى الجماعيَّة
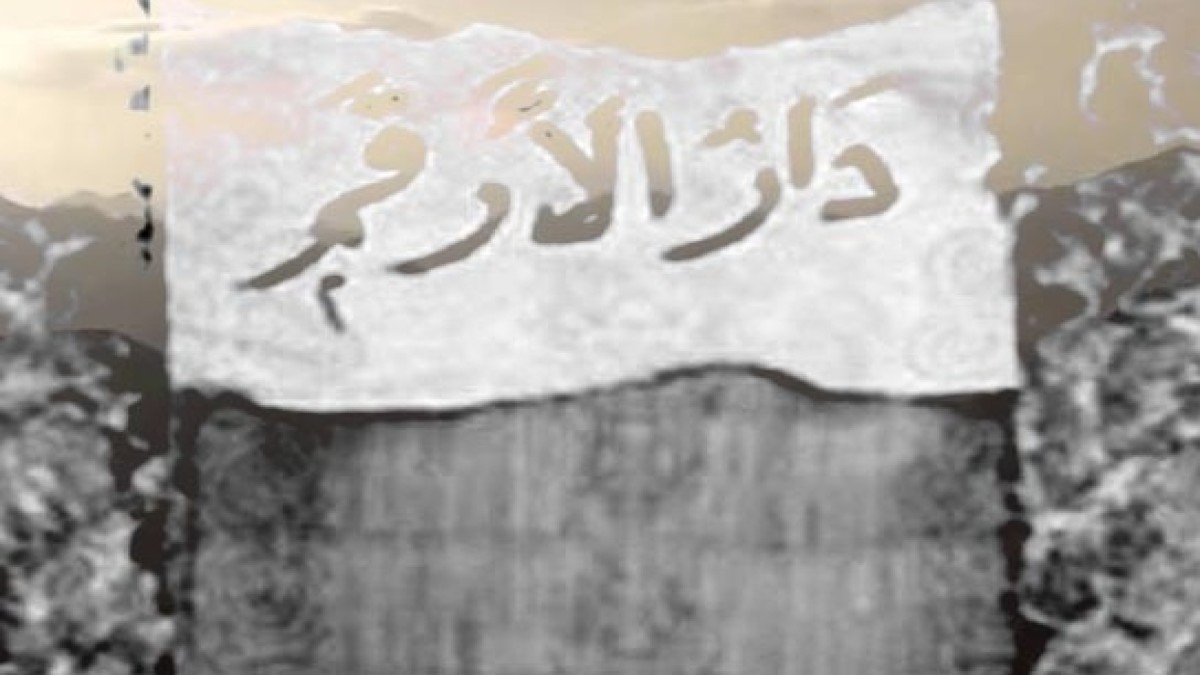
مباشرة بعد بدء الرسول (ص) بالدعوة إلى الإسلام، تقريباً في عام 610م، افتتح نبي الإسلام العظيم محمد (ص)، مجلسًا في دار أحد المُخلصين الأوائل للدين الإسلامي الحنيف، وهو الأرقم ابن أبي الأرقم (ر). (597 – 675م). ([i]) وأصبح “مجلس دار الأرقم” أول مجلس شُيّدَ في الإسلام، مكانًا للتعلم والتحاور والتخطيط واتخاذ القرارات (البغدادي 1985) (ابن-سعد 2001) ولتدريبهم على الانضباط تحت قواعد قرآنية حديثة (الزكري القضاعي 2022).
تأسس مجلس دار الأرقم بعد مضي قرابة 130 سنة ([ii]) من عمر انطلاق مشروع أول مجلس مدني عربي “دار الندوة”، الذي أسسه قصي بن كلاب (400-480م) في منتصف القرن الخامس الميلادي.
قبل الكتابة عن سبب بزوغ دار الأرقم علينا شرح طرق عمل “دار الندوة”، فهو أول مجلس مدني عربي، ويقع مكانه قرب الكعبة المشرفة في مكة، بهدف تنظيم شؤون قريش وزوار بيت الله الحرام. تميزت هذه المؤسسة بكونها أول فضاء رسمي للتشاور واتخاذ القرار في الجاهلية، حيث ضمت زعماء قريش الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، وهدفت إلى ترسيخ ثقافة الجدل السلمي والانضباط الجماعي.
لكن هذه النخبوية أفرزت سلبيات، إذ اقتصرت العضوية على زعماء قريش دون غيرهم من سكان مكة أو القبائل الأخرى، وحجّمت دور الشباب، مما حد من التمثيل المجتمعي الأوسع.
بداية تصدع أداء “دار الندوة” هو دخول صحن الكعبة ليلعب دورًا تكميليًا كمجال شعبي مفتوح للتعبير عن الرأي والنقاشات اليومية، وإن لم يكن ذا تأثير رسمي مباشر. وقد مثّل هذا الصحن فضاءً عامًا للتجار والزوار والعامة من مختلف الطبقات، مما خلق توازنًا جزئيًا مع دار الندوة.
لكن بعد مضي قرابة قرن 130 سنة من انطلاق دار الندوة نجده أنه ركز على قضايا الهويّة عبر هيمنة القرابة القبلية بعدم انفتاحه على المكونات غير القرشية وعدم اعترافه برجاحة الشباب والتنكر للشأن العام الذي كانت بالأساس مبدأ للعدالة الاجتماعيّة.
قريش لم تجاري تطورات الزمن فانبثق اختلاف جوهري في البنية والمضمون:
زمن الرسول (ص) أختلف كثيرا عن زمن قصي. حصلت تغيرات ديمغرافية وتطورت قريش عبر رحلة الشتاء والصيف بالتعرف على حضارات أمم محيطة بجزيرة العرب. هذه التطورات نقلت الواقع المكي الذي كان عليه في زمن قصي الى واقع آخر. استطاع الرسول (ص) من ملء فراغ اللحظة المكية بشكل عبقري. توجه الرسول (ص) الى أحد الشباب المخلصين للدين الإسلامي في مرحلته الجنينية الأرقم ابن أبي الأرقم (ص) ليجعل من مجلسه دارا تدشن مشروع منصة تعالج الشأن العام على أسس تتجاوز مثالب دار الندوة.
على الرغم من أنّ الصحابيَّ الأرقم t كان من قبيلة قريش –بني مخزوم– فإنه لم يكن زعيمًا في عشيرته. في الواقع، لم يكن أغلب روّاد المجلس من طبقة الرؤساء في عشائرهم، بل أنّ بعض روّاد المجلس كانوا من غير العرب: من أصول أفريقية (بلال t) أو بيزنطيّة (صهيب t).
إنها وجوهٌ وأسماءٌ مَنَعَت أعراف مجلس دار الندوة من استضافتهم على الرغم من رجاحتهم ورصانة رُشدهم. كان إقدام مجلس دار الأرقم على استضافتهم بمثابة “دستور جديد” يعلنه أول مجلس شُيّدَ في الإسلام.
نعم هو مجلس يُقرّ بمبدأ تقاسم الرأي وكسر الاحتكار عبر فتح الكلام والحوار كما هو الأمر في مجلس دار الندوة، ولكنه في معظم أعرافه قام بتدشين أعراف حديثة غير مسبوقة. والأهم أنّ جُلّ مبادئ وأفكار مجلس الأرقم صدرت عن قيم ثورية تنتمي إلى بنية معرفية غير مألوفة، قادمة على أكتاف كتاب الله العظيم إلى وعي العرب لأول مرة مبشرةً بقيم السواسية، وملغيةً للطبقية، ومرحبةً بالعقل والرشد والحِكمة والعَدالة.
من ناحية موقع دار الأرقم الجغرافي، فهي دار ليست ذات بروز في مدينة مكة المكرمة. بل أنّ مجلس دار الأرقم يقع خارج محيط مركز مدينة مكة المكرمة المطروق من قبل النخبة والتجار والزوّار. فالمجلس لم يكن بناءً خاصًا مستقلاً كدار الندوة، بل هو لا يعدو كونه غرفة في منزل يقع على شارع ضيق شرقي تَلّ الصّفاء (ابن-الضياء 2004) (الأزرقي 2003).
إنه موقع أقلّ وضوحًا من دار الندوة. بعيدًا عن قلب المدينة. موقع الدار جعل هذا المجلس نائيًا عن مركز القوة. مكانًا يقع في الهامش بعيدًا عن مجال نفوذ قريش. علاوة على كونه مهمّشًا جغرافيًا أيضًا، فإنّ معظم روّاد مجلس دار الأرقم كانوا أشخاصًا مهمّشين ثقافيًا محظورين من المشاركة في الاجتماعات في دار الندوة المقتصرة على النخبة. بتخصيص النبيّ محمد ﷺ مجلسًا في بيت الأرقم، فإنه بذلك أبعد الحركة الإسلامية عن المفهوم الهرمي الحاد للتمثيل القرشي المحلي، وعرفها وقَرّبَهَا من مفهوم أماكن التجمعات العامة المفتوحة للجميع.
على عكس دار الندوة – الذي لم يكن مركزًا دينيًا للتعليم – فقد فتح مواضيع أول مجلس شُيّدَ في الإسلام ليغطي مواضيع الشؤون الدينية والمدنية. وبدأ الرسول الكريم ﷺ ببثّ أفكار القرآن الكريم القائمة على التسامح والمساواة نحو الناس وعامتهم كافة.
يعد مجلس دار ابن الأرقم حدثًا ثوريًا في زمانه، يحمل رمزية ذات صدًى هائل في الوعي العربي حينها. إنه انزياح ثقافي عن أعراف كل الماضي، انزياح تبنى نوعًا جديدًا من الانتماء المَبْنِي على “الأخوة في خدمة الإله المشترك” بدلاً من “الأخوة القائمة على أسس الدم والقرابة”. بات نظام رابطة الدم الذي رسم حدود من هو الأقرب دمًا فأخوة، وحدّد من هو الأبعد دمًا فدنوٍ، ومعه فكرة الكرامة والشرف والعلو والترتيب المرتفع، أو الوضاعة والمنخفض والمنحدر تتعرض للتحدي مع النظام القرآني الجديد.
مع مرور الوقت، ضاق صدر المكيّين بالمسلمين فمارسوا أشدَّ أنواع التعذيب والمقاطعات ضد المسلمين الأوائل، مما أدى بهم إلى هجرتهم إلى المدينة المنورة. ازدهر في المدينة المنورة أنموذج مساحات التواصل العامة المُقتبسة من مجلس دار الأرقم، وأعيد استنساخه في عدة مجالس مدينية. كان واضحًا حجم ابتهاج جمهور المدينة المنورة بفرص التساوي المتاحة لهم في هذا النوع من المجالس الحديثة. فرص أتاحت لكل فرد حكيم منضبط قادر على التعبير عن رأيه علانية من المشاركة في جدل الكلام والحوار.
كل هذا جعل أنموذج مجلس دار ابن الأرقم يتمتع بجاذبية في المدينة المنورة. ومع ذلك، بسبب صغر حجمها، فإن هذه الأماكن أصبحت مزدحمة بروادها، وكان هناك حاجة ماسة إلى دستور عرفي، ينظم حشود الزوار، وإعطاء فرص لأكبر عدد ممكن للناس من الجلوس والاستماع والمشاركة في حواراته وجدلياته وقضاياه، وتعلم طرق التوصل إلى اتفاق جماعي.
ومن الملفت أن القرآن الكريم تطرق إلى المجالس في إطار وضع آلية الانضباط في السلوك إلى تنظيم المجالس المكتظة. يقول الله تعالى:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ” (سوره 58: المجادلة 11).
أتت هذه الآية القرآنية الكريمة لتوسّع معنى الانضباط من خلال ضبط آلية التفاسح في المجالس لاستيعاب أكثر عدد ممكن من الزوار. ويمكن فهم هذه الآية الكريمة على أنها شَرْعَنَة أنموذج مجلس دار ابن الأرقم، وساعدت في ترويج المجالس بين كافة أوساط المجتمعات التي اعتنقت الإسلام، فأصبح أنموذج مجلس دار ابن الأرقم منتشرًا في المحليات العربية والإسلامية كافة.
التصور الأولي لنموذج المجلس في الإسلام أثرى مخيلة الكثير من النخبة الإسلامية، مما دفع بعضهم إلى كتابة العديد من الكتب عن آداب المجالس وبروتوكولاتها وأدبيات الانضباط فيها، وذلك عبر التاريخ الإسلامي. على سبيل المثال؛ كتاب “بهجة المجالس وأنس المجالس” من تأليف يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسي (المتوفى 463هـ)، وكتاب “المجالس والمسايرات” للقاضي النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيُّون المغربي (المتوفى 363هـ) وغيرهما كثير.
خاتمة: من دار الأرقم تبدأ شرعية المجالس المدنية في الإسلام
لقد كان مجلس دار الأرقم أكثر من مجرد غرفة في بيت؛ كان إعلانًا ثوريًا عن ميلاد وعي سياسي ديني جديد، وشرارة انبعاث نظام شوري قاعدي يكسر سلطة النسب ويخلخل احتكار الرأي. لقد دشّن هذا المجلس، الذي انعقد في الهامش الجغرافي والاجتماعي، مركزًا جديدًا للقرار والمعنى، لا يستمد شرعيته من الدم والجاه، بل من الحكمة والتقوى والعقلانية والانضباط الجماعي.
من هناك، من زوايا تلك الدار المتواضعة، أُطلقت أول تجربة إسلامية في تنظيم الشأن العام على أساس المساواة والجدارة، لا الطبقية والامتياز الوراثي. لم يكن مجلس دار الأرقم بديلاً تقنيًا لدار الندوة فحسب، بل كان انقلابًا معرفيًا ومؤسسيًا على نموذج قريش القديم، وانتصارًا لمفهوم الإنسان المؤمن المواطن، لا الإنسان المُصنّف وفق القبيلة أو الطبقة.
وهكذا، حين نعيد قراءة بدايات المجالس الإسلامية، لا بد أن نعيد الاعتبار لدار الأرقم، لا كرمز تاريخي فحسب، بل كمرجعية حضارية يمكن استحضارها في مشاريع إعادة بناء مؤسسات الحوار والشورى في عالمنا العربي والإسلامي المعاصر. فهناك، حيث جلس بلال وصهيب وسلمان جنبًا إلى جنب مع القرشيين، وُلدت الفكرة الأولى للمجلس الذي يخدم الجميع، لا فئةً دون أخرى.
ومن دار الأرقم، بدأت الرحلة.
___________
المصادر والمراجع:
ابن الضياء، محمد بن علي. فضائل مكة وحرمة البيت الحرام. مكة: مكتبة النهضة، 2004م.
ابن سعد، محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. بيروت: دار صادر، 2001م.
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. بهجة المجالس وأنس المجالس. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م.
الأزرقي، محمد بن عبد الله. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. بيروت: دار الثقافة، 2003م.
البغدادي، عبد القادر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. القاهرة: دار الكتب، 1985م.
السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. بيروت: دار المعرفة، 2009م.
الزكري القضاعي، محمد. (2022). المجالس كبيئة لقوننة السلام الاجتماعي: تاريخ الانضباط العربي من دار الندوة إلى مجالس المحرّق. مجلة الحقوقية، العدد الثاني، ديسمبر، ص. 263–293.
القاضي النعمان بن محمد المغربي. المجالس والمسايرات. تحقيق: محمد كامل حسين، القاهرة: دار الفكر العربي، ط2، 1984م.
Dostal, Walter. The Bedouin in Arabia. [n.d.].
Peters, F. E. Muhammad and the Origins of Islam. Albany: SUNY Press, 1994.
Watt, W. Montgomery. Muhammad at Mecca. Oxford: Clarendon Press, 1988.
[i] وُلد الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بين عامي 590–597 م (وفق أغلب المصادر، تحديدًا حوالي 594 م) ، تُوفي في المدينة المنورة خلال خلافة معاوية بن أبي سفيان، وذلك في سنة 55 هـ، الموافق تقريبًا عام 675 م، وبلغ من العمر نحو 78–85 سنة.
[ii] الفارق الزمني بين وفاة قصي بن كلاب (حوالي عام 480م) وبدء النبي محمد ﷺ بالدعوة إلى الإسلام (حوالي عام 610م) هو: 610 – 480 = 130سنة تقريبًا. إذًا، مرت نحو 130 سنة بين وفاة قصي بن كلاب وبداية الدعوة الإسلامية.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




