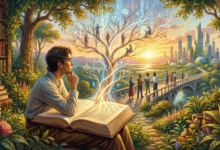هردر والتأسيس الفلسفي -الأنواري لإتيقا «التعدُّديَّة الثَّقافيَّة»

صاغ الفيلسوف والأديب الألماني « يوهان جوتفريد هردرJohann Gottfried Herder» باقتدار شديد، المقدمات الأولى لما صار يعرف في القرن العشرين بمبدأ أو إتيقا «التعددية الثقافية»، فرغم أنه لم يبلغ مبلغ نحت المفهوم، إلا أنه أسس لمبادئه التي سيكون عليها فيما بعد، حينما برر رفضه خلال القرن الثامن عشر (ولد عام 1744 وتوفي سنة 1803) لفكرة ذوبان الثقافة الألمانية ضمن القوالب الجاهزة التي فرضتها في زمنه غلبة الروح الفرنسية، متشبعا بفكرة الحق في التمتع بالخيارات الثقافية باعتباره ضمانا للحق في الاختلاف، وهو المبدأ الذي انتهى إقراره إلى تأسيس فكرة لزوم تجاوز الإقصاء الثقافي من خلال رفض العمى عن الاختلافات.
وقد قاد في هذا الصدد تصورا جريئا حينها، أكد بواسطته “للكّتاب الألمان أنهم إن التمسوا الإلهام في جذور الأمة وحياة الشعب، فسوف يأتي الذي يبزون فيه الفرنسيين في كلما حققوه، وقد تحققت هذه النبوءة في الفلسفة والعلم”[1]. وهو ما حدث فعليا بعد فترة زمنية قصيرة حيث أضحى الألمان أصحاب مشاريع عظيمة في أغلب تخصصات الفلسفة والعلم، وأنجبت قريحتهم أعمالا فلسفية وتحف فنية ومصادر علمية، لا زالت إلى الآن ملهمة للفرنسيين وغيرهم، تأكيدا على فكرة هردر القائلة: بمحورية الأصالة كولاء للذات والجماعة، تجاوزًا لمأزق «الأصالة» في لبوسها الفرداني الغارق في الذاتية.
بل وصل الحال به، إلا التأثير في جيل كامل حمل مشعل تثبيت هذه المقدمات، وكان «غوتة» ضمن هؤلاء الذين ألهمهم دفاع هردر عن سلطة الشعب وعمق أصالته، ومركزية ولائه لذاته، “فقد ألهمه رأي هردر القائل بأن الشعر ينبثق غريزيا في الشعب”[2]. وكأن أصالة الفرد باعتباره شاعرا أو فنانا أو كاتبا، في عمقها مستمدة من قريحته الشخصية المربوطة بوثاق هذه الجماعة الممثلة للشعب أو للأمة، لدرجة كان يوصي هردر الشعراء في زمانه “بأنه أخلق بهم أن يتشبثوا بالمنابع الشعبية لتقليد أمتهم في الشعر الفولكلوري، والتاريخ القصصي الغنائي”[3]، بل “راعت ثقافة المؤلف الشاب –هردر- كانط وليسنج ونيقولاي ولا فاتر، وامتدحوا دعوته إلى أدب قومي متحرر من الوصاية الأجنبية”[4].
ثم إن تأسيس “هردر” لمبدأ الأصالة باعتباره سندا محوريا وحدسا أخلاقيا مركزيا في الحداثة الغربية، لم يمنعه من أن يكون بحق ضمن الذين كرسوا تصورات نقدية تمهيدية حول «الأنوار»، و«عبادة الحرية»، و«هوس الاستقلال»، و«تمجيد العقل والذات»؛ حينما عبر عن تبرمه من الفلسفات الداعمة لغلبة الكوني على الخصوصي، رغم ارتباطه بأعلامها من قبيل روسو وكانط. وتكمن المفارقة ها هنا، في الارتباك الحاصل حول “الأنوار وألمانيا”، ومعهما هردر طبعا، إذ في اللحظة التي صاغ فيها كانط دستور الأنوار، الذي تم به إعلان خبر ولادة عصر كرامة الإنسان، في رده على سؤال: ما الأنوار؟ كان هردر سباقا إلى إنشاء ثورة ألمانية، ضدا على هذه الروح الكونية التي أقرها كانط قرينه في الدم والوطن. وفي لحظة إعلان صاحب «النقد الثلاثي» عن إعجابه الشديد بفرنسا روسو، أو على الأقل إعجابه بروسو فرنسا. كانت قريحة ألمانية تتشكل على جنب كانط تماما، لإعلان رفضها الشديد لأشكال الهيمنة الفرنسية كلها في الثقافة والفنون والأدب، وصلت حد تأسيس ثورة «حركة العاصفة والاندفاع»[5].
فكان “هردر” من الذين وضعوا على عاتقهم مسؤولية “شن حرب ضد النزعة الكونية المتشاكلة لعصر الأنوار باسم التنوع الثقافي”[6]، رفضا لأي عملية إقصاء فرنسي ممنهج لهذه الثقافة الغنية. بل ورغم سفره لفرنسا وافتتانه ببعض ما خلفته حضارتها، ولقائه بمفكريها من أمثال «ديدرو»، وانكبابه على دراسة الفكر السياسي الفرنسي، كما في تخصيصه لأوقات مهمة من أجل دراسة «مونتسكيو» وروح قوانينه، إلا أنه رفض فكرة التهام فرنسا لألمانيا ثقافيا، تعبيرًا عن كبرياء جريح ومهان، لا يريد الاستقواء بما يملكه الآخر، ولا يرضى أن يصير مجرد صورة مطابقة لأصل معكوس في مرآة. وهو الرفض الذي يمكن قراءته كأصل حداثي لفكرة التعددية الثقافية القائمة على رفض «تراتبية المواطنة»، حين يجري تقسيمها وفق صورتين مُتخيلتين: الأولى مُحتَقَرَة تكون من درجة ثانية، وأخرى مُحتَقِرَة تكون من درجة أولى.
وأصر هردر، رفضا لهذا الإحساس Sentiment بالدونية وتجاوزا للتسليم بفكرة الخضوع الألماني لأنوار باريس، على تأسيس البدايات الأولى لمطلب التعددية الثقافية، عبر “الإصرار على المفهوم الألماني للثقافة بوصفها هوية نوعية، وغير قابلة للاستبدال في مقابل النزعة الكونية المجردة”[7]، متأثرا بما دعا إليه «جورج هامان» في تلك الفترة. ومؤسسا في الآن ذاته لثورة ألمانية حقيقية ضد أشكال «الاحتجاز الثقافي» الذي أقامته “السجون الثقافية” لفرنسا، على “الإبداع الألماني”، الذي أتمت بعض صوره في ما بعد أقلام أخرى من قبيل عائلة “مان”، بل إن تأثيره شمل ما هو أوسع[8]، لدرجة يرد له البعض الفضل في تخصيب الفكر اللاحق عليه في الغرب بأكمله.
وبالمختصر؛ بقي هردر مفتونا إلى حد كبير بفكرة الترابط العضوي بين الفرد والجماعة التي تشكله، مدافعا عن فكرة “الأمة”، التي بفضلها يستطيع الأفراد التعبير عن أصالتهم واختياراتهم، معتزًا بفكرة أن المشاركة في بناء الحضارة التي ينتمي لها الشخص، تعني التعبير عن الشعور الداخلي الذي بمقتضاه يدرك كل فرد ذاته باعتباره جزءًا مكملا للمجتمع ككل[9]. وهو الإدراك الذي يقوي فرضية الحاجة إلى الارتباط مع الجماعة من حيث كونها سندا مرجعيا، لا بد منه، وهذا سبب تكريسه وقتا مطولا للدفاع عن أهمية اللغة باعتبارها أحد أسلاك الربط التي بموجبها يعي الفرد وجوده الفردي والقومي، حيث تتوحد الهوية الفردية، مع الهوية الجمعية، بواسطة اندماجهما في هوية واحدة موحدة[10].
فكان هردر بحق؛ هو الشاعر والناقد والفيلسوف، الذي اسبق زمانه وهو يضع اللمسات الأولى لمطلب سيكون على رأس أولويات الفكر السياسي لما بعد القرن العشرين، والقصد هنا «إتيقا التعددية الثقافية» بكل ما تعنيه من معاني التشارك ورفض الاحتقار والتعالي باسم التفوق العرقي أو الديني أو اللغوي أو الثقافي، ومن حيث كونها نزعة إنسانية قصدها تجاوز كل أشكال التصنيفات الضيقة التي تنتهي إلى إقامة مواطنتين أو إنسانيتين: واحدة من درجة أولى مكتملة ومتفوقة وُمنتجة وعالمة، وأخرى من درجة ثانية منقوصة ومُحتقَرة وجاهلة، في مقابل تكريس حق “الاختلاف”، ورفض أشكال نفي “التعدد” كلها، والرهان على “الانفتاح” و”التعايش”، وضمان “الحق الجماعي في التعبير عن الأصالة”، بما تحمله من تركات وموروثات ثقافية ودينية وعرقية كلها، ومكتسبات إنسانية وتاريخية، بحيث لا يحدث استقواء أي من هذه الموروثات على الأخرى، وتثمين أسس الدولة المدنية والمواطنة ومؤسسات الرعاية.
__________
المصادر والمراجع:
- وول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة فؤاد أندراوس، الكتاب الرابع، الإسلام والشرق السلافي 1715-1796، الشمال البروتستانتي، الجزء الثالث من المجلد العاشر، منشورات دار الجيل، بيروت، 1977.
- باربارا باومان وبريجيتا أوبرله، عصور الأدب الألماني تحولات الواقع ومسارات التجديد، ترجمة هبة شريف، مراجعة عبد الغفار مكاوي، منشورات عالم المعرفة، العدد 278، فبراير 2002.
- داريوش شايغان، الهوية والوجود العقلانية التنويرية والموروث الديني، ترجمة جلال بدلة، منشورات دار الساقي، بيروت، ط1/2020.
- يوهان جوتفريد فون هيردر، ضمن موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة طريف بن عيد السليطي، منشورات مجلة حكمة، بتاريخ 06 غشت2021.
- محمد مجدي الجزيري، نقد التنوير عند هردر، منشورات دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، طنطا، 1999.
- Gérard Wormser, La Pensée Romantique une Révolution des idées, Sens Public, Publié le :24-12-2016.
[1]– وول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة فؤاد أندراوس، الكتاب الرابع، الإسلام والشرق السلافي 1715-1796، الشمال البروتستانتي، الجزء الثالث من المجلد العاشر، منشورات دار الجيل، بيروت، 1977، ص267.
[2]– وول ديورانت، قصة الحضارة، مرجع سابق، ص266.
[3]– المرجع نفسه، والصفحة.
[4]– مرجع سابق، ص265.
[5] – “Strum und Drang” وتعني: “العاصفة والاندفاع/الدفع”، وهي حركة أدبية ثورية ألمانية، جاءت كرد فعل ضد الصرامة العقلية للأنوار. ولمزيد بيان حول المدرسة ورموزها وأفكارها وبداياتها وتحولاتها ورهاناتها ونماذج عنها. يمكن العودة إلى كتاب “عصور الأدب الألماني: تحولات الواقع ومسارات التجديد”، وبالضبط للفصل السابع، الذي حمل عنوان الحركة نفسها: “العاصفة والدفع”، والذي تم تخصيصه حصريا للحديث عنها، حيث جاء فيه: “أن الجيل الذي ولد في منتصف القرن الثامن عشر قد حمل لواء هذه الحركة التي توصف بأنها “أول حركة شبابية ثورية” في الأدب الألماني (…) وقد جمع بين أدباء عصر العاصفة والدفع إحساس بالتضامن، فكونوا مجموعات في مدن مختلفة مثل ستراسبورغ وفرانكفورت وشفابن (…) ويعود هذا المصطلح “العاصفة والدفع” إلى تمثيلية بالاسم نفسه لفريديريك ماكسيميليان كلنجر، واسمها الأصلي هو “فوضى”، ثم أطلق هذا الوسم على العصر بأكمله، وفي عام 1773، أصدر “هردر” كتابا جمع فيه الإسهامات الألمانية وأطلق عليه اسم “عن الأدب والفن الألماني”، ويعتبر هذا الكتاب البرنامج المكتوب لحركة العاصفة والدفع الألمانية (…) فعلى الرغم من الأعمال التي كتبها كل من يوهان جورج هامان: 1730-1788، وفون جرستنبرغ، قد حوت ملامح حركة العاصفة والدفع، فإن التسمية ارتبطت بظهور كتاب هردر المشار إليه”. ينظر:
– باربارا باومان وبريجيتا أوبرله، عصور الأدب الألماني تحولات الواقع ومسارات التجديد، ترجمة هبة شريف، مراجعة عبد الغفار مكاوي، منشورات عالم المعرفة، العدد 278، فبراير 2002، ص149-150، بتصرف.
-كما يمكن العودة أيضا إلى دراسة مختصرة ومهمة في هذا الشأن، للإشارة إلى التحولات العميقة التي حدثت في القرن 18، والتي وُلدت في سياقها هذه الحركة الثورية:
–Gérard Wormser, La Pensée Romantique une Révolution des idées, Sens Public, Publié le :24-12-2016.
[6]– داريوش شايغان، الهوية والوجود العقلانية التنويرية والموروث الديني، ترجمة جلال بدلة، منشورات دار الساقي، بيروت، ط1/2020، ص20.
ومن باب الإشارة فإن الكتاب -أو بالأحرى الكاتب في كل ما ألفه-، قد أقام جهدا حفريا محترما في الشق المرتبط بالنقاشات الدائرة حول فكرة “المركزية الغربية أو الواحدة”، من خلال إبراز الردود غير الغربية والغربية على هذه الحضارة، بل حتى اهتمامه بهردر جاء في سياق إبراز فكرة أن نشأة المآخذ على الغرب كان هو نفسه غربيا، عارضا تجربتين أساسيتين جمع ضمنهما الإسهامات الألمانية والروسية كدلالة على هذا التوجس في بواكيره التمهيدية الأولى.
[7]– المرجع نفسه، والصفحة.
[8]– يمكن في هذا السياق العودة إلى ما تم جمعه حول هردر ضمن “موسوعة ستانفورد للفلسفة” في الجزء المتعلق بـ “تأثير هردر”، والذي تضمن جردا مختصرا لأهم الذين تشكلوا بواسطة الخلفيات الفكرية والأدبية واللغوية التي أقرها هردر، بما فيها مساهماته في تكريس الأسس المتينة للهرمينوطيقا، التي استلهمها شلايرماخر من تصوراته حول علاقة الفكر باللغة، وأسهم في تشكيل رؤى غوتة، هيجل، نيتشه، فون هومبولت، دلتاي، جون ستيوارت ميل، أعلام الحركة الرومانسية. ينظر:
– يوهان جوتفريد فون هيردر، ضمن موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة طريف بن عيد السليطي، منشورات مجلة حكمة، بتاريخ 06 غشت2021، ص70 وما بعدها.
[9]– محمد مجدي الجزيري، نقد التنوير عند هردر، منشورات دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، طنطا، 1999، ص115.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.