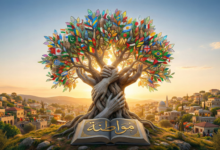الأسس النَّظريَّة لفكرة التَّفاوت الطَّبيعي في الفكر اليوناني

إذا عدنا إلى كتاب «السياسة» لأرسطو، فسنجد تأكيده على أطروحة أساسية مفادها «أن الإنسان حيوان سياسي بطبعه»؛[1]بما يفيد أن الإنسان جُبِل على الاجتماع في بقعة جغرافية محددة مع كائنات بشرية أخرى بالطبيعة. غير أنه إذا كانت الضرورة الطبيعية قد دفعت البشر إلى الاجتماع مع الآخرين في أمكنة ومواضع معينة تحقيقا للسعادة بما هي الخير الأسمى في تسلسل الخيرات، فإن الطبيعة نفسها قد جعلت بينهم نوعا من التفاوت في الملكات الفكرية والبدنية التي يملكها كل إنسان على حدة. بمعنى آخر، إذا كانت الطبيعة تدفع الناس إلى الميل للاجتماع في أمكنة محددة ولغايات مشتركة، فإنها لم تجعل بينهم نوعا من «المساواة»، إذ الكائنات البشرية متفاوتة بالطبيعة من حيث قدراتها وإمكاناتها.
ولعل عدم إعطاء أولوية لمفهوم «المساواة» في هذه الفلسفة الأرسطية بشكل خاص، وفي الفلسفة اليونانية بشكل عام، عائد -من وجهة نظرنا- إلى عوامل نظرية مرتبطة بالأساس الذي بُنيت عليه النظريات الفلسفية في مجال «علم تدبير المدن»[2]آنذاك. فما دامت الفلسفة لم تظهر نظريا إلا في اليونان، فإنه لم يكن أمام فلاسفة هذه المرحلة من تاريخ التفلسف، من نموذج نظري يستعينون به في بناء نظرية فلسفية تجيب عن المشكلة الكبرى في مجال الفلسفة السياسية؛ أي البحث عن النظام الأفضل للحكم (Alain Renaut, 1999) اللهم نظام الطبيعة.[3]لذلك، كانت النظريات السياسية في اليونان (أفلاطون وأرسطو نموذجا) ليست إلا تصريفا نظريا للخلاصات التي تم الاهتداء إليها في العلوم النظرية، ولاسيما، في مجال علم الفلك (الكصمولوجية).
فبالعودة إلى كتاب «رسالة في السماء» لأرسطو (384ق.م-322ق.م) نجد تقسيمه العالم إلى عالمين؛[4]«عالم ما فوق القمر» بما هو عالم الكمال والأزلية، حيث كل جرم يؤدي وظيفته التي أسندت إليه بالطبيعة، و«عالم ما تحت القمر» بما هو عالم الكون والفساد، حيث لا يؤدي كل كائن ما أسند إليه بالطبيعة. كما أن الأجرام السماوية مختلفة من حيث الوظيفة التي تؤدي إلى سيرورة النظام في الطبيعة، بحيث إن وظيفة الشمس ليست هي نفسها وظيفة القمر، كما أن وظيفتي القمر والشمس ليست هي وظيفة باقي الكواكب والنجوم الأخرى، وبالتالي ما دام كل جرم-كوكب إلا وله وظيفته الخاصة التي ينبغي عليه تحقيقها بالطبيعة سعيا للنظام والكمال، فإن ذلك يفيد انعدام وجود المساواة في طبيعة ووظائف الأجرام-الكواكب السماوية. وإذا كان الأمر كذلك في نظام العالم-الطبيعة، فإن نقل هذه الخلاصات لتطبيقها في مجال عملي كالسياسة، يجعل من فكرة «التفاوت الطبيعي» أمرا ضروريا. بحيث إذا كانت الأجرام السماوية متفاوتة من حيث الطبيعة والوظيفة، فإن البشر كذلك، لا بد وأن يكون بينهم نوع من التفاوت بالطبيعة أيضا، خصوصا، وأن الطبيعة هي النموذج الذي استند عليه فلاسفة اليونان في تأسيس نظرياتهم الفلسفية.[5]
ولتبيان طبيعة هذا «التفاوت الطبيعي» في مجال العلوم العملية (علم تدبير المدن)، يمكن استحضار نموذج فلسفي جعل صاحبه يوصف كما لو كان فيلسوفا يؤسس لنظام سياسي شمولي[6]في زمانه،[7]أقصد الفيلسوف اليوناني «أفلاطون» (427ق.م-347 ق.م) الذي أكد أطروحة أساسية مفادها أنه لتحقيق النظام والتجانس والكمال في المدينة-الدولة، لا بد من التشبه بالنظام الكصمولوجي للعالم، حيث إن الذي يجعل من «عالم المحسوسات» عالما يعيش في حال من الفوضى والخواء، هو أن ما يوجد فيه لا يؤدي وظيفته التي أسندت إليه بالطبيعة. وما دام «عالم المعقولات» متمايز من حيث طبيعة أجرامه، إذ نجد الشمس في مقام الكوكب الأسمى يليه القمر، فباقي الكواكب والنجوم، فإنه لتحقيق النظام الأفضل في «العالم المحسوس»، لا بد من تقسيم المجتمع إلى ثلاث فئات هي كالتالي؛[8]هناك «فئة الذهب» التي يقصد بها أفلاطون من جبلوا بالطبيعة على الحكم؛ أي الفلاسفة الذين وهبوا القدرة على التشريع القانوني.[9]ثم، «فئة الفضة» التي يقصد بها من جبلوا على حراسة المدينة-الدولة من المخاطر والشرور الناتجة عن الحروب الداخلية والخارجية، نظرا، لكونهم يملكون بنية جسمانية ضخمة تتيح لهم ذلك. وأخيرا، «فئة النحاس» أي أولئك الذين ليس في مقدورهم بالطبع لا على الحكم، ولا الحراسة، بقدر ما أن وظيفتهم هي الخدمة والصناعة.
وبما أن هذه الفئات متمايزة بالطبيعة، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال -إذا ما أردنا النظام في المجتمع حسب أفلاطون- أن يرتقي من ينتمي إلى «فئة النحاس» -مثلا- إلى «فئة الذهب»، ليصبح حاكما، كما لا يمكن لشخص ينتمي إلى «فئة الذهب» أن يصبح في يوم من الأيام في مقام الحرس أو الصناع والحرفيين، وعلة ذلك، أن الطبيعة هي التي وهبتهم هذا المقام الطبيعي. لذلك، وسعيا لتحقيق النظام في المدينة-الدولة، لا ينبغي أن يتجاوز المرء طبيعته ووظيفته التي أسندت إليه بالطبيعة، وإلا سنعود إلى الفوضى والخواء (Chaos) من جديد. فالطبيعة هي التي «فطرت» الناس على طبائع ووظائف في تأديتها تحقيق للنظام، وفي التنصل منها تحقيق للفوضى. وعليه، كان هذا التقسيم الأفلاطوني لفئات المجتمع، تقسيما طبقيا يستند على «التفاوت الطبيعي»، لا على «المساواة الطبيعية».
غير أنه وجب التأكيد في هذا السياق، على مبدأ أساس من مبادئ التفكير الإبستمولوجي الذي يفيد أن النظر إلى فلسفة القدماء بشكل عام، وفلسفة أفلاطون بشكل خاص، من زاوية الراهن يجعلنا في حال تأكيد بكون هذه الفلسفة هي حلقة خارج دائرة الإنسانية والواقعية، بيد أنه إذا نظرنا إليها من زاوية السياق الفكري والمعرفي الذي أسست فيه، فإن ذلك يدفعنا إلى اعتبار ما توصلوا إليه، ليس إلا سعيا للتماهي مع النظام الميتافيزيقي للعالم في شرطهم التاريخي.
[1] أرسطو، السياسيات، ترجمة الأب أوغسطينس بربارة البولسي، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت، 1987، ص. ص. 74-75.
[2] من المعروف أنه في التقليد الفلسفي اليوناني يمكن التمييز بين نوعين من العلوم؛ هناك من جهة؛ «العلوم النظرية» التي تشمل كلا من العلم الطبيعي، والعلم الإلهي (ثاولوجيا باليونانية)، وعلوم التعاليم (الرياضيات)، ومن جهة أخرى؛ «العلوم العملية» التي تشمل علم الأخلاق، وعلم تدبير المنزل (تدبير الخاص)، وعلم سياسة المدينة-الدولة (تدبير العامة). أنظر؛
-محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تحقيق محمد كمال الأدهمي، مؤسسة هنداوي، 2020، ص. ص. 92-93.
[3] Leo Strauss, Les Trois Vagues De La Modernité, Traduit de l’anglais par Michael Nafi, dans le philosophoire, N° 25, 2005, p.p. 167-180. P.170.
[4] Aristote, Traité Du ciel, Tra. J, Barthélemy saint-Hilaire, Librairie philosophique de ladrange, Paris, 1866, p.313.
[5] كان الاعتقاد السائد آنذاك، هو بما أن عالما ما فوق القمر يتميز بالكمال والأزلية على عالم ما تحت القمر الذي يتميز بالكون والفساد، فإن له شرف تدبير كل ما يطرأ في عالم ما تحت القمر، بل وكل ظواهر العالم الأرضي سببها حركة الأفلاك السماوية، ومحكومة بسلسلة من الدوافع الناتجة عن الحركات المنظمة للأفلاك السماوية. أنظر؛
-سالم يفوت، إبستمولوجيا العلم الحديث، دار توبقال للنشر، 2008، ص.12.
[6] الشمولية هي نظام سياسي فيه اعتراف من الدولة بكون سلطتها لا حدود لها، ومن ثم، فهي تسهر على تنظيم كل جانب من جوانب الحياة العامة.
[7] كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، ج، 1، ترجمة السيد نفادي،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2014، الفصل السادس.
[8] أفلاطون، الجمهورية، ترجمة فؤاد زكريا، مراجعة سليم سالم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004، ص. 284.
[9] كان كانط يعتبر أن الفلاسفة ليس بالضرورة قادرين على تسيير الدول والحكم فيها، حيث بما أنهم يملكون قدرات على التشريع، فيمكن أن يستغلوها في تحقيق أمجادهم فقط.
_________
*د. لوكيلي عبد الحليم[1]/ أستاذ مادة الفلسفة/ المغرب.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.