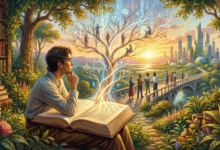الفلسفة والشّعـر أو القرابة بين الـميتـافيـزيـقـي والشّاعـر
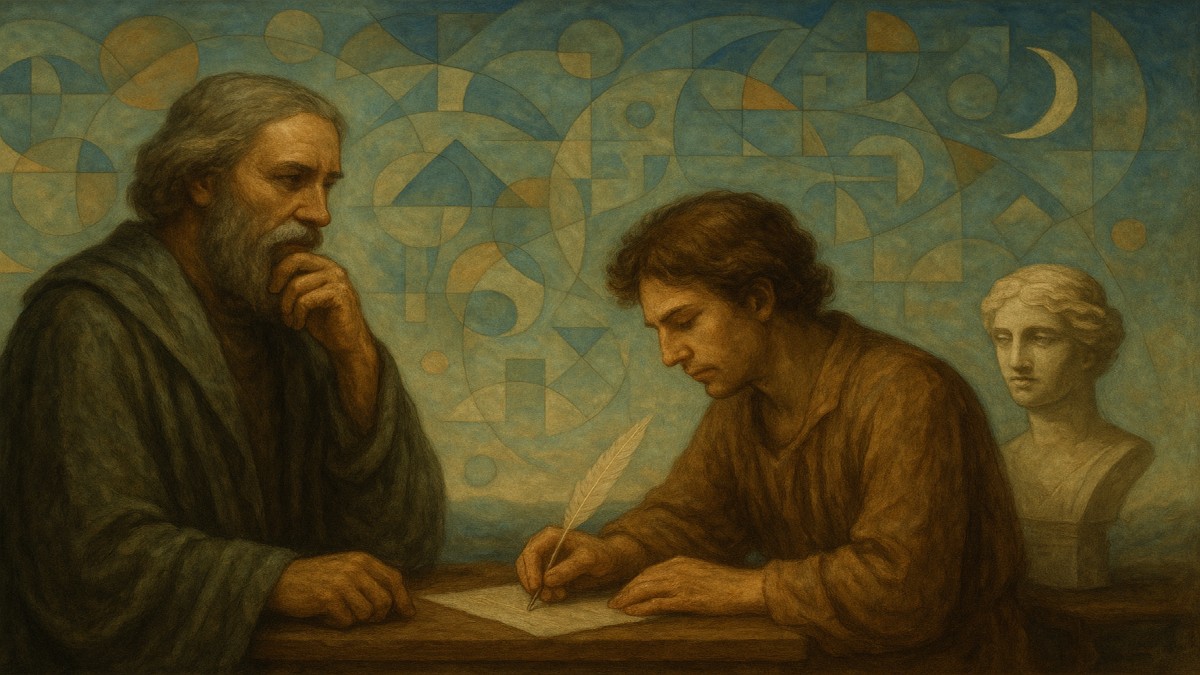
»فـي البدء كان الشعـر «
» الشعر هو الفلسفة قبل الفلاسفة «
« سيتعلم الفلاسفة كثيرا لو أنهم أصغوا جيدا إلى الشعراء » بَشْلار
لم يتردد «نيتشه» في أن يقدم لنا أفكاره في نوع من الشعر الغنائي. وهناك من شكك فيه بوصفه فيلسوفا، لكننا – يقول Alquié – صرنا نسمع اليوم أنه أب الفلسفة المعاصرة. وإن نمطا جديدا في التفلسف قد بدأ معه. يبدو أن تلك الصورة التي شُيّدت عن الفيلسوف باعتباره العقلاني صاحب البرهان والحجة قد انتُقدت نقدا لاذعا. من هنا، نتساءل: هل استطاع الفيلسوف يوما أن يجتاز مرحلة الخيال، لكي يقبض على الحقيقة بجُمْع يديه، ويزعم لنفسه أنه ليس في فلسفته سوى البداهة والوضوح واليقين والنظر العقلي الخالص؟ أو هل نجح الميتافيزيقي يوما ما في القضاء على الأساطير والرموز والشفرات، حتى يدعي أنه ليس في مذهبه سوى نتائج مستخلصة من مقدمات؟!
كتب الفرنسي «جان فال» Jean Vall عن العلاقة بين الميتافيزيقا والشعر قائلا: «أيها الشعر [الميتافيزيقا تخاطب الشعر]، إنكـ لَعَمْرِي أخي الوفيّ، فليرتفع صوتك عاليا، ولتعلم أنني أنصت إليك، فإنني حينما ألقي إليك السمع، إنما أكون أنا المتكلمة!». فهل يجوز القول إن الميتافيزيقا هي شعر الفلاسفة وأن الشعر هو ميتافيزيقا الأدباء؟
يبدو أن الفيلسوف أو الميتافيزيقي حريص على أن يقاس مذهبه بمقياس الحق، في حين أن الشاعر يتطلب منا دائما أن نحكم على شعره بمعايير الحسن والقبح لا بمعايير الصدق والكذب. ولكن العلاقة بين الشعر والفلسفة وثيقة، وآية ذلك أن الشاعر قد يجيء فيكشف لي عما في الطبيعة من عنصر ميتافيزيقي، أو يظهرني على ما في اللحظة العابرة من طابع أزلي. ثم إن الفيلسوف كثيرا ما يستعمل صور شعرية حين يحاول النزول إلى سر الوجود أو الصعود إلى ما وراء النجوم. ومعنى ذلك هو أن الميتافيزيقي على حد تعبير «جاك ماريتان» Jacques Maritain إنما هو ذلك «المفكر الذي يؤمن بأن عقل الإنسان يعلو على الإنسان، وأن في وسع الموجود البشري بوصفه موجودا ميتافيزيقيا أن يطير بأجنحته!».
إذا سلمنا بأن علاقة الإنسان بالكون هي المشكلة الميتافيزيقية الأولى، سنجد أن الشعراء قد اهتموا بها على طريقتهم. فهذا «لُكُونت دو ليل» Leconte De Lisle يهتف في “أشعاره البربرية” قائلا: «أيها الإنسان؛ إن السماء خرساء، والأرض نفسها تزدريك [ولا تكف عن احتقارك]»، وهو قول يريد بيان أن العالم آلية عمياء، وأن الإنسان نفسه ليس سوى عرض زائل لا معنى له. وهذا «ألفريد دي فني» Vigny يعبر – في قصيدته “بيت الراعي” – عن عظمة الإنسان وقدرته على فرض نظامه الخاص وقيمه الإنسانية على الكون، فيقول: « لقد أضاء الراعي مسكنه المتواضع، فأثبت أنه أعظم من الكون الذي يتجاهله، إذ استطاع أن يحكم عليه ».
من ذا الذي يمكن أن ينكر معاناة الإنسان الحديث التي تحدث عنها الفيلسوف والشاعر؟ يقول الشاعر الألماني «هولدرلين»، معبرا عن فكرة هايدغر، وواصفا شقاء الإنسان الحديث بعد أن خلقته الآلهة وحيدا لا سند له ولا عون، أن الحقيقة القدسية لم تمت، ويُبشّر الإنسان الحديث بمقدم إله جديد: «ففي أعماق العدم الذي يرين على الموجود البشري من كل صوب، إنما تكمن تباشير الفجر الإلهي الجديد».
وعن قيمة اللحظة الآنية أو “الآن” يكتب الشاعر الانجليزي الصوفي «ويليام بْلِيكـ» W.Blake مُعبّرا عنها وكأنها الأبدية بعينها قائلا: «حين ترى الجنة في زهرة برية، وترى الدنيا في حبة رمل واحدة، فكأنما قبضت على السرمدية بيمينك، وعشت الخلود في ساعة زمن! ».
يكتب الصوفي الكبير «جلال الدين الرومي» عن حقيقة الإنسان وعلاقته بالموجودات، قائلا: «عشت تحت الثرى في عوالم الأحجار وخامات المعادن.. ثم ابتسمتُ لزهور عديدة الألوان.. ثم تجولت مع الوحش في البرية ساعات.. فوق الأرض وفي الهواء وفي مناطق المحيطات.. وفي ميلاد جديد غطست تحت الماء.. وطرتُ في الهواء.. وزحفت وجريتُ.. وتشكلت كل أسرار وجودي في صورة أظهرتها للعيان.. فإذا أنا إنسان.. ثم صار هدفي أن أكون في صورة ملاكـ.. وراء السحاب .. وراء السماء.. في عوالم لا يتغير فيها أحد ولا يموت.. ثم أمضي بعيدا وراء حدود الليل والنهار.. والحياة والموت.. سواء كانت هذه الحدود مرئية أو غير مرئية.. حيث كل ما هو كائن؛ كان دائما واحدا وكُلا».
هكذا يظهر لنا أن الشعراء قد شعروا ببعض المشكلات الميتافيزيقية، فحاولوا أن ينقلوا إلينا إحساسهم بالوجود، وشعورهم بقيمة الإنسان، وفهمهم للعلاقة بين الإنسان والكون والإله والأبدية… وليس معنى هذا أن الشاعر ميتافيزيقي بمعنى الكلمة من حيث بناء مذهب متكامل. كما أن الميتافيزيقي ليس شاعرا يبدع القصائد ويتفنن في جمال الكلمات، وإنما القصد أن هناك تقاطع وتكامل بينهما في الاقتراب من سر الوجود والحياة؛ تكامل في مجاورة الحق والجمال والخير!
نختم مؤكدين أن الفلسفة قد تكونت «في عملية نشاط روحي وفكري لا ينفصل فيه النثر والشعر والأسطورة والدين والعلم ومتطلبات الحياة والعمل، وتشكل مجموعها وحده متكاملة. فلما انفصلت الفلسفة عن هذه الميادين بقي الفيلسوف حيّا في هؤلاء الذين انفصل عنهم، كما تبقى فيه شيء منهم». فهل الفيلسوف والعالم والفنان والشاعر… صور مختلفة للإنسان الذي يشترك في شيء ما، يلفُّه الغموض، مع الموجودات؟ وما سر الشعور بالقرابة بيننا وبينها؟ هل صنائعنا تعبير، لا شعوري، عن محاولة لفهم الأصل؟ وما طبيعة هذا الأصل؟
ــــــــــــــــــــــ
الـمـراجــــع:
ـ الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، المركز الثقافي العربي، ط1، 1990.
ـ إقبال محمد، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة محمد يوسف عدس: دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2011.
ـ زكريا ابراهيم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، القاهرة، بدون تاريخ.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.