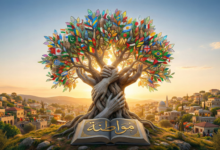الإجهاد الإعلامي؛ حين تتحوَّل وفرة المعلومات إلى عبء نفسي ومعرفي

في ظلِّ الطفرة الرقمية المتسارعة، تحوَّل الإعلام من أداة تواصل ونقل خبر إلى منظومة معقَّدة تتداخل فيها المعطيات النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية. ومع اتساع منصات الإعلام الرقمي، وتعدد مصادر الأخبار والمحتوى، بدأ يطفو على السطح مفهوم “الإجهاد الإعلامي” أو ما يعرف بـ Media Fatigue، كمصطلح يعكس حالة من الإنهاك الذهني والنفسي الناجم عن التعرض المفرط والمتكرر للمعلومات.
الإرهاق الإعلامي لم يعد مجرد شعور عابر، بل أضحى ظاهرة متنامية ترصدها الدراسات النفسية والسوسيولوجية، وتتفاعل معها مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام نفسها، خاصة في فترات الأزمات، كجائحة كورونا أو الحروب والكوارث الطبيعية، حيث يرتفع استهلاك الأخبار ويزداد معها العبء المعرفي والعاطفي على المتلقي.
1-في مفهوم الإجهاد الإعلامي: تفكيك العلاقة بين المتلقي والمعلومة في زمن الرقمنة
يعد مفهوم الإرهاق الإعلامي من أبرز تجليات ما بعد الحداثة في الفضاء الإعلامي الرقمي، حيث لم يعد التحدي يتمثل في الوصول إلى المعلومة، بل في القدرة على التعامل معها دون أن تستهلك المتلقي نفسيًا وذهنيًا. الإعلام في زمن الرقمنة لا يقدم المعرفة كخدمة، بل يفرضها كعبء مستمر، ومتسلل، ومتعدد الأشكال، حتى بات حضور المعلومة يشبه ضوضاءً دائمة لا يمكن الهروب منها.
وفقًا لما يطرحه الباحث فينسينت ميلر، فإن التعب الناجم عن تدفق المعلومات لا يرتبط فقط بعدم القدرة على الاستيعاب، بل يتصل أيضًا بتغير بنية الزمن الإدراكي لدى الإنسان، حيث يعيش المتلقي في دوامة من الاستجابات اللحظية المتتالية، ويفقد شيئًا فشيئًا قدرته على التوقف، والتأمل، أو إنتاج معنى شخصي لما يتلقاه. هذا التدفق المستمر لا يتيح المجال للتفكير ولا للتفسير، بل يُبقي الفرد أسير إيقاع متسارع، لا ينقطع، ولا يرحم.
من هنا تظهر إشكالية ما يمكن تسميته بالاستقبال القهري، حيث لا يملك المستخدم حرية اختيار ما يستهلك، بل يُفرض عليه ذلك بشكل غير مباشر عبر خوارزميات ذكية، وتنبيهات دائمة، وإعلانات موجهة، ومحتوى متشابك لا نهاية له. ومع الوقت، يتحول العقل البشري إلى حقل مشوش تتنازع فيه المعطيات، دون أن تمنحه أي شعور بالاكتمال أو الإشباع المعرفي. تتولد عن هذا الوضع حالة من الضجر المعرفي، إذ تصبح المعلومة عبئًا يثقل كاهل المتلقي بدل أن تمنحه وعيًا أو تمكينًا.
يمكن النظر إلى هذه الظاهرة بوصفها أزمة في الوعي المعرفي، حيث لم تعد المعرفة تؤدي دورها التقليدي في توجيه السلوك والفكر، بل أصبحت مصدرًا للشلل المعرفي. يتقاطع هذا التحليل مع ما طرحه بول فيريليو حول السرعة والمعلومة، حيث أشار إلى أن تسارع نقل الأخبار والمحتوى لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الفهم، بل قد يفضي إلى بطء في الإدراك وانفصال عن الواقع. هذا الانفصال يُعرف في علم النفس بتأثير الانفصال المعرفي، حيث تتلاشى القدرة على الربط بين ما يتم تلقيه وبين ما يُعاش واقعيًا، فيغدو المتلقي محاصرًا بمعلومات لا توجّه فعله، بل تزيد من تشتته.
ومقابل نموذج المتلقي الواعي، الذي كان يبحث ويقارن ويُخضع ما يصله للفهم النقدي، برز في السياق الرقمي نموذج آخر: المتلقي المنهك، أو المشتت، الذي لا يملك الوقت ولا الطاقة الذهنية لتصفية ما يُعرض عليه. هذا المتلقي يُطلب منه التفاعل السريع، إبداء الإعجاب، أو إعادة النشر، دون أن يسأل عن المصدر أو الغرض. تؤدي الخوارزميات هنا دورًا كبيرًا في ترسيخ هذا النمط من الاستقبال، إذ تقدم للمستخدم ما يتوافق مع ميوله فحسب، فينشأ ما يُعرف بفقاعة المعلومات التي تعزز العزلة المعرفية وتقلل من قدرة الإنسان على التفكير النقدي والتقاط التناقضات.
في ظل هذا السياق، لم يعد الإرهاق الإعلامي ظاهرة فردية يمكن تجاوزها عبر الانقطاع المؤقت، بل أصبح جزءًا من منظومة كاملة تهدف إلى إنتاج متلقٍ خاضع، سطحي، وغير ناقد. لم يعد الإعلام الرقمي يهتم ببناء وعي، بل بتكريس أنماط سريعة ومشتتة من التلقي، تعمل وفق منطق السوق، لا منطق التنوير. لذلك فإن فهم هذه الظاهرة يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، نفسية وثقافية واجتماعية، ولا يكفي التعامل معها عبر الدعوة إلى التقليل من التفاعل الإعلامي، بل يجب أن يعاد النظر في دور المتلقي نفسه، وتحويله من مستهلك سلبي إلى فاعل نقدي يمتلك أدوات التحليل والاختيار، ويقاوم منطق الاستهلاك الرقمي السائد بما يحافظ على طاقته الإدراكية وكرامته المعرفية.
2-الإجهاد الإعلامي كأزمة وعي معرفي في ظل تسارع تدفق المعلومات
ومع تعمق هذا الإرهاق الإدراكي الناتج عن فيض المحتوى، تتغير وظيفة الإعلام من أداة للإخبار والتنوير إلى منتج يغذي الإشباع السلبي للمعلومة، وهو إشباع لا ينتج عنه وعي أو إدراك حقيقي، بل يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ”التخمة المعرفية المُعطّلة”. فالمعلومة التي تتكرر باستمرار، دون عمق أو تحليل، تتحول من كونها محفّزًا للفهم إلى مجرد ضجيج معرفي يُقوّض الحاجة للتفكير النقدي.
في ظل هذه المعادلة، ينقلب منطق “الإعلام من أجل المعرفة” إلى “المعرفة من أجل التمرير”، إذ تُقدّم المعلومة على نحو اختزالي، وتُستهلك بسرعة، بما يشبه الوجبات السريعة. وهي معرفة لا تُطلب لذاتها، بل لاستكمال دورة الاستهلاك، كما هو الحال في المقاطع القصيرة والفيديوهات السريعة التي تُغذي المتعة اللحظية دون أن تترك أثرًا.
هنا تظهر تحولات بنيوية في طريقة استقبالنا للخبر، للحدث، وللواقع ككل. فالتكرار الكمي للمعلومة لا يعمق الفهم، بل يُنتج تشويشًا معرفيًا، يجعل من التمييز بين المهم والهامشي أمرًا عسيرًا. تضعنا هذه الوضعية أمام سؤال جوهري: هل يمكن أن تُصبح كثافة المعلومة بديلاً عن قيمتها؟ أم أن الإعلام الحديث قد اختزل المعرفة في “جرعات مشاعرية” مصممة لتحفيز الانفعال لا التفكير؟
المثير للانتباه أن هذا التحول لم يغير فقط في طريقة التلقي، بل في بنية المادة الإعلامية ذاتها. فمع صعود المنصات الاجتماعية ومنطق “التفاعل” كمؤشر على نجاح المادة، بدأ الإعلام يُكيّف محتواه بما يخدم هذا التفاعل لا بما يخدم الحقيقة. فالأولوية لم تعد للدقة أو التحليل، بل للعناوين الجذابة، للمحتوى القابل للمشاركة، للمعلومة السريعة التي تخلق رد فعل مباشرًا.
وهنا نقترب من المفارقة الكبرى: كلما ازداد تدفق المعلومات، كلما تضاءلت فرص المعرفة الحقيقية. إنها وفرة تؤدي إلى فقر معرفي، حيث نعرف كل شيء عن لا شيء، ونستهلك المعلومة كما نستهلك منتجًا بصريًا، لا كأداة لبناء موقف أو تشكيل وعي. هذا الانقلاب في الوظيفة الإعلامية يخلق فجوة نفسية واجتماعية تؤسس لما يمكن تسميته بـ”الاغتراب الرقمي”، حيث يشعر المتلقي بأنه حاضر في كل الأحداث، لكنه عاجز عن الفعل أو الفهم.
3-بين التلقي النقدي والتلقي المنهك: نحو فهم آليات الاستهلاك الإعلامي المعاصر.
ومع ترسخ هذه الظواهر، لم يعد الإرهاق الإعلامي مجرد حالة ذهنية عابرة، بل تحول إلى واقع نفسي واجتماعي ملموس، تظهر تجلياته في سلوك المتلقي اليومي وتفاعلاته الرقمية. إذ يبدأ الأمر بما يشبه التوتر الخفي الذي يصاحب المتلقي عند تصفحه المستمر للأخبار المتسارعة، ثم يتحول تدريجيًا إلى قلق مزمن ناتج عن الإحساس الدائم بوجود أحداث لا يمكن السيطرة عليها، أو مآس لا تفهم أبعادها، مما يراكم مشاعر العجز وفقدان الأمان.
في هذه اللحظة، يتحول التلقي من فعل معرفي إلى حالة دفاعية، حيث يصبح المتابع أكثر عرضة لما يسمى بـالتبلد الشعوري، وهي حالة نفسية يفقد فيها الفرد قدرته على التفاعل الوجداني مع المآسي، بسبب تكرارها المفرط وتقديمها دون سياق إنساني. وعليه، لم تعد المآسي تثير التعاطف بقدر ما تحدث انسحابًا عاطفيًا لحماية الذات من الانهيار النفسي، وهو انسحاب يعبر عن نفسه أحيانا في شكل لامبالاة ظاهرية أو حتى سخرية من الكارثة، كمؤشر على الإنهاك النفسي لا على قسوة حقيقية.
يتطور هذا المسار ليصل إلى ما يعرف بـالعزوف المعرفي، حين يقرر المتلقي أن يقاطع الأخبار، أو يختار العيش في ما يُشبه العزلة الإعلامية، كاستراتيجية نفسية للهروب من الضغط المستمر. وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: فالإعلام الذي صُمم ليُقرّب الأفراد من قضاياهم ومجتمعاتهم، قد يدفعهم ـ إذا غاب الوعي والانتقاء ـ إلى الابتعاد عنها، بل والانفصال التدريجي عن الشأن العام.
هذا التأثير النفسي يتقاطع بدوره مع البعد الاجتماعي، حيث تُنتج هذه الحالة نوعا من الاستقطاب السلبي، إذ ينقسم المتلقون إلى فئات منهكة تنسحب من الإعلام، وأخرى تستهلكه بشراهة دون تفكير، مما يُضعف القدرة الجماعية على تكوين رأي عام نقدي وواعٍ، ويجعل المجتمعات أكثر هشاشة أمام خطاب التهويل أو التضليل.
4-الإعلام الرقمي وإنتاج المتلقي الخاضع: دور الخوارزميات في تشكيل الإدراك
أمام هذا الواقع المرهق نفسيا واجتماعيا، تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في الكيفية التي نتفاعل بها مع الإعلام، لا من زاوية الحماية السلبية، بل من منطلق التمكين المعرفي والنفسي. ذلك أن الخروج من دوامة الإرهاق الإعلامي لا يقتصر على الانسحاب أو الإقصاء، بل على بناء وعي نقدي يُمكّن الفرد من اختيار ما يستهلك، وكيف، ومتى.
في هذا السياق، تطرح التربية الإعلامية الرقمية نفسها كحل استراتيجي، إذ لا يمكن مواجهة سيل المعلومات إلا بمنهجية تُدرب المتلقي على تحليل المحتوى، وتقييم مصادره، وتمييز الخبر من الرأي، والحقيقة من الدعاية. هذه المهارات، التي باتت ضرورية في زمن التلاعب العاطفي بالصورة والكلمة، تشكل جدار الحماية الأهم ضد السقوط في فخ الإنهاك الإعلامي.
كما أن تنظيم وقت التعرض للمحتوى بات ضرورة لا رفاهية، في ظل خوارزميات مصممة لإبقاء المستخدم مشدودًا إلى الشاشة لأطول وقت ممكن. إن استعادة السيطرة على الوقت الذهني والمعرفي تبدأ من قرارات صغيرة: كإيقاف الإشعارات، تخصيص أوقات محددة لتصفح الأخبار، أو حتى الانقطاع الدوري عن المنصات. كل ذلك ليس تهربًا من الواقع، بل حفاظ على الاتزان العقلي وسط واقع يرهق بأحداثه المتلاحقة.
في المقابل، تتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية كبيرة في الحد من هذا الإرهاق الجماعي، من خلال مراجعة خطابها التحريري، والانتقال من الإثارة اللحظية إلى التحليل الهادئ، ومن التكرار المُنهك إلى الانتقاء الواعي، بحيث لا يختزل الخبر في عناوين صادمة، بل يقدم في سياق يساعد المتلقي على الفهم لا على التوتر.
هكذا، فإن إعادة تشكيل العلاقة مع الإعلام لا تعني الانفصال عنه، بل تطوير أدواتنا في التفاعل معه. إنها دعوة إلى أن نكون فاعلين لا مستهلكين سلبيين، أن نختار أن نعرف من دون أن نُنهك، وأن نُصغي للعالم دون أن نفقد ذواتنا وسط صخبه المتواصل.
في الختام، يظل الإعلام الرقمي جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، لا يمكننا الهروب منه، لكن يمكننا تعلم كيفية التفاعل معه بشكل صحي ومتوازن. إن الإرهاق الإعلامي ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو تحدٍ جماعي يطال المجتمع ككل. لذا، من المهم أن نعيد النظر في علاقتنا مع المعلومات والأخبار، وأن نطور آليات للتفاعل الواعي معها.
التربية الإعلامية الرقمية، التي تتيح لنا التفكير النقدي وتعزيز قدرتنا على التمييز بين المعلومة والتمويه، هي الأساس لبناء مجتمع قادر على التعامل مع المعلومات بذكاء، دون أن يقع فريسة لتأثيراتها السلبية. كما أن تنظيم الوقت في التعامل مع الإعلام، واعتماد المؤسسات الإعلامية على سياسات إعلامية مسؤولة، يمكن أن يُقلل من التأثيرات الضارة لهذا التدفق اللامحدود من المعلومات.
التحول الرقمي يجب أن يرافقه تحول في طرق استهلاك الإعلام، بحيث يصبح أداة للمواطنة الواعية، لا مصدرا للإرهاق النفسي. إن استعادة توازننا النفسي والاجتماعي في هذا العصر الرقمي يتطلب منا أن نكون أكثر حذرًا ووعيا في تعاملنا مع الإعلام. الإعلام هو أداة تواصل، ويجب أن يستخدم لتعزيز الفكر، لا لتدميره.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.