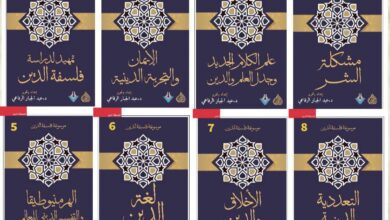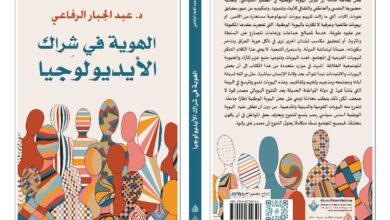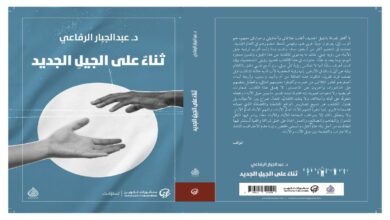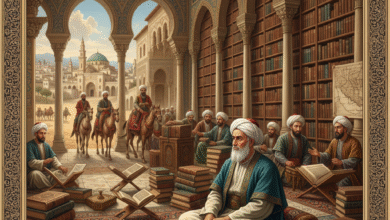الدرس الفلسفي في المدارس الدينية: الواقع وآفاق الانتظار

الدرس الفلسفي في المدارس الدينية: الواقع وآفاق الانتظار[1]
عبداللطيف حاج قويدر[2]
يحرصُ عبد الجبار الرفاعي في كلِّ فرصة سانحةٍ على بيان أهمية الفلسفة وضرورتها، وتبايُن مجالها عن مجالَيْ العلم والدين، وانفرادِها بخصائص تفكيرها من خلال تجرُّدها وموضوعيتها، وتوليدها الأسئلة التي بها تتنوَّع وتغتني وتتطوَّرُ الرؤى والآراء، وغايتُها الحقيقةُ من حيث هي الحقيقةُ فقط. وهي ابنة عصرها وبيئتها وظروفها، لذا فاهتماماتها وإشكالياتُها وبناء أفُقِها من صميمِهمْ، وتتماهى المعرفة الإنسانية بها في حالتيْ بسطِها وقبضها، وكلُّ محاولةٍ لتدجينها آيلةٌ بصفة حتميةٍ إلى الفشل،
وفرَّق الرفاعي بينها وبين علم الكلام الذي يُصدِر به البعضُ كتاباته مسوِّقاً إياها تحاليلَ فلسفيةً، ثمَّ انتقل إلى بيان حالِ الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية، فذكرَ أنَّه لم يكن في ماضي العصور على وفاقٍ مع الدرس الفقهي، فقد كان للأخير حضورٌ متسيِّدٌ جعل الكلَّ يتودد إليه، والكلُّ يريدُ الحصول على أكبر نصيب منه، كان أسداً بين الدروس يصول بكل أريحية، فإذا ما أطلَّ الدرسُ الفلسفي لوَّحَ به بعيداً مُخرجاً إياه من دائرةِ الاهتمام، فيلجأ الدرسُ الفلسفي إلى التقيَّة والتخفِّي منتظراً أن تتهيَّأ له ظروفٌ أفضل وشروط أحسن، كان الدرس الفلسفي بين ظهورٍ محتشمٍ وتخفٍّ مُتَحَيِّنٍ، لكنَّ العجيبَ أنَّه مع كلِّ هذا التضييق والازدراء أدَّى ـ في فترات استرخاء الدرس الأصولي ـ دورَه في تحصين العقول وبناء التفكير المنطقي، وإرساء آلة السؤال، نجح في تكوين أصوليين فلاسفة آحادٍ من كلِّ جيلٍ، شهد لهم أقرانُهم بعمق ما يطرحون، وجودة ما يقدمون، وحلَّ العصر الحديث، وحلَّتْ معه آلياتُه الجديدة وتحدياتُه غير المسبوقة، وأسئلتُه المربكة، وأصابتْ ألسِنةُ لهبِه اللافحةُ أروقة الدرس الحوزوي، الذي بدا عليه الإحراجُ، فلم يكن له بدٌّ من الاستعانة بالآلية الفلسفية. أدركت المدرسة الدينية أنَّ الدرس الفلسفي هو وحده المخوَّلُ له مثل هذه المواجهات، فلم تلبث أن اعترفتْ له بقيمته، وبوَّأتْهُ مكانته.
وفي فترة التحول هذه كان الرفاعي يدرجُ أولى خطواته في نهْل دروس الحوزة، فاغترف منها ما شاء له الاغترافُ، ونال من علوم الأصول وسائر العلوم ما جعله فارساً فيها، ونال مثلها من الدرس الفلسفي، ونالَ منه الأوَّلُ حظَّ التَّأليفِ فيه، واستغرَقهُ الثاني تدريساً ومناقشةً حواليْ أربعين عاماً، وترجم له كتباً إلى العربية ككتاب “شرح المنظومة المبسوط” في أربعة أجزاء، و”محاضرات في الفلسفة الإسلامية” ص47.
وبحكم المعرفة ومراكمة الخبرة والتجربة، عرف مكامن القوة والضعف في كلٍّ من الدرسيْن: درس الأصول ودرس الفلسفة، ووفاءً منه لحوزته، واعترافاً بمقامها، وحرصاً على جودة معارفها، وردّاً لبعض أفضالها استقلَّ بالدَّرس الفلسفي، يدرسُه من جميع زواياه، مخضعاً إياه لعملية الجَرْح والتعديل على طاولة النقد بمنهجية الباحث الموضوعي المتجرد، بدأ بالدرس القديم، فأشار إلى أنَّ منهجه المُعدَّ للتدريس مرهِقٌ معقَّدٌ يستنزف جهداً عقلياً مضنياً ووقتاً يُعدُّ بالسنوات، بسبب اعتماده المتونَ الشعرية، التي يُطلق عليها اسمُ “المنظومات”، وهي ملغزة الاصطلاحات متشعبة المقولات ص31، أو كتبٍ نثرية كَالأسفار الأربعة لصاحب “مدرسة الحكمة المتعالية” ص35.
أمَّا بالنسبة للدرس الفلسفي الجديد، فأشار الرفاعي إلى أنه وإنْ تخلص من المنظومات لكنه لم يتمكن من الاستغناء عن “الأسفار الأربعة” وهي مع علُوِّ شأوِها وعمق معارفها، ما زالتْ تستنزفُ العمر لاستيعابها، وهو ما لا يسمحُ به العصر الحديثُ، كما تنتمي بعض مقولاتها وأسلوب صياغتها لزمانٍ آخر غير هذا الزمن، ولفَت النظرَ إلى تغييبٍ غيرِ مبرَّرٍ لأعمال فلاسفةٍ مسلمين من أمثال الكندي والفارابي وابن باجة وابن رشد ص49.
وهالَه افتقارُ أساتذة الدرس الفلسفي للغات الأجنبية، وبالتالي جهلهم لفلسفاتها ومفاهيمها، ومقولاتها ومناهجها، ومقارباتها وطرق تحاليلها واختلاف زوايا نظرها. جهلُهُم هذا جعلهم ينكفئون على اجترار مقولاتٍ تاريخية قديمةٍ ضئيلة الفائدة، أوْ على ترجماتٍ هاويةٍ متفاوتةٍ، قدْ لا تفي بالغرض، أو قد يختلطُ سمينُها بغثِّها، كما أَشارَ إلى غيابِ الحاسَّة النقدية ـ آلةِ الفلسفة ـ التي تُصاحبُ الدَّرسَ مصاحبة الظلِّ، مع إضفاءِ حالة تعظيمٍ مبالَغ فيها للفلسفة الصدرائية ص69. شدَّد على ضرورة تحلِّي دارس الفلسفة بحاسَّة النقد التي هي صنوُ الفهم والتجديد والإبداع، ولكيْ لا تكون ملاحظتُه حبيسة إطارٍ نظري، تقدَّم بمثال عن رؤيته النقدية إزاء كتاب الأسفار الأربعة، فأبدى تأييده لبعض مقولاته، وتحَفَّظَ عن مقولات أخرى، وبيَّنَ السَّقطاتِ التي وقع فيها كاتبُها ص128، وقام بنقدِ رؤى وأفكار هنري كوربان التي طرحها في حلقة الطباطبائي الفلسفية في طهران ص130، مع أن الطباطبائي نفسه كان معجباً بها، وتناول أيضاً بالدَّرسِ والنَّقد كتاباً ذائع الصيت، وهو “فلسفتنا” لمحمد باقر الصدر معلِّلاً ومستدلاًّ ص 58. ص129.
ثم عرج على مدرسة النجف العريقة، صنيعةِ الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري، والمتجدِّدة على يد السيد حيدر الآملي في القرن الثامن الهجري. هذه المدرسة العصيَّةُ على الدرس الفلسفي، لم تكنْ تحملُ له أيَّ ودٍّ، لذا اضطرَّ العالمُ العارف حسين قلي الهمداني صاحب المدرسة السلوكية إلى مزجه بالدرس العرفاني ص167، لكنَّهُ لمَّا كان التشدُّدُ أجذرَ وأقوى اضطرَّ المشتغلون به إلى الهجرة.
وأفرد له الرفاعي فصلاً مبيِّناً ريادة العلامة الطباطبائي للفلسفة الشرقية منتصف القرن العشرين، ترعرعت ملَكَتُهُ العلمية في النجف وأكملها في قم. أحبَّ الفلسفة ونبغ فيها، وأينعتْ ثمارُها فيه، وعمل على جنْيِ قطوفها في مدرسة قم، ونجح في الذَّبِّ عن حياضها ورفْع الحواجز ومجاوزة المصدَّات، وأحدث في تدريسها ثورةً في مناهجها التعليمية وبيداغوجية إيصالها.
اعتبر محور “المعرفة” أولى وأسبقُ في الاهتمام من محور “الوجود”، وألَّف للطلبة منهجاً دراسياً جديداً، يتمثل في كتاب “بداية الحكمة” بديلاً عن منظومة السبزواري المعقدة، وكتاب “نهاية الحكمة” بديلاً عن أسفار ملا صدرا الشيرازي الأربعة. وأسَّس في قم “حلقة قم الفلسفية” رشَّح لها خِيَرَةَ طلبته، يعقدون أسبوعياً تحت إشرافه لقاءيْن مستغرَقَيْن مناقشةً وحواراً في إشكاليات يختارُها الطباطبائي، أسفرتْ عن إنجاز سَفْرِ “أصول الفلسفة والمذهب الواقعي” في خمسة أجزاء ص126. 127، وتخرَّج على يديْه جيلٌ فلسفي رائدٌ بنى الصَّرحَ الفلسفي المعاصر في حوزات وجامعات إيران.
ويقوم نهجه الفلسفي على: اعتماد البرهان، وفصل الإدراكات الحقيقة عن الاعتبارية، ومنهجة المسائل الفلسفية وإيضاحها وإيجازها، وتجاوز المنهج الطبيعي الكلاسيكي الفلسفي، واستلهام الحكمة الإلهية من الكتاب والسنة، واعتماد المنهج المقارن، ومن آرائه الفلسفية التي أبدعها وارتبطتْ به: تقرير برهان الصديقين، وإيجاد الفرق بين الإدراك الحقيقي والاعتباري، واستخلص ثمرات نظرية الحركة الجوهرية التي لم يستطعْ مكتشفُها جني ثمراتها، فقال بالبعد الرابع، والحدوث الزماني لعالم المادة والطبيعة ص131، وأشار الرفاعي إلى تميُّزه “عن معظم رجال الدين بنزعته الإنسانية المعنوية الأخلاقية” وتمتُّعه “بحرية عقلية رحبة في التفكير” ص144.
فإذا كان الدرسُ الفلسفي المضَيَّقُ عليه والمطاردُ قد استطاع إنجاز مدرسة متكاملة الأركان، مدرسة “الحكمة المتعالية”، ومذهبٍ فلسفي تجاوز به محمد باقر الصدر في كتابه “الأسس المنطقية للاستقراء” المذهبيْن العقلي والتجريبي ص36، واستطاع صناعة فلاسفةٍ بقياسات عالمية، فما الذي سينجزه هذا الدرسُ في هذه المدرسة إذا أتيح له الحرية والانعتاق وحسن التقدير والاحترام؟ أعتقدُ أنَّ هذه هي رسالةُ الرفاعي التي نستشفها من بين ثنايا هذا الكتاب.
[1]مراجعة كتاب الدرس الفلسفي في المدارس الدينية. الواقع وآفاق الانتظار. تأليف: د. عبد الجبار الرفاعي. منشورات تكوين الكويت. ط1 يوليو 2024.
[2] كاتب جزائري.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.