التَّفاهة كجزء من الحل؛ قراءة فلسفيَّة في جدليَّة السطح والعمق
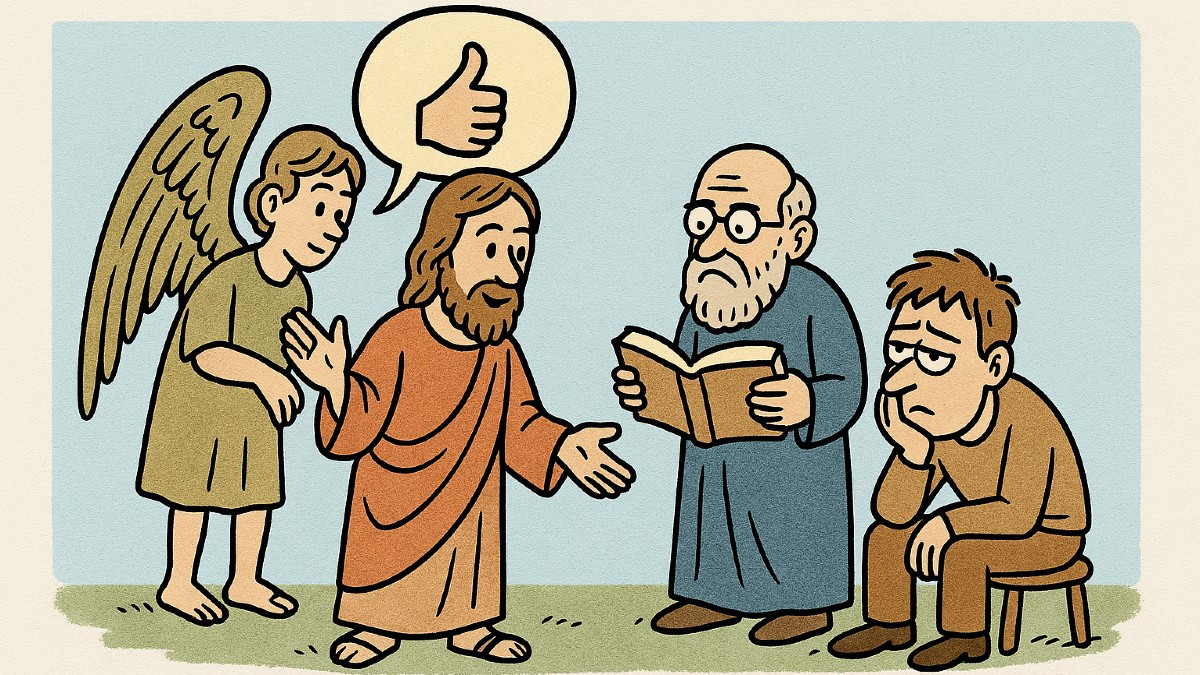
من إعداد: ذ. أمين عبد الحي
في عالمٍ مثقلٍ بالأسئلة الوجودية والهموم الكونية، تبرز التفاهة كعدوّ ظاهر للعقل الجاد، وكمعطى يومي تافه يُستصغر في الحقول الفكرية الكبرى. لكن، ماذا لو كانت التفاهة ليست مجرد عَرَضٍ جانبي في حضارتنا، بل جزءًا من الحل؟ ماذا لو كانت التفاهة، في انحدارها الطفيف، تحمل سرًّا من أسرار النجاة في عصرٍ يطغى عليه الهوس بالمعنى؟
حين نُمعن النظر في بنية الحياة اليومية، نجد أن التفاهة تسكن تفاصيلها: نكتة تُروى في مقهى، مشهد سخيف في مسلسل، أو محادثة لا طائل منها . هذه العناصر التي تبدو بلا قيمة، تُمارس في العمق دورًا شبيهًا بما أسماه ميشيل فوكو بـ”المقاومة الميكروية”. التفاهة، في هذا السياق، ليست انحدارًا أو انحطاطًا، بل مقاومة ناعمة تُخفف من عبء الجدية المفرطة، وتُبقي الإنسان في توازن هشّ بين العبث والمعنى.
الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، حين يُحلّل ظواهر الثقافة الشعبية، يبيّن كيف أن السخافة قد تكون تمويهًا يُخفي حقائق أكثر عمقًا. بل إن التفاهة قد تكون طريقة لمقاومة أنظمة القمع التي تتسلل من خلال الأيديولوجيا “العاقلة”. إذن، ففي كل ضحكة فارغة، وفي كل لحظة ضياع ظاهر، تكمن إمكانية للانفلات من قبضة الجدية السلطوية.
في الفكر الإيديولوجي الطهراني، كل لحظة يجب أن تكون ذات مغزى، وكل قول يجب أن يُخدم فكرة عليا. هذه النزعة الطهرانية، على الرغم من نقائها الظاهري، تتحول بسرعة إلى شكل من أشكال الإرهاب الرمزي: تَحقير للضعف، ازدراء للمتعة، ورفض للغريزة. وهنا، تأتي التفاهة كـترياق مضاد، كفضاء يسمح للإنسان بأن يكون ناقصًا، عاديًا، وأن يخطئ بلا خوف من الطرد من مملكة الطهر.
إن فكر التفاهة يفضح وهم المثالية المطلقة، ويعيد الإنسان إلى واقعه النسبي، المشوش، المليء بالهشاشة. ومن ثم، تصبح التفاهة ضربًا من الاعتراف بحدود الذات، وكأنها تقول: “لا بأس أن أكون بسيطًا، لا بأس أن أكون غير استثنائي.”
قد يرى البعض أن التفاهة مرادف للجهل، غير أن هذا الجهل نفسه ليس دائمًا عدوًا. في بعض الأحيان، يُمكن للجاهل أن يُعبّر عن الحقيقة ببراءة تفوق تعقيد المثقف. الطفل، المجنون، والعجوز الذي يتكلم من دون حذر، قد يقولون أشياء لا يدركون عمقها. والتفاهة، في هذا السياق، هي نوع من الحكمة اللاواعية التي لا تثقل نفسها بالبراهين.
هكذا نفهم كيف أن الشعوب، في نكاتها وسخريتها اليومية، تصوغ فلسفة مضادة للأنظمة الكبرى. فبين ضحكات البسطاء، تتراءى لنا حكمةُ لا يمكن للأنظمة الرسمية أن تُنتجها: إنها حكمة التفاهة.
الوعي، حين يبلغ ذروته، يتحول إلى عبء. فمن يفكر طويلاً في الموت، قد ينسى أن يعيش، ومن ينغمس في تأمل الشر، قد يُصاب بالشلل. من هنا، تلعب التفاهة دور الاستراحة الوجودية، فتكون مثل قيلولة قصيرة في خضمّ معركة الوعي. في لحظات السطحية العابرة، يتنفس الإنسان، ينسى، يتجاهل، ويتحرر.
الفيلسوف الروماني إميل سيوران قال: “لو لم يكن بوسعي أن أكون تافهًا، لانتحرت.” في هذا التصريح تكمن ذروة الفهم: التفاهة ليست نقيض الحياة، بل وسيلتنا للبقاء فيها.
نحو أخلاق جديدة: فلسفة التفاهة النبيلة
إن الاعتراف بقيمة التفاهة لا يعني الترويج للبلادة أو الاستسلام للسطحية، بل هو دعوة لأخلاق جديدة: أخلاق تسمح بالتعدد، بالضحك، بالخطأ، وباللاجدوى أحيانًا. في هذا الإطار، تتحول التفاهة إلى فعل فلسفي يحمل تمرّدًا خفيًا ضد الاستبداد الرمزي الذي يُريد أن يجعل من كل لحظة لحظة عظيمة.
في زمن مهووس بالإنتاجية والمعنى والإنجاز، تصبح التفاهة شكلًا من أشكال العصيان: أن تجلس وتشاهد شيئًا سخيفًا، أن تضحك على نكتة لا معنى لها، أن تُضيع وقتك… هو أحيانًا أصدق تعبير عن حريتك.
قد تكون التفاهة، في نهاية المطاف، العمق متخفيًا. فالعمق الحقيقي لا يحتاج إلى تكلّف أو تكبّر، بل يمرّ أحيانًا من خلال السخرية، الهزل، والعاديّ. ومن ثم، فإن اعتبار التفاهة جزءًا من الحل لا يعني التنازل عن المعنى، بل إعادة صياغته: معنى لا يَختنق تحت عبء الجدية، بل يتنفس، يتحرك، ويختبئ أحيانًا وراء قناع السطح.
في التفاهة، نتحرر. وفي هذا التحرر، قد نجد الطريق إلى المعنى الذي نبحث عنه بإلحاح قاتل.
ومع كل ما سبق، تبقى التفاهة سلاحًا ذو حدين. فرغم كونها أحيانًا ضرورة نفسية، ومتنفسًا للذات وسط صخب الحياة وتعقيداتها، فإن الإفراط فيها، أو تحويلها إلى مبدأ أعلى يُقدّس ويُحتذى، قد يشكل خطرًا كبيرًا على المعنى والوعي الجمعي. عندما تصبح التفاهة معيارًا للنجاح، أو تحل محل العمق والمعرفة في الثقافة العامة، فإنها تُسهم في تمييع القيم، وإنتاج وعي سطحي هش، غير قادر على طرح الأسئلة الجوهرية أو مواجهة الأزمات. من هنا، يصبح من الضروري إعادة ضبط علاقتنا بالتفاهة: أن نُبقيها في هامش الحياة لا في مركزها، وأن نعي متى تكون متنفسًا ومتى تتحول إلى تهديد للفكر والحرية والكرامة الإنسانية.
المراجع :
كتب
سلافوي جيجيك – “العيش في نهاية الزمن” (Living in the End Times):
إميل سيوران – “اعترافات لحميم” و”المياه السوداء”:
ميشيل فوكو – “المراقبة والمعاقبة” و”تاريخ الجنون”:
مقالات :
“The Philosophical Significance of Triviality”
“Banality and Resistance in Everyday Life”
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




