ٳتيقا العدل في رسالة تدبير المتوحّد لابن باجة: “المفاهيم والتجلِّيات”
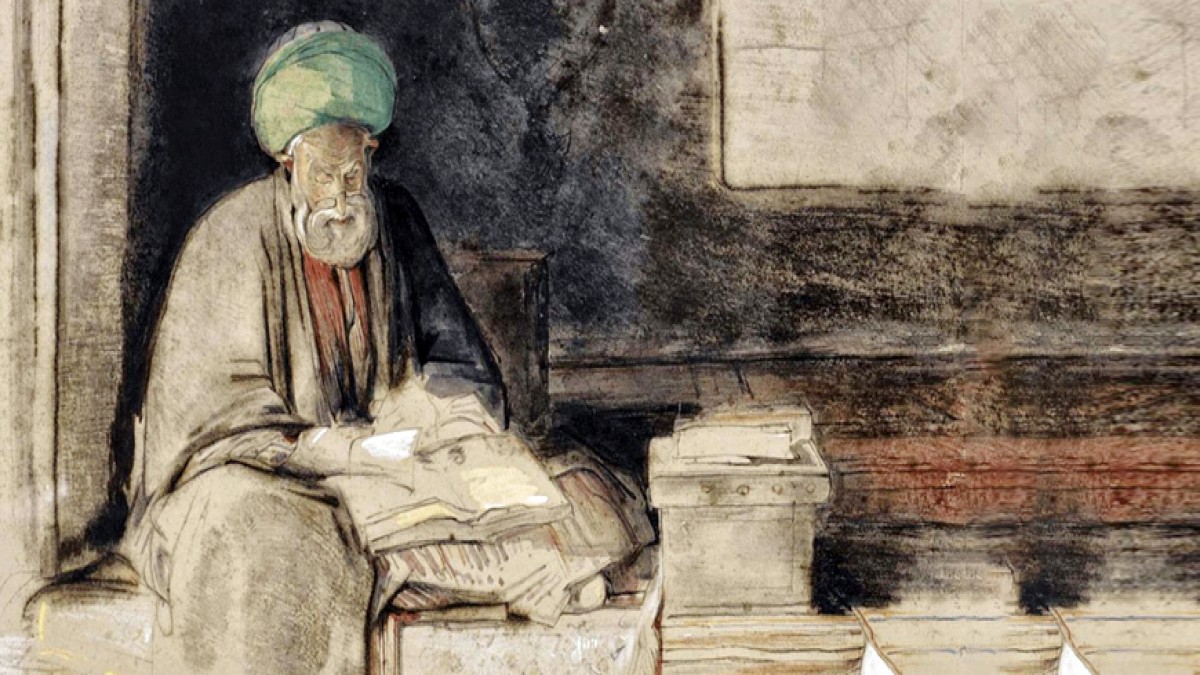
الملخص:
نخصص هذه الورقة لعرض آراء وأفكار ابن باجة حول العدل من منظور إتيقي، في رسالته “تدبير المتوحد”، في إطار سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية. وتوضيح تباين فلسفته السياسية عن أفلاطونية الفارابي. إذ يبتعد ابن باجة عن فكرة الحاكم الفيلسوف المرتبط بالنظام الإلهي، معتبرا أن الفلسفة والسياسة العملية لا ينسجمان. حيث تكمن مشكلته الأساسية في كيفية اندماج الفيلسوف الحكيم في مجتمع ناقص. ويشير ابن باجة في فلسفته إلى “النّوابت”، أي الفلاسفة الذين يعيشون في مجتمعات غير مكتملة، حيث يفتقرون إلى تطلعات المجتمع المشترك. ويكون هدفهم الأساسي هو تحقيق السعادة والأمان، لكن دون أن يتلوثوا بالرغبات الجماهيرية أو الأنماط الاجتماعية التقليدية. يربط ابن باجة أفكاره بجانب واقعي من الفلسفة السياسية الأفلاطونية، والذي يعترف فيه بعيوب الدولة بدلاً من تصور نموذج مثالي. حيث يرى أن الفيلسوف يجب أن يعيش بين الناس، ولكن دون أن يسعى للكمال بينهم، مما يعكس نظرته المتشائمة إلى السياسة والمجتمع.
الكلمات المفاتيح: ابن باجة، تدبير المتوحد، المفرد، النوابت، العدل، الإتيقا، الصور الروحانية.
مقدمة:
لما كان تاريخ الفكر الفلسفي يروي لنا في بعض جوانبه بعضا من المحاولات التي قام بها الأفذاذ من رجال الفكر في حل ٲهم المعضلات الكونية والجهود التي بذلوها، والمشقات التي احتملوها من جراء أيمانهم بمبادئهم، كان من المفروض على المهتم بتاريخ الفكر أن يلم بهذه العوامل المؤثرة تٲثيرا فعليا في محطات تكوين هذا الفكر ومساراته.[1] وهذا حال معظم فلاسفة الحقبة الوسطية من تاريخ الفكر الإسلامي.
كان سؤال العدل من بين أهم الأسئلة التي شغلت بال الفلاسفة المسلمين واستأثرت باهتمامهم، فأنتجوا في هذا الباب وفي مراحل زمنية مختلفة، ٲعمالا ونصوصا متنوعة، أبانت عن علو شأنهم المعرفي وعمق تفكيرهم، ومن أهم المفكرين الذين برز اسمهم في هذا السياق نذكر اسم العالم والفيلسوف الأندلسي ٲبي بكر ابن الصائغ الملقب بابن باجة. فقد ساهم ابن باجة من جهته بنصيب وافر في إغناء مبحث السياسية ومعها الأخلاق وذلك عن طريق صياغة نموذج نظري لمفهوم العدل، ينسجم وتطلعات البيئة الإسلامية التي عاش فيها. ومما يحسب في تأليف وأعمال الرجل أصالتها، و تفردها بأسلوب خاص وطابع علمي مميز، لاسيما وأنه قد خط لنفسه طريقا آخر مختلفا عمّن سبقه إلى الكتابة في هذا المجال، وكان أكثر تعبيرا عن واقع الفكر الفلسفي في عصره،[2] فضلا عن أنه كما يقور الجابري في حق فلسفة وفكر الرجل قد تحرر من إشكالية التوفيق التي دشنها المشرقيون بين الدين والفلسفة أو بين العقل والنقل، ويكشف الجابري عن ذلك بشكل صريح في بنية العقل العربي قائلا “دشن ابن باجة في الثقافة العربية الإسلامية خطابا فلسفيا جديدا متحررا من علم الكلام وإشكالياته ومن هاجس التوفيق والتلفيق، الذي استولى على فلاسفة الشرق.“[3]
تحديدات مفاهيمية:
قبل أن نشرع في قراءة و بيان موضوع العدل عند ابن باجة، ومحدداته وشروطه لابد من فحص بعض المدلولات المفاهيمية، وبالتالي استجلاء معانيها بدقة.
يحرص ابن باجة في مبدأ حديثه في رسالته “تدير المتوحد” على استحضار الدلالات، والمعاني المتعددة لأحد المكونات الرئيسية لعنوان رسالته وهو مفهوم التدبير، فيبدأ أساسا في تحديد على ما تقال لفظة التدبير. فمن أشهر دلالاتها يقول ابن باجة في لسان العرب: “ترتيب أفعالٍ نحو غاية مقصودة.”[4]
فاللفظ يدل عنده في أشمل معانيه على مجموع الأفعال التي نرمي بها الى تحقيق مقصد معين. لينتقل إلى حصر المفهوم في تعريفات مفصلية ودقيقة أكثر.
يتبين للوهلة الأولى أن ابن باجة يفصل بين ثلاث تحديدات أساسية للفظ ومعنى التدبير:
أولا: أن التدبير مجهود فكري وقوة عقلية تنحو نحو غاية مقصودة. ما يجعل اللفظ مشروطا بالضرورة بشرط معين.
ثانيا: عبارة عن سلسلة من الأفعال المتتالية المدبرة وفق رؤية ومنهج معينين، والمسخرة نحو غاية مقصودة. ما يجعل فعل التدبير خاصية إنسانية صرفة، مادام أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتفرد بخاصية التفكير ويتعقل وجوداته. وهذا التعريف الذي حدده ابن باجة هو علة تسمية الإله بمدبرٍ للعالم عنده حيث يقول: “ولذلك لا يطلقونها على من فعل فعلا واحدا يقصد به غاية ما. فإن من اعتقد في ذلك الفعل ٲنه واحد لم يطلق عليه التدبير.”[5]
ما يجعل لفظ التدبير عنده ينقسم إلى نوعين أو مستويين:
تدبير استباقي: يكون بالقوة وهو ذلك التدبير العقلي ٲو النظري الذي يختص به الإنسان دون سائر الكائنات. ما يجعل التدبير مفهوما مرتبط أساسا عنده بملكة التفكير، فهو يحيا داخل التوظيف الكلي للعقل، ومع الفكرة ولا يحرز وجوده دونهما. علما أن التدبير القائم على التعقل، والناتج عن روية وتبصر هو ما يحقق الشرط الإنساني للوجود. وهو بمثابة فعل يسبقه تنظير وتخطيط عقلي لفعل نرمي به نحو تحقيق غاية مقصودة، لأن الترتيب يقتضي بالضرورة التفكير والتخطيط ويحتاج إلى تدبر.
لذا لا يمكن تصور وجود هذا الأخير في نظر ابن باجة خارج إطار الفكرة باعتبارها الفضاء الذي يدبر فيه الفعل وفق مخططات و استراتيجيات قبلية، ووفق منطق حكيم خاضع لحكم العقل وضوابطه، فهو بمثابة نظام للنفس وخطة مقررة تسير عليها .[6]
ثم التدبير بالفعل: ومؤداه تلك الصورة النهائية للتدبير التي يتحقق بموجبها الفعل بالفعل.
ويرى ابن باجة أن المعنى الأول للتدبير الذي يكون بالقوة ينسجم أكثر مع دلالة التدبير، ما يجعله يؤدي المعنى أكثر من الثاني، كونه يرصد لنا فعل التدبير لا كفعل واحد بل كأفعال متعددة تتمثل أساسا في التخطيط والتفكير، وهذا دليل التسمية عنده.[7]
ثالثا: يقال بتشكيك باعتباره معطى مشترك بين الموجودات على اختلافها (بين الإنسان والله)، لكن لا على نحو تواطئي إذ يدل عنده اسم التدبير على الموجودات بضرب من ضروب التشكيك الذي هو اتفاق من وجه واختلاف من وجه، كما لو أطلقنا لفظ العارف على الله وعلى الإنسان والحيوان، فلا شك أن المعرفة هي في كلٍ حسب ماهيته لا على نحو واحد.[8]
لذا أكد ابن باجة أن يقال لفظ التدبير هنا على الموجودات لا على وجه التساوي والتواطؤ، وإنما على وجه التفاوت والاختلاف، فقيل اللفظ عنده بتقديم وتأخير.
ثم ينتقل بعدها لحصر معنى التدبير في صنف معين يرى أنه الموضوع الأمثل والأفضل للتدبير. فيعرض صنفين من التدبير هما؛ تدبير الإله للعالم الذي يعتبره بعيد النسبة إلى معنى التدبير هنا،[9] والذي يراد به تدبير المدينة، ويلحق به تدبير المنزل.
فماذا يعني ابن باجة بتدبير المنزل؟ وكيف يكون كمال المنزل جزءاً لا يتجزأ من كمال المدينة الفاضلة؟
يرى ابن باجة أن تنظيم الحياة اليومية في المنزل، يمثل جزءاً أساسياً من بناء مستقبل المدينة والمجتمع وتطويره. وبالتالي، فإن كمال المنزل يرتبط بشكل مباشر بكمال المدينة الفاضلة، وهو ما يعني أن الحياة السعيدة والمستقرة في المنزل هي عامل أساسي لنجاح المجتمع بأكمله. ويشير إلى أن بناء المجتمعات الناجحة يتطلب تمكين الأسرة وتوفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسمح للأفراد بتطوير أنفسهم ومساعدة المجتمع بأكمله. في النهاية، فإن تنظيم المنزل وتحسين أدائه، يمثل جزءًا رئيسيًا من العملية الأكبر لتحسين جودة الحياة الاجتماعية والسياسية.[10]
ويشير ابن باجة إلى ذلك قائلا: “وأيضا فإن كمال المنزل ليس من المقصودة بذاتها، وإنما يراد به تكميل المدينة أو غاية الإنسان بالطبع. وهو بين ٲن القول فيه جزء من القول في تدبير الإنسان نفسه.” [11]
فالأصل هنا هو بيان أن بناء الفرد لذاته، وتقويمه لها يؤدي لا محالة إلى بناء وتجويد البناء السياسي والاجتماعي للمدينة. إيمانا بالمبدأ القائل لا نطمح بترقية المجتمع إلا بترقية أبنائه.
فما هو إذن النموذج الأمثل لتدبير؟
مهما تعددت واختلفت معاني التدبير فأهمها وأفضلها على الإطلاق، هو تدبير الإنسان لنفسه الذي يكون بتدبير المنزل والذي ينعكس على تدبير المدينة. والذي من شأنه تحقيق سعادة المفرد. فما هو تدبير المتوحد وما شرط تحققه عند ابن باجة؟
أما المتوحد عند ابن باجة فهو الغريب في وطنه الذي يعيش في عزلة اجتماعية، وفي حالة اغترابٍ فكري، بسبب عدم انتساب أفكاره لأفكار أهل المدينة. فهو كالنابتة عند ابن باجة التي تنمو من تلقاء ذاتها بين الزرع. ووجود النابتة في نظره هو علة فساد المدن وابتعادها عن العدل، ما يجعلنا نكاد نجزم أن المتوحد في زمن ابن باجة لا يمكن أن يكون إلا فيلسوفا.[12]
فالمتوحد حسب ابن باجة، هو شخص يتفرد بهوى معين أو موهبة فريدة، ويعيش بصورة مستقلة عن المجتمع الذي يحيط به. وفي نظر ابن باجة، المتوحد هو الذي يتمتع بالذكاء وبهامش من الإبداع، ويستطيع الوصول إلى أعلى مراتب العلم والفلسفة والروحانية.[13]
وعليه يتناول ابن باجة في فلسفته حول “تدبير المتوحد”، مفهوم “النّوابت”، بقصد الإشارة إلى الفلاسفة الذين يعيشون في مجتمعات ناقصة ولا يتماشون مع أهدافها وقيمها. يركز ابن باجة على كيفية تحقيق هؤلاء الفلاسفة للسعادة والأمان دون الانغماس في الفساد الأخلاقي أو التأثر برغبات العامة وأهوائها.
يرى ابن باجة أن الفيلسوف يجب أن يعزل نفسه عن المجتمع، لأنه لا يمكنه إيجاد الكمال في وسطه. ويعتبر أن هذا النهج مستوحى من تقليد أفلاطوني غير طوباوي وغير سياسي، حيث يُنظر إلى الفيلسوف كشخص غريب عن المجتمع، لا يدين له بشيء. ويستشهد بقضية سقراط، الذي أُعدم في أثينا، لتوضيح قناعته بأن الفلسفة والسياسة لا يمكن أن تتوافقا بسهولة.
فبين إذن أن السبيل الوحيد والأوحد في نظره لتحقيق العدل؛ هو الكمال العقلي والمعرفي ونشر قيم الانعزال عن المجتمع الجاهل والفاسد، من خلال الربط بين هذه المكونات والعناصر الثلاث والإيمان بعلاقاتهما التكاملية، والتي تربط تحقيق العدل بالتكوين العقلي والفكري للفرد، وليس بالقوانين والأنظمة السياسية المتوازنة فقط.
وفي هذا الباب يقول ابن باجة “وصواب التدبير إنما يكون تدبير المفرد، وسواء كان المفرد واحداً أو أكثر من واحد ما لم يجتمع على رأيهم أمة أو مدينة.” وهؤلاء هم الذين يعنونهم الصوفية أيضا بقولهم الغرباء. أما في رسالة تدبير المتوحد فيهدف من خلالهم ابن باجة الإشارة أساسا إلى المفهوم المتعلق بالوحدة والاستقرار، “فالمفرد” هنا اسم يشير إلى الوجود الفردي الذي يتمتع بالاستقلالية والتميز عن الأشياء الأخرى والتفرد في الكفاية والمكانة، ويقصد به الوجود الأصيل.
فمن خلال التحديد والتفريق الواضح بين الكيانات المفردة، يمكن تحقيق التوازن والإيجابية في العلاقات بينها، وبذلك يأمل الفيلسوف الأندلسي تحقيق الاستقرار في رسالته “تدبير المتوحد“، ويشير إلى المفرد باعتباره مفهومًا للوحدة الفردية للنفس البشرية، وحالة الاستقلالية التي لا تتطلب الاعتماد على أي شخص آخر أو شيء آخر.[14]
فالتوحد إذن وبناء عما سبق، يشير إلى حالة الوحدة العامة والملموسة للإنسان في جميع جوانبه الجسدية والعقلية والروحية. وبمعنى آخر، فإن التوحد يشير إلى حالة الانسجام والتواصل بين العناصر المختلفة والمرتبطة ببعضها في الإنسان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة السعادة والمكانة الروحية العليا. وما يضمن تحقيق الوحدة المدنية وشيوع المحبة والسعادة بين أفرادها أيضا. فالغاية التي يرمي إليها ابن باجة في آخر المطاف هي تشييد المدينة الفاضلة وتعميم العدل بين أفرادها.[15]
ومنه فإن تدبير المتوحد الذي اعتزل الهيئة الاجتماعية الناقصة عند ابن باجة، هو صورة الدولة الكاملة وهو يرى أن الدولة المثالية يجب أن تخلو من الأطباء والقضاة والقوانين، لأنها لا تكون مثالية إلا إذا احتكم أهلها إلى الصدق والعدل والخير، وفي هذه الحالة يكون وجود الأطباء والقضاة نوعا من العبث، وهؤلاء المتوحدون أو النوابت هم عناصر الكمال في الدولة (الناقصة)، التي يعتريها الفساد في التدبير.[16]
وعلى هذا الأساس يكون العدل عند ابن باجة ليس مجرد إنصاف بين الناس، بل هو انتظام للأفعال وفقًا للترتيب العقلي الصحيح، مما يحقق التناسق بين قوى النفس. ويظهر ذلك في حرص المتوحد على تهذيب نفسه، والالتزام بالفضيلة، وتوجيه أفعاله نحو الغاية القصوى، وهي بلوغ الكمال العقلي. كما يتجسد ذلك في تمييزه بين الإنسان الفاضل الذي يسير وفق مقتضيات العقل وإملاءاته، وبين من تغلب عليه شهواته، ما يعكس رؤية أخلاقية قائمة على تحقيق الاتزان الداخلي والخارجي.
في الأفعال الإنسانية:
أما ما يخص الأفعال الإنسانية فيرشدنا ابن باجة لتبين أوجهها إلى الاستناد على الطبيعيات، والمقصود هنا بالطبيعيات، علم الطبيعة لٲرسطوطاليس، وذلك للتمييز بين الأفعال التي هي للإنسان وحده لا يشاركه فيها غيره، وبين الأفعال التي تخص الكائنات الأخرى من جماد ونبات وحيوان.[17] هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لفحص ومعرفة ما يحقق من بينها غاية المتوحد. “فينطلق العلم الطبيعي في هذا المجال من التمييز في أفعال الإنسان بين ما يرجع ٳلى كون بدنه مركبا من العناصر الأربعة: (الماء، التراب، الهواء والنار) من جهة، وإلى اختصاصه بالفكر والروية من جهة أخرى،“[18] ولعل هذا ما يجعل الأفعال تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول ما كان ناشئا عن الإرادة الحرة الناشئة عن روية ونظر.
القسم الثاني وهو ما كان باعثه الغريزة الحيوانية أو البهيمية كما يسميها ابن باجة الخاضعة لنفسه الناطقة.[19] وهو ما يجعل الإنسان تلحقه مجموعة من الأفعال اللاإرادية وهي من صنف الأفعال الضرورية التي لا اختيار له فيها كالإحساس.[20]
فما يميز الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى، هي قدرته على التفكير الذي يحسن به تمييز وتدبير أشيائه. وبما هو قوة مفكرة فإن أفعاله ستكون بالضرورة مخالفة لأفعال غيره من الموجودات التي من المفروض أو بالأحرى من المفترض أنها لا تتمتع بملكة التفكير.
أما طبيعة هذه الأفعال الخاصة بالإنسان دون سائر الموجودات فهي أفعال تتم عن طواعية واختيار، بناء على مسلمة أساسية تقول إن “الأفعال الانسانية الخاصة به هي ما يكون باختياره، كل ما يفعله الإنسان باختيار فهو فعل إنساني، وكل فعل إنساني فهو فعل باختيار.“[21] وهو لهذا في أعلى المراتب الأخلاقية، إذ إن كل من غلبت قواه البهيمية قوته الناطقة هو أخس من الحيوان مادام إن غلبة الشهوة على الحيوان أمر فطري وطبيعي، وهو يرى إن أفعال كل فرد تتعلق بإرادته الخاصة، وأنه يستطيع إن يوقف تيار شروره، متى أراد ذلك، وأن من الواضح أنه لا يصل فرد ٳلى غايته إلا بأفعاله، وٲنه لهذا هو محصلة لأفعاله ومسؤول عنها تمام المسؤولية.[22] وهذا هو نموذج الإنسان الفاضل في نظره الذي من شأنه المساهمة في تحقيق العدل في المدينة. ما يعكس تصورا فلسفيا لأفعال الإنسان، التي تتمايز عن الأفعال الطبيعية من خلال إدراج الإرادة الحرة والاختيار الأخلاقي، وما يجعل تحقيق العدل في المقابل يستدعي فهم البعد الإثيقي للفعل الإنساني، بدلا من حصره في تأثيراته المادية فقط.
انطلاقا مما سبق، يمكن استخلاص بعضا من مقومات وجوانب نظرية ابن باجة في الأفعال البشرية؛ والتي تقتضي، أولا وقبل كل شيء، الانفصال عن تأثير المجتمع، حيث يرى ابن باجة أن على الفلاسفة الحقيقيين، أو “المتوحدين”، أن ينأوا بأنفسهم عن المجتمعات الفاسدة لإتقان فكرهم وسلوكهم الأخلاقي.
وبخلاف النظرة الأرسطية القائلة بأن الأخلاق مرتبطة بالحياة الاجتماعية و السياسية، يرى ابن باجة أن الكمال الأخلاقي رحلة فردية يسلكها المرء عبر التهذيب الفكري الذاتي.
ومادام أن أسمى أفعال الإنسان هو طلب الحكمة، التي تؤدي إلى السعادة. ينبغي أن تُقاد الأفعال بالعقل لا بالعواطف أو الضغوط الخارجية في نظر ابن باجة. وعلى عكس الفارابي، الذي يُشدد على قيادة الملك الفيلسوف لدولة مثالية، يُشكك ابن باجة من جهته في إمكانية تحقيق العدالة في المجتمعات المُعيبة والفاسدة. ولعل هذا مجمل القول وتفصيله في الأفعال الإنسانية.
الصور الروحانية:
لما قرر ابن باجة إن أفعال الفرد هي التي تحقق غايته، لا ينسحب مباشرة للحديث عن الغايات الإنسانية، بل يشرع أولا في بيان موضوع الصور الروحانية أو ما بات يعرف بالصور العقلية والذهنية، التي نتحصلها عن الأشياء. والتي تشكل أقصى ما يمكن ٲن يبلغه المتوحد من غاياته، ومنه يقسم ابن باجة الصور الروحانية إلى أربعة أصناف هي بمثابة مراتب للمعرفة الإنسانية:
صور الأجسام المستديرة وهي الأجسام السماوية التي تتحرك حركة دورية
العقل الفعال والعقل المستفاد
المعقولات الهيولانية
المعاني المجردة التي تتضمنها قوى النفس الثلاث، وهي الحس المشترك، وقوة المخيلة وقوة التذكر[23]
فالصنف الأول عند ابن باجة لا تخالطه هيولى، والصنف الثالث فيه نصيب من الهيولى لٲن وجودها في الهيولى، والصنف الثاني هو من حيث الٲصل غير هيولاني البتة، وٳنما نسبته ٳلى الهيولى هي ٲنه متمم للمعقولات الهيولانية، وهذا هو العقل المستفاد عنده، ٲو فاعل لها، وهذا هو العقل الفعال، ٲما الصنف الرابع فٳنه وسط بين المعقولات الهيولانية والصور الروحانية.[24]
أما الصور الروحانية فهي ٳما عامة لها نسبة إلى الإنسان الذي يعقلها وإما خاصة ولها نسبتان إحداهما؛ خاصة وهي نسبتها ٳلى المحسوس، والٲخرى عامة وهي نسبتها إلى الحاس المدرك لها (الإنسان الذي يعقلها). فالأمر أشبه ما يكون هنا عند ابن باجة بصورة جبل ٲُحد عند من أحسه، إذا لم يسبق له ٲن شاهده يوما. فتلك صورته الروحانية الخاصة، لأن نسبتها إلى الجبل خاصة.[25]
من هنا كان للصور عند ابن باجة ثلاث مراتب في الوجود:
أولها الروحانية العامة، وهي الصورة العقلية، وهي النوع.
والثانية الصور الروحانية الخاصة.
والثالثة الصور الجسمانية.
والروحانية الخاصة لها ثلاث مراتب:
أولها معناها الموجود في القوة الذاكرة.
والثانية الهيئة أو الرسم الموجود في القوة المتخيلة.
والثالثة الصورة الحاصلة في الحس المشترك.[26]
والصور إما عامة أو خاصة، أما العامة فهي المعقولات الكلية، والخاصة منها روحانية ومنها جسمانية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصور الروحانية بها مراتب أكثر روحانية وأقلها روحانية. والصور التي في الحس المشترك هي أقل المراتب روحانية وهي أقربها الى الجسمانية، ولذلك يعبر عنها بالصنم،[27] فيقول إن الحس المشترك في صنم المحسوس، وتليه الصورة التي في المخيلة، وهي أكثر روحانية من نظيرتها وأقل جسمانية، وإليها تنسب الفضائل النفسانية، وتليها التي في القوة الذاكرة، وهي أقصى مراتب الصور الروحانية الخاصة،[28] وهي الصورة المحضة الخالصة والبريئة من علائق المادة، والفكرة المجردة المدركة.
على هذا النحو يركز ابن باجة على كيفية تحقيق الإنسان للسعادة القصوى من خلال تطوير قدراته العقلية والتأملية، مع التركيز على تدبير أفعاله للوصول إلى الفضيلة الأخلاقية. إلا أن التزام المتوحد بترتيب أفعاله نحو غاية مقصودة، وهي الاتحاد بالعقل الفعال،[29] يتضمن ضمنيًا ممارسة العدل في أفعاله، سواء تجاه نفسه أو تجاه الآخرين. فالعدل، بمعناه الفلسفي هنا، يتجلى أساسا في تحقيق التوازن والانسجام بين قوى النفس، وهو ما يسعى إليه المتوحد في تدبيره لأفعاله.
الغايات:
من هنا يقسم ابن باجة الأعمال الإنسانية بما ينسجم مع الصور السالفة الذكر إلى ثلاثة أقسام:
القسم الاول: وهو ما كانت غايته الصورة الجسمانية كالأكل والشرب واللباس،[30] “وليست اللذة الحيوانية هي المقصودة لذاتها من أفعال هذا القسم، وإنما المقصود هو إتمام الصورة الجسمانية التي لابد منها للصور الروحانية.“[31]
والقسم الثاني: ما كانت غايته الصور الروحانية الشخصية، وأفعال هذا القسم على أربع مراتب:
المرتبة الأولى هي ما كانت أفعالها متجهة نحو الصور المرتسمة في الحس المشترك كمحاولة بعض الأفراد تحت تأثير الغرور تجميل الملابس الخارجية دون عنايتهم بالملابس الداخلية، ولما لم يكن الحامل على هذه العناية هو اللذة الجسمانية بل شيء آخر وهو الغرور في ملكة الحس المشترك،[32] فقد اندرجت هذه الأفعال ضمن مراتب الروحانيات. والمرتبة الثانية هي ما كانت أفعالها متجهة نحو الصور المرتسمة في المخيلة، وذلك مثل التزين بالأسلحة بعيدا عن المعارك والهيجاء، والمرتبة الثالثة هي ما كانت أفعالها متجهة نحو المسرات الروحانية، وذلك مثل الاجتماع مع الأصدقاء والاشتغال بالأدب والشعر،[33] والمرتبة الرابعة هي ما كانت أفعالها موجهة نحو الكمال العقلي والخلقي، كاشتغال الفرد على أحد العلوم بغرض تقويم ذاته دون ابتغاء منفعة مادية من ذلك.[34]
أما القسم الثالث فهو ما كانت غايته الصور الروحانية العامة وأفعال هذا القسم، هي أكمل الأفعال الروحانية العامة وأشرفها، وهي دون الغاية الأخيرة. لذا يؤكد ابن باجة على أن يختار المتوحد من كل مرتبة من هذه المرتبات أسماها وأعلاها مرتبة، حتى إذا وصل إلى الغاية الأخيرة وهي إدراك العقول البسيطة والجواهر المجردة (المفارقة) إدراكا ذاتيا صار واحدا منها، ٳذ ذاك يبرئ نفسه من جميع الأفعال الجسمانية والروحانية التي لا تليق به.[35]
هنا يظهر مفهوم العدل عند ابن باجة في مسألة الغايات، من خلال التٲكيد على وجوب ترتيب الإنسان لٲفعاله وفق غاية عقلية سامية، تتمثل في الاتحاد بالعقل الفعال كما سبق وٲشرنا. لٲن هذا الترتيب يتطلب انسجامًا وتوازنًا بين قوى النفس، وهو جوهر العدل في المنظور الفلسفي. فالعدل يظهر هنا في توجيه الفردنحو الفضيلة، بحيث لا تطغى قوى الشهوة أو الغضب على العقل، بل يعمل الإنسان وفق نظام متناسق يحقق وفقه كماله الذاتي. كما أن سعي المتوحد لتحقيق غايته دون الاضطراب بالملذات الحسية أو التأثيرات الخارجية يعكس مفهوم العدل الذاتي، أي العدل الذي يمارسه الفرد على نفسه من خلال ضبط أفعاله بما يحقق كماله العقلي ومن ثم الكمال السياسي العادل المطلوب للمدينة.
خاتمة:
هكذا بين ابن باجة من خلال رسالته تدبير المتوحد الأفعال التي من شأنها أن توصل الإنسان المتوحد إلى بلوغ السعادة القصوى، حيث يتجلى العدل بأكمل صوره عنده عبر الاتصال بالصور العقلية والذهنية، فهذه الأفعال التي تتحقق بموجبها العدالة منحصرة في اختصاص العقل والنظر والتأمل، إذ بهذه الوسائط المعرفية يتمكن الإنسان من تجاوز العوائق الحسية والانفعالية التي قد تعيق مسعاه نحو العدالة الداخلية والانسجام النفسي، ما يمكنه في النهاية من بلوغ الحكمة والسعادة الحقيقية. وإيجاد منفذ للعدل والعدالة.
وتبعا لذلك تتجاوز العدالة الحقيقية عند ابن باجة كونها مجرد انتظام في العلاقات الاجتماعية والسياسية، بل هي قبل ذلك انسجام داخلي يبلغه الفرد عبر تنمية قواه العقلية وتوجيهها نحو إدراك الحقائق المجردة. ومن هذا المنطلق، فإن العدل عند المتوحد يتمثل في تحقيق النظام داخل النفس، بحيث تترتب أفعاله وفق منطق عقلي صارم يقوده إلى الاتصال بالعقل الفعال، وهو الغاية الأسمى للفكر الفلسفي عند ابن باجة.
المصادر والمراجع:
[1] محمد غلاب، الفلسفة الإسلامية في المغرب ، ،1967.ص: 5-6
[2] محمد عابد الجابري، العقل الٲخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات
الوحدة العربية ، بيروت مارس٢٠٠١، ص: ٣٦٦
[3] محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي2، بنية العقل العربي، دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2009، ص:529
[4] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر .1994ص:5
[5] المرجع نفسه، ص: 5
[6] المرجع نفسه، ص: 5
[7] المرجع السابق،ص:5
[8] يوسف كرم، العقل والوجود، تقديم وشرح وتعليق.ٲ.د. مصطفى النشار.ط1.-القاهرة:مكتبة الدار العربية للكتاب، 2018. ص: 114
[9] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر 1994 ص:5
[10] المرجع نفسه، ص: 8-9
[11] المرجع نفسه، ص: 9
[12] المرجع نفسه، ص:12-13
[13] المرجع نفسه، ص: 12
[14] المرجع نفسه، ص: 13
[15] ابن باجة، تدبير المتوحد، ص:13
[16] محمد غلاب، الفلسفة الاسلامية في المغرب،1967.ص:٣٠
[17] محمد عابد الجابري، العقل الٲخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات
الوحدة العربية ، بيروت مارس٢٠٠١، ص:٣٦٩
[18] المرجع نفسه، ص: ٣٦٩
[19] الدكتور محمد غلاب، الفلسفة الاسلامية في المغرب،1967.ص: ٣٠
[20] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر، 1994.ص: 16
[21] المرجع السابق، ص:16
[22] الدكتور محمد غلاب، الفلسفة الٳسلامية في المغرب، 1967 .ص: ٣١
[23] ابن باجة ، تدبير المتوحد، سراس للنشر، ص:21
[24] المرجع نفسه، ص:21
[25] المرجع نفسه، ص:22
[26] الدكتور عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة الجزء الاول من ٲ ٳلى س، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الاولى ١٩٨٤
[27] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر، 1994.ص:38
[28] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر1994.ص:38-39
[29] د. سامي محمود ٳبراهيم، ٳشكالية العقل والٳنسان في فكر ابن باجة. مجلة الهدف، 2022.
[30] المرجع نفسه، ص39.
[31] الدكتور محمد غلاب، الفلسفة الاسلامية في المغرب، 1967.ص٣١:
[32] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر 1994.ص:39
[33] المرجع نفسه، صر: 79
[34] الدكتور محمد غلاب، الفلسفة الاسلامية في المغرب، 1967. ص:٣١
[35] ابن باجة، تدبير المتوحد، سراس للنشر، ص: 81
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




