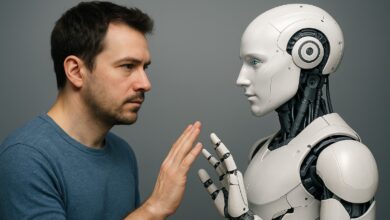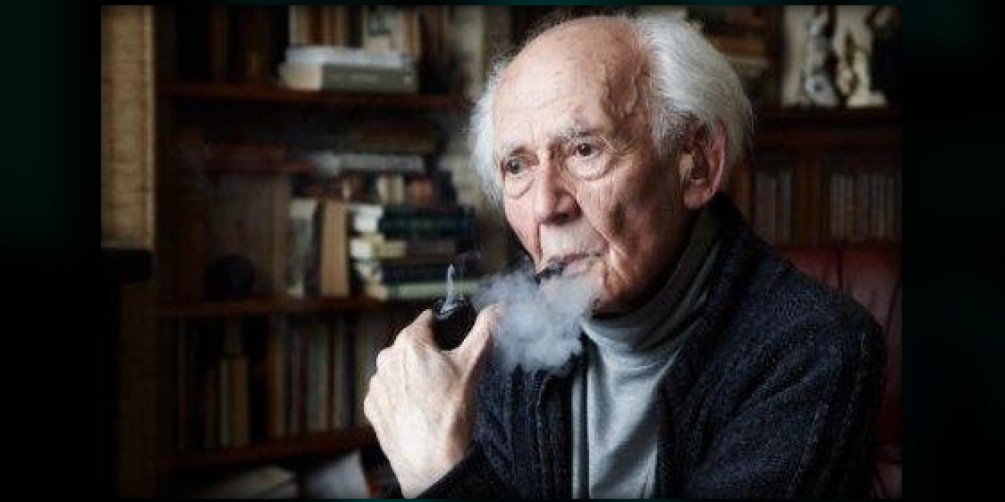الشيخوخة في مفترق الطرق بين مسار الماضي والسياق الحالي

يجب أن نشير أولا إلى مسألة أن مسارات التشيخ متنوعة للغاية، وأن هناك تفاوتًا كبيرًا في أوضاع هذا التشيخ، والتي تتسم بالتالي بتفاوتات عميقة جدا. من المهم أولا فهم الأصول المزدوجة لهذه التفاوتات. فمن ناحية، نحن نشيخ إلى حد ما “كما عشنا”: فالشيخوخة هي دالة على مسارنا السابق والموارد، التي تأتي من ذلك المسار بشكل أو بآخر، سواء كانت هذه الموارد أكثر أو أقل عددًا. ولكن، من ناحية أخرى، نحن نشيخ بنفس الطريقة التي تسمح لنا بها بيئتنا المجتمعية الحالية: فالشيخوخة هي أيضًا دالة للطريقة التي عشنا بها. إنها ظاهرة علائقية، وعلى نطاق أوسع، تعتمد على السياق الحالي للحياة، وهو سياق غني بشكل أو بآخر بـ “الدعامات”.
أولا: الشيخوخة، نتاج مسارات الماضي
إن الطريقة التي يتقدم بها الأشخاص في العمر خلال سنوات تقاعدهم هي استمرار لمسارهم الحياتي السابق وتعتمد على الموارد التي تراكمت لديهم خلال هذا المسار. وتختلف هذه الموارد اختلافًا كبيرًا وفقًا للخلفية الاجتماعية للشيخ وجنسه.
أولا، تلعب التفاوتات في الصحة دورًا رئيسيًا في التفريق بين مسارات الشيخوخة. تتأثر صحة الناس بطرق مختلفة، اعتمادًا على وظائفهم المهنية السابقة، والتي تضع درجات متفاوتة من الإجهاد على أجسادهم. والأكثر من ذلك، فإن العلاقة بالصحة ليست واحدة وفقًا للخلفية الاجتماعية للشيخ، حيث تكون الطبقات الوسطى والعليا من المتشيخين أكثر تقبلاً للتدابير الوقائية، في حين أن الطبقات العاملة منهم تتبع نهجًا علاجيًا أكثر في التعامل مع مشاكلها الصحية. نتيجة لذلك، يعاني أفراد الطبقة العاملة من عقوبة مزدوجة في هذا المجال، فهم يعيشون حياة أقصر ومساراتهم أكثر اتسامًا ببداية التبعية.[1] أما بالنسبة للنساء، فإنهن يعشن عمراً أطول من الرجال، ولكنهن أكثر عرضة للمعاناة من قصور وظيفي على مستوى الذهن في العمر نفسه.
ثمّة موارد أخرى، تنبع من المسار الماضي، لا بد من الإشارة إليها. أولاً، تبقى الأوضاع المالية في الشيخوخة شديدة التفاوت، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمهن التي تم شغلها ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، معاشات العمال تقل بأكثر من الضعف مقارنة بمعاشات المديرين التنفيذيين،[2] كما أنهم يستمتعون بهذه المعاشات لفترات أقل، نتيجةً لقصر العمر المتوقع لديهم. أما بالنسبة للنساء، فتتدنى معاشاتهن بنسبة 40% مقارنة بالرجال (ويقل الفارق إلى 28% عند احتساب المعاشات التقاعدية المستحقة من الوفيات). ثمّ، في صفوف الأجيال التي بلغت سن التقاعد اليوم، نجد أن النساء أقل قدرة من الرجال على قيادة السيارات، ما يشكل عقبة كبيرة في تنقلاتهن، لا سيما عندما يعشن بمفردهن ولا يمتلكن الوصول السهل إلى وسائل النقل العامة. وأخيرًا، يجب التأكيد على أهمية الشبكة الاجتماعية، التي يمكن أن تكون عونًا في الحفاظ على الروابط مع العالم الخارجي، وهي، بدورها، ثمرة من ثمار الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن القدرة على التكيف متجذرة أيضاً في الماضي وتنبع منه. ويبدو أن هذه القدرات أكثر أهمية في حالة أولئك الذين أتموا دراستهم: فهم أكثر قدرة على الحفاظ على استقلاليتهم عندما يواجهون مشاكل جسدية. يشير بعض الباحثين إلى أن هناك وجود فروق واختلافات في الطريقة التي يتعامل بها الرجال والنساء مع التغيرات التي تحدث لهم في سن التشيخ، حيث طورت النساء المسنات “قدرة على التكيف” و”براعة علائقية في العلاقات الاجتماعية” أكبر بكثير مقارنة بالرجال. هذا الاختلاف متجذر في الطريقة التي تم بها بناء الهويات الجندرية والجنسية لأجيال المتقاعدين اليوم، حيث أن هويات النساء أكثر توجهاً نحو الآخرين، وهويات الرجال أكثر توجهاً نحو “الإنجاز”. حتى أننا قد نتساءل عما إذا كان المثال الأعلى الذكوري للرجولة[3] ليس عائقًا في مواجهة صعوبات التشيخ: فالرجال الذين يعيشون حتى سن المائة يبدون مثل “السنديان الذي يقاوم ثم ينكسر”، بينما تتكيف النساء بلطف أكثر، مثل “القصب الذي ينحني ولا ينكسر”.
وهكذا، تأخذ الشيخوخة معاني مختلفة حسب نظام القيم الذي يعطي معنى للوجود ويمنح الحياة معناها. هذا النظام القيمي يعتمد على الجنس، كما رأينا للتو، كما يعتمد أيضًا على الطبقة الاجتماعية والانتماء الاجتماعي للشيخ، كما يتضح من دراسة لتمثلات التشيخ أجريت في سويسرا في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينيات. فبينما يُعتبر بالإجماع أن مرحلة التشيخ تتسم بالاستبعاد من الحياة الطبيعية، إلا أن بداية التشيخ تتخذ أشكالًا مختلفة حسب الخلفية الاجتماعية للشيوخ وفئاتهم الاجتماعية: عندما لا يعود بإمكانهم مواصلة عملهم السابق، ولو بوتيرة أبطأ، يشعر المزارعون (الفلاحين) المسنون في فاليه (مدينة فالاي) أنهم لم يعودوا يشاركون في “الطقوس الكونية الكبرى” التي تنظم في نظرهم نظام ترتيب الحياة: بالنسبة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء، يتسم التشيخ بالاستبعاد من عالم العمل المهني، أو من البدائل التي تم العثور عليها بعد التقاعد: بالنسبة لأفراد الطبقات الوسطى والعليا، الذين يحملون راية التفوق الشخصي، فإن الشيخوخة تُحرمهم من المتع التي يمكن أن تقدمها لهم الحياة.[4]
ثانيا: الشيخوخة، ظاهرة علائقية وسياقية
إن الطريقة التي نتقدم بها في العمر لا يحددها الماضي فقط. فهي تعتمد أيضًا على البيئة التي نشيخ فيها. فقد تكون مصدر إقصاء، أو على العكس، يمكن أن تكون غنية “بالدعم”.
-“الذكاء التفاعلي والاقصاء (الذاتي)”
تعد البيئة أولاً وقبل كل شيء هي التي تلعب دورًا رئيسيًا في عملية الشيخوخة. لقد جعلت وجودية سارتر من نظرة الآخرين المحرك الحقيقي للشعور بالشيخوخة: لقد كتبت سيمون دو بوفوار: “في نظري أنا الآخر هو الذي يشيخ، وهذا الآخر هو أنا” بمعنى الأنا الذي أكونه بالنسبة للآخرين. لتعيين التفاعلات التي يشعر فيها الشخص بأنه يُنظر إليه أو يعامل على أنه عجوز، يمكننا أن نتحدث، استنادا إلى نظرية التفاعلية الرمزية، عن “التمييز العمري التفاعلي بينهم”. يُظهر مسح أسترالي لهذه الظاهرة كيف ينشأ الوعي بالشيخوخة أثناء التفاعلات: هناك أفعال وتعليقات جارحة من الناحية الأخلاقية حول بطء كبار السن؛ توجيه السب للمسنين بسبب القيادة بحذر شديد؛ أسئلة متشككة حول قدرتهم على القيام بالأشياء (هل ستتمكن من القيام بذلك في عمرك؟)؛ نقص الصبر عليهم، وعدم الاهتمام من جانب الأطباء بهم؛ كذلك المواقف المتعالية من طرف الناس حولهم، وقد يعاملون بحسن أخلاقي كذلك، كما هو الحال عندما يتخلى شخص ما عن مقعده في خدمة النقل العام لشخص كبير في السن. هناك آلية تفاعلية أخرى مرتبطة بالعمر: فقد شعروا، كما قالوا، “بالإغراء”، أي أن لديهم انطباعًا بأن أي خطأ أو تراجع في النشاط من جانبهم سيفسره المحيطون بهم، الذين كانوا يتوقعون ويخافون اللحظة على حد سواء، على أنه علامة على أنهم “يتخلون” وبدأوا يفقدون السيطرة.
إن صعوبة التفاعل مع الناس والأشياء في محيطهم هي عامل من عوامل الإقصاء (الذاتي) والانسحاب إلى الفضاء المنزلي. التواجد في الفضاء العام يمكن أن يكون مصدر قلق بالنسبة لهم! الخوف من عدم القدرة على مجاراة معايير التنقل في السيارة وقراءة حركات سائقي السيارات الآخرين مثلا؛ الخوف من تعطيل تدفق حركة المرور كذلك؛ صعوبة الصعود والنزول من الحافلة أثناء تنقلهم في النقل العمومي، لأن ارتفاع درجة الصعود إلى الحافلة يشكل عقبة محفوفة بالمخاطر ولأن السرعة المطلوبة للصعود والنزول من الحافلة، تحت نظرات السائق التي لا تفهم دائمًا تجعل المناورة صعبة ومرهقة لتقدير الذات؛ الخجل من تعريض جسد المعاق لنظر الآخرين. لذلك يقلل كبار السن من نزهاتهم إلى الشارع، ويفضلون الهدوء والسكينة في أماكنهم المنزلية، وعندما يخرجون يفضلون الساعات التي تكون فيها حركة المرور في المناطق الحضرية في أدنى مستوياتها. كما يبحثون أيضًا عن “الأماكن المحمية التي تكون فيها العلاقة التنافسية بين كبار السن والشباب أقل وضوحًا: المتاجر أو الحدائق العامة التي هجرها الشباب كمثال، أو مراكز التسوق حيث يستولي المتقاعدون المعزولون على “أماكن استراحة” معينة للالتقاء بشكل شبه يومي!
«بيئة ذات درجات متفاوتة من “الدعم”»
ومع ذلك، فإن الآخرين لا يستبعدون المسنين من الساحة العامة ببساطة ويحبسونهم في سن التشيخ. تأتي هذه المساندة الشخصية من العائلة والأصدقاء، وتتخذ شكل طلبات وتشجيعات موجهة إلى المسن لتشجيعه على المشاركة في هذا النشاط أو ذاك، أو في بعض الأحيان تكون ببساطة مجرد حضور ومراعاة تظهر ما يعنيه المسن بالنسبة للمقربين منه. يمكن أن يصبح هذا الدعم متناقضًا، على سبيل المثال عندما يكون الفخر بأحد الأقارب المسنين الذي يواصل المشاركة في الرياضة مشوبًا بالقلق. والأكثر من ذلك، يمكن أن تتقوض هذه الدعامات عند وفاة أحد الأقارب المقربين، وخاصة الزوج أو الزوجة. ومع ذلك، تبقى أشكال الدعم الشخصية الأخرى، أو حتى تظهر. من المرجح أن تقيم الأرامل الأكبر سنًا علاقات مع نساء أرامل أخريات ويطورن أنشطة معهن، مثل الانضمام إلى نادٍ أو الذهاب في رحلة منظمة: هناك دعم متبادل بين الأرامل، وهو ما يلعب دورًا مهمًا في شيخوخة النساء. من جانبهم، يمكن لمقدم الرعاية المنزلية أو أحد الأقارب مساعدة الشخص الذي أصبح ضعيفًا جسديًا في الحفاظ على الروابط مع العالم الخارجي.
وبالإضافة إلى هذه الدعامات العلائقية، فإن البيئة التي يتقدم فيها المسنون في العمر توفر لهم إمكانية الوصول المادي إلى العالم من حولهم بشكل أو بآخر، وذلك حسب ثراء وجودة المرافق المتاحة، والتي تسهل أو تعيق وجود المسنين في الأماكن العامة: القرب من المحلات التجارية والخدمات المتنقلة؛ توافر وسائل النقل العام وإمكانية الوصول إليها: المرافق الحضرية (حالة الأرصفة، وجود الممرات وبيئة العمل في الممرات والمقاعد العامة والوقت المسموح به للمشاة لعبور الطريق، إلخ). القرب من المحلات التجارية هو أيضًا عامل يشجع كبار السن على الخروج والتواصل الاجتماعي. والهدف من برنامج “المدن الصديقة للمسنين”، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في سنة 2005، والهدف من العلامة الوزارية “الشيخوخة الجيدة – العيش معًا”، هو تشجيع السلطات المحلية على أخذ هذه الحقائق في الاعتبار وتعزيز الدعم الذي يمكن أن تقدمه البيئة الحضرية للأشخاص مع تقدمهم في السن.
ثالثا: الشيخوخة في سياق مؤسسي معين:
السجن بالنسبة لعالم الاجتماع، يعطي السياق شكلًا لتجارب التشيخ. ومن هنا يأتي الاهتمام بالبحث في سياقات معينة للتشيخ، وتنبع الاهتمامات بالسياقات الاجتماعية للتشيخ، كمؤسسة السجن على سبيل المثال.
وفي حين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سن الخمسين يمثلون 12% من مجموع السجناء، تسلط كارولين توروا الضوء على “الاغتراب” الذي يميز تجربتهم في السجن، والذي تصفه من أربعة جوانب رئيسية لهذه التجربة:
-1 شعور بعدم التماشي مع نزلاء السجن، الذين هم أصغر سنًا في المتوسط؛
-2 شعور بالضعف والهشاشة، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى حقيقة أن المحتجزين المسنين غالبًا ما يرتبطون بـ”المؤشرات” التي تدل على أنهم مجرمين جنسيين، أي المسجونين بسبب جرائم جنسية، وهم بالطبع ليسوا جميعًا كذلك، لأنه تصنيف لا يشمل الجميع بالطبع.
-3 محنة جسدية، حيث أن مساحة السجن ليست مصممة للمحتجزين الأكبر سنًا (على سبيل المثال، هناك زنازين ضيقة والتي تكون غير مريحة، والسلالم العديدة الموجودة في المؤسسة السجنية، مع عدم وجود مقاعد في صالة ألعاب الرياضة)؛
-4 شغل محدد للمكان، الذي يفضل مناطق معينة (مثل المكتبة أو غرفة الفنون) على حساب الآخرين الذين يخشى عليهم من مواجهة الأشخاص الأصغر سنًا (مثل الملعب وغرفة حمل الأثقال) .
بالإضافة إلى هذه التجربة المشتركة، تعتمد علاقتهم بالسجن على مسار حياتهم وتأثير السجن على هذا المسار الحياتي. فبعض الناس قد “تعطلت” حياتهم، أي أن حياتهم العادية قد توقفت بوحشية، إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح، بسبب السجن، وهو ما يعتبرونه مصدرًا للخيبة والغضب. أما البعض الآخر، الذين سُجنوا عندما كانوا متقاعدين بالفعل، فقد “أنجزوا” حياتهم المهنية وتقبلوا مصيرهم بسهولة أكبر. وآخرون كانت حياتهم “معطلة”، وتميزت بفترات طويلة من السجن، مما يجعلهم يشعرون عند استرجاع ذكريات الماضي بأنهم فاتهم أن يعيشوا حياتهم: فهم ينتظرون الخروج من السجن لتعويض ما يمكن تعويضه وهم يدركون ويتحسرون على أمر أن الأوان سيفوت قريباً.
من هذا الطرح البسيط من الناحية السوسيولوجية، يجب أن نتذكر أن علم الاجتماع يطور رؤية خاصة به لشيخوخة الفرد. فهو لا يرى الشيخوخة من حيث التحول المفاجئ من وضع “كبير السن” إلى وضع “الشخص المسن المعال” (كما يشجعه التمثيل ثنائي القطب للتشيخ السائد اليوم)، ولا من حيث الشيخوخة والضعف والتدهور العضوي (كما هو التفسير الطبي الحيوي للشيخوخة). بالنسبة لعلم الاجتماع، الشيخوخة هي عملية معقدة، نتيجة لمسارات الماضي والحاضر على حد سواء، وتحدث خلالها سلسلة من التغيرات، ليس بمعنى التبعية أو التدهور، بل بمعنى المشقة: مشقة التحولات الحياتية التي يجب التغلب عليها؛ مشقة كبار السن.
يمكن القول في الختام أن الشيخوخة في مفترق الطرق بين مسار الماضي والسياق الحالي تمثل نقطة تحول هامة في فهمنا الاجتماعي للأفراد في مرحلة متقدمة من العمر. في الماضي، كان التشيخ غالبًا مرتبط بتجربة فردية أكثر عزلة، حيث كان كبار السن يعانون من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، وكانوا يعتمدون بشكل كبير على الأسرة والمجتمع المحلي. كانت أدوارهم في المجتمع تتسم بالحكمة والرعاية، ولكنهم كانوا يُعتبرون غالبًا قيدًا على التقدم، سواء في السياقات الاقتصادية أو الاجتماعية.
أما في السياق الحالي، فقد تغيرت نظرة المجتمع تجاه الشيوخ بشكل كبير، نتيجة لعوامل مثل التحضر، والتقدم الطبي، وارتفاع متوسط العمر المتوقع. أصبح هناك توجه نحو إعادة تعريف مرحلة التشيخ، بحيث لم يعد يُنظر إليها فقط على أنها مرحلة نهاية الحياة أو العجز، بل على أنها مرحلة يمكن أن تتسم بالإنتاجية، والنضج الاجتماعي، وحتى النشاط السياسي والاقتصادي. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات، مثل العزلة الاجتماعية أو الفقر، خاصة في المجتمعات التي تواجه تشيخ سكاني متزايد.
من الناحية السوسيولوجية، يمكن القول إن الشيخوخة تقطع اليوم بين إرث اجتماعي قديم وتطلعات جديدة. فبينما يسعى المجتمع المعاصر لإعطاء كبار السن مكانة أكبر في العمل والحياة الاجتماعية، ما زالت الأبعاد الاقتصادية والطبقية تؤثر بشكل كبير على كيفية تمكينهم أو تهميشهم. بالتالي، يشكل التشيخ في هذا السياق مفترق طرق بين التقاليد القديمة التي كانت تركز على دور الأفراد المسنين في الأسرة والمجتمع، والواقع المعاصر الذي يواجه تحديات اقتصادية وصحية جديدة تفرض إعادة التفكير في أدوار كبار السن في المجتمع.
[1] مسارات حياتهم تتسم بظهور الاعتمادية.
[2] الأفراد الذين يشغلون أعلى المناصب الإدارية في الشركات والمؤسسات، ويكون لهم دور رئيسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإشراف على العمليات اليومية.
[3] المثال الذكوري للرجولة يشير إلى مجموعة من القيم والمعتقدات التي تربط مفهوم الرجولة بصفات محددة، مثل القوة البدنية، الاستقلالية، الصلابة العاطفية، القدرة على التحمل، والقدرة على تحمل المسؤولية. في العديد من الثقافات، يتم تربية الرجال ليظهروا بشكل قوي وغير قابل للكسر، وأنهم لا يجب أن يظهروا ضعفًا أو هشاشة عاطفية. هذا النموذج المثالي يشمل أيضاً فكرة أن الرجل يجب أن يكون مسيطرًا على حياته، مقدامًا، ومتخليًا عن أي مظاهر من الضعف أو العاطفة المفرطة. في هذا السياق، يتم طرح سؤال حول ما إذا كانت هذه الصورة التقليدية للرجولة – التي تتسم بالقوة والثبات أمام الصعوبات – قد تكون في الواقع عائقًا أمام الرجال في مواجهة صعوبات الشيخوخة. حيث يُقارن الرجال الذين يظهرون مثل الأشجار المنكسرة في نهاية مطافها وهي تواجه التغيرات الجسدية والعاطفية مع النساء اللواتي يتمتعن بقدرة أكبر على التكيف، مثل “القصب الذي ينحني لكنه لا ينكسر”، مما يبرز فكرة أن التكيف المرن قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة تحديات الحياة المتقدمة.
[4]عني أن أفراد الطبقات المتوسطة والعليا، الذين يعتقدون أن الحياة تدور حول تحقيق التفوق الشخصي والنجاح، يواجهون تحديات كبيرة عندما يصلون إلى مرحلة الشيخوخة. ففي هذه الفئات الاجتماعية، يعتبر النجاح الشخصي والتمتع بمزايا الحياة جزءًا أساسيًا من هويتهم. لكن مع تقدم العمر، قد يشعرون أن هذه المزايا والمتع التي كانوا يحصلون عليها – مثل السفر، الأنشطة الترفيهية، أو الاستمتاع بالحياة بشكل عام – تصبح أقل أو محجوبة. بمعنى آخر، مع دخولهم مرحلة الشيخوخة، قد يُحرمون من تلك المتع التي كانت تمثل لهم جزءًا من تحقق الذات والرفاهية.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.