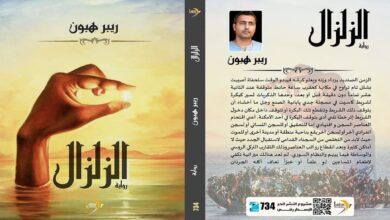مؤخّرًا، قضيت يوميا عدة سويعات مع رواية “زارع الريحان ” لهاجر القحطاني. أقول ‘سويعات’ لا لأستفيد من صيغة التصغير في نحو اللغة العربيَّة، بل فقط لأنَّ هذا ما اقتطفته من الوقت في اليوم الواحد لقراءة الرواية، سويعات. ولأنَّها كانت سويعات مترعة، فقد اتَّسمت بصيغة ‘التكبير’ وليس ‘التصغير’ في نحو لغة الأحاسيس.
ولأني أسهر مع عملي، ولا أملك وقتًا بين ذلك أردت في البداية أن أزيح الرواية عن ناظري، واتركها لأجلٍ يجلبُ نفسه، لكن عينيه، اقصد بطل الرواية والراوي، وهو يكاد ينتأ على صفحة الغلاف الواعدة بمحتوى ثرّ، تستدرجاني: نظرة ، فكلمة ، فسطر، فصفحة، ثم بلا مقاومة صفحات ، ورأس مغرقٌ في الكتاب.
كنت أقرأها نوتة نوتة لا تغفل عيني عن حرف.
ثم هناك الرغبة الحثيثة لاستحضار الوجود المحبب لصديقة قلّما ألتقيها، وقد أهدتني مشكورة فلذة من عالمها: روايتها الريحانيَّة: زارع الريحان. وانتهيت مع الرواية إلى وئام: المجالسة مع وجبتي الطعام.
وبدأت رحلة العناء اللذيذ الذي تكبدته للقراءة أثناء الفطور والغداء. لا وقت آخر لدي. بقيت أكتافي تنحني لتقريب الكتاب لكن الشغف أكبر من إحساسي بالأثر المزعج للانحناء. صرتُ قارئًا مستميتًا.
التعليقات البينيَّة لراوٍ هائج حتى في هدوئه (الأستاذ صفاء) هي سرّ الانشداد إلى القصة وليست ألاعيب فنيَّة في تقنية القصَّة أو نزعات غرائبيَّة للإثارة والجذب.
التعليقات تترى بوقعٍ مدوٍّ وجازم، وبعضها يظلّ صداه يتردَّد مع السطور التالية، فأعود لقراءته حتى يلزم زاويته من الكتاب، وهكذا عاودت الكثير من هذه التعليقات التي تتوسطُ الحوارات والأحداث بما تحمله من تشبيهات نافذة ترتمي ببساطة على الورق بدون تزويق أسلوبي:
خيلاء شيخ منتشٍّ بمشيخته نراها في الغبار المتصاعد من سيارته التي لا تليق به، وهو يحثُها كالخيول في معارك المجد.
وقود! نحن البشر وقود العلم ليبلغ النجاح. مفردة بليغة في هذا السياق تعبٓر عن وحشيَّة العلم وتجرده وتجريبيته.
“عندما دار العراق دورته السنويَّة حول الشمس …. ” عبارة كأنَّها نشيد وطني حماسي يتغنَّى بالوطن.
تراشق متسارع بين الوصف المكاني، ووصف الوجوه والملامح وبين التصوير الخفي الحيّ لدواخل شخوص الرواية، هشاشة نفوسهم، أو أحيانًا قليلة عمليتها ومتانتها. والشخصيّات بمجملها مركّبة لا تمنح مكنوناتها بسهولة.
توظيف المعالم الفيزيائيَّة لتنطق عمَّا يعتمل في الداخل يجعل الرواية كأنَّما تتحدَّث عن المكان والمحيط، الغرفة، الستائر، مواقع الجلوس، الركن الأخضر، الحديقة، الزهور، لكنها تتحدَّث عنهم، عن دواخلهم، شخوص الرواية، وهم يتنفَّسون ويتفاعلون لصنع الحبكة. إبداع تصويري تراه عيوننا لكنَّه استبطان للأعماق.
عندما أردت أن أنتخب جملاً من الرواية للاستشهاد، بدت لي متكافئة، لذا أدعها لقارئ الرواية يختبرها بذائقته. أكتفي بهذا:
“شخص عادي، أخ عادي، جار عادي” (لحظات شعوره بضآلته)
“أرضيَّة الغرفة اللامعة انسحب زخرفها، سريري الوثير جفَّت طراوته، ولوحة عبَّاد الشمس لفان كوخ ذبلت أوراقها الصفراء فوق السرير” (لحظات خيبة)
“كأني مجبر على العيش ……” (اعترافات تتداعى بروعة).
الرواية فيها كمّ من التحليل النفسي والنظر الثاقب المستثمر لرؤى هذا العلم في اضطرابات الشخصيَّة، يدلِّل على اطِّلاع الكاتبة في هذا الميدان، بطريقة تذكر أننا نحن مادة هذا العلم، ونفوسنا حلبته، أي أنَّنا أيضاً في فلك هذه الحبكة مع أبطالها ولسنا قراء غرباء.
وجميل أن تعرج الرواية على جمل ذات طابع علمي، فغالبا ما نجد اليوم الروايات التي يعلو شأنها في الغرب تتعاطى مع العلم أو تتزيا بشخصيته، منطلقة من توجسات أو تنبُّؤات علميَّة حول وجودنا ومستقبلنا وكوننا أكبر من مجرد خيال علمي.
أرى أنَّ ذلك أضفى على رواية “زارع الريحان ” المزيد من الرصانة والمواكبة.
وأتمنَّى من هذه البراعة القصصيَّة، والمقدرة الفائقة على الإنصات للنبض العراقي، وتشخيص علته وعافيته، اضطرابه وسكونه، عظمته وتهافته، أن تلتقط لنا شيئا من الروح الباذلة المتفانية للإنسان العراقي، تلتقط عصبا من أسرار بسالته، وتخلّده فيها في عمل مقبل.
______
* انعام الشريفي، مترجمة وكاتبة عراقيَّة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.