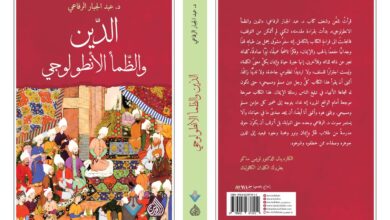ديناميكيَّة الدين كحاجة للأجيال في فكر الرفاعي

رجاء البوعلي[1]
قُبيل السبعين عامًا، الدكتور عبدالجبارالرفاعي قائلًا: “الإنسان هو مجموع معانيه الروحية والأخلاقية والجمالية” خُلاصة هائلة مُكثفةٌ بالمعنى القيّم للإنسان. هنا تكمن فرادة الرفاعي، كيف يأخذك في طريق شجاع وحر، وأخلاقي في الحين ذاته، كأنك على وشك الوصول، أشرعة المراسي تلوّح لك على الشاطئ لكنك فعليًا لازلت وسط البحر والأمواج تعصف بك يمنة ويسرة، هذه طبيعة الوجود، والله شرّع الأمواج للعصف بك، ليس تحديًا إنما ليُخرجك من قاع البحر نقيًا على سبيل النجاة، لن ينقذك أحدٌ من الغرق، فكل أنواع الغرق تحيط بك، إنما الأمر مُلقى عليك، فأنت حرٌ في عُرفه، مُكرمٌ بدخول مدينته الفكرية الإيمانية. ألست إنسانًا؟ إذًا أنت موعود بالضوء، والضوء كافٍ لإنارة الطريق.
المفتاح في اللقاء الأول
للقاءات الأولى طبيعتها الاستشرافية وليست القطعية، يأخذنا الفضول المعرفي للغوص أكثر وأكثر في بحر المعرفة إذا انفتح طريق الماء، فكيف انهمر الماء؟ كما يلتقي الناس في ميادين الحياة الواقعية؛ يلتقي القُراء والكُتاب في ميادين الفكر والمعرفة والآداب على أرفف المكتبات المنتشرة في العالم، وبين دهاليز الصفحات المُعتقة والمُحدثة، وهذا ما يجعل الكاتب كائنًا عولميًا يخترق الجغرافيات بهوية مُخففة من مادتها، يُقارب الثقافات في الفضاء الرحب، ينفذ في الأدمغة نفاذ الأكسجين، ويجري في الوعي مجرى الماء، ليؤثر في الإنسان أثر الفراشة، ذلك أثر القراءة. وكقارئة على سبيل النجاة، اشتدت قرائتي الجادة بعد تخرجي من الجامعة عام 2011 بدرجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، تعلمتُ من تلك الدراسة الأكاديمية أن الدين عامةً يحضر بشدة في الأدب الإنساني العالمي، كما أن الميثالوجيا تُسيطر على المجتمعات الإنسانية كافة وفقًا لسياقاتها الثقافية والتاريخية المتباينة، وأن قراءة الإنسان للأحداث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوعيه وقدرته على التأمل والتفكير المنطقي والقراءة النقدية، وفي ذلك كله لا يمكن أن نغفل عن أثر الدين في تفسير الإنسان للأقدار والأحداث الواقعة من حوله.
ومن دراسة وقراءة الأدب تلمستُ أهمية الإطلاع على تحولات الفكر الإنساني بصيغته المباشرة عندما أقتنيت كتاب ’’الدين وأسئلة الحداثة “ حوار وتحرير د. عبدالجبار الرفاعي، في طبعته الأولى 2015 الصادر عن مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد ودار التنوير للطباعة والنشر ببيروت، مدّ لي جسورًا هامة في ساحة تجديد الفكر الديني نحو قامات علمية أثرت المكتبة الفكرية الإسلامية، مثل د. محمد أركون، الأستاذ مصطفى ملكيان، د. حسن حنفي، د. عبدالمجيد الشرفي، فجاءت أشبه بالفتوحات على قراءة الفكر الديني الحديث، تعرفت أيضًا على الشيخ محمد مجتهد شبستري بكتاب “ نقد القراءة الرسمية للدين “ الطبعة الأولى 2013 الصادرة عن دار الانتشار العربي، ووجدت الدين برؤى مغايرة عن السائد والمشهور؛ فكتاب مثل “العقلانية والمعنوية“ لمصطفى ملكيان، يرفع منسوب التساؤل حول المعنى، أما أركون فبقوته يكسر حاجز التصالح والاستسلام والوهم بامتلاك الحقيقة بسؤال مائي “أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟“ في طبعته الرابعة الصادرة 2010 عن دار الساقي، ليترك القارئ في رحلة أشبه بالمعركة الجوانية أو الحرب السؤالية على الذات.
قرأت حتى بدأت أستشعر حسرة الجهل وغربة الوعي، تلمست تفكيك المفاهيم وهز المعتقدات المُعششة في الأذهان طويلًا مع جملة هؤلاء المفكرين، أعترف بأنهم هزوا قاعدة الثبات، ولكنهم لم يستطيعوا ازالتها كليًا أو استبدالها بما يُثبت الزلزال الفكري الحاصل، ليشعر القارئ بأنه عالقٌ في بحر عريض، لا هو قادرٌ على السباحة بأمان، ولا هو قادرٌ على العودة لشاطئ الراحة! وبين هذا وذلك كان لفكر الدكتور الرفاعي ملمحًا بارزًا بمحاولة تثبيت الزلزال وتهدئة الاهتزاز الشديد، برغم أن الفلسفة تعني بقرع جرس التساؤلات أكثر من تحصيل الإجابات، لكن ميزة الرفاعي أنه سعى لشد كل تلك الموجات والتذبذات نحو المركز – الذي هو انطولوجيا الدين – تحقيقًا لمقاصد مركزية الإنسان في الأرض كامتدادٍ لمركزية الله في الوجود. كما أيقنت أن ما يواجه الإنسان من ظروف اجتماعية وسياقات جغرافية وثقافية وتاريخية لها الأثر البالغ في صناعته الفكرية، مع اعتبار أنّ لكل إنسان سياقًا خاصًا، يتمظهر فيه الدين تمظهرًا مُتغيرًا في بعده الشكلاني وثابتًا أزليًا في بعده الوجودي. وتأتي رسالة كتاب “الدين والظمأ الأنطولوجي“ للرفاعي، لتُمسك على الدين كمعنى أصيل بالنسبة للإنسان عامة، مهما تعددت أساليب التعبير عنه والتجسيد له، فالأهم أن يظل نبضه يقظًا في الروح وحيًا بالأخلاقية الإنسانية.
بيد أن طريق الوعي بهذا المعنى حسّاس وسالكه قد يشعر بغربة، فالناس لا تريد المعرفة، لأن المعرفة تتطلب الشك والتغيير الأمر الذي يهز منطقة الراحة، مما يدفع بالإنسان للثورة أمام الهزة البسيطة للمسلمات المتراكمة لدرجة التكلس، والمانعة للتغيير في حالات كثيرة، فهو يفرح بالوهم المريح أكثر، وهنا تكمن صعوبة تحريك القيم والمعتقدات السائدة لعصور وأزمنة طويلة، لكن الإشكالية أن هذا الركون له انعكاساته التراكمية السلبية جدًا، فقد يتسبب في إهدار العمر كاملًا، وتضييع فرصة الحياة بجودة عالية وتوازن معتدل بين الحاجات الإنسانية المادية والمعنوية.
الإنسان بوصفه مشروعًا تنويريًا
أؤمن بأن الفعل الفكري ينطلق من الإنسان بوصفه فاعلًا حيًا تنويريًا على المدى المفتوح، ينبثق وجوده – الفعل – بولادته الكتابية مُعبرًا باللغة عن أهم الأفكار التي تقرع في ذهن الإنسان، تُربك فكره، تهز عاطفته، تُثير شكوكه لتقوده إلى الإيمان في أفضل الأحوال أما الأسوأ فهناك ضياعات محتملة كثيرة! وأجمل ما يُميز هذا الفعل الجوهري هو البقاء المُرسل على سطوح المكتبات، مُتجذرًا في تاريخ الفكر البشري، محفوظًا كإرثٍ وجودي يُخلد صانعه أبدًا على قيد الحياة، ويظل يجري كالنهر السلسبيل دون توقف أو انقطاع موسمي، ليشق مسالكًا في الأذهان، ويُنشئ بنىً تحتية في فكر الإنسان الحديث، ليُشيّد عليها مبانيه التراكمية، فتبقى صروحًا يتوراثها علم الاجتماع البشري. على هذا النحو الوجودي، وقفت قِبالة مشروعه في تجديد الفكر الديني، وقد أتيتُ من موقعٍ مُختلف بكل أبعاده الاجتماعية والثقافية والتاريخية لأكتب بصفة لا تشبه ما كُتب سلفًا عن بعض الموضوعات من مشروعه في فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، فأنا لستُ طالبة أبتغى شهادة علمية بكتابة بحثية، ولم أتبع يومًا أي انتماء. لستُ إلا قارئة على طريق النجاة، آتية من جيل الأبناء باعتباره من جيل الآباء، ومن بيئة اجتماعية وثقافية لا تشبه غيرها، فالتدين العنيف المُسلح الذي يتحدث عنه الرفاعي ويمقته بشدة ليس حاضرًا في مجتمعي – والحمد لله – بفضل الله ثم قوة الوطن الآمن، غير أن الحساسية المفرطة تجاه قضايا الدين هي المسألة الإشكالية، لكني أتلمس حاجة جوهرية لمشروع الرفاعي للإنسان الحديث لاسيما الأجيال المعاصرة والقادمة.
جدير بالذكر، أن فترة قرائتي تلك تزامنت مع تشكيلي للقاءات حوارية أشبه بالنادي القرائي للشابات في المنطقة، تدور الحوارات حول كِتاب مُنتخب أو موضوع مُجمع على تناوله، فتبدى لي ميلًا واضحًا لدى شريحة الشباب لقراءة الأدب الصوفي والفلسفي مثل رواية ” قواعد العشق الأربعون ” للروائية التركية أليف شافاق “، وكتاب “هكذا تكلمت زرادشت” للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، بالإضافة لطرح أسئلة كثيرة حول الدين ومحدداته، نافرة من التقليدية. وكمشرفة على عملية الحوار – التي أخذت في النمو نموًا بناءً لتأسيس أرضية لاحترام الرأي والرأي الآخر – خاصة مع حصولي آنذاك على شهادة المدربة المعتمدة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المملكة العربية السعودية، وتقديمي لبرامج حوارية في مؤسسات متعددة ولشرائح متنوعة، لاحظت التعددية الفكرية وأدركت صعوبة ضبط الميزان بين تلك المستويات المتباينة من الوعي والإدراك بقيّم الدين، فالتدين مفهوم فضفاض في سياق تطبيقه الاجتماعي. فماذا يعني الدين؟ ماهو التدين؟ من هو الإنسان المتدين؟ ماهي ملامح المجتمع المتدين؟ هل هناك فرق بين المتدين والمؤمن؟ وهل الملامح الشكلانية برهان على جوهرية الدين في إنسان هذا المجتمع؟ وماهي العلاقة بين الدين والقيم العليا والأخلاق؟ تُطرح هذه الأسئلة باعتبارها خروجًا عن الفهم الشائع والسائد، لفتح نوافذ الفكر نحو إيمانية عقلانية، لأن جرس السؤال يفتح أبواب البحث والتقصي، وعليه؛ تنقشع أغشية وتسقط أقنعة وتنكشف حقائق وتتأكد براهين ويترسخ إيمان جديد، غالبًا ما يكون أقوى وأقوم من نسخة ما قبل البحث والسؤال. استخلصت من تلك التجربة الحوارية قناعة؛ الحاجة لفكر ديني حاضن للأجيال المعاصرة والقادمة، بمواصفات ديناميكية قابلة لمواكبة حاجات الإنسان العصري؛ باعتباره كائنًا عولميًا، منخرطًا في صيرورة الحياة، وعنصرًا أساسيًا في العالم الحديث، وليس كفردٍ محجوزٍ في أفقه الخاص، وهذا ينطبق على مشروع الدكتور عبدالجبار الرفاعي، لقيامه على مرتكزات تأصيلية في صناعة الوعي الديني، أذكر منها.
أولًا: الدين والمعنى
يقول الرفاعي: “الدين هو المعنى الذي يستجيبُ للمتطلَّبات الأساسية لحياة الإنسان، الجسديَّةِ والسيكولوجيَّةِ والأنطولوجيَّةِ، ويزوِّدُ الإنسانَ بطاقةٍ إيجابية، تكفلُ له خلقَ حالةِ توازُن بين مختلفِ احتياجاته، ويجيب عن سؤال الوجود والمصير، فيخفض وتيرة القلق الوجودي الذي يفترس حياة الإنسان إلى أدنى حد، ويحميه من وَحشة الوجود، ويمنحه مزيدًا من طمأنينة القلب وسكينة الروح”، من كتاب ” الدين والاغتراب الميتافيزيقي ” الطبعة 3 صفحة 57. وهنا ينبثق السؤال الأكبر عن المعنى، أعني المعنى الذي ينفثه الإنسان بوجوده في هذا الكون الهائل، وهو سؤالٌ يطرحه كثير من الناس إثر تفكير وتأمل أو استشعار بوقوع في مأزق الحياة.
فما هو المعنى الذي يقصده الرفاعي؟ يربط الرفاعي بين المعنى الوجودي للإنسان والدين باعتباره حاجة أنطولوجية تحقق للنفس البشرية الغنى والثراء والمعنى في الحياة، ومهما تعددت المسالك والطرائق وتباينت مظاهر معتقداتها وممارساتها، تبقى متفقة في أنطولوجيا المعنى المقدس، وأصالته للوجود الإنساني، كلبنة عميقة في بنيته الفكرية والروحية والجمالية والأخلاقية. ويأتي التنوع كطبيعة في التكوين البشري الذي أراده الله، في قوله: ” وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ” حقيقًا لسبل الوصول الملائمة لتباين الوعي الإنساني والمعرفة المتنوعة في مشاربها.
ثانيًا: أنسنة الأديان، نذكر ثلاث تجليات:
- المحبة والسلام:
المجتمعات الحديثة التي تعولمت في سياق تطورها الحديث، تعي أهمية العيش المشترك بالحب الإنساني تجاه الإنسان الآخر بما تضمنه الأخلاقيات والقيم العليا، أقربها ما يمكن إدراكه في حيز الإمكان بقوله تعالى ” لِتَعَارَفُوٓاْ ” وأبعدها ما هو خارج حيز الإمكان في قوله: ” إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”، سورة الحجرات (13) وهنا يمكننا تجاوز منطقة قبول الآخر في سياق النفعية الاجتماعية Social utilitarian إلى سياق علاقة إنسانية خلاقة تستند على أصالة الله في النفس البشرية على اختلاف رؤاها وأساليبها، وطقوسها، اعتمادًا على جوهرية الغاية التي هي الإيمان بالمطلق. فالرفاعي يُقيم مشروعه الفكري مُتكئًا على الإنسان كمحور أساسي تدور حوله الحياة على الأرض، وخليفة الله الذي هو مركز الوجود، وعليه، يقدم تعريفاته لهذا الإنسان مرتبطًا بمشتركات وجودية متعددة مثل: الإيمان، الحب، الحرية، الرحمة.
- الحرية:
يبدأ بناء الإنسان ببناء الذات الباطنية أولًا، مُنطلقًا من الداخل إلى الخارج، داعيًا لتحرير الذات الفردية من الذات الجمعية، والفكر الفردي من الفكر الجمعي، فالإنسان فردٌ في خلقه ووجوده، يأتي ذلك بمعنى تخليصها من القيود الخارجية المفروضة، اعتقادًا بحقها في الحرية، الحرية التي هي نقيض العبودية. فيسأل الإنسان ذاته في مرحلة التحرر: من أنا؟ هذا سؤال الهوية الوجودية، الذي يصدم الإنسان بذاته كصورة منعكسة عن الذات الجمعية أو العقل الجمعي، كما عبر عنه عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركايم، نتيجة لتراكم طبقات فكرية إنسانية أقوى، يصعب تحركها بصفة مستقلة، خارجة من إطار مُحدد لها سلفًا، فيظل الأفراد يتناسخون فكريًا عن نموذج واحد، وهذا ما اعتبره الرفاعي “ نمذجة “ في كتاب الدين والظمأ الأنطولوجي، واستعرضه بشكل وافٍ في فصل ” نسيان الذات ” إنما يعتقد الرفاعي بأن ” الحرية ليست أمرًا ناجزًا قبل أن نشرع باستعمالها، وجود الحرية يعني ممارستَها. الحرية لا تتحقّق بعيدًا عن مسؤولية الفرد تجاه ذاته. لحظة تنتفي الحرّيّة تنتفي الذات ” من كتاب “ الدين والظمأ الأنطولوجي “ الطبعة 4 صفحة 36.
- اللغة الرحمانية:
لغة الرفاعي تنفذ في النفس النبيلة، ذلك لأنه يكتب بقوة المفكر العقلاني والمؤمن الروحاني والإنسان الأخلاقي، هذا المزيج المتجانس هو ما يجعل تأثيره يتحقق بلين القول وشدة الحجة، فقراءة كتب الرفاعي لا تحدك بحدود أوراقها بل تفتح للقارئ أبوابًا على موضوعات أخرى وشخوص استثنائية وعديدة، فكأنك في حضرته بين التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والدين في حصة واحدة، يحدث ذلك بلغة سلسلة بعيدة عن التعقيد الذي يحجب نشر المعرفة. ويُمثل الحب في لغة وفكر الرفاعي قيمة عليا، تماثل الإيمان وترتبط بوجودية الإنسان، باعتباره كما ينص ” الحب أعذب معاني الفرح ” بالإضافة لكونه رافدًا ضد الكراهية والظلام في هذا العالم.
ثالثًا: مهمة الدين وتجديد علم الكلام
يعرف الرفاعي الدين بـقوله: “الدين حياةٌ في أُفق المعنى، تفرضُه حاجةُ الإنسان الوجودية لإنتاجِ معنىً روحي وأخلاقي وجمالي لحياتِه الفردية والمجتمعية”. وفيه يقترن الدين بالمعنى الروحي والأخلاقي والجمالي لحياة الإنسان على المستويين الفردي والجماعي، إذًا هي معادلة بين الحاجات الإنسانية المتعددة في إطار أخلاقي، وهذا يعني إرساء قاعدة أخلاقية لضبط تلك الحاجات. وشخصيًا أرى أن هذه القيمة هي الأهم في سلم الوعي الديني المعاصر، الذي يواجه تحديات التغيير، التغيير على جميع الأصعدة، وهو مطالب بمواكبة الحياة المتطورة دون التخلي عن الدين. وهذا ما تقوم عليه رؤية الدكتور الرفاعي في تجديد الفكر الديني في الإسلام، ذلك؛ بإعادة تعريف المسلمات المنطقية في علم الكلام وهي: تعريف الإنسان، تعريف الدين، تعريف الطرق إلى الله، تعريف الوحي، تعريف النبوة، تعريف الشريعة، تعريف التكليف. يتحقق ذلك بتوظيف الفلسفة والعلوم الحديثة في قراءة وفهم النصوص الدينية.
سبعينية من الزمن
” الإنسان هو مجموع معانيه الروحية والأخلاقية والجمالية ” خاتمة القول هي افتتاحيته، فالحكمة رفيقة الفيلسوف الأخلاقي صانعٌ للمعنى الوجودي، وهذا ما يبزغ لنا بالنظر لسيرة الإنسان المفكر بتتبع هذه التجربة، يأخذنا التأمل والتعلم والإعجاب بسيرة أبدعت في تقديم معناها، وحفرت وجودها عميقًا في تاريخ فلسفة الدين، الدكتور عبدالجبار الرفاعي، يمضي قُدُمًا في سماء السبعين، حاملًا على عاتقه رحلة طويلة لمركز دراسات فلسفة الدين ببغداد، ومجلة قضايا إسلامية معاصرة، ومشروع ضخم في علم الكلام الجديد يقود به أجيالًا معاصرة وأخرى قادمة في طريق الدين الديناميكي، القادر على السير الموفق نحو اللانهاية. نسأل الله أن يبارك له في عمره وعلمه وعمله، ويسبغ عليه رداء الصحة والعافية.
مقالات سبعينية المفكر العراقي الدكتورعبدالجبار الرفاعي
رجاء البوعلي – أديبة وكاتبة رأي سعودية
[1] أديبة وكاتبة رأي سعودية.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.