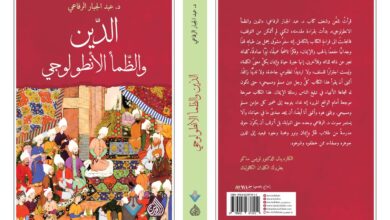فيلسوف المعنى عبد الجبار الرفاعي؛في ضوء كتابه “مقدِّمة في علم الكلام الجديد”

د. كوثر فاتح[1]
ملخص
تقدم هذه الورقة البحثية قراءة مركبة للمشروع الفكري لعبد الجبار الرفاعي كما جاء في كتابه: “مقدمة في علم الكلام الجديد”، إذ تنطلق الورقة من فكرة أنّ هذا الكتاب هو أكثر كتابات الرفاعي إفصاحًا عن ثورته الناعمة على التحجر والانغلاق في الفكر الإسلامي.
بعد وقوف الرفاعي عند الحاجة الانطولوجية للإيمان، وتأكيده على الأسس الميتافيزيقية للوجود الإنساني، ودعواه إلى “أنسنة إيمانية” جديدة، وبناء مشروع تأويلي معاصر؛ يذهب الرفاعي في كتابه هذا إلى زعزعة ثوابت عِلْم ميّز الفكر الإسلامي وابتنى عليه وهو علم الكلام، يفسّر من خلال ذلك الرفاعي الانتكاسة الفكرية للحضارة الإسلامية.
عندما نقرأ للرفاعي هذا الكتاب وغيره نراه يقوم بانتفاضة تأويلية بأدوات إبستيمولوجية وغايات إيمانية لتحقيق “ثورة المعنى”، الذي يشدد الرفاعي على ضرورة استحضاره في التفكير الديني اليوم. نكتشف من خلاله أن الرفاعي “فيلسوف معنى”، كما يعبر كتابه هذا عن ذلك، وما يؤسس له في تعريفه الذي ينفرد فيه للدين. الشغف باكتشاف المعنى في الدين هو الهمُّ الذي يتحكم في منهج الرفاعي لفهم رسالة الدين في الحياة، وتفسير القرآن الكريم وكل النصوص الدينية. في بحثنا هذا، نميل للقول ان الرفاعي يسعى لاكتشاف “المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي” حيث وجده في الدين ونصوصه. ويجعل من هذا المعنى منطلقًا للفهم، ويضعه ميزانًا لكل ما يقبله من الموروث؛ ذلك هو رهان كتابه: “مقدمة في علم الكلام الجديد”.
تلقي هذه الورقة البحثية إذن الضوء على علم الكلام الجديد عند عبد الجبار الرفاعي من حيث إمكاناته، ممكناته، عوائقه وحدوده، انطلاقا من مقاربة مستعرضة للقول بأن التجديد في علم الكلام لا يعني القطيعة الإبستيمولوجية، بقدر ما يخص المنعطف الهيرمينوطيقي من أجل تأويلية هيرمينوطيقية في الفكر الإسلامي.
كلمات مفتاحية
علم الكلام -معنى -هيرمينوطيقا- تأويل-تجديد -قطيعة-منعطف
Abstract
This scientific review is shedding light on the intellectual project of Abdul-Jabbar Al-Rifai، as stated in his book “Introduction to the New Theology”. The central question of the book is to ask what it means to take this new theological vocation seriously. Then، Al-Rifai tries to destabilize the hermeneutical foundations of a science which distinguishes، in large measure، the Islamic school of thought. Using an analytical criticism Al Rifai provides guidelines to justify the theory of an intellectual setback of Islamic civilization.
This research is discussing the epistemological standards for the emergence of the new theology as envisioned by Al-Rifai. The discussing is based on a transversal approach to saying that renewal in theology does not mean epistemological rupture as much as it refers to a hermeneutic turn. The paper contributes to better understanding of the hermeneutic process in new islamical theology.
Keywords
New theology-interpretation-rupture-hermeneutic -turn
- جغرافيا الكتاب
“مقدمة في علم الكلام الجديد” هو الكتاب السادس من سلسلة كتب خصها عبد الجبار الرفاعي لدراسة علم الكلام؛ دشنها بتحرير كتاب: “علم الكلام الجديد وفلسفة الدين” الصادر سنة 2002، مرورا بـ “الاجتهاد الكلامي: مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد” (2002)، فكتاب: “مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد” (2005)، ثم “تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية” (2010)، و”علم الكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين” (2016)، وأخيرًا كتابه هذا، موضوع الورقة، الصادر مستهل2021
علم الكلام إذن أرق مزمن يلازم كتابات الرفاعي، ولعله جوهر مشروعه الفكري كما ذهبت لذلك زبيدة الطيب، وإن كان مشروعه هذا يتجاوز نقد التراث الذي أشارت اليه الطيب، والذي عزتْه لدوافع ذاتية وتكوينية وعملية (زبيدة الطيب، (2019، وإن كنا نرى في الرفاعي “فيلسوفَ تأويل” أكثر منه “فيلسوفَ نقد”، طالما أن هاجس اكتشاف المعنى يسكن مشروعه الفكري أكثر من هاجس العقل، وإلا كيف لنا أن نبرر تصوف الحياة عنده أو لاهوت الحياة، أو قوله بظمأ أنطولوجي واغتراب ميتافيزيقي؟
عمومًا، قد تكون بدايات الرفاعي نقدية، لكن كتاباته المتأخرة تأويلية، فأيّ جديد يحمله هذا الكتاب؟ وأية خبايا يفصح عنها في فكر الرفاعي؟
يقدم هذا الكتاب قراءة تاريخية لظهور مفهوم “علم الكلام الجديد”، تسافر به في جغرافيا الاجتهاد الإسلامي، وتقف عند محطة الإسلام الهندي، تلك المحطة التي مازالت غير حاضرة كما يليق بها في المباحث الفكرية العربية؛ ذلك أنّ القطار الفكري الحديث للعالم الإسلامي قد توقف كثيرًا عند محطة “الغرب”، ولعل ساعة الرحيل قد آنت، فلدى الحضارات الأخرى الشيء الكثير لتعلمنا إياه، لذلك لا يزال حضور الفكر الإسلامي الهندي في العالم العربي حضورا باهتا (الرفاعي،2017).
على مستوى بنيته؛ جاء الكتاب في أربعة فصول تتباين كمًّا وموضوعًا. الفصل الأول، اختار له الرفاعي عنوان: “علم الكلام: ملخص لنشأته وتطوره وعجزه وانسداده”؛ والذي انهال فيه الرفاعي بسهام نقد جريء على علم الكلام القديم، مقدمًا لتشريح دقيق لأسباب كساده الفكري.
وحدد في الفصل الثاني بوضوح أن: “علم الكلام الجديد هو الفهم الجديد للوحي”، ليشرح لنا الأبعاد الإبستيمولوجية لهذا العلم القديم الجديد؛ مقدما لمقاصده وضوابطه، وموضحًا لمحورية الوحي الخاصة فيه.
في حين يتعلق الفصل الثالث من الكتاب بـ: “الفهم الجديد للوحي في الهند” بقراءة نقدية لإسهام المفكرين المسلمين الهنود وتجديدهم، وفي هذا المبحث الذي ينتهي من خلاله الرفاعي إلى الإقرار بجرأة مفكري الهند وتحررهم النوعي من رقابة الماضي.
أما الفصل الرابع من الكتاب فهو بعنوان: “إيقاظ المعنى القيمي للدين في علم الكلام الجديد”، هو يشكل فرصة للرفاعي أثناء إحدى حواراته يعود من خلالها إلى هاجس اكتشاف المعنى الديني الذي يؤسس له مشروعه الفكري منذ بدايته، وهو كذلك فرصة انتهزها الرفاعي ليقدم المبررات الأنطولوجية الإبستيمولوجية والأخلاقية للتجديد في هذا العلم.
تلك خطة ذكية من الرفاعي، لأن كتابات التجديد تهتم باستقراء الوضع القائم ثم تنتقل إلى اقتراح مناهج تصحيحية، لذلك سعى الرفاعي إلى إشراك القارئ بضرورة إدراك الحاجة الملحة إلى تجديد علم الكلام؛ ولعل هذا ما يسمح لنا بالقول إن ما يقترحه الرفاعي في كتابه هذا هو خطة تصحيحية لاستدراك ما ترتب عن موت سريري لعلم الكلام الذي استمر طويلًا.
ربما لا نكون بصدد ولادة علم جديد كما قد يوحي بذلك العنوان، بل بنضوج جديد لهذا المبحث الفريد في تاريخ الفكر الإسلامي؛ إنه قانون التغيير: إما الموت أو الاستسلام لرهان التغيير. ولعلها ولادة جديدة تلك التي يبشر بها الرفاعي، وإن كان من الصعب التكهن بالمسافة الزمنية بين البُشرى وتحقق الأماني، والأصعب هو إيجاد الطريق والأدوات؛ لعل هذا هو السبب الذي يدفع الرفاعي للاعتراف بقوله: “لا يمكن بناء علم كلام جديد بديل لعلم الكلام القديم بمدة زمنية وجيزة، وإن كانت محاولات بعض المفكرين جديرة بالتبجيل، لعلميتها ورصانتها وجديتها …”. (الرفاعي، ص 24). إن الأمر إذن يتعلق بمشروع فكري تتعاون فيه أيدٍ وإرادات موحَّدة غايتها الفهم وليس الإقناع.
ولأن لكل عصر أسئلته فلا بد أن يكون لكل عصر إجاباته، فأية أسئلة تلك التي يوقظها الكتاب؟ وأية إجابات قد يحملها؟ أم أن الرفاعي على نمط كيركگورد الفيلسوف الدانماركي الذي خصه بكتاب: “الحب والايمان عند سورن كيركگورد” (2015)، ربما لا يخلو فكره من حضور مختلس لتصور الفيلسوف الدانماركي للإيمان، وإن كان الرفاعي لا يتفق كليًا مع كيركگورد في أفكاره. ولعله قد تأثر هو الآخر بذبابة الخيل المزعجة، فجاءت كتاباته دعوة ملحة لتحريرنا من كسل التأويل والركون للمألوف.
عموما، الكتاب رحلة شيقة في التاريخ، والجغرافيا، والدين، وفلسفة المعنى، والسياسة، باتجاه محطة أخيرة هي اكتشاف المعنى في الدين حيث الوعد بـ “إنسانية إيمانية”.
- الكتابة الرفاعية
تحضر عند الرفاعي لغة السرد بقوة أيضا، ويستسلم كثيرا للاعتراف، دون أن يغرق كتاباته في بحور التبشير الديني، بل على العكس من ذلك، تحضر النزعة العقلانية النقدية بقوة أحيانًا، إذ تستنفرنا في كتاباته انتفاضة ومقارعة للأطروحات المتحجرة والآراء الراكدة.
على هذا الأساس لا يمكن أن تقرأ كتابات الرفاعي إلا ضمن ازدواجية الدين والفلسفة. قد يكون للمرجعية التكوينية للرفاعي سبب في ذلك، فهو يجمع في زواج سعيد بين الفكر اللاهوتي والفلسفي، والدراسة الحوزوية والأكاديمية، وقد تكون لمهنة التدريس دورها أيضا في انصرافه غالبا إلى أسلوب الحوار الذي يتيح له التحرر من سيولة الكتابة الأكاديمية، باتجاه بينذاتية الخطاب المتبادل، لذلك تبدو كتابات الرفاعي سلسة بنكهة عذبة، وإن تكررت بعض الأفكار هنا وهناك. إنّ قلق العقل وكثافة السؤال إذن أهم ما يميز فكر الرفاعي (الطيب، ص 14).
من جهة أخرى، كتابات الرفاعي غزيرة، لذلك من غير الصحيح القول بأن التأليف قد يعجزه، لاستمرار مؤلفاته وكتاباته وتدفقها المتواصل، أو أنه غير قادر على بلورة منهج فكري واضح المعالم إبستيمولوجيًا، أو أن خيار الذاتية نراه في كتاباته (معاذ بني عامر، الظمأ الإبستيمولوجي في كتاب “الدين والظمأ الانطولوجي”)، (مؤمنون بلا حدود، فبراير2016)؛ ذلك أن حضور الذاتية إثراء للمعنى لا ينفي رصانة التفكير، بقدر ما يعبر عن انخراط فاعل في هموم وانشغالات مشتركة مع العامة من الناس، ولعل الذاتية أيضا إشراك للقارئ غير الخبير، وتحرير للخطاب الأكاديمي من قيوده.
لا يبدو أن الرفاعي يكتب لخواص فقه أو فلسفة دين، ولأنه يقارب الظاهرة الإنسانية، فلا بد أن تأتي كتاباته متجاوزة ضيق أفق الإبستيمولوجيا والعقلانية الصارمة، ذلك أن النزعة الإنسانية تغلب على فكر الرفاعي؛ وتحضر بقوة في كتاباته كثيفة المعنى، حيث تتجاور مفاهيم لم يكن في خطة واضعيها أن تقترن ببعضها، أما إذا غلبنا كفة العقلانية، وهو ما يميل اليه أغلب الدارسين للرفاعي، معتبرين إياه “فيلسوف تنوير ديني”، (ز .الطيب، ر. ج. كاظم، ب. الكرباسي…)، فقد نتلمس عنده فَقْرًا إبستيمولوجيًا، غير أن هاجس التنوير العقلي ثانوي عنده، إذ يطغى على كتاباته أرق الفهم وكشف المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي في الدين، فلا تكاد تخلو كتاباته من عودة متكررة لمفهوم المعنى باعتباره غاية مشروعه الفكري. وقد يكون من الأولى قراءة الرفاعي في ضوء الهيرمينوطيقا الغنية، وليس في ضوء تنويرية عقلانية فقيرة، فلا يكفي استدعاء خطاب عقلي للقول بأهداف تنويرية، أما المعنى فقد يتجاوز حدود العقل.
الرفاعي يتجاوز في كتاباته توثين العقل وتسيّده الديكارتي، واهدار كل معنى خارج العقل كما انتهى الفيلسوف ديكارت وأمثاله. يهتم بالمتخيل، ويرى أن تجاهل دراسة أثر المتخيل في فهم الدين وتفسير وظيفته أحد أبرز الثغرات عن مفكري الإسلام في العصر الحديث. المتخيل في نظره موطن صناعة المعنى الديني والابداع الأدبي والفني، يقول الرفاعي: “اكتشافُ جغرافيا المتخيَّل وفاعلياتِه ضروريةٌ للكشف عن نشأةِ وتطور الأديان، وأثرِ مخيلة الجماعة في إنتاج المعنى الديني، وكيفيةِ ولادة وتضخّم مخيلتها في سياق: رغباتها، وأمنياتها، وأشواقها، وأحلامها، وأوهامها، ومسعاها للتعويض عن كلّ ما تعجز عن إنجازه في عالمها الأرضي، بنحوٍ يمسي ذلك المتخيَّلُ شديدَ التأثير في حياة الفرد والجماعة، وربما يطغى تأثيرُه، فيسيطر عليها ويأسر حاضرَها ومصائرَها… المتخيَّل موطنُ صناعة المعنى الديني والابداع الأدبي والفني، يعيش فيه الدين والأدب والفن، ويتغذى وينمو ويتجذّر ويتشعّب كنسيج متشابك يتكثّف على الدوام. المتخيَّل شبكةُ صور راقدةٌ في اللاوعي الجمعي، تترسّب وتتراكم وتتغذى مما تنتجه سردياتُ الجماعة، وتأويلُها لنشأتها وتحولاتها ومختلف وقائع تاريخها ومطامحها وأحلامها. من يمتلك المنابعَ المغذّية للمتخيَّل الجمعي يتحكم بنظام إنتاج المعني في حياة الجماعة، ويتحكم بتوجيه حاضرها ومستقبلها”، “الرفاعي، المسألة الدينية عند الوردي: رؤية نقدية”.
الرفاعي مسكونٌ باكتشاف المعنى في الدين أكثر من شغفه بالعقل. يبدو أن الخيط الناظم في كتاباته هو الإنسان وليس الدين،كما قد توحي بذلك قراءة أولى لما يكتبه، فما الدين عنده إلا ما ينشده من المعنى الذي يثري به حياة الإنسان. نقرأ ما يقوله في كتابه الأخير الدين والكرامة الإنسانية: “هذا الكتابُ محاولةٌ في فهمِ الإنسان أولًا، ومعرفةِ شيءٍ من طبيعته، واكتشافِ احتياجه لمعنى وجوده، والوقوفِ على شيءٍ من الدوافع المتضادّة لسلوكه ومواقفه. لا يمكن أن نفهمَ الدينَ قبلَ أن نفهمَ الإنسانَ، وحاجةَ الإنسان لمعنى لحياته، وحاجتَه للكرامة… في كل هذا الكتاب وغيره من أعمالي، اعتمدت المعيار الذي أفهم فيه الدين بوصفه حياة في أُفق المعنى، تفرضه حاجة الكائن البشرية الوجودية لإنتاج معنى روحي وأخلاقي وجمالي لحياته الفردية والمجتمعية”. (الرفاعي ص 145).
ولعل الرفاعي سابق على دارسيه ممن لا يزال يغريهم مشروع التنوير، وإن كان مجرد محطة في تاريخ الفكر الإنساني انتقلتْ بنا اليوم إلى فكر ما بعد حداثي، شهد عودة قوية للروحانيات وللميتافيزيقا الدينية وعودة للإله. في كتابه: “Psychothérapie de Dieu” يعرج بنا Boris Cyrulnik على الحاجة الأنطولوجية للدين ولله، باعتبار الدين بعداً نفسيًا وعلائقيًا واجتماعيًا ووجدانيًا يعطي للوجود معنى، مصرحًا دون تردد بأن هذه الألفية الثالثة ألفية تديّن روحاني دون شك. وفي هذا تعزيز للمقاربة الفلسفية للرفاعي من زاوية علم النفس العصبي، وتأكيد على الحاجة المتزايدة للمعنى وليس للعقل. على هذا الأساس يمكن أن نلحق الكتابة الرفاعية بالمدارس ما بعد الحداثية، التي تحررت من قيود القطائع الإبستيمولوجية بين الحقول المعرفية، وتخلصت من وزر الشرط العقلي، وعدم رؤية تطلعات الروح وأشواق القلب.
إن عبدالجبار الرفاعي “فيلسوف معنى”، وفيلسوف المعنى يختلف عن “فيلسوف المنهج”. يحضر السعي لاكتشاف المعنى في الدين في كل كتاباته بكثافة، ففي تعريفه للدين يحيل اليه بوصفه: “حياة في أُفق المعنى” حسب فهمه، مثلما يحيل إلى “المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي” لوظيفة الدين، وأن المعنى هو الأُفق لانتظار الإنسان من الدين، ويضع الرفاعي الكشف عن هذا المعنى غاية كل عملية تجديد للدين، كما يضعه معيارًا لاختبار قيمة وراهنية أي فهم للدين وتفسير لنصوصه يواكب الحياة وتقدمها.
- عن غرض الكتاب
يضعنا الكتاب أمام مأزق الفهم، حيث يستسلم الرفاعي في مدخل كتابه للتعبير عن ضيق ما يشعر به نتيجة انحسار أفق التأويل في العالم الإسلامي؛ ذاك الضيق نفسه الذي نستشعره في كتاباته السابقة، وكأن مجمل كتاباته تأوهات فلسفية تنتفض ضد قيود تأويل لازماني، لتطالب بتحرير الزمن والطلاق من ماضٍ نرفض أن يمضي.
ينطلق الكتاب من الإقرار بالحاجة الأنطولوجية للبعد الديني والإيماني في الوجود الإنساني، يعرج بعدها الرفاعي للاعتراف بأن الطبيعة التأويلية للدين ونصوصه، واستغلاله كمادة للأيديولوجيا وشبكات المصالح المتصارعة، تجعله خاضعًا لصراعات التأويل وأيديولوجيا القراءات، مصرحًا بأنه يجمع بين عاملي الهدم والبناء، (الرفاعي، ص (5، فهو معًا رسالة للموت ورسالة للحياة (ص 6). لا يمتنع الرفاعي بعد هذا عن استنكار “شح المعنى” الذي فرضه تعطيل الاجتهاد والتجديد في المعارف الدينية، وكيف أن المعنى الذي يفيضه الدين على الإنسان، وتفاعل ذلك المعنى مع روح الإنسان وقلبه ومشاعره، وحاجة الإنسان إليه مادام حيًّا، وعجز الإنسان عن تأمينه من منبع بديل، كل ذلك -كما يقول الرفاعي- يدعونا: “للانتقال من علم الكلام القديم إلى علم الكلام الجديد، استجابة لما فرضته الأسئلة الحائرة للإنسان وقلقه الوجودي، وشح المعنى في حياته، وشعوره بعدم الأمان”، (الرفاعي، ص (6. هو إذن تصريح برفض الفهم الواحد وإقصاء الفهوم الأخرى. (الطيب ص 8).
في صفحات الكتاب الأولى، يقيم الرفاعي تقابلا سريعا بين القراءة البروتستانتية والكالفينية والقراءة الأشعرية لفكرة الخلاص؛ الأولى دنيوية، في حين أن الثانية أخروية، إذ جعل البروتستانت من العمل سبيلا للخلاص الديني، ولعل هذا ما يفسر ازدهار الرأسمالية، وفقًا لتصور ماكس فيبر الذي يستند إليه الرفاعي. قد يكون لهذا التقابل ما يبرره من جهة، إلا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار المخاض التاريخي للحركة الإصلاحية المسيحية، والثمن الذي دفعته مقابل التحرر من تغوّل “حراس المعبد” على حدّ قول ابن سينا. أما في عالمنا الإسلامي فإن مشاريع الإصلاح لم تعمّر طويلا؛ ليس لأن الخطاب الديني الإسلامي عصي على التجديد، وإنما لعوامل تاريخية وسيكو-اجتماعية، ربطت نهضة المسلمين بالدين وحده، وجعلته مبررا لكل تميز. وإن كان الدين من دوافع النهضة إلا أنه ليس دافعها الوحيد، لأن هذا الدافع سرعان ما تحول إلى ذريعة نبرر بها تفوقنا إن وجد، وفشلنا متى اعترفنا به، لكن لا يقتضي الإصلاح قطع الحبل السري مع الماضي، وإنما القطيعة الإبستيمولوجية مع العذر الواحد، فأعذار تخلف المسلمين الحضارية كثيرة، وليس ارتهان الفهم الديني للماضي إلا أكثر أشكالها ظهورًا. وقد تكون التجربة الاستعمارية التي عاشتها مجمل الدول الإسلامية مبررًا آخر لموقف الانغلاق على الماضي وإحساس الدونية المتلبس، وقد يكون أصل ما يعانيه المسلمون هو “أزمة ثقة ثقافية”.
لهذا تجتمع في الأزمة الحضارية عند المسلمين – حسب الرفاعي – أزمةُ الزمن وأزمةُ المعنى. من هذا المنطلق يقترح الرفاعي في الصفحات الأولى من كتابه الانطلاقَ من مسلمة التغير التاريخي، والتأكيد على أن الدين مكون أساسي لبناء معنى الوجود، لما له من أثر في تكون البنية الذهنية للمجتمع، خاصة في المجتمعات التقليدية، لينتقل بعد ذلك إلى المقاربة الهيرمينوطيقية بغرض الإفصاح عن أسباب تخلف المسلمين الحضاري، والذي يعزوه إلى تعصب تأويلي، وتقديس لقراءات تعالت على النص نفسه، من هنا جاءت الحاجة إلى “علم كلام جديد” يؤسس لفهم آخر للمقدس في علاقته بالإنساني. وبناء عليه يلح المفكر العراقي – في سياق خارطة طريق تأويلية – على ضرورة إعادة تشكيل صورة الله، وإعادة تعريف الوحي، مع الايمان بمصدره الإلهي، إذ يقول: “الفهم الذي أتبناه للوحي لا يهدرُ البُعدَ الإلهي الغيبي المتعالي على التاريخ الذي ينطقُ به الوحيُ”، مع الإقرار بالبُعد البشري للوحي؛ من حيث التلقي البشري له؛ ومن حيث حضوره في الواقع، فيؤكد على أن: “البُعد الإلهي في الوحي لا يقعُ في إطار صيرورة التاريخ وسياقاته، بخلاف البُعد البشري في الوحي الذي يقع في إطار صيرورة التاريخ وسياقاته”، (الرفاعي، ص141-142). يشدد الرفاعي على ضرورة إعادة تشكيل صورة الله، وإعادة تعريف الوحي، باعتبارهما البدايات الأولى لإعادة بناء معنى الدين عند المسلمين، واللبنة الأساسية لإعادة الثقة بزمانية حضارتهم، ليكون غرض الكتاب هو الكشف عن تموضع النص الديني في التاريخ، وخضوع عملية التأويل نفسها لبراديم التطور، حتى نتجاوز “شح المعنى”، (الرفاعي ص 9) .
الكتاب إذن ككتابات الرفاعي السابقة استكمال لمشروعه الفكري، المطالب باكتشاف المعنى في الدين، وبإعادة التصالح مع الحاضر ومع الإنسان، لكن بشرط طلاق ودي مع الماضي؛ لا يمحو ذكراه بقدر ما يحفظ جميل صنيعه، فهو ليس تأسيسا لعلم جديد بقدر ما هو دعوة أخرى إلى انطلاقة فعلية لورش التجديد في عِلم ميّز الحضارة الإسلامية. إجمالا يمكننا القول بأن الانطلاق بعلم الكلام خصوصًا وبالفكر الإسلامي عمومًا نحو رحابة المعنى، وتحريرهما من إرث الفكر ما قبل الحداثي، من الأهداف الأساسية للمشروع الفكري لعبد الجبار الرفاعي.
- الإسلام الهندي
ينخرط الرفاعي في هذا الجزء من كتابه في سجال فكري مع بعض أعلام المدرسة الهندية، فهو يعترف في مستهل مقاربته التاريخية لمنشأ علم الكلام الجديد بندرة المراجع التي تكشف عن بداية التأسيس والظهور الأول لـ “علم الكلام الجديد”، ويحاول أن يؤرخ بإيجاز لذلك، فيشير إلى الولادة العسيرة لهذا العلم، وذلك نتيجة تداخل أدوار مفكرين كثر تتأرجح بين سنوات اجتهاد خصب وتوالي سنين فكرية عجاف، (الرفاعي، ص 28). يرفض الرفاعي نسبة هذا العلم لاجتهاد فردي، وهذا ما يجعله يلحقه بسيرورة تكامل المعرفة الإنسانية، حيث يكتب: “يغدو القول بوجود فرد واحد مؤسس لهذا العلم قولًا يقفز على حقائق التاريخ ويجهل المدلول الحقيقي لتجديد الكلام… وليس تجديد علم الكلام بدعًا من ذلك؛ وإنما هو مشروع تضافرت في احتضانه وتطويره مبادرات وجهود فكرية وعملية، أسهم فيها رجال كثيرون من أعلام المسلمين في العصر الحديث، وإن كان دور الريادة يبقى نصيب عدد محدود منهم “، (الرفاعي، علم الكلام الجديد ووهم التأسيس، 2002).
تنطلق رحلة الرفاعي في البحث عن أصل تسمية علم الكلام الجديد ونشأته ومؤسسيه من الهند، إذ يجد الإرهاصات الأولى لقيام علم الكلام الجديد في الإسلام الهندي، فيرى أن علم الكلام الجديد انطلق من الهند، بفضل التعددية الدينية والثقافية، ثم إيران عن طريق الترجمة ابتداءًا، حيث أعاد المفكرون الإيرانيون تكوينه والعمل على بناء مرتكزاته الأساسية وتطويره، ثم انشغل فيه العرب، إذ أغنى مفكرو البلاد العربية علم الكلام الجديد وفلسفة الدين بتوظيف الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع الحديثة.
إن ما يميز الهند حسب الرفاعي هو: “تنوع ميتافيزيقي، وعقل تركيبي يثريه تراكم تجارب الأديان وتلاقحها”، (الرفاعي، ص 73). في المقابل، يقر الرفاعي بالفقر الميتافيزيقي للتيار السلفي في العالم العربي، وميله إلى حرفية التفسير، وتزمته في النفور من الدلالات الرمزية للنص، وانغماسه في بساطة الفهم، مما يحرمه من خصوبة المعنى. وينسب انتشار التفسير السلفي في الجزيرة العربية إلى عوامل جغرافية واجتماعية وثقافية، (ص 51 )، جاعلاً من الأرض القاحلة وفقرها الميتافيزيقي مرتعًا لعوز الفهم وضيق أُفق التأويل، وقد لا تكون الأسباب الجغرافية وحدها عاملًا في انغلاق المعنى، فتلك الصحراء قد أنجبت من تملّك اللغة وروض المعنى و طوّع الدلالات كما نقرأها في الشعر، ولربما الإفراط في الاعتقاد بتفرد الحضارة العربية وتميزها، والنزوع إلى التعالي البيّن على باقي الشعوب، في رد فعل فاضح لمركب نقص ثقافي، من دوافع التقوقع على الذات وفقر التأويل وتغييب البعد الزماني فيه. إن العيب ليس عيب أرض، بل عيب مَنْ يسكنها.
بالعودة الى الهند، نجد أن الحركة الإصلاحية فيها تأرجحت بين تيارين دينيين متعارضين: تيار تصوف تعددي بنكهة عرفانية ينسب لابن عربي، (ص 52)، الذي يعده الرفاعي تيارًا منفتحًا؛ يمثله كل من: ولي الله الدهلوي، وسيد أحمد خان، ومحمد إقبال، وفضل الرحمن. ويغيب أثر هذا التيار في الفكر الديني للجماعات الإسلامية في المحيط العربي، لميله أكثر إلى العرفان، وتجاوزه لخطوط الأدبيات السلفية، لهذا اقتصر اتصال العرب بالهند على الشعر والأدب، كما هو الحال مع محمد إقبال مثلا، الذي اشتهر بالعربية بوصفه شاعرًا، وليس فيلسوف دين ومتكلمًا جديدًا.
إلى جانب هذا التيار التعددي المنفتح وُجد تيار كلامي أُحادي آخر منغلق، يمثله كل من: شبلي النعماني، أبو الحسن الندوي، وأبو الأعلى المودودي، وكان الأخيرُ الأكثرَ انغلاقًا وتشددا حسب الرفاعي. هذا التيار يثير شهية الجماعات الإسلامية العربية لقربه من خطابها الأصولي، كما يصرح بذلك الرفاعي، (ص53)، الذي يرى أن فكر المودودي هو الأكثر حضورًا والأعمق تأثيرا في أدبيات الجماعات الدينية العربية، نظرًا لاختلاط مشروعه الفكري بأهداف سياسية، أبرزها حلمه بإقامة دولة ما قبل الدولة الحديثة، لذلك فإن الأحلام السياسية عنده غطت على أهداف الإصلاح، فانغمس مشروعه الفكري في أيديولوجيا الجماعات الدينية. ونظرا لتبني المودودي لخطاب القوة والعنف، وصخب قراءته الأيديولوجية السياسية، يكتب الرفاعي أن: “المودودي حوّل الإسلام إلى: دين بلا روح، ودين بلا قلب، ودين بلا عقل”، (ص 54). في عبارة أخرى في كتابه: “الدين والكرامة الإنسانية” يضيف الرفاعي موضحا أكثر موقفه من المودودي فيكتب: “أهدر المودودي المعنى الذي يمنحه الدين للحياة، وأدخل هو، ومن سقط في شباك قراءته السياسية لعقيدة التوحيد الإسلامَ في مأزق حضاري؛ ذلك أن الدين الذي يخلع على نفسه جلبابا سياسيا يهدر الدلالات الميتافيزيقية لكتابه المقدس، ويبدد المعاني الروحية والأخلاقية والجمالية التي يمنحها الدين للحياة”. (الرفاعي، ص 135) .
وقد نبّه حسن حنفي هو الآخر لأثر فكر المودودي على الجماعات الدينية خاصة في مصر، إذ خصّه بمقال مهم في كتابه: “الدين و الثورة في مصر، الحركات الدينية المعاصرة”، وقف من خلاله عند أثر هذا المفكر على هذه الجماعات في حديث مطوَّل عن الأسس الفكرية لمشروعه، وكيف تغذّت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من معين حلمه بدولة دينية، لذلك فإن غلبة الأطماع السياسية على مشروع التجديد كافية لإقصاء المودودي من سيرورة التجديد التأويلي، بل إن مشروعه الفكري هو أقرب إلى التطويع الأيديولوجي للدين، (حسن حنفي، الدين والثورة في مصر، الحركات الدينية المعاصرة 1988، 1981-1952، مكتبة مدبولي، القاهرة).
لا بد أن نضيف هنا أن موقف الرفاعي من الحركات الدينية العربية موقف ناقد، يتضح من خلال نقده لـ “أدلجة الدين” أو “التدين السياسي”، كما أشار له في تصنيفه لأشكال التدين. ليس لنا إلا أن نقول إن الرفاعي ينقد كل مظلة تأويلية تحجب معنى الدين الروحي والأخلاقي والجمالي، إذ أن الدين عنده تغلب عليه الغاية الأنطولوجية، بتجلياتها الروحية والأخلاقية والجمالية، كنوع من “تصوف عقلاني”. ما دفعنا لهذا التصنيف هو قول الرفاعي بتحديد مجال الدين في مجال المعنى، ورفضه لإقحام الجماعات الدينية وتوظيفها المارق لخطاب المقدس في السياسة، ودغدغتها لأحلام دولة ما قبل الدولة الحديثة. نقرأ في كتاب الرفاعي أن “الدين لحظة تأسيسه انبجاس غزير لينبوع المعنى… وقد يصبح الدين أخطر ما يهدد بنية المجتمعات البشرية، لأنه عندما يخرج من حقله الطبيعي ويجتاح حقول الحياة الأخرى خارج مجاله، يصادر كل ما هو من اختصاص العقل والعلوم والمعارف والتجارب البشرية، ويعمل على العبث فيها وتبديدها”، (الرفاعي، ص 83).
يعبر الرفاعي عن رؤيته هذه بمصطلح “إنسانية إيمانية”، بوصفها شكلا من أشكال التدين العقلاني الأخلاقي الرحماني، و”طريقا ثالثًا” يختلف عن التفسير التراثي للدين وتفسير الجماعات الدينية، كما يصرح بقوله: (الإنسانية الإيمانية تحاول بناء طريق ثالث؛ لا يكرر طريق معاهد التعليم الديني التقليدية، التي يسودها فهم تراثي للدين، وقراءة تراثية لنصوصه، ولا يكرر طريق الإحيائية الأصولية المسكونة باستئناف الماضي كما هو، والاستحواذ على السلطة والثروة. إنه طريق ثالث؛ يقدم فهمًا للدين بوصفه حياة في أُفق المعنى، ونظاما لإنتاج معنى روحي وأخلاقي وجمالي للحياة الفردية والمجتمعية. التدين الذي ينتجه هذا الفهم للدين هو “تدين عقلاني أخلاقي رحماني”. “الإنسانية الإيمانية”، تختلف بشكل جذري عن “الإنسانية العلمانية أو غير الإيمانية”. لا يصح تصنيف “الإنسانية الإيمانية”، تحت عنوان: “العلمانية المؤمنة” أو غيرها”). يضيف الرفاعي: (“أنا مسلم وكفى”، “أؤمن بالله ورسوله محمد “ص” والوحي والقرآن الكريم، وأُقيم الصلاة. أعمل باجتهادي في فهم الدين وقراءة نصوصه. أرفض هذه التصنيفات. أرفض هذه التصنيفات والتوصيفات. أنا لا تقدمي ولا رجعي، لا يمين ولا يسار، لا علماني ولا حداثي ولا ما بعد حداثي، لا اشتراكي ولا ليبرالي). هذا جواب أثناء نقاش خاص بتاريخ 29 غشت “آب” 2021 جمعني عبر الأنترنيت بالأستاذ الدكتور عبد الجبار الرفاعي قاسمته فيه موقفي من توجهه الفكري باعتباره أقرب الى تصوف “عقلاني” بأدوات تأويلية، لكن عبر الدكتور الرفاعي عن رفضه بشدة لكل هذه التسميات والتصنيفات، وميله إلى الاقتصار على صفتي “الإنسانية” و”الإيمانية”، وشدد على قوله: “أنا مسلم وكفى”.
كتابات الرفاعي تتجاوز حدود الخطابات الإنسانية الصرفة باتجاه “إنسانية إيمانية روحانية أخلاقية” تبشر بها الألفية الثالثة. رفض الرفاعي الانصياع لكل تصنيف قد يلغي غنى خطابه، وإن كان يجد مبرره في ثقافته البين–مجالية، وانتفاضه ضد قيود الخطابات الأكاديمية الصارمة، متنصلًا من تسييجات الإبستيمولوجيا الصلبة، بل وحتى الفلسفة. إنه نزوع نحو كونية الخطاب بعيدًا عن محلية الموضوع.
قد تكون إباحة قيام خطاب معرفي عقلاني إبستيمولوجي لاهوتي، لا ينتمي بالقوة الى المدرسة اللاهوتية الكلاسيكية، ثورة أخرى على جمود التأويل في الفكر الديني. وقد يكون من الملائم قبل الخوض في مغامرة التأويل هذه وتجديد الفهم التصالح مع مفاهيم العلمانية والعلمنة، وتجاوز التقابل الأيديولوجي الضيق الذي يجعل كل تحديد لمجال الدين إقصاء له من الوجود الفاعل للإنسان، فإذا كان الرفاعي يطالب بالتأويل خارج الذات التراثية فلا بد كذلك من التحرر من جدليّة الدولة والدين التي ورثها الإسلام المعاصر عن الحركات الدينية، وذلك بغرض تجفيف ينابيع تجارة الدين الرابحة في بعض الأيديولوجيات السياسية.
في سياق آخر، واستكمالًا للقراءة التاريخية التي قام بها الرفاعي لنشأة علم الكلام، نجده بعد أن أقصى المودودي من الكلام الجديد، إذ به يعترض على إقحام شبلي النعماني في مساره، لكن إذا كان الرفاعي قد أقصى المودودي من مسار علم الكلام الجديد لأسباب الأيديولوجيا السياسية للمودودي، فإنه يقصي شبلي النعماني لدواعٍ إبستيمولوجية، معتبرا إياه مجرد “شارح جديد لعلم كلام قديم”، (الرفاعي ص 28). وإن كان الاستعمال الأول لعنوان “علم الكلام الجديد” في التأليف يعود الى كتاب النعماني الصادر في جزئين سنة 1903 و1904 بعنوان: “علم الكلام الجديد”، كما يصرح بذلك الرفاعي؛ معترفاً له بفضل السبق في استعمال العنوان، غير أنه يعترض على منهج شبلي النعماني، ولا يرى فيه تجديدًا، بقدر ما يجد فيه تبسيطًا وتحديثًا لقضايا سابقة في علم الكلام القديم، (الرفاعي ص 25). يكتب الرفاعي: “شبلي النعماني يستأنف القديم بلغة أكثر وضوحًا واختزالًا للاستطرادات والتفاصيل المملة، وحتى العناوين الجديدة التي أدرجها في كتابه هذا لا نرى في حديثه عنها ما يشير إلى معالجة تخرج من جلباب الآباء”، (الرفاعي ص 28). يرى الرفاعي في شبلي النعماني: “متكلم تقليدي وضع عنوانًا جديدا لمضمون قديم”، (الرفاعي، ص 28). ما يرفضه الرفاعي هو موقف النعماني التبريري، وميله للدفاع بدلًا من تجديد الفهم حيث (تظل وظيفة الكلام الجديد في مفهوم النعماني دفاعية، إذ يمكث علم الكلام في مقولات متكلمي الفرق القديم، يشرحها ويعزز أدلتها بأدلة جديدة، من دون أن يعيد النظر في مضمونها… لا نرى محاولة لبناء رؤية جديدة ترسم صورة بديلة لله والعالَم في كتابه “علم الكلام الجديد”، أو تعريفًا جديدا للوحي والنبوة، أو مسعى لتوظيف المكاسب الحديثة للفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع في فهم الدين وتفسير نصوصه). (الرفاعي ص 27).
من حيث منشأ علم الكلام الجديد يرى الرفاعي أن إرهاصاته ارتبطت بمطلع القرن الثامن عشر، وبالضبط مع ولي الله الدهلوي، الذي يعتبره الرفاعي من أعلام الإسلام التعددي في الهند؛ كونه جمع في مشروعه الفكري بين التجديد والتصوف، (ص 56)، إذ استطاع أن يوفق بين الميل العرفاني دون مغالاة، والغرض الإصلاحي؛ وذلك بفضل التربية الدينية الصوفية التي تلقاها عن والده، وبفضل ميوله الفكرية والنقدية المجددة. لذلك تعد كتابات الدهلوي من المشاريع النقدية الأولى التي مهدت لولادة علم الكلام الجديد، وبشارة انتفاض ضد جمود التأويل. ولعل ما يجعل من الدهلوي مفكرًا مجددًا في علم الكلام هو مقاربته للوحي ولدور النبي الفاعل فيه، ووقوفه عند الأبعاد الاجتماعية للدين، (سيد عبد الماجد الغوري، 2016). إن ما حققه الدهلوي هو تغيير في المنهج، وتغيير في الغاية، وانتقال من الوظيفية التبريرية إلى الوظيفة التأويلية. أما ما يسعى إليه الرفاعي في علم الكلام الجديد فهو تغيير في المنهج والغاية والأدوات، مطالبا بالانفتاح على الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع الحديثة.
يقف الرفاعي عند وجه آخر من وجوه حركة الإصلاح الإسلامية المعاصر في القرن التاسع عشر، مشيدًا بالدور التربوي الرائد لمؤسس جامعة عليكرة سيد أحمد خان، وسعيه للنهوض الحضاري بمسلمي الهند، عبر تبني طرائق تعليمية جديدة والاستفادة من الخبرة الغربية، متمثلة في الجامعات البريطانية العريقة، إذ رد “سيد أحمد خان تدهور أحوال المسلمين إلى سببين؛ الأول: نقص التعليم لديهم، والثاني: عدم الاتحاد والاختلاط بالإنجليز”، (معراج الدين الندوي)، لكن موقفه المتسامح مع فكر الغرب، ودعوته لمحاسبة الذات قبل لوم من تطاول على الأرض، جرّت عليه ويلات من يريحهم السكون لدور الضحية، وكان هذا الانبهار بالغرب مع نزوع نحو العلمانية جعلت أفكاره لا يستسيغها أغلب المسلمين شرقًا وغربًا، وإن كان ذلك لا ينتقض من أهمية مشروع تجديد الخطاب الديني عند سيد أحمد خان، فأفكاره تكاد تكون سابقة لعصرها، خاصة مواقفه من التربية والوحي وبشرية الفهم لتفسير القرآن والإجماع والجهاد، (رائد نصري أبو مؤنس). أشرنا هنا إلى هذه الدراسة التي قام بها رائد نصري أبو مؤنس من جامعة غزة، ونشرت بمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية في يناير 2020، وهي تكرر نفس الانتقادات المتحاملة على الفكر التجديدي لأحمد خان، والتي سبقه في نقد أحمد خان إليها جمال الدين الافغاني وشبلي النعماني وغيرهم، مقدمة بذلك صورة عن تغول التيار التقليدي واستمراره، على الرغم من عقود تلت محاولة سيد أحمد خان الإصلاحية. إن ما يزعج في موقف أحمد خان حسب الرفاعي: “تمرده على مقولات المتكلمين التقليدية، وتقديمه لقراءات جديدة لمفاهيم الوحي والنبوة”، وهذا ما يدعو الرفاعي لاعتبار أحمد خان: “أول متكلم جديد في العصر الحديث”، (الرفاعي، ص 60).
أثّر منهج أحمد خان في معاصريه وتابعيه، وبالأخص محمد إقبال وفضل الرحمن، اللذان خصهما الرفاعي بمنزلة مميزة في لحظة التأسيس لعلم الكلام الجديد، فهو يرى أن: “محمد إقبال كان من أنضج مفكري الإسلام في القرن العشرين؛ في بناء رؤية نظرية لتجديد التفكير الديني، وأكثرهم براعة في الكشف عن الأبعاد الكونية للقيم الروحية والأخلاقية في الإسلام”، (الرفاعي، ص 65).كما أن تجربة محمد إقبال تعكس محاولة ذكية للجمع بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، وإن كان الرفاعي يؤاخذه على الحضور المحتشم للفلسفة في خطاباته، وعلى انشغاله بمشاريع قومية وسياسية صرفته عن “صياغة رؤية لنظام معرفي بديل، وإنجاز أركان فلسفة دينية، وبناء ركائز علم الكلام الجديد”، (الرفاعي، ص 64)، وأسف الرفاعي على كون إقبال أول من صاغ رؤية لـ”هوية دينية للدولة”، (الرفاعي، ص 64)، لكن ما يميز محمد إقبال في نظر الرفاعي هو جمعه بين المختلفات، من خلال فكر مركب؛ تناغمت فيه الفلسفة والعرفان مع الدين والأدب والشعر والسياسة، وإن كانت هموم تأسيس باكستان على أساس “هوية دينية للدولة” استنزفت تفكيره وبددت جهوده في سنواته الأخيرة، حسب الرفاعي.
الوجه الآخر للمحاولات الجادة في بلورة علم كلام جديد يمثله فضل الرحمن، الذي لم يتمكن هو الآخر – على الرغم من اجتهاداته الذكية – من التحرر من سطوة الثرات السلفي في نظر الرفاعي (الرفاعي، ص 68)، وعلى الرغم من محاولاته لخلق عقلانية متطورة، (الحاتمي،2020)، لكن يبقى موقف فضل الرحمن من إعادة فهم الوحي أهم اجتهاد كلامي جديد لديه في نظر الرفاعي، دون ذلك فإن فضل الرحمن يظل عاجزا لأنه كان وفيا للمرجعية الدينية السلفية إلى الحد الذي أعاق اجتهاداته، يكتب الرفاعي: “أحيانا يعجز فضل الرحمن عن عبور آراء متكلمي الإسلام ومفسريه ومحدثيه، ولم يشتق لاجتهاده طريقا مغايرا، كان يكرر آراء تعبر عن وقائع وأحوال عصرهم، لذلك نرى بعض آرائه أسيرة تفكير انتهى زمانه” (الرفاعي، ص 70). لذلك لا تعدو تجربة فضل الرحمن إلا محاولة أخرى في صرح التمهيد لقيام علم كلام جديد.
في ضوء ذلك يمكن القول إن قيام علم كلام جديد مشروع غير مكتمل وفق ما ذهب إليه الرفاعي، وإن كانت لدينا اجتهادات متنوعة جريئة، لعلماء دين وفلاسفة ومتمرسين في العلوم الإنسانية، من أمثال: محمد حسين الطباطبائي، وأمين الخولي، ومحمد عبد الله دراز، وعلي شريعتي، ومرتضى مطهري، ومحمد باقر الصدر، وفهمي جدعان، ومحمد أركون، وعبدالكريم سروش، ومحمد مجتهد شبستري، ونصر حامد أبو زيد، وحسن حنفي، وعبد المجيد الشرفي، وآخرين، (الرفاعي، ص 46)، وربما لا تكتمل في الكل شروط المتكلم الجديد التي وضعها الرفاعي.
فمن هو هذا المتكلم الجديد؟ وما هي الضوابط الإبستيمولوجية التي يضعها الرفاعي لقيام علم كلام جديد؟
IV-في الحاجة لعلم جديد
يحتل علم الكلام مكانة خاصة في المشروع الفكري لعبد الجبار الرفاعي كما تؤكد ذلك خلاصات زبيدة الطيب، (الطيب، ص 19)، إذ يحضر بقوة سواء كان ظاهرًا أو مستترًا، في كتبه الخاصة أو كتاباته المشتركة، فقد خصّ الرفاعي على سبيل المثال مباحث التجديد في علم الكلام بمجموعة أعداد من مجلة قضايا إسلامية معاصرة، وحرّر كتابًا بعنوان: “الاجتهاد الكلامي، مناهج ورؤى متنوعة في علم الكلام الجديد”، ضمّنه رغبته الملحة بأنسنة علم الكلام وجعل غايته اكتشاف المعنى الروحي والأخلاقي للحياة، وإعادة وصله بالبعد العملي في الوجود الإنساني، بعد أن تحول لمجرد “علم تجريدي”، (الطيب، ص 26)، مقارعًا بذلك القراءات الضحلة القائمة على إعادة التدوير الفكرية، والاكتفاء بالأجوبة الجاهزة والمكررة، بعيدًا عن احتياجات اليومي والمعيش. تتناسل إذن مطالب الخروج من وصاية الفهم التقليدي في كتابات الرفاعي، وتجديد علم الكلام، في اعتقاده بالمنعطف الهيرمينوطيقي اللازم لبناء فهم ديني راهن عن الانسان والعالَم. يكتب:”علم الكلام الجديد في رأيي يمثل نظرية المعرفة في الإسلام، لأنه هو الذي ينتج منطق التفكير الديني، ومنطق كل عملية تفكير هو الذي يحدد طريقة التفكير ونوع مقدماته ونتائج، وذلك يعني أن أية بداية لتجديد التفكير الديني في الإسلام لا تبدأ بعلم الكلام ومسلماته المعرفية ومقدماته المنطقية والفلسفية، فإنها تقفز إلى النتائج من دون المرور بالمقدمات”. (الرفاعي، ص 33).
على هذا الأساس فإن محطة علم الكلام هي اللحظة الأولى لفهم كيف تبلور الفكر الإسلامي، ومن ثم الشروع في قراءات جديدة لهذا الإنتاج الكلامي المرتبط بأسئلة وتحديات شهدتها الحضارة الإسلامية في أزمنة سابقة، فكانت المقولات الكلامية إجابات عنها. لكنها ما لبثت أن تحولت إلى إجابات نهائية عن كل الأسئلة – التي تغيرت شكلًا، مضمونًا وسياقًا- تتحكم في الراهن، الغريب كليًا عن لحظتي النشأة والتطور. زد على ذلك أن أهداف علم الكلام التقليدي انحسرت في أُفقي الدفاع والتبرير في إطار استراتيجية هيرمينوطيقا تبجيلية، ومثال ذلك ما جاء في تعريف الفارابي لغرض هذا العلم، إذ يقول: “الكلام: صناعة يقتدر بها الإنســان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة، وتزييف كل ما خالفها من الأقاويل”، (أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1991، ص41). أما اليوم فإن رهان الدين تحوّل إلى حاجة لبناء فهم جديد عن المعتقد، وعن انعكاسه على حياة الإنسان، وأصبحت وظيفة الدفاع لاحقة على وظيفة الفهم. وإن كان هاجس الدفاع ما زال مستمًرا في بعض الاجتهادات السطحية، حتى وإن تغيّرت التسمية، كما هو الحال مع شبلي النعماني؛ من علم كلام قديم الى آخر جديد. نقرأ في كتاب النعماني (علم الكلام الجديد): “إن علم الكلام القديم عني ببحث العقائد الإسلامية، لأن شــبهات الخصوم كانت ترتكز على العقائد فقط، بينمــا يجري التأكيد هذا اليوم علــى الأبعاد الأخلاقية والتاريخيــة والاجتماعيــة في الديــن، وتتمحور الشــبهات حول المســائل الأخلاقيــة والقانونية مــن الدين، وليــس حــول العقائد”، (شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، ترجمة: جلال السعيد الحفناوي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2012، ص 181). لأجل هذا ينتفض الرفاعي ضد ما يسميه “ذهنية كلامية تقليدية”، تميل إلى التجريدية عبر فهم ميكانيكي للوحي وتأويل منغلق للنصوص، يغربها وينفيها عن عصرها، ويحشر الفكر الإسلامي المعاصر في مأزق الوفاء للماضي، للإرث، للهوية، تحت وصاية الذات التراثية. فهو يقر بأن التأويلات ما هي إلا إجابات مرحلية، مدافعا بذلك عن زمانية المعنى، ومشيرًا إلى ما يسميه “المعنى المؤقت” بزمن خاص، وهو يبحث عن المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي الدائم، (الرفاعي ص 15). فإذا كان الرفاعي يشدد على القول بالحاجة الأنطولوجية للدين، وبالاغتراب الميتافيزيقي أو الوجودي للإنسان المعاصر، فلابد كذلك من الإقرار بتغير الوعي الإنساني، وخضوعه لسيرورة التاريخ، ذلك أن “العقل كائن تاريخي يتغير ويتطور ويتكامل تبعا لنمو وتراكم معقولاته ومعطياته كيفا وكما”، (الرفاعي ص 30).
من هنا أيضا؛ لابد من الإقرار بأهمية تأويلات علم الكلام الجديد نفسه، فهو علم منفتح يسافر بالنص تبعًا لزمن التأويل، يكتب الرفاعي: “أبدية الكتب المقدسة وعبورها الزمان والمكان قائمة على تعدد قراءتها وتنوع فهمها وتعدد المعنى الذي يتلقاه القارئ منها، بالانطلاق من تساؤلات الذات الواعية لمناهج الفهم والقراءة. لا ثمة ديمومة تدعي الفهم النهائي والأبدي للكتب المقدسة”، (الرفاعي ص 91). بهذا المعنى يفقد النص في علم الكلام الجديد تعاليه على الزمن، وينتج نصوصًا تأويلية قد تنتهي كما هو الشأن في الهيرمينوطيقا المسيحية بتغليب كفة إنسانية النص المقدس. ولعل هذا ما يخشاه متعصبو التأويل التقليدي. إن انتقال ملكية النص مغامرة تأويلية، قد لا يرضاها الكثيرون؛ علما بأن هذا النص إنما جاء مخاطبا الإنسان محدود الفهم والمعرفة. نقرأ للرفاعي: “إن الله مطلق ومعرفة الإنسان بالله نسبية، لأنها محدودة بحدود طبيعته البشرية وآفاق وعيه وثقافته ونمط رؤيته للعالَم وللزمان والمكان الذي يعيش فيه”، (الرفاعي، ص13)، فالقول بخضوع النص للفهم الإنساني ليس قولًا بمحدودية النص بقدر ما هو تسليم بمحدودية الفهم الإنساني نفسه العاجز بمفرده عن بناء معنى نهائي ومريح عن النص. ذلك أن النص ينبغي أن يُقرأ في ضوء دائرة هيرمينوطيقية غنية. لا يتعلق الأمر إذن بالمقابلة بين المقدس والإنساني بقدر ما يتعلق بالمقابلة بين المعنى والإنسان. وليست الهيرمينوطيقا تهديدا لسلطة المقدس أو النص وإنما هي أيضا رحلة أخرى للفهم.
في المحصلة، لا بد من الاعتراف بزمانية النظام المعرفي لكل عصر وخضوعه لمتغيرات المجتمع والإنسان، ثم الإقرار بزمانية المعنى وظرفيته، والوقوف ضد كل تقديس يطال التأويل فيحنطه، ويصادر حق النص في الترحال في فضاء الفهم بعيدًا عن وصاية الماضي والأسلاف. وأمام سيرورة التكرار التي أنهكت العلوم الدينية، إنه لمن المشروع -كما يدافع عن ذلك فيلسوف الحوزة – المطالبة بإنتاج تأويل معاصر للنص الديني في الإسلام. هذه الثورة الهيرمينوطيقية من شأنها أن تنهي عقودًا من تعطيل المتغير البشري في المباحث العلمية الإسلامية. هذا الحفر في أساسيات التغيير هو ما قاد الرفاعي للدعوة إلى “تحيين المعنى الديني”، (الرفاعي، ص 16)، فهل يتعلق الأمر بتحديث أم تجديد؟
نثير هنا إشكالا ابستيمولوجيًا يتعلق بالحدود الرفيعة بين التحديث والتجديد في علاقتهما الملتبسة بالماضي، فهل ما يريده الرفاعي هو الانسلاخ عن علم الكلام القديم إلى حد يمكن معه تحقيق هذه القطيعة الإبستيمولوجية؟ وهل يمكن تجاوز الإطار المرجعي لعلم الكلام القديم؟ أية شروط؟ وأي ضوابط؟
يكتب الرفاعي مجيبًا: “هو علم “جديد” بوصفه لا يستنسخ مناهج الكلام القديم، ويتحرر من كثير من مسائله وجدالاته المكررة، ويتسع لمسائل جديدة تتصل بأسئلة ميتافيزيقية توالدت في ذهن إنسان اليوم ولم يعرفها إنسان الأمس، خاصة الأسئلة المتصلة بمعنى وجود الإنسان وحياته ومصيره”، (الرفاعي، ص 22).
إن رهان القطع إبستيمولوجيًا مع الماضي كان ولا يزال قطب رحى كل مطالبات التجديد في الفكر الديني، لذلك قد يكون من الضروري تبرئة هذه القطيعة الإبستيمولوجية من تهمة العقوق. إنها ليست قضاءً على الأصول بقدر ما هي تحرير للخلف من وصاية السلف الخانقة، وانتقال لمسؤولية الفهم واستملاك المعنى الديني الذي يواكب الواقع.
نطالع في مقال لعبد السلام بن عبد العالي يثير فيه مسألة القطيعة الإبستيمولوجية، فيقول: “علينا أن نميز بين مفهومين عن القطيعة: مفهوم وضعي يفصل فصلا نهائيا بين مرحلة وأخرى، بين عامل وآخر – أو كما يقول أصحاب الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم – بين إشكالية وأخرى. ومفهوم يريد أن يذهب أبعد من ذلك؛ فيجعل القطيعة انفصالا لا متناهيا ما يفتأ يتم. وما ذلك إلا لأنه ينطلق من نفي الـ “حضور” والتحقق النهائي. بهذا المعني فإن “جوهر” القطيعة لا يكمن في الفصل وإنما في لا تناهي الفصل ولا محدودية، فليست القطيعة هي حلول حاضر يحجب ما قبله. القطيعة هي انفصال لا متناه، أي أنها حركة دائبة دائمة لا تنفك تتم. ليست القطيعة انفصالا بين حاضرين بين حضورين، وإنما هي خلخلة للحضور ذاته؛ إنها اقحام اللامتناهي “داخل” الكائن”، (عبد السلام بن عبد العالي، 2020).
إن القطيعة في هذا المعنى أقرب لمعنى الامتداد، إنه امتداد دون وصاية، وقطيعة دون عقوق، إنها ليست الغاءً للماضي؛ إنما رفض للتبعية الاتصالية زمانيًا والنكوصية معرفيًا. هو ارتهان المعنى للفهم، وارتهان النص للاجتهاد الإنساني وللراهن. إنه ليس كذلك توفيقًا مسالمًا بين الماضي والحاضر، إنه انتقال هيرمينوطيقي بارٌّ بالماضي شغوف بالحاضر ومتطلع للمستقبل. وليس قفزة إبستيمولوجية منسلخة عن الماضي ومستلبة للحاضر، متوهمة بمستقبل لا يحمل تجاعيد الماضي وإن بهتت. لنقرأ للرفاعي “منهجي في بناء علم الكلام الجديد ينطلق من فهم الترات واستيعابه، لكنه لا ينتهي بالتراث”. رأيي هو رأي الشيخ أمين الخولي، الذي لخص البداية بقوله: “أول التجديد قتل القديم فهما”، (الرفاعي، ص 86). لذلك فالتحديث بمنظور تجديدي الذي يتبناه الرفاعي ينطلق من إعادة النظر في فعل التأويل في كليته؛ انطلاقا من علاقة المؤول بالنص، من خلال القول ببشرية تلقي الوحي، مع إيمان الرفاعي بالمصدر الإلهي الغيبي للوحي، وبشرية التأويل، ثم علاقته بالعقل عبر الانفتاح على مباحث العلوم الإنسانية وجديد العلوم المتنوعة، وعلاقته بالواقع وانخراطه في راهن عصره وانشغالاته. هكذا يتسع مجال علم الكلام الجديد ليشمل سعة الوجود الإنساني المركب.
دعونا نلخص إذن أبرز ملامح الاختلاف بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد فيما يلي:
| علم الكلام القديم | علم الكلام الجديد |
| محاجات ذهنية تجريدية تفسير منغلق لا زمانية الفهم قراءة لا تاريخية إطلاقية النص وصاية الفهم تحنيط المعنى تمجيد الماضي وظيفة تبريرية المقدس نسيان الإنسان الخوف الصلة بالله أُحادية الاتجاه | حس نقدي وموضوعية إبستيمولوجية تأويل منفتح زمانية الفهم قراءة تاريخية إنسانية فهم النص رهان الفهم بناء المعنى تجاوز الماضي وظيفة معرفية الإنسان مركزية الإنسان في الأرض في سياق مركزية الله في الوجود، بمعنى “الاستخلاف” القرآني. المحبّة:”يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ” الصلة بالله ثنائية الاتجاه |
بعد تحديد ما يبدو لنا أهم نقاط الاختلاف بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد، لنقف عند الضوابط الإبستيمولوجية لعلم الكلام الجديد كما تصورها الرفاعي، الذي وضع لهذا العلم الجديد أركانًا سبعة تؤسس لاستراتيجية هيرمينوطيقية خاصة (ص41)، تتمثل في الآتي:
1-تفسير جديد للوحي
مخاض التجديد في علم الكلام الجديد يفترض معيارًا أساسيًا قائمًا على بناء فهم جديد للوحي. لهذا يركز الرفاعي على أن بناء فهم جديد للوحي هو الشرط العلمي لقيام علم كلام جديد. من هنا يميل للقول ببُعدين للوحي: “بُعد إلهي هو المصدر، وبُعد بشري هو المتلقي”، (الرفاعي، ص 42) . البُعد البشري في الوحي يعني “التلقي البشري للإلهي”، (الرفاعي، ص 42)، مضافًا إلى أنه أيضًا “التعبير الإنساني عن الإلهي”، (الرفاعي، ص 42).
يسمح هذا التصور عن الوحي بانفتاحه على نظريات التلقي، ويكشف عن أبعاده الإنسانية وعن دور النبي الفاعل، وإن كان يفصح أيضًا عن نقائص تدوين ونقل الثرات ويسائله من زوايا مناهج التاريخ. يكتب الرفاعي: “في ضوء هذا الفهم يكون للقرآن والكتب الوحيانية وجه إلهي ووجه بشري، فهو من جهة اتصاله بالغيب إلهي، وهو من حيث تلقي النبي له وتعبيره عنه بلغته وثقافته والواقع الذي كان يعيش فيه بشري، أي تظهر فيه حدود لغة النبي وقيودها ومدياتها، وطبيعة حياته الشخصية، وملامح عصره ومجتمعه وثقافته وبيئته”، (الرفاعي، ص 42). لكن لا يختص الوحي دائمًا بكتاب أو نبوة نبي كما يرى الرفاعي، وهذا ما ذهب إليه محيي الدين بن عربي، وهو ما يفسّر التعددية الدينية في رأيه، لذلك يدعو لإعادة تعريف النبوة والكشف عن أبعادها الإلهية والإنسانية. هذا الفهم للوحي يسمح حسب الرفاعي بتجاوز مأزق تغييب البعد الإنساني والكوني والتاريخي فيه. إن القول بفاعلية النبي في الوحي من شأنه أن يقدم لقراءة جديدة للدين تعيده إلى مجاله ببناء الحياة الروحية والأخلاقية والجمالية، كي يتحول الدين إلى أداة للبناء لا للهدم، (الرفاعي، ص 47).
2-إعادة بناء صورة الله
يرى الرفاعي أن أول عملية تأويل في تاريخ البشرية ارتبطت بصورة الله، حيث بحث الانسان عن ذاته ومعنى لوجوده من خلال بحثه عن الخالق (الرفاعي، ص 135). لذلك فإن مقاربة الفهم الذي لحق بصورة الله في اللاهوت التقليدي من شأنه أن يؤسس لبناء تصور عن موقع الإنسان في هيرمينوطيقا علم الكلام القديم. ولهذا الغرض يقف الرفاعي ضد التصورات اللارحمانية لصورة الله، إذ يرى أن صورة الله في المقولات الكلامية ارتبطت بمعاني التسلط والاستبداد التي تهدر المعاني الروحية والأخلاقية والجمالية للدين. يكتب الرفاعي: “القراءة المتوحشة تبدد الإيمان وتهدر كرامة الانسان وتفتك به، والقراءة الخرافية لا تخلو من وثنية، وكل وثنية لا تهدر كرامة الانسان وتبدد المضمون الروحي والأخلاقي للدين فحسب، بل يحتجب معها الله عن العالم، وتنتصب بديلا عنه أوثان تتعدد بتعدد تلك الخرافات، وهذه الأوثان ليست إلا آلهة زائفة تستعبد الإنسان، بعد أن تشل عقله وتمزق روحه وتبذر حقوقه، وتحجبه عن الإله الرحماني” (الرفاعي، الدين والكرامة الإنسانية، ص161). يضيف فيلسوف العراق كذلك أن هذا الانفصال ما بين الله والإنسان إنما حدث بفعل تأويلات تلغي معاني الرحمة، وتنشر معاني الاستعباد أو ما يسميه الرفاعي “لاهوت الاستعباد” في مقابل “لاهوت الحرية”، ولا أدل على ذلك من مطالبته بـ “إنقاذ صورة الله”، (الرفاعي، ص 18). ما يقصده الرفاعي هو إعادة تأويل صورة الله بعيدًا عن قراءات حرفية مغلقة متصلبة، تجعل علاقة الله بالإنسان علاقة تسلطية صرفه وجافة ومخيفة، كما جاء في عقيدة الجبر أو مفهوم الحاكمية الإلهية للمودودي، وهي أمثلة يوردها الرفاعي كنموذج عن غربة الإنسان عن رحمة الله في اللاهوت القديم. ويتضح موقفه هذا أكثر فيما كتبه بعد ذلك دون تردد في كتاب: الدين والكرامة الإنسانية، إذ يقول: “في لاهوت المتكلمين يغترب الانسان وجوديا عن الله، لأن ذلك اللاهوت يبرع في نحت صورة لله تحاكي علاقة السيد بالعبد المكرسة في مجتمعات الأمس. الله في هذا اللاهوت تسلطي كما الملوك المستبدين، ونمط علاقته بالإنسان كأنها علاقة مالك برقيقه، فهو يمتلك الناس كما يمتلك الأسياد الرقيق، ويمتلك أقدارهم، ويمتلك التصرف بكل شيء في حياتهم. إن الصورة التي صاغها المتكلمون لله في كتاباتهم لا يتجلى فيها شيء من رحمته، بل تظهر قاسية شديدة مخيفة، إذ عمل المتكلم على رسم صورة الخالق بوصفه معاقبا لخلقه عقابا مريرا، ومعذبا لهم عذابا مريعا، ومتسلطا عليهم؛ يراقب كل زلة أو خروج عما فرضته تلك الصورة من أوامر ونواه تتسع لكل صغيرة وكبيرة في حياتهم. وتغلبت صورة الإله المرعب وتغلغلت في آثار المتكلمين، حتى طمست ما يشي بمحبة الله لخلقه، ورحمته، وعفوه، وتوبته، ومغفرته لهم”، (الرفاعي، ص192-193).
إن التفسيرات المغلقة للدين كما يرى الرفاعي أنتجت كل ذلك. نورد هنا ما أشار إليه دايفيد جاسبر في كتابه مقدمة في الهيرمينوطيقا ملمحًا هو الآخر إلى الحدود الرفيعة بين الدين والسياسة، يقول: “هذا يذكرنا بأن الهيرمينوطيقا كانت دائمًا نشاطًا دينيًا وسياسيًا وأنه لا توجد قراءة بريئة من الدوافع المسبقة”، (دايفيد جاسبر، ص 51). وهكذا يتضح ما لتطويع الدين لأغراض السلطة من أثر على معانيه وغاياته وما يترتب عنه من تشويه لفهم الدين نفسه، ولذلك لا تقرأ هيرمينوطيقا اللاهوت بعيدا عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية والنفسية في مدارس ما بعد الحداثة.
يبدو كذلك أن أول مهمة لعلم الكلام الجديد هي إعادة وصل الانسان بالله وإعادة تشكيل صورة الله الرحمانية، البعيدة عن صور التجبر والاستعباد التي تهدر كرامة الإنسان وتستلب حريته. يصرح الرفاعي: “في علم الكلام الجديد يعاد اكتشاف صورة الله، وفي ضوء هذه الصورة يعاد بناء صلة الانسان بالله، وهي صلة تتحرر من ركام العبوديات بمختلف أشكالها”، (الرفاعي، ص 95).
لا بد أن نشير هنا إلى جانب آخر مهم في الكتابة الرفاعية، يتخلل كتابه هذا كما في كتبه الأخرى، بوح عرفاني أحيانًا، فهو يتحدث عن العبادة بوصفها حالة “انجذاب حميمي”، (الرفاعي، ص 132) لا تهدر كرامة الانسان ولا تصادرها، وهكذا يمكن للعلاقة بالله أن تُؤَسَّس على المحبة والوصال. إن ما يريده الرفاعي هو “إنسانية إيمانية” بنكهة عرفانية، كما جاء في قوله في صفحات الكتاب الأولى: “أعاد العرفان بناء صورة جميلة لله، كلها إشراق وجمال ومحبة، يلتقي عبر هذه الصورة الانسان مع الله عاجلا، لأن هذه الصورة ألغت المسافة اللامتناهية التي صنعها المتكلمون بين الله والبشر”، (الرفاعي، ص 14). تلك صورة من شأنها أن تحرر الانسان من لاهوت الموت والاكتئاب وتنجيه بلاهوت الحياة.
3-ايقاظ المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي في الدين
لا يكتفي الرفاعي بالمطالبة بإنقاذ صوة الله أو القول ببشرية بُعد تلقي الوحي وأثر الواقع فيه، وإنما يلجأ إلى الدعوة إلى إحياء معاني الرحمة في فهمنا للألوهية وللحاجة للدين كضرورة أنطولوجية. بل يطالب الرفاعي بإيقاظ معاني الدين الأخرى والتي توارت خلف حجاب الاستعباد والتهويل، حيث يردف كتابه “مقدمة في علم الكلام الجديد” بحوار تتبدى فيها رؤيته بوضوح عن المنهج الجديد لعلم الكلام، الرامي إلى الإقرار بالمعاني الروحية والأخلاقية والجمالية للدين، والتي تتجاوز ضيق أُفق المقولات الكلامية. ينطلق الفيلسوف العراقي من إعادة قراءة مفهوم المقدس في لقائه بالدين، مؤكدا أن انتاج المقدس يتسع مع الابتعاد تدريجيا عن لحظة ظهور الدين، مستحضرا أثر المسافة الزمنية في توليد المخيال الديني، ليشخص الرفاعي: “تضخما للمقدس” في الحياة الإسلامية بالتدريج بعد عصر البعثة الشريفة، (الرفاعي، ص 78)، وتغوله على ما هو ديني، علما بأن المقدس يدين بالكثير للحس المشترك عند العامة ولثقافة الحشود. من هنا جاءت الحاجة إلى الفصل بين الدين وما ترتب عنه من أشكال فهم مشوه في التراث؛ قد تكون المسؤولة عمّا لحق الدين اليوم من نفور وتأويلات فاشية كما ألمح إليها الرفاعي. يعرج بعد ذلك الرفاعي للوقوف عند علاقة الدين بالدولة وبالمجتمع، معتبرا إياه حاجة ضرورية للتكامل الوجودي للكائن البشري، وللتضامن الاجتماعي، دون أن يجعل الرفاعي للدين حق التفرد في توجيه وشرعنة ضوابط العيش المشترك؛ ذلك أن الرفاعي مقتنع بأن الدين اليوم خرج كثيرًا عن مجاله بوصفه منبعًا للمعنى الروحي والأخلاقي والجمالي، لذلك فإن الحاجة ملحة إلى إعادة الدين إلى مجاله الأنطولوجي والميتافيزيقي، وإيقاظ معانيه الروحية والأخلاقية والجمالية. ولا يتحقق كل هذا إلا في إطار مشروع فهم جديد وراهن للدين يخلصه من خطايا التفسيرات التاريخية.
4-فهم جديد للنصوص الدينية
لا يكتمل مشروع علم الكلام الجديد دون الرهان على فهم جديد للنصوص الدينية، خارج إطار ما عهدناه في القراءات الكلامية التقليدية، وما تكرره الاجتهادات المعاصرة على رصانتها وجديتها، اذ لا بد أن ينطلق تجديد التفكير الديني هذا من خطوات هيرمينوطيقية أساسية، تتجلى أولا في اعتبار القارئ هو الإطار الصحيح لقراءة النص؛ هذا القارئ ما هو إلا المتكلم الجديد. لبناء هوية هذا المتكلم الجديد يعرج بنا الرفاعي باتجاه حفريات تاريخية تعود بنا إلى أواخر القرن 18 ومحاولات التجديد الأولى في الفكر الإسلامي.
أقصى الرفاعي كثيرا ممن اعتبرهم عاجزين عن التحرر من سطوة نواميس علم الكلام التقليدي، من أمثال: شبلي النعماني، وطه عبد الرحمن، وغيرهما، (الرفاعي، ص 34) باعتبار أن هؤلاء عجزوا عن التحرر من القراءة الكلاسيكية لعلم الكلام، ويقر للمفكر المغربي طه عبد الرحمن بأنه حمل تجديدًا فيلولجيا لعلم الكلام القديم، واصفا موقفه بـ “التبجيلي لعلم الكلام التقليدي”، (الرفاعي، ص 36). اعتبر الرفاعي أن المتكلم الجديد هو ذاك “الذي يفكر في آفاق عقلانية العصر الحديث، ولا يفتقر للحس التاريخي، ويفهم الوحي فهمًا ديناميكيًا، خارج مفهومه في علم الكلام القديم”، (الرفاعي، ص 36). إنه الهيرمينوطيقي القادر على الجمع بين الحاجة التأويلية والرصانة الإبستيمولوجية، لأنه قادر على ضمان مسافة نقدية مع الماضي. إن شرطًا أساسيًا يستحضره الرفاعي في بناء هوية المتكلم الجديد يتعلق بشرط الإيمان. وهذا ما يؤشر لحضور الذاتية في علم الكلام الجديد، الا أنها ذاتية إيمانية وليست ذاتية انفعالية. لذلك فإن علم الكلام الجديد هو بصدد بناء “هيرمينوطيقا إيمانية” بعيدة عن هيرمينوطيقا الشك، (دايفيد جاسبر، ص24).
نجد في نموذج الفيلسوف الفرنسي بول ريكور مثالا جديًّا عن إمكانية تحقق “هيرمينوطيقا إيمانية” بهمة إبستيمولوجية عالية، بعيدا عن الخطابات الدعوية والتبشيرية أو التشكيكية المتحاملة. وقد يكون من غير الصائب نفي إمكانية قيام هيرمينوطيقا الإيمان في الإسلام وإن كان هذا يتطلب زمانًا طويلاً، ولا يتحقق دون بناء كفاءات تأويلية ومعرفية جادة. لكن إلى أي حد تستطيع الجامعات العربية ومعاهد التعليم الديني – في ظل انغلاق التخصص والقطائع المفتعلة بين الحقول المعرفية – التأسيس لبناء فهم جديد لصورة الله وللوحي وللنبوة وغيرها من القضايا الكلامية المحورية؟
هنا لا بد أن نميز في الفهم الديني بين فهم أكاديمي وفهم لسوق الاعلام. ساحتنا الفكرية تفتقر لمفكري إعلام من أمثال مفكري فرنسا، ميشيل اونفري وغيره، ممن يحررون الإشكالات الوجودية والفلسفية وحتى الدينية من قيود الأكاديمي وحصون المغالاة المعرفية، فيشاركون في هموم اليومي ويخاطبون احتياجات العامة من الناس، وليس في ذلك تبضيع للمعرفة العالِمة، بقدر ما هو تذليل لها حتى تساهم بفاعلية في بناء الوعي العام. هذا الانخراط الجماعي في أسئلة وجودية راهنة من زوايا دينية تأويلية شعبية من شأنه أن يمهد الطريق لقيام تأويلية عالِمة؛ هذا ما نلمسه على الأقل في كتاب الرفاعي “الدين والكرامة الإنسانية” حيث تتجاور في زواج سعيد الفلسفة العالِمة مع قضايا المعاش بلغة لا ترهق الفهم أو تعاند التأويل.
5-الانفتاح على العلوم الإنسانية
إن علم الكلام الجديد يستدعي أيضا تغيرًا في باراديجمات المنهج والأدوات والأهداف، إذ يفترض الانفتاح على العلوم الإنسانية والمعارف الأخرى، من خلال استحضار آليات هيرمينوطيقية معاصرة، فإلى جانب التوجه الكلامي التقليدي، الذي ينتفض ضده الرفاعي، أشار إلى تيارين آخرين لتفسير الوحي، من شأنهما إلهام علم الكلام الجديد؛ هما: التيار الميتافيزيقي، وتيار آخر تاريخي. التيار التاريخي لا يظهر فيه البُعد الميتافيزيقي للوحي، ويقدم لقراءة جافة عنه، لا تتحدث عن حضور الغيب في الوحي، وعدم حضور الغيب في الوحي يعني افتقاره للمعنى الديني الروحي والأخلاقي. هذا التيار التاريخي يمثله رواد الفلسفة وعلوم الانسان والمجتمع العرب، من أمثال: محمد أركون، ونصر حامد أبو زيد، وحسن حنفي، وعبد المجيد الشرفي، وآخرين (الرفاعي، ص 46). في مقابل هذا التيار هناك تيار آخر يغلب كفة العرفان، من خلال التأكيد على البُعد الغيبي في الوحي، وهو التيار الميتافيزيقي، الذي يمثله: أحمد خان، ومحمد إقبال، وفضل الرحمن، ومحمد مجتهد شبستري، وعبد الكريم سروش، (الرفاعي، ص 46) .
يطالب الرفاعي بالانفتاح على العلوم الحديثة، وعلى اجتهادات رصينة في علم الكلام خارج معاقل علم الكلام القديم، إلا أنه لا يتنكر لأثر البيئة الثقافية، فهو لا يدعو إلى قطيعة تامة مع التراث، لأنه يراها متعذرة، (الرفاعي، ص 88). لا يقتضي التسليم بالهوية الحضارية القطيعة مع مناهج ومعارف العلوم الحديثة، وإنما يقف الرفاعي، كما ألمح لذلك في كتابه، ضد العقل الأيديولوجي المتحيز في المقاربة العلمية. إنه نزوع نحو الموضوعية في البحث الديني من جهة، ونحو راهنية خطاباته من جهة أخرى.
خاتمة
طالما نادى الرفاعي دون انقطاع بضرورة الانتقال نحو تأويلية جديدة تكتشف المعنى في الدين، وتخرجه من مأزق اللازمانية وحرج الأدلجة. إن كتابه هذا، وإن خص مبحث علم الكلام بمخطط التجديد، يظل هو الآخر محاولة رصد لشروط قيام ثورة تأويلية مأمولة منذ عقود. لا يحمل كتاب الرفاعي هذا ادعاءات تجاوز علم الكلام التقليدي كلية، لكنه يوفر أرضية خصبة لمستقبل الاجتهاد الفكري في هيرمينوطيقا الإيمان. إنه بداية الرحلة فقط، و”ما زال أمامنا طريق طويل في رحلتنا، ولكن على الأقل بدأنا وعلينا أن نتقد بمزيج صحي من الإيمان والشك، وبجهوزية أن نفكر بصلابة”، (دايفيد جاسبر، ص 41).
الرفاعي ليس “فيلسوف دعوة” ولا مدعي تنوير، لكنه أقرب إلى مبشر التجديد، مثل سلفه من دعاة التحرر من وزر الماضي الذي لا يمضي، في انتظار ثورة معنى ناعمة تطيح بانسداد الفهم التقليدي. على الرغم من أن الرفاعي قارئ شجاع وجريء إلا أنه كاتب حذر، علينا أن نتذكر خلفيته الإيمانية، وعقله النقدي، وميوله الإنسانية لتوليد رؤية جديدة عن الدين، الكل بنغمة عرفانية للإيمان والمحبة والرحمة الإلهية في الحياة.
يختصر الرفاعي هدف مشروعه باكتشاف المعنى الديني حيثما وجده، إذ يقول: “يتحكم اكتشاف المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي في فهمنا للدين ورسالته في الحياة. هو المبتغى لإعادة بناء علم الكلام، وهو البوصلة في تفسير القرآن الكريم وكل النصوص الدينية، وهو منطلق تعريف الدين، وإدراك حاجة الإنسان إليه، وهو معيار ما نقبله من الموروث”، (الرفاعي، ص 15).
إن الدعوة الى التجديد ما زالت مستمرة منذ ما يقارب القرنين، فمتى ننتقل إلى مرحلة المأسسة وإحداث مراكز بحث متعددة التخصصات، وفق مقاربة تشاركية، وذكاء جماعي يستنفر كلا من: علوم الدين، والفلسفة، والعلوم الإنسانية، والعلوم الدقيقة، بغرض بناء فهم جديد للظاهرة الدينية المركبة؟ متى سندرك أن الفهم لا يتم الا بمشاركة عقول كثيرة وبسواعد متعاونة؟ ألم يحن الأوان بعد للفطام من الماضي؟
مراجع
-عبد الجبار الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، الطبعة الأولى، (دار التنوير. بيروت،2021). وصدرت طبعة ثانية مزيدة ومنقحة من الكتاب خريف 2021.
– عبد الجبار الرفاعي، الدين والكرامة الإنسانية، (دار التنوير. بيروت،2021).
– عبد الجبار الرفاعي، ” علم الكلام الجديد ووهم التأسيس”، صحيفة الوسط البحرينية،12 ديسمبر ، 2002، شوهد بتاريخ 08-08-2021،في
http://www.alwasatnews.com/news/856156.html
– عبد الجبار الرفاعي، “فضل الرحمن والفهم الرحماني الأخلاقي للقرٍآن”، مؤمنون بلا حدود، 7يوليو 2017، شوهد بتاريخ 03-08-2021، في
اطلع عليه بتاريخ 03-08-2021
– عبدالجبار،الرفاعي، المسألة الدينية عند الوردي: رؤية نقدية، ورقة في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية السنوي – دورة علي الوردي، سنة 2021.
– دافييد جاسبر، مقدمة في الهيرمينوطيقا. ترجمة وجيه قانصو، (الدار العربية للنشر والعلوم. بيروت،2017)
– أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، (مركز الإنماء القومي. بيروت. 1991)، ص 41
– حسن حنفي، الدين والثورة في مصر الحركات الدينية المعاصرة 1952 -1981، (مكتبة مدبولي. القاهرة مصر1988)
-شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، الطبعة الأولى، ترجمة جلال السعيد الحفناوي (المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2012). ص 181
– معاذ بني عامر، “الظمأ الابستيمولوجي في كتاب “الدين والظمأ الانطولوجي ” “، مؤمنون بلا حدود، 3فبراير 2016، شوهد بتاريخ 22-07-2021، في
– زبيدة الطيب ، ” علم الكلام في فكر عبد الجبار الرفاعي… أي غاية؟”،مركز نماء للبحوث و الدراسات ، 09 August، 2019 ، شوهد بتاريخ 08-08-2021، في:
https://nama -center.com/Uploads/Files/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
– سيد عبد الماجد الغوري، “الامام شاه ولي الله الدهلوي وجهوده في القران الكريم تفسيرًا وترجمة وتأصيلًا”، وحدة الامة العدد السابع، الهند ،دجنبر 2016، شوهد بتاريخ 07-08-2021،في https://www.researchgate.net/publication/336915599_alamam_shah_wly_allh_aldihlwy_wjhwdh_fy_alqran_alkrym_tfsyraa_wtrjmta_wtasylaa
-معراج الدين الندوي،” السير سيد أحمد خان وجهوده الإصلاحية في القارة الهندية (1817 – 1898م)”، شبكة ضياء، 13 نوفمبر، 2015، شوهد بتاريخ 17-08-2021، في
-رائد نصري أبو مؤنس، “تيار سيد أحمد خان وآراءه التجديدية في أصول الفقه دراسة أصولية نقدية”، (مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشريعة والقانونية. العدد28. غزة. فلسطين، 2019)، شوهد بتاريخ 6-08-2021، في: https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/view/4995
-عبد السلام بن عبد العالي، “الحداثة ومسألة القطيعة” مؤمنون بلا حدود، 10يونيو 2020، شوهد بتاريخ 03-09-2021، في
*نشير هنا الى أنه اثناء كتابة هذا المقال صدرت الطبعة الثانية لكتاب مقدمة في علم الكلام الجديد للرفاعي لذلك فإن ترقيم الصفحات قد يختلف في الطبعة الثانية.
نورد هنا ملحقاً يوضح توجه الرفاعي في بناء علم الكلام الجديد، كما ورد في الطبعة الثانية في بغداد.
ملحق رقم (1)
أركان علم الكلام الجديد عند عبد الجبار الرفاعي، (علم الكلام الجديد، ط 2، 2021، بغداد).
علمُ الكلام الجديد برأيي علمٌ يقوم على الفهم الجديد للوحي، وهو يمثل الأساس الذي تقوم عليه عدةُ أركان، إن تحقّقت يتحقّق، وإن انتفت ينتفي. وكلُّ كتابة لا تتضمّن هذا الأساس، وما يتفرّع عنه من أركان لا أصنّفها كلامًا جديدًا. وهذه الأركان تتمثّل في الآتي:
- الأساسُ الذي تبتني عليه وتتفرع عنه الأركانُ الآتية يتمثل في أن علمَ الكلام الجديد يُفسِّر الوحي تفسيرًا ديناميكيًا، بمعنى أنه لا يرى النبي منفعلًا سلبيًا حالة الوحي، كما يرى علمُ الكلام القديم الذي يفسّر تلقّي النبي للوحي، وكأنه قناةٌ تمرّ من خلالها كلمةُ الله للناس، من دون أن يكون النبي متفاعلًا معها ومتأثّرًا ومؤثّرًا فيها. للوحي في الكلام الجديد بُعدان إلهي وبشري، البشري تعكسه شخصيةُ النبي والواقعُ الذي كان يعيش فيه. نكتشفُ منابعَ تفسير الوحي في آثار العرفاء، مثل محيي الدين بن عربي وغيره، وظهرت إشاراتٌ له مجدّدًا في آثار وليّ الله الدهلوي (1703-1762)، واستأنفه أحمد خان (1816-1898) بتفصيل وصياغة أوسع، وأعاد بناءَه محمد إقبال (1877-1938)، وفضل الرحمن (1919-1988)، وطوّره بعضُ المفكّرين الإيرانيين والعرب في نصف القرن الأخير.
- الإنسان بطبيعته ينفر ممن يخاف منه، ولا يحاول الاقتراب إليه. علم الكلام القديم رسم صورةً مخيفة لله، وفي سياقها تشكّلت علاقةُ المسلم بالله. علم الكلام الجديد ينشد إعادةَ رسم هذه الصورة بشكل يجعل صلةَ المسلم بالله لا خوفَ فيها، صلة مشبعة بالسلام الروحي. في ضوء هذه الصورة يعيد الكلامُ الجديد بناءَ هذه العلاقة، فينقلها من علاقة مسكونة بالخوف إلى صلة تتوطّن مقامَ المحبة.
- تتحدثُ الآيةُ 54 من سورة المائدة عن بناءِ صلةٍ بالله تتأسسُ على المحبّةِ المُتبادلَة: “يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ”. ترسمُ الآيةُ صورةً تفاعلية للصلة بالله، ثنائيةُ الاتجاه لا أُحادية، من الله إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الله. يبدأ اللهُ الإنسانَ بالحُبّ، فيتفاعل معه ويبادله الإنسانُ الحُبّ. الصلةُ في الآية ليست عموديةً تسلطية باتجاه واحد، الحُبُّ فيها مُتبادَل، لا تتحدثُ الآيةُ عن الله بوصفه فاعلًا وعن الإنسان بوصفه منفعلًا سلبيًا في الحُبّ. عندما يفيض اللهُ الحُبَّ على عباده يتخذ الحُبُّ قلوبَهم موطنًا له، يهدأ قلقُهم الوجودي، ويعيشون سلامًا باطنيًا، وتنشرح صدورُهم بالاستنارة الروحية. الاستنارةُ الروحية أجملُ ما منحته الأديانُ لحياة الإنسان، في الإسلام كانت الاستنارةُ الروحية منبعًا مُلهمًا لتحويل الصلة بالله من علاقة مسكونة بالخوف والرعب إلى صلة مشبعة بسكينة الروح وطمأنينة القلب.
- ينشدُ علمُ الكلام الجديد إيقاظَ المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي في الدين، بما يتواءم وحاجةَ حياة الإنسان للمعنى الديني في زماننا، ويسعى لاكتشاف القيم الكونية المشتركة في الإسلام مع الأديان الأخرى، ويعمل على الكفِّ عن إخراج الدين عن مجاله، ومصادرته لكل شيء في الحياة، وزجِّه في مجالاتٍ تُجْهِض المعنى الذي ينشدُه.
- لا يُعرِّف الكلامُ الجديد الدينَ بوصفه يتسع لكلِّ شيء في الحياة، ويكونُ بديلًا للعقل والعلوم والمعارف والتجربة وتراكم الخبرة البشرية، كما يُعرِّف الدينَ بذلك أكثرُ الذين ينطلقون من تفسير علم الكلام القديم للوحي والنبوة. في ضوء تعريف الوحي في علم الكلام الجديد يُعادُ تعريفُ النبوة، ويُعادُ تعريفُ الدين، بالشكل الذي يكونُ الدينُ منبعًا لما يثري حياةَ الإنسان بالمعنى الذي يتطلبه وجودُه، ويعزّزُ الأملَ والرؤيةَ المتفائلة للعالَم، ويوقظُ الحوافزَ الخيرية لدى الإنسان ويغذّيها باستمرار، ويكونُ الدينُ عنصرًا فاعلًا في بناء الإرادة وترسيخها، ورفدها بكلِّ ما يكرّس الشخصية ويجعلها صبورة صلبة لا تنكسر عند مواجهة التحديات الصعبة في الحياة.
- لا يتحقّق علمُ الكلام الجديد من دون تعدّدِ قراءات القرآن الكريم، وإعادةِ تفسير كلام الله، وتنوعِّ فهم النصوص الدينية تبعًا لتنوع الأزمان وتعدّد الأحوال، وإعادةِ تفسير آيات القرآن في ضوء حاجة الإنسان للمعنى الروحي والأخلاقي والجمالي الذي يتطلبه العيشُ في عالَم يتسارع فيه إيقاعُ المتغيرات، وتتفاقم فيه كلُّ يوم مختلف المشكلات. يقول محيي الدين بن عربي: “كلامُ اللهِ اذا نزلَ بلسانِ قومٍ فاختلفَ أهلُ ذلك اللسان بالفهمِ عن اللهِ ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات مع اختلاف مدلولاتها، فكلُّ واحدٍ منهم وإن اختلفوا فقد فهمَ عن اللهِ ما أراده، فإنه عالِمٌ بجميع الوجوه تعالى، وما من وجهٍ إلا وهو مقصودٌ لله تعالى بالنسبة إلى هذا الشخص المعين، مالم يخرجُ من اللسان، فإن خرجَ فلا فهمَ ولا عِلْمَ”، (ابن عربي، الفتوحات المكية،باب 418، ج 7، ص 36، 1999، دار الكتب العلمية، بيروت).
- يُفكِّر علمُ الكلام الجديد في آفاق العقل ومعطيات الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع والتأويل الحديثة، لأن تجديدَ علوم الدين وإعادةَ بناء علم الكلام يتكفّله تجديدُ علوم الدنيا، فكلّما تطورت علومُ الدنيا وتجدّدت تطورت علومُ الدين وتجدّدت تبعًا لها. المناهجُ وأدواتُ النظر الموروثة في فهم الدين وتفسير نصوصه لا تُنتِج إلا المعنى الديني الذي تكرر إنتاجه من قبل، لذلك لا يمكن أن نترقبَ إنتاجَ علم كلام جديد عبر تكرار استعمالها والتفكير في فضائها.
[1] أستاذة فلسفة متخصصة في الهيرمينوطيقا، المغرب.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.