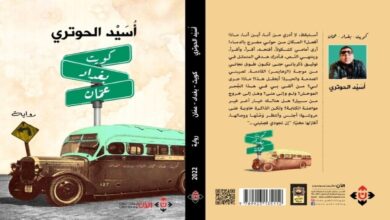مصطفى يحيى وذاكرة العقود التسعة

قراءة في سيرته الشخصيَّة من خلال كتاب العقد التاسع
في مقال سابق لنا عنوانه الهويَّة والانتماء في كتابات مصطفى يحيى نشر بموقع التنويري هذا منذ سنة بالضبط، تحدَّثنا عن غزارة إنتاج هذا الأديب العصامي الذي أفادته خبرته الثريَّة بالحياة وصروفها، بتونس وخارجها، وحرصه على النهل من كنوز الأدب والثقافة العربيَّة والفرنسيَّة، بزاد إبداعي كبير جعله ينظم الشعر ويكتب القصة بهاتين اللغتين بتميُّز مرموق وبسلاسة لا تتوفَّر إلا لقلَّة من المبدعين المتمرِّسين. وعدّدنا في خاتمة ذلك المقال منشوراته التسعة التي حوصلت ما كتبه في هذين الجنسين من الأدب. ونعرض اليوم إصداره الأخير الذي أثرى به المشهد الأدبي بجهة قابس، وعنوانه “العقد التاسع” وهو كتاب في السيرة الذاتيَّة ضمّ اثنتين وعشرين قصَّة جاءت في ثلاث مائة وستين صفحة أكَّدت تضلُّعه الأدبي وقدرته السرديَّة الكبيرة.
وقد جلب انتباهنا عند اطلاعنا على هذا الكتاب أن الكاتب اختار لمؤلفه عنوان العقد التاسع في صيغة المفرد كما لو كان مضمونه يتعلق فقط بفترة محدودة من عشرة سنين تمثل حاضر المؤلف وتجسِّد معيشه الآني. في حين أنَّ الكتاب يتضمّن متابعة زمنيَّة لسيرة شخصيَّة أطول كثيرا. هي مسار العمر كله بعقوده التسعة المتواترة التي جاءت مليئة بالأحداث المتنوعة زاخرة بالتجارب وبالعواطف والشجون وبالأفعال والانفعالات. عقود مليئة بالأحداث المتقلبة المتلاطمة حينا والهادئة أحيانا. عقود موشحة بالقيم والمبادئ الثابتة الوارفة ملتحفة بالخبرات وبالتغيرات من ميدان لآخر ومن علاقة لغيرها. فما مضمون هذه العقود؟ وكيف يمكن قراءة هذه السيرة وكشف أرديتها وتواشيحها التي ذكرنا؟
إن الاستعراض الموجز لمسار هذه السيرة الذاتيَّة كما جاءت في كتاب العقد التاسع، يبرز لنا تتالي الأحداث وتواترها بالشكل التالي :
– في العقد الأول، عقد الطفولة الذي قد يتراءى للبعض أنه فقط عقد البراءة والمرح مع الأتراب داخل بساتين واحة قابس الجميلة و”حبالها” ومنعرجاتها، وعقد العجز والتبعيَّة التامة للأسرة، بل كان مليئا بالشجن هو أيضا، خاصة بسبب المرض وآلامه التي عجز عن تخفيفها جميع “أساطين” الطب الشعبي ونطاساته، وكذلك بسبب الرعب من معارك الحرب العالميَّة الثانية الضارية التي فرضت على الجميع الهرب ومغادرة منازلهم وقضاء الليالي الطوال في العراء عرضة للحشرات والثعابين، أو عند بعض المعارف والأصدقاء بأرياف مارث بعيدا عن الواحة.
– في العقد الثاني كانت بداية النضج الجسدي والفكري والنموّ الشخصيَّة اللافت بمكوناتها الفزيولوجيَّة منها والذهنيَّة وقد ساعدت على ذلك الدراسة بالقسم الزيتوني وبالمدرسة والاندماج مع الأصدقاء والخلان، وكذلك التفاعل الإيجابي مع عديد المدرسين القدوات الذين كان لهم الأثر العميق في نحت شخصيَّة الطفل وتطويرها.
في هذه الفترة نمى الوعي الوطني وراجت لدى شباب المدارس أخبار البطولات التي كان يأتيها المقاومون ضد المستعمر الفرنسي، فكان ذلك حافزا على الانخراط في النضال الوطني والمشاركة في المظاهرات الإحتجاجيَّة وعمليات التوعية والإمداد اللوجستي مع مجموعات الشباب الدستوري التي لم يتردد في الإلتحاق بها دعما لهذا النفس التحرري المتنامي والتزاما بالواجب الوطني. لكن هذا العقد شهد ايضا انتكاسات عاطفيَّة كثيرة بسبب الآلام والجراح التي خلفها موت الأب فكان الاضطرار إلى الانقطاع عن الدراسة ودخول معترك الحياة.
– العقد الثالث، هو فعلا أهم العقود وأدقها وأخطرها، التحق المؤلف خلاله (في 6 / 5 1957) بسلك الأمن الوطني بالعاصمة كحافظ أمن مفعم بالحيويَّة والاستعداد لخدمة وطنه المستقل حديثا والمحتاج لجهود كل أبنائه. وقد فتحت هذه التجربة عينيه على عديد الحقائق والأوضاع بفضل ما عاشه خلالها من علاقات متقلبة مع زملائه ومسؤوليه متّن معرفته بالتفاعلات الداخليَّة لهذا السلك وللسلطة التنفيذيَّة بشكل عام، وما كان له من علاقات مع عديد الأجانب خاصة من الفرنسيين، بعضها إنسانيَّة وبعضها إداريَّة رسميَّة خضعت لمنطق الإتصال بين طرفين متعاديين.
في هذه الفترة تطوّع الأول لحرب ببنزرت، وانتقل إلى مدينة المخاطر وبقايا معارك التحرير فمكنه ذلك من المشاركة في معركتها التحريريَّة المعروفة بمعركة الجلاء واطلع ميدانيا على هولها وفضاعاتها. كما اطلع على حدّة تعامل السلطة الحاكمة مع معارضيها من أنصار صالح بن يوسف. فاستفحل لذلك كرهه لهذا الحاكم وتواترت انتقاداته لسياسته وشاعت معارضته لسلوك دولته وهو الضالع في جهازها التنفيذي فكان الخوف من الانتقام والمحاسبة كما جرى مع غيره من الأمنيين والعسكريين. ونتج عن ذلك القرار الحاسم الذي غير حياته وقلبها رأسا على عقب وهو قرار الهجرة والالتجاء إلى فرنسا (في أفريل 1963). وهذا حدث مفصلي مثَّل نقلة نوعيَّة في حياة مصطفى يحيى برمتها إذ ترتّب عنه مستقبل مغاير كليا لما كان منتظرا عندما أقدم على الالتحاق بالأمن الوطني. وانبنت عليه أحداث عميقة التأثير.
– في العقد الرابع: طاب به المقام ونما إعجابه بفرنسا وترسخ في النفس لمميزاتها وصفاتها الجذابة التي سمع عنها كثيرا وخبرها الآن وتأكد من صدقها بالمعايشة اليوميَّة، فرنسا الحضارة والقيم وليس فرنسا الاستعماريَّة المتغطرسة التي لا يمكن أن يحبها . هذا العقد مليء بالتقلبات أيضا ابتدأ بصعوبات حياتيَّة عديدة في الشغل والإقامة ثم تيسرت فيه الأمور وعاش المعني خلاله:
– الترحال بين عديد المدن والأماكن الفرنسيَّة.
– الاشتغال في عديد الحرف ومزاولة عديد الأعمال بمؤسسات مهنيَّة مختلفة.
– لقاءات مع أشخاص مهمّين كثيرين والدخول معهم في معاملات متنوعة وربط علاقات جيدة مع الكثيرين ومتوترة مع آخرين.
– ثم كان الانتقال إلى العاصمة باريس (في 12 / 4 / 1964) والاستقرار المهني بها ممّا أفرز استقرارا اجتماعيا في السكن والعلاقات توّج باستقرار عاطفي أيضا بعد الزواج من موريسات سنة 1968. ويتوّج هذا العقد بإنجاب طفل اختار له من الأسماء جمال. هو عقد مزهر حقا أعطى دفعا روحيا ومعنويا كبيرا للمعني ومتن تواصله بالأهل وبجميع المحيطين به. وتدعمت هذه الراحة النفسيَّة بزيارة أفراد الأسرة له بباريس (الأم والأخ).
ثم جاء العقد الخامس يحمل تقلبات كثيرة أخرى بدأت بإعلان العفو العام بتونس مما شجع مصطفى يحي على العودة النهائيَّة إلى أرض الوطن والاستقرار به وبعث مشروع تجاري مربح كان يديره مع شريك له. لكن هذا الأخير سرعان ما استحوذ على المشروع ومداخيله مستغلا تسجيل جميع الوثائق والمستندات باسمه. وأفضى غدر الشريك هذا إلى وضع أسري كارثي سمته الفقر المدقع والاحتياج والاضطرار إلى مزاولة عديد الأعمال المتعبة.
– وشهد العقد السادس انفراج هذا الوضع الاجتماعي الصعب بعد الحصول على عمل إداري قار والالتحاق بشركة شحن بالميناء التجاري بقابس. ويبقى أهم حدث في هذا العقد هو نجاح الابن جمال في دراسته والتحاقه بجامعة ليل الفرنسيَّة وهو إنجاز أعاد تفكير مصطفى يحي في فرنسا فطلب جنسيتها لتيسير انتقاله إلى هناك وزيارة ابنه متى شاء دون عراقيل.
– العقدان السابع والثامن، تميزا خاصة بقرار مصطفى يحيى الإقبال على مزاولة العمل الحزبي والنضال السياسي والالتحاق بالحزب الديمقراطي التقدمي PDP. كما تركز اهتمامه أكثر على الأنشطة الأدبيَّة بكتابة القصة ونظم الشعر، وسنة 2001 تمّت طباعة ونشر ديوانه الشعري الأول: ذكريات من المستقبل. وتتالت بعدها عمليَّة نشر الكتب والدواوين باللغتين العربيَّة والفرنسيَّة.
غير أن العقد التاسع، اتسم بفواجع متلاحقة انطلقت بموت الزوجة في 2016 وتلتها الإصابة بأمراض ألزمته بالتردد على المصحات للعلاج وإجراء عمليات جراحيَّة، إضافة إلى ارتكاب حوادث طريق خطيرة. ومع ذلك يتواصل التحدي والتمسك بروح التفاؤل ومواصلة الإقبال على الحياة بعزيمة كبرى وطموحات متجددة. فيتواصل الاشتغال بالكتابة والنشر والمشاركة في التظاهرات الثقافيَّة ومواكبتها والتردد على منابر الأصدقاء وربط المزيد من الصداقات بود كبير وروح متفائلة مرحة.
إنه ليس عقدا بل مسار من العقود الزاخرة، موشحة بانفتاح فكري مشهود وبثوابت قيميَّة راسخة.
الغربة والاغتراب وأردية العقود التسعة:
الرداء الذي تتلفع به هذه العقود التسعة هو الغربة والاغتراب. الغربة بمعنى شعور انفعالي عاطفي ووضع نفسي يتسم بالانشغال والتوتر والمعاناة بسبب البعد عن الوطن ومفارقة الأهل أي بسبب الهجرة. وللغربة تأثيرات نفسيَّة كثيرة (التبرم بالحياة والحزن والشعور بالوحشة والضيق …) وتأثيرات صحيَّة (الهزال والمشاكل البدنيَّة) وتأثيرات اجتماعيَّة أيضا (الوحدة، فقدان السند، الاحتقار، العنصريَّة، ….).الغربة معاناة فعلا لكن كثير من هذه الوضعيات مفترضة فقط ولم يعشها الكاتب كلها وبعمقها القاسي في جميع العقود وفي كل المراحل الزمنيَّة والوضعيات التي مرّ بها لما يتمتع به من قدرة على الصبر والتحمل وعلى الإندماج أيضا وربط العلاقات ويسر التواصل مع الآخرين. ولقد تيسر له ذلك بفضل ثقافته وإتقانه لغة القوم وإطلاعه على عاداتهم وتقاليدهم. كما استطاب له الأمر أيضا بفضل انفتاحه الفكري ولباقته وقدرته على الحوار والإقناع إضافة إلى اهتمامه بمظهره وأناقته بما يعطي عنه إنطباعا إيجابيا دائما، وبالتالي تتدعم قدرته على الإندماج والتأقلم وينبسط قبوله باساسيات العيش المشترك. وتسنى له تلطيف هذه الغربة أكثر بالعمل والعلاقات الاجتماعيَّة والزواج واستقبال الأقارب (الأم والأخ). أما حلها النهائي فهو طبعا العودة لأرض الوطن.
أمّا السبب الفعلي للغربة فهو الوضع الإجتماعي السيء وغياب السند العائلي بفعل الانتماء إلى وسط محدود الإمكانيات حتى وإن لم يقع التصريح بذلك علنا. هي اختيار شخصي أضطر إليه مصطفى يحي لمعالجة وضعه. فالرغبة في تحسين هذا الوضع والخروج من دائرة الحاجة ومن مطبات الفقر كانت حاسمة لديه… ومثل الطموح إلى وضع أفضل دافعا ذاتيا قويا.
أما العوامل المساعدة على القبول بالغربة والإقبال عليها واتخاذ قرار الهجرة ذاته فهي:
– اليأس من الوضع الداخلي التونسي المتسم بالعسف والتسلط والمحاباة والتعامل بقسوة مع المعارضين. هذا أورث كرها للنظام ورئيسه ونقمة عليه وخوفا منه أيضا خاصة بعد المجاهرة المتكررة بالاعتراض على سياساته وبالانحياز إلى خصمه أي إلى جماعة التيار اليوسفي داخل الحزب.
– الانتماء إلى سلك مسدود الآفاق ولا يلبي أي طموح ولا ينعش أملا، تروج فيه عديد الممارسات السيئة مثل المراقبة والمتابعة والتبليغ والمغالطة أو النفاق وغياب المصداقيَّة إضافة إلى الترصّد والسعي إلى الإيقاع بالآخر وتوريطه ولو زورا. كما أنه سلك تخترقه الولاءات والمحسوبيَّة والتبعيَّة المطلقة للنظام التي ينفذ من خلالها سياساته وعسفه. وهذه وقائع ومواصفات تتناقض مع قناعات الأديب مصطفى يحيى الأخلاقيَّة ومع توقه للحريَّة والتزامه بها. هو لم يكن مستهدفا مباشرة من النظام بل من زملائه. إذ لم يقع إيقافه ولا التحقيق معه ولا حتى التنبيه عليه ولا وُجّهت له أيَّة تهمة ومخاوفه متأتية من استقراء شخصي للوضع السائد وبسبب تحذيرات من بعض المقربين منه.
والواضح أنه لم يكن على قائمة المستهدفين من قبل النظام أصلا بدليل مغادرته البلاد وعودته إليها بيسر كبير دون مساءلة أو متابعة من أي كان على غير العادة في التعامل مع معارضي السلطة. بل قبل سفره كان من الأعوان المبجلين إداريا بدليل ما ناله من تنويه الإدارة لما قام به من أعمال جليلة أثناء معركة بنزرت وبعدها وترقيته وإدراج اسمه بسجل الشرف للشرطة (ص 29) وهذا أورث غيرة زملائه منه، وكثير منهم ضالع في ترصد الآخرين والتبليغ عنهم واختلاق الأكاذيب حولهم. وكان يخشى فعلا إتهامهم له بالتعامل مع المخابرات الفرنسيَّة أي بالخيانة والعمالة للأجنبي خاصة بعد سهولة وسرعة حصوله على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وهو ما سجله زميل له بأحد تقاريره (ص 31) أكثر من اتهامه بمعارضة النظام. فتلك تُعدّ تهمة العار حسب قوله ولا أمل لمن يرمى بها في النجاة (ص 32).
– أما العنصر الآخر الذي حفزه على الهجرة ودفعه إليها فهو تشجيعات بعض المعارف والأصدقاء الفرنسيين وطمأنتهم له على مصيره هناك أي التزامهم بمساعدته في الغربة وبإمكانيَّة التعويل عليهم للوقوف معه وأساسا الصديقة ميلاني (ميكي) وزوجها اللذين تعرف عليهما ببنزرت وبقي على اتصال بهما بعد عودتهما إلى فرنسا. وهذا عنصر خارجي مهمّ جدا ينضاف إلى العنصرين الآخرين الداخلي والذاتي حتى تتضافر عديد العوامل المشجعة على الهجرة والداعمة لها.
والملاحظ أيضا أن القبول بالغربة واختيار الهجرة لم يكن بدافع ايديولوجي رسم اختلافا عضويا مع النظام وسعيا إلى التخلص منه ولو عن بعد. فالكتاب لا يكشف التزاما ايديولوجيا لكاتبه ولا يخبر عن أي فعل سياسي معارض مارسه خلال مدة تواجده بالخارج، ونحن نعلم أن فترة الستينات مثلت زخما كبيرا في عمل المعارضة التونسيَّة بفرنسا خاصة بعد منع الأحزاب بتونس سنة 1963، فتحول مركز الثقل إلى باريس وهنالك تكونت المجموعات الأوليَّة لليسار التونسي وللحراك الطلابي ولم يذكر المؤلف أي مشاركة له معهم أو اتصال له بهم. فالمغترب مصطفى يحيى له مواقف سياسيَّة لا ترتقي إلى حدّ الالتزام السياسي أو الأيديولوجي لذلك احتسبنا هذه المواقف ضمن العناصر الداعمة لقرار الهجرة والقبول بالغربة وليس السبب الرئيس لها.
الجزء الثاني من الرداء أو اللحاف الذي تتلفع به هذه العقود التسعة هو الاغتراب، وأعني به الشعور بالغربة محليا أي في وسط الأهل والأقارب والأصدقاء نتيجة غرابة سلوكيّاتهم وعدم التكيف مع الوسط الذي يجمعهم أو توتر العلاقة مع المحيطين وعدم التوافق مع بعض الأطراف المقربة وعدم استساغة صنيعهم أو القبول به. وهذا الشعور سيطر على المؤلف في ثلاثة فترات من حياته خاصة أو في ثلاثة عقود: عندما كان أمنيا ببنزرت متواجدا مع مجموعة من الزملاء الانتهازيين المتربصين به يحصون عثراته ويسجلون أقواله ويبلغون عن أي سلوك يأتيه، ثم عند خلافه مع شريكه الذي غدر به وأنكر حقوقه في مشروعهما التجاري بكل صلافة، ودون مراعاة لأيَّة قيم وتعهدات وما ترتب عن ذلك من عوز وفاقة، ثم كذلك بعد وفاة زوجته وبقائه في وضع نفسي حادّ جدا وفي واقع مجدب يعمّه الفراغ والوحدة لم تلطفه إلا الكتابة ومجالسة الأصدقاء من حين لآخر.
أما عن الوشائح التي زينت هذه العقود التسعة فنقصد بها مجموعة كبرى من القيم والمبادئ التي حرص صاحب السيرة على التحلي بها طوال حياته. وهي من نوعيات مختلفة: وطنيَّة وأخلاقيَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة أيضا، مررها الكاتب من خلال سرديته ودافع عنها.
فالقيم الوطنيَّة مثل حب الوطن والغيرة عليه والوفاء له والتطوّع للدفاع عنه ميدانيا وفي كل المجالس… تتردد في عديد المقاطع والقصص التي تدور وقائعها داخليا وخارجيا، في سن الشباب وعند الكبر، وليس أدل على ذلك من المشاركة الميدانيَّة الفعليَّة في معارك الجلاء ببنزرت وقبلها في معارك التحرير وشد إزر المقاومين مع بقيَّة الشباب… وفي نفس الإطار يتنزل أيضا الدفاع عن فلسطين وعن الأمّة العربيَّة والحزن لمآسيها (مثل هزيمة 67) والفرح لانتصاراتها كما حصل في حرب 73. وهو ما يجيز لنا الحديث عن هويَّة نضاليَّة لدى المؤلف تتواتر تجلياتها بين المحلي التونسي والقومي العربي والكوني الأممي.
– أما القيم الأخلاقيَّة مثل الصدق والتفاني والقيام بالواجبات والإيفاء بالتعهدات والاعتراف بالجميل ونصرة المظلوم ودعم المحتاجين فهي مما التزم به مصطفى يحيى في كامل ردهات حياته ومما حرص عليه في كل فعل يأتيه وفي كل واجب يؤدّيه. وكذلك كانت علاقاته بجميع من تعامل معهم أي في كنف الصراحة والشفافيَّة والاحترام والتمسك بالمبادئ والقناعات والحرص على الإيفاء بواجب الصداقات. واجتماعيا تخبرنا سيرته أنه تشرب الوفاء للعائلة كافة وللأم في المقام الأول وكذلك لكبار السن كأم زوجته وللقدوات (أو الشخصيات الاعتباريَّة تونسيا وعربيا وعالميا مثل بن يوسف، عبد الناصر، شارل ديغول…). لكنه لم يتسامح مع مدّعي التطبيب والمشعوذين وعارض بشدة هرطقاتهم والتلاعب الذي يمارسه. كما أنه كان يكبر جهود كل من مدّ له يد المساعدة ويعترف بجميلهم ويعاملهم بمثل أخلاقهم من الود والشهامة والحفاظ على الأعراض بدليل رفضه العلاقة الخاصة التي سعت إليها ميكي احتراما لزوجها واعترافا بفضله وتقديرا لاستضافته له بمنزله ولما بذله من جهد في مساعدته على الحصول على عمل وعلى سكن.
أمّا في الجانب الثقافي فإن حب المطالعة والاطلاع على الإنتاجات الأدبيَّة المختلفة باللغتين العربيَّة والفرنسيَّة هو مما جلب انتباه المحيطين به ودعم تقديرهم له وإعجابهم بتكوينه وبسعة إطلاعه. أما غرامه بالشعر فقد ظهر لديه مبكرا إلى حد حرصه على حمل ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي معه إلى فرنسا. كما حدثنا في سيرته عن زياراته للمعارض وعن رحلاته المتتاليَّة وانتقاله بين عديد الأماكن بفرنسا وأوروبا والمغرب وتونس منفردا حينا ومع زوجته أو أصدقائه أحيانا. ولقد تطور لديه نظم الشعر وكتابة القصة من العربيَّة إلى الفرنسيَّة وتولد عنده حرص كبير على نشر انتاجاته الأدبيَّة والتعريف بها لدى القراء ولدى متابعي وسائل الإعلام.
قد نختلف مع الأديب مصطفى يحي في ما يكتبه وخاصة تركيزه المفرط على شخصه وعلى سيرته الذاتيَّة دون التفات منه إلى الشأن العام وما يعتمل به من أحداث اجتماعيَّة زاخرة باستثناء بعض المقاطع المقتضبة المتابعة للأوضاع السياسيَّة مدفوعة بموقف معارض للنظام الحاكم ولسلوكيات رئيسه، لكن القارئ لا يملك إلا الإكبار لعصاميته ولطموحه وحرصه الشديد على الارتقاء والتميّز وعدم الاستسلام للأقدار أو البقاء في دائرة الشائع والمعتاد ليس حرصا على المخالفة الشكليَّة الجوفاء على شاكلة خالف تعرف، بل حبا للإضافة والإثراء والحضور الإيجابي والفاعل في جميع الميادين وبأسلوب سلس وجذاب. كما ينبهر المتابع بأخلاقيات الرجل الفاضلة وبرسوخ قيمه وصدق التزامه بها بما يسر اندماجه في جميع الأوساط التي تعامل معها ووفّر له مجالا شاسعا من الصداقات القيمة والمعتبرة.
__________
*محمد رحومة العزّي/باحث تربوي من تونس.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.