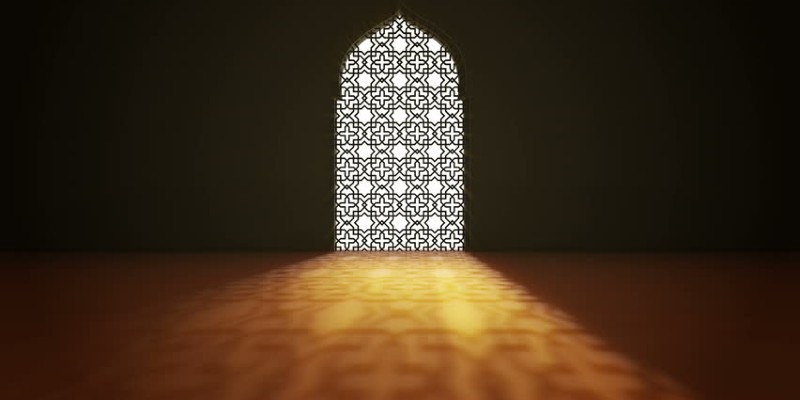
هناك مصطلحات إذا أُطلقت أثارت معها دواوين من المناقشات والاختلافات العميقة وسحبت معها إرثا تاريخيا من السجال، يحضر ذلك كله بكل صفحاته البيضاء والسوداء ليقف خلف هذا المصطلح المفخَّخ بالمثيرات والثارات الغائرة في القدم، وأبرز تلك المصطلحات؛ مصطلح (التنوير)، وحضوره هنا يستفزّ ويثير حفيظة الكثير، مهما حاولت أن أخصّه بمفهوم معيَّن أو أحيّده عن معاركه التاريخيَّة، فالتنوير كان عند البعض سبب النهضة والحداثة والتطوير، وعند آخرين سبب التسلُّط والاستبداد الإمبريالي والضلال الديني والانحراف عن الحق، وكلما أُستدعي التنوير في مشروع فكري أو نهضوي استجلب معه هذين الصنفين والصفّين المتقابلين عداوةً واحترابًا.
ولادة التنوير الإسلامي من رحم التجديد:
ولِد سؤال التنوير الإسلامي –حسب الاستعمال المتداول- مع بدايات عصر النهضة في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وشكّل منعطفا تغييرا لدى عدد من مفكِّري العالم العربي والإسلامي، وبعث معه روح النقد وأسئلة التجديد في العقل العربي، وأثمر بعد صولات وجولات، نتاجا فكريا عميقا من خلال ثورة البحث عن أسباب التخلُّف والضعف والضمور الذي لفّ العالم الإسلامي آنذاك، حصل هذا الحراك الفكري بعد مرحلة التماس السلمي مع الغرب الناهض والمتقدِّم في مجالاته الحياتيَّة المختلفة، وكانت مشاريع التنوير الأوروبيَّة تبحث لها عن آراضٍ جديدة تطولها يد القوَّة والفكر الجديد للتبشير بعالم حرّ قادم من الشمال، في تلك اللحظة القاتمة والمتخلِّفة في عالمنا العربي بدأت محاولات طرح سؤالات النهوض على يد عدد من شهود ذلك التماس الحضاري بين الشرق والغرب، فكان رفاعة الطهطاوي (1873م) من أوائل من حمل هذا اللواء، عندما بدأ ببثِّ الوعي النهضوي في كتابه (تخليص الابريز)، ثم أكمل مساره خير الدين التونسي (1888م) في كتابه( أقوم المسالك في معرفة الممالك ) حيث بيَّن شروط تجديد التمدُّن الإسلامي ووسائل نهوضه، كما قام عبدالرحمن الكواكبي (1902م) بنشر ثقافة النهضة من خلال مقدَّمة كتابه (أم القرى) بشكل خاص وكتابه (طبائع الاستبداد) بشكل عام، و نشط هذا الحراك النهضوي بشكل أكبر على يد محمد عبده (1905م) من خلال جدل التجديد والتقدُّم الديني مع رينان وهانوتو وفرح انطوان وغيرهم، كانت هذه الملامح الأولى لفكر نهضوي يستلهم روح الإسلام في فكرته مع تمكين وترسيخ لأدوات التغيير الأوروبي للواقع العربي آنذاك، ربما وجدوها بداية مناسبة للانطلاق تحاكي أنموذجًا حضاريًّا صالحا للاتباع، ولكن من حيث التأريخ العملي لطرح هذا السؤال، فيمكن أن نجعل ابن خلدون (1406م) رائدا في إثارة السؤال النهضوي حول كيفيَّة بناء الأمم والحضارات وكيفيَّة ضعفها وسقوطها في مقدّمة تاريخه؟ أكَّد هذا المنحى عدد من الباحثين الذين ربطوا مشروع الطهطاوي والتونسي بالنهج الخلدوني في دراسة النهوض والانحطاط من خلال إعمال الأسباب والمسبّبات والعلل، كما أنَّ الاستفادة من مضامين المقدمة الخلدونيَّة كان طاغيا في إنتاجهم الفكري ومحاولاتهم التجديديَّة (انظر: خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر للدكتور سهيل الحبيب ص 75- 87، فكر ابن خلدون العصبيَّة والقبيلة للجابري ص 252).و لكن مع بداية القرن العشرين ظهرت مشاريع فكريَّة أخرى تستلهم العودة الدينيَّة كأساس للتحضُّر مع حفاظ أشد على الهويَّة الإسلاميَّة من التأثّر بالنماذج الغربيَّة التي بدأت تغزو معاقل التعليم في الشرق الإسلامي، كان من أبرز رواد هذه المرحلة الشيخ محمد رشيد رضا (1935م) من خلال مجلته المنار، والأمير شكيب ارسلان (1946م) من خلال كتابه التساؤلي (لماذا تأخَّر المسلمون وتقدَّم غيرهم) والمفكِّر الهندي محمد إقبال (1938م) في كتابه (إحياء الإسلام)، بعدها بدأت مرحلة أخرى من العمل الإصلاحي اتجهت فيه نحو الحماية من التغريب الحضاري الداخلي؛بعدما تكوّنت الدولة المعاصرة رافعةً لواء الفكر الإستعماري التغريبي؛ ما أدَّى إلى بروز عدد من الحركات الإسلاميَّة في مقابل تنامي التيارات اليساريَّة والعلمانيَّة التي جالت أفكارها بحثا في سؤال النهضة ومأزق التخلف، وللأسف أنَّ هذا الحراك المتسارع في النمو والإثارة الفكريَّة قد تحوَّل عند الإسلاميِّين إلى سؤال الهويَّة والمحافظة عليها وقمع المخالفين والمناوئين، واختزل مشروع نهضة الأمَّة إلى مشروع حفظها بقيام دولة الإسلام المحقِّقة لتعاليمه وقيمه، ظهر ذلك التوجّه بشكل واضح في كتابات أبي الحسن الندوي(1999م) والمودودي(1979م) وسيد قطب(1966م) ومحمد قطب(2014م) وغيرهم، ثم أدَّت الصدامات العنيفة ذات البعد السياسي التي مرَّت بها الحركات الإسلاميَّة إلى انشغال العديد من مفكّريها بالمحافظة على كياناتها بمواجهة أعداء التغريب وحملات التشويه؛ ممَّا جعل سؤال النهضة وأدبيّاتها من ثانويات الخطاب الإسلامي بعد منتصف القرن العشرين، باستثاء مبادرات هامة قدّمها مالك بن نبي(1973م) و الطاهر ابن عاشور(1973م) وعلال الفاسي(1974م) تجاوزت هموم المواجهات الفكريَّة والمدافعات السياسيَّة التي أُدخلت الحركات الإسلاميَّة في أتونها ولم تخرج حتى اليوم، إلى تساؤلات تبحث في عمق الخلل الحضاري والسكون النهضوي، ويمكن بعد تلك المقدمة التاريخيَّة الموجزة لسؤال التنوير والنهضة في مجتمعاتنا العربيَّة والإسلاميَّة، البحث عن أسباب ضعف وتنحِّي جدل التنوير الذي بدأ ثم أنطفأ.
علاقة التنوير بالدين في تاريخنا العربي المعاصر:
يقابل التنوير العقلاني في غالب أدبيّاته المعاصرة ما هو ديني غيبي أو كهنوتي، وهو ما عليه فلاسفة التنوير الفرنسي عندما استعاضوا عن دين الكتب ووساطة الكنيسة بدين طبيعي، جان جاك روسو (1778م) على سبيل المثال، بيد أن التنويريّين الألمان الأوائل حاولوا التوفيق بين الدين والعقل بأن يكون الدين في حدود العقل، إمانويل كانت (1804م) على سبيل المثال.[انظر: علي أومليل في بحثه عن معنى التنوير ضمن كتاب حصيلة العقلانيَّة والتنوير في الفكر العربي المعاصر من نشر مركز دراسات الوحدة العربيَّة ص 142] ومع تحفّظي على هذه الثنائيَّة الحادَّة بين التنوير والدين التي يتبنّاها الكثير من المعاصرين، فإن هناك محاولات توفيقيَّة ومجالات أرحب للتنوير حتى في مصدره الأوروبي بعيدة عن الصدام المباشر للدين، تحوي العديد من المفاهم التجديديَّة والتجريبيَّة والتجفيفيَّة مع المحافظة على أصل الدين، ويمكن التمثيل على ذلك بمذهب ” المؤلّهة الطبيعيّين ” الذين خرجوا في وقت مبكّر حوالي عام 1624م فبرز منهم انتوني كولينز (1676م) وألكسندر بوب(1744م) في كتابه “مقال عن الإنسان” وأفكار جون لوك (1704م) وباروخ سبينوزا (1677م)كانت تقترب كثيرا نحوهم [ انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة لوليم كلي رايت، نشر دار التنوير 2010م ص 228]، ليس المقصد هو بيان الموقف التنويري من الدين بقدر ما هو محاولة توضيحيَّة أن العلاقة السائلة بينهما في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدأت في الجمود والتحوّل إلى علاقة منفصلة وصلبة بُنيت على أساس النقل الأول الذي جاء لمنطقتنا العربيَّة من خلال بعض نخبنا المثقّفة في استيراد التنوير كمنتج متكامل ومبهر، فانتقل إلينا بكل أحماله وأثقاله وجدالاته الفلسفيَّة، وتموضع هذا المستورد في قوالب لا تسمح بتداخل الدين والثقافة في التنوير إلا أن تخرج في قوالب أخرى، وبناءً عليه برزت في ساحتنا نماذج لمشاريع تجديديَّة وإحيائيَّة لا تقل أهميَّة عن مثيلاتها بأوروبا، مثل مشروع نقد العقل الإسلامي لأركون(2010م)، ومشروع نقد العقل العربي للجابري(2010م)، أو محاولات جابر عصفور في خلق تنوير عربي جذري ونقدي باحثا عن الأطر الثقافيَّة الداعمة له من ليبراليَّة غالبة وقوميَّة متفتحة وماركسيَّة مستترة، أو كمشروع محمد عمارة التنويري بروح إسلاميَّة دفاعيَّة مغايرة، أو ما قام به محمد شحرور من نقد تنويري علماني خصوصًا للنصّ وتأويلاته، وما قام به محمود العالم والطيب تزيني وحسين مروة من زاويتهم العقلانيَّة الماركسيَّة، هذه المشاريع خلقت حالات من التنوير المعاصر بصورته الجامدة التي لا تقبل الدين إلا باشتراطات تأويليَّة خارج سياقاته المعرفيَّة، ذهب صالح مصباح بتتبّعها تاريخيًّا من خلال موجات بدأت منذ قرنين على أساس التأصيل الإصلاحي الذي انطلق مع الطهطاوي والأفغاني وعبده مستمدًّا الإصلاح الإحيائي ومتمركزا على تحصيل (التمدُّن)، ثم جاءت موجة التنوير الراديكالي الذي يتَّجه نحو التحديث الجذري أو تحصيل (التقدُّم)، كما فعلت التيارات الاشتراكيَّة والليبراليَّة من خلال ثورات تحديث صداميَّة أحيانا، وكان هذا التنوير الأكثر تعقيدا؛ إذ ضمَّ اشتراكيّين رواد، مثل شبلي شميل(1971م) وفرح أنطون (1922م)، كما ضمّ من جهة ثانية ليبراليّين، مثل قاسم أمين (1908م) ومنصور فهمي (1959م) وسلامة موسى (1958م) ولطفي السيد (1963م)، وأدخلت مفاهيم الثورة السياسيَّة والتنمية الاقتصاديَّة والوحدة القوميَّة ملتبسةً بلبوس جديد هو فكرة الثورة الوافدة من التجربة الأمريكيَّة والفرنسيَّة وخاصَّة الروسيَّة، ثم حاول مصباح أن يتحدَّث عن موجة ثالثة أفردها بالتوضيح تحت مسمَّى الموجة التنويريَّة العربيَّة الثالثة ما بعد الكولونياليَّة زمنيا ووريثة الحقبة الكولونياليَّة واقعا، وهي ذات مسحة خلاسيَّة بيّنة؛بعضها ليبرالي جديد، تخلَّى عن كل ما سبق من شعارات ورفع راية الديمقراطيَّة، وبلغة الراهن “الإصلاح السياسي” مستعيدا عناصر عديدة من كتابات الليبراليّين التقليديّين، أمثال الطهطاوي وخير الدين التونسي والكواكبي، متّصلةً بذلك مع التنوير المعتدل الليبرالي الأوربي، يعني تنوير هوبز(1679م) ولوك ومنتسكيو (1755م) وكانت. [انظر: بحث التنوير العربي المعاصر.. ملاحظات أوليَّة من منظور ما بعد/لا كولونيالي للدكتور صالح مصباح، نشر في العدد 19 صيف 2011 مجلة إبداع القاهريَّة، عدد خاص بتونس:الثورة والفكرة ص 189-208].
هذه التشكّلات التنويريَّة الفسيفسائيَّة التي ذكرها مصباح مع تداخل كبير بينها لم تحسمها الأفكار المكتوبة آنذاك؛بل المواقف المشهودة التي برزت مع الاستعمار والمقاومة والتحديث والممانعة وغيرها، ولكن بعد الربيع العربي بدت لنا تيارات التنوير أكثر تمايزاً نحو المواقف الصلبة مرة أخرى، تستتبعها تنظيرات تبريريَّة وليست تنويريَّة تصطف بعماء مع السلطة أو الحزب أو الثورة أو المال أو الخرافة، ما دعاني أمام تلك المتغيّرات في الحالة التنويريَّة العربيَّة أن أسطِّر أهم تلك الإشكاليات التي تداخلت فيها المبادئ مع النزق المصلحي، والمقدَّس مع المدنَّس، والثابت مع المتحوّل، وكلها أظهرت غبشا هائلا في الرؤية والموقف، بينما الأصل والمفترض أن يكون التنوير إظهارا للسطوع وبيانا للنور الهادي نحو الطريق القويم.
في نقد ادِّعاء التنوير:
ولعلّي أرصد بعض تلك الإشكالات في جسد التنوير نفسه أو ما ينبغي للتنوير فعله، على النحو الآتي:
أولا: التحوّل الليبرالي في مواقفه القيميَّة خصوصا أمام ما يطلق عليه بالإسلام السياسي، ومن قضيَّة الدعوة للديمقراطيَّة ومحاربة أعدائها الرجعيّين إلى حالة متوحّشة لا تقبل شريكا آخر في الساحة سوى لأحزابها المهترئة، فقد نتفهَّم المخالفة للأجندة الدينيَّة في العمل السياسي من استغلال شعاراتي عاطفي وتشدّد وانغلاق تنموي، لكن من غير المفهوم أن يكون التحوّل إلى موقف قمعي استبدادي يطالب بالإقصاء التام من الساحة، والتبرير بالقتل والسجن تحت ستار الحرب على الإرهاب، في موقف صارخ يتنافى مع أبسط المواثيق الحقوقيَّة الدوليَّة والمبادئ الديمقراطيَّة المسلّمة.
ثانيا: ممارسة بعض التيّارات الإسلاميَّة اللعبة الديمقراطيَّة الشكلانيَّة، كصورة من صور التنوير الديني بتسويغ العمل الديمقراطي لأجل الدخول المؤدّي للفوز والحصول على أصوات الشعب، دون إكمال مشوار الديمقراطيَّة القائم على أدبيّات غربيَّة لم تحسم تلك الجماعات موقفها من تلك المسائل الكثيرة والشائكة؛ كالحريَّة الدينيَّة والمشاركة السياسيَّة وقضابا المرأة وحقوق الأقليات والعلاقات الدبلوماسيَّة مع الآخر المختلف وغيرها، بمعنى أن الإشكال قائم في الاندفاع اللاواعي بحيثيات وطبيعة المشوار الديمقراطي الشائب والشائك، وأحيانا بالجهل والتعجّل في فهم الواقع الدولي وتحدّياته الهائلة بأحداث معارك خاسرة مع العسكر والقوى العميقة تزهق فيها الأرواح وتغيب فيها الطاقات البشريَّة الشريفة في السجون تحت شعارات التضحية في سبيل الله ومقاومة أعداء الدين، فكأن التكتيك السياسي الذي دخلت به تلك التيارات اللعبة الديمقراطيَّة تحوّل إلى حرب مقدَّسة وشهداء يتسابقون للجنَّة.
ثالثا: ما ينبغي للتنوير توضيحه هو زيف المقاومة الذي يعتبر أهم الشعارات الجماهيريَّة التي تلتف حولها الشعوب المهضومة، فكم مُرّرت مصالح حزبيَّة قاتمة وطائفيَّة باسم المقاومة، وكم اخترقت أوطاننا العربيَّة بأوهام المقاومة الكاذبة، حتى أصبحنا نرى المقاومة التي هي خط الدفاع الأول عن الأمَّة العربيَّة تطعن شعوبنا من الخلف وتحوّل معاركها إلى الداخل نصرةً للطائفة وتزييفا للشعارات، والأعجب أن يدخل في هذا النفق مثقفون يدّعون الموضوعيَّة وكتّاب يصفون أنفسهم بنبض المجتمع ليبرروا مجازر الأنظمة القمعيَّة والأحزاب الطائفيَّة.
هذه الحالات اللاتنويريَّة هي الأشد ظلاما للفكر وإيلاما للضمير الإنساني، و التنوير الرشيد لم يقم بدوره كما هو مطلوب منه قيميا وتاريخيا؛ما يعني أن المشروع التنويري وإن كان قديم الوجود في الفضاء العربي والإسلامي إلا أنّه مشروع لم ينجز بعد، على حدِّ تعبير هابرماس، ويمكن أن نستعير توصيف ميشيال فوكو (1984م) الأبلغ في بيان الواقع التنويري الذي نشهده حيث يقول:” إنَّ عصرنا ليس عصرا متنورا، فالتعصُّب والخرافات والتشاؤم والخوف تبدو جميعا وكأنها تتفاقم، ولكننا ما نزال جميعا أبناء التنوير، قد يكون وضعنا أكثر تعقيدا وقد تكون مواردنا الفكريَّة أكثر تطوّرا، ولكننا نواجه متاهات من شأنها أن تكون مألوفة لأي ديدرو (1784م) أو لأي فولتير (1778م) أو روسو.أمر واحد من شأن ديدرو والآخرين أن يكونوا واثقين منه: على المرء أن يتجرَّأ على مواجهة المسائل، ويعتمد على قواه وتفكيره ويكون مستعدًّا لإعادة التفكير بكل شيء، إنّ المسألة المركزيَّة للفلسفة والفكر النقدي منذ القرن الثامن عشر قد كانت دوما: ما هذا العقل الذي نستخدمه؟ وماهي تأثيراته التاريخيَّة؟ وماهي حدوده، وما هي مخاطره؟” [نقلا من كتاب التنوير للويد سبنسر و أندريه كراوز، نشر المجمع الثقافي بأبوظبي 2003م، ص 171]. واليوم يبرز معطى آخر لا يقل أهميَّة عمَّا ذكره فوكو، وهو الكلمة الحرَّة والنقد الصادق والمسؤوليَّة الثقافيَّة وإلا الصمت أوسع لكثير من المخاطرين بتاريخهم المقامرين بفكرهم، وقديما قال علماء أصول الفقه في تبرير منفعة السكوت مع التنبيه لضرره عند الحاجة: ” لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان.!”[انظر: شرح القواعد الفقهيَّة للزرقا، دار الفكر 1989م، ص 337].
حاجتنا المعاصرة للتنوير الإصلاحي. ولماذا؟
ولكي أدخل في مرادي دون تطويل، أعتقد أن مرحلتنا الراهنة في أمسِّ الحاجة لمشروعٍ تنويري إسلامي إصلاحي، يعيد النور والسطوع لمفاهيم النهضة والتجديد التي غشيتها الظلمة أحيانًا، وأحيانا الغبرة وسوء النظر والتقدير، الذي يزيد هذه المفاهيم حيرة واضطرابًا لاسيما عند من يروم التطبيق وسلوك دربها في التغيير، ويمكن إجمال بواعث الحاجة للتنوير فيما يلي:
1-الحراك التنويري الذي أُطلق عليه هذا المصطلح ليس حراكا في جغرافيا محدَّدة أو تاريخ معين في العالم؛ بل هناك تنوير متعدِّد الجهات بدأ في المشرق وانتقل في أماكن متنوّعة من العالم، ربما كان الحدث الأهم في تاريخ التنوير الإنساني قد بدأ عام 610م ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمّى هذا الحدث العظيم الدكتور زين العابدين الركابي(2014م) (نهضة التنوير الكبرى) وبعدما استشهد بروايات عدد من المؤرِّخين الغربيِّين الذين يثبتون هذا المنعطف التاريخي الهام يضع مقصوده في معنى التنوير، حيث قال:” هو استحضار العقل بعد غيبة، وتحريك طاقة التفكير بعد جمود حتى تبلغ أعلى المعدلات المتاحة لها، وتسديد حركة التفكير بمنهج علمي سديد عاصم من الأوهام، والمعتقدات الفاسدة، والتقليد الضرير، ثم بناء المعتقد والمفاهيم والأعمال وفق هذا المنهج السديد” [انظر: جريدة الشرق الأوسط العدد: 12359]، وما جاء في التنزيل الحكيم يوحي بصدق تسمية بعثته عليه الصلاة والسلام بأنها نور حقيقي شعّ في الظلام، كما في قوله تعالى:”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا”(١٧٤ النساء) وقوله تعالى:” لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ “(11 الطلاق)، وقوله تعالى:”هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ” (43 الأحزاب)، فالهدى والنور كان من أبرز صفات الإسلام وواقعه التطبيقي يشهد على تحقُّق هذه الفرادة الحضاريَّة، كما لا نغفل وجود نماذج من الحراك التنويري؛ تعدَّدت مصادره الشرقيَّة، فهناك التنوير الصيني، حيث بدأت حركة الإصلاح الديني في عهد المينج (1472 – 1529م) من خلال القراءة الحرَّة العقلانيَّة والمتجدِّدة للكونفوشيوسيَّة، وكرّست نظام الفصل بين الدين والدولة، وأقامت تجربة الدولة المركزيَّة القوميَّة بنظامها البيروقراطي العقلاني وبلورت قيم الفاعليَّة الإنسانيَّة الحرَّة. أما اليابانيّون فيعتبر عهد ميجي هو حقبة التنوير التي بدأت عام 1871م من خلال إصلاحات سياسيَّة ومشاركات شعبيَّة، تأسَّست لأجل ذلك مجالس حكم محليَّة وأنظمة اقتصاديَّة متطوّرة، والأهم هو انفتاحه الكبير على المعارف والعلوم وإرسال خيرة الشباب الياباني للنهل من هذه العلوم في كل أصقاع الأرض، وكذا في الهند والسند وأواسط أسيا، فلم يخلُ تاريخ الشرق من تنويرٍ أحدث الكثير من العلوم والمعارف والإصلاحات المدنيَّة، وسحب المصطلح على الأنموذج الأوروبي فقط؛ فيه الكثير من المغالطة والاختزال. [ انظر للاستزادة: التنوير الآتي من الشرق.تأليف جي جي كلارك ترجمة شوقي جلال.طبعة دار المعرفة 2007م].
2-أن عصرنا الحالي يمرّ بظلمات كثيرة بعضها فوق بعض، ظهرت من خلال تأسيس الجهل ومحاربة المبدع ونفيه عن وطنه، وصناعة العصبيَّة والتقليد وقمع المعرفة وتأطيرها في مجالات معينة لا يخرج عنها إلا مارق أو مخالف، كما ساهمت السياسة والمال في وضع تلك الأطر التسلّطيَّة البعيدة عن نور الهدى وبدهيات الحقيقة، وهذا ما جعل هناك تشوّف وتشوّق لمرحلة تنويريَّة تزيل بعض الران عن الفكر والفقه وتصفي التراث مما علق به من مقدَّسات بشريَّة لم تخلُ من النقص والتناقض، وهذا ما دفع ببعض المصلحين إلى إثارة حاجتنا للتنوير من خلال تسمية بعض الدعاة والمصلحين -إعجابا بهم- بالتنويريين [ انظر على سبيل المثال: كتاب “ابن باديس، فارس الإصلاح والتنوير” لمؤلفه الدكتور محمد بهيّ الدين سالم، دار الشروق 1420 هـ، وكتاب ” رفاعة الطهطاوي.رائد التنوير في العصر الحديث”، لمؤلفه أ.محمد عمارة، دار الشروق 2007م]، وخرجت على أثر ذلك دعوات جديدة تسمَّى بالتنوير الإسلامي أو الإسلام المستنير، واختلط في تلك الدعوات مناهج تطلب التجديد في النصّ والوحي، ومناهج هربت من النمطيَّة التقليديَّة في الفقه إلى النمطيَّة العصبيَّة في الحداثة، وأصبح المثقّفون بين مفكِّرٍ مستنير أو عالم متخلّف أو زنديق منحرف، كأحد صور التراشق بالتّهم، والتي لا تصحّ بحال، لما فيها من نزق التصفية للخصوم بكيل التهم جزافًا دون برهان، ولأجل تلك الحالة قام عدد من المفكّرين بوضع معايير للتصنيف والفصل بين التنوير الحقيقي وخلافه؛ فتح الباب لجدل أوسع نتيجة للأحكام النهائيَّة التي ذكرها مؤلفوها.[ انظر للاستزادة فيمن ألّف في هذا الجانب، محمد جلال كشك في كتابه ” جهالات عصر التنوير: قراءة في فكر قاسم أمين وعلي عبد الرازق” طبعة مكتبة التراث الإسلامي عام 1990م، وكتاب “الإسلام بين التنوير والتزوير” لمؤلفه أ.محمد عماره، دار الشروق، القاهرة 2002م، وكتاب “قضيَّة التنوير في العالم الإسلامي ” لمحمد قطب، دار الشروق عام 1989م ].
3-إنَّ مشاريع التنوير التي يرومها عالمنا الإسلامي باتت حاجة ملحَّة للفرد والمجتمع، فغياب العدالة الاجتماعيَّة وتمكُّن الاستبداد السياسي وانتقاص الحريّات والحقوق الأساسيَّة بالإضافة لغلبة التعصُّب والاحترابات الداخليَّة وتهيئ بعض المجتمعات العربيَّة للفوضى المدمِّرة، كل هذه الصور القاتمة تتطلَّب تنويرا عاجلا ينقذ مجتمعاتنا الإسلاميَّة من مزيد من التشظّي أو الانحسار، وحالة الربيع العربي لم تكن سوى تصادم عنيف بين رغبات الشعوب للحريات والحقوق ورغبات الحكومات للاستئثار والهيمنة دون أن يكون هناك تلاقٍ سلمي إلا في أماكن محدودة من العالم العربي، وأهميَّة المشاريع التنويريَّة أنها تؤسِّس المفاهيم اللازمة للمجتمع المنشود وتغرس تلك الأفكار والنظريات في أجواء مناسبة لبناء القناعات بها أولاً، بدلاً من القفز على كراسي الحكم وإدارة الدولة دون ممهّدات ركيزة لمفاهيم الحريَّة والحقوق والمشاركة الديمقراطيَّة، ودون معرفة لدور الأمّة والدستور في تشكيل مرجعيَّة مدنيَّة للمجتمع، ما يجعل الدولة ميدانا للتجارب البكر والمراهقة السياسيَّة، الخطأ فيها لا يحتمل الغفران.
كل ما سبق ذكره من معطيات تبيِّن أهميَّة استعادة أفكار التنوير لنهضة مجتمعاتنا؛ سوف يصطدم بفكرةٍ كؤود تراكم على الاعتقاد بها أجيال من المسلمين، والتي تقول بأن التنوير اليوم هو إسقاط تام واستنساخ كامل لمشروع التنوير الأوروبي، والقبول بالتنوير هو القبول بالعقلانيَّة الإلحاديَّة والماديَّة المنحرفة، خصوصا أنَّ أشهر دعاة التنوير في عالمنا الإسلامي لم يكونوا يعلنون سوى أفكار كانط ولوك وفولتير وروسو وديدرو وغيرهم دون تمحيص وتنزيل يتماشى مع احتياجنا الإصلاحي، لذلك تواطأ الفهم أنَّ التنوير لا ينصرف إلا على التجربة الأوروبيَّة وحدها، ومهما تخوّفنا وتوارينا عن التنوير الأوروبي فإنّه في عصرنا الحاضر يعتبر المشروع التنويري الأبرز والأقوى، ووجوده في العالم كله أصبح واقعًا لا يمكن أن نغمض أعيننا عنه، فنظرياته وأدبياته المعرفيَّة والفلسفيَّة حاضرة في كل العالم شئنا أم أبينا، أيضًا هناك أسباب فرضت الأنموذج التنويري الغربي، منها ما يلي:
أولا: امتاز التنوير الأوروبي بالحسم والقطيعة التامة مع إرثه المسيحي الذي استمرَّ قرونا طويلة، والحسم يعني بداية جديدة تتطلَّع لها أنفس وعقول الناس الباحثين عن التغيير، فكان التنوير سببًا في التقدُّم الأوروبي وإسقاطاً لهيمنة الوصاية والاستبداد الديني والسياسي على عقل المجتمع وتطوّره، فكانت فكرة التنوير هي فكرة الخلاص التي كان يبحث عنها المجتمع الأوروبي بتعجّلٍ ولهفة، يفسّر إيمانويل كانت معنى التنوير أو الأنوار في رسالته المشهورة حول الأنوار، بقوله:” خروج الإنسان من حالة القصور الذاتي الذي يعدّ هو بذاته مسؤولًا عنه، والقصور هنا يعني عجز الإنسان عن استعمال عقله دون قيادة وتوجيه الغير، والسبب في ذلك لا يعود إلى نقص في العقل، وإنما إلى جبن الإنسان وخوفه من استعمال عقله بكل حريَّة. هكذا تكون الأنوار دعوة لكل إنسان إلى أن يعمل بشكلٍ مستمرّ على رفع كل أشكال الوصاية عن نفسه، طالما أن لا أحد يفرض عليه القبول بتلك الوصايات إلا خوفه من استعمال عقله، لذلك كان شعار الأنوار هو:تجرَّأ على استخدام فهمك الخاص” [انظر: حصيلة العقلانيَّة والتنوير في الفكر العربي المعاصر، بحث الدكتور أومليل “في معنى التنوير” مركز دراسات الوحدة العربيَّة ص135-136 بيروت الطبعة الأولى 2005م]، فالمعنى أنَّ أوروبا كانت أمام مرحلة فاصلة بدأت هناك بوادر تطوّرات صناعيَّة وزراعيَّة وديموغرافيَّة جديدة وكان عليها أن تحدِّد موقفها بثورة حقيقيَّة ضدّ عوامل تأخّرها التي بلغت حدًّا ينذر بالكارثة.
ثانيا: إنَّ التنوير الأوروبي هو الأكثر هيمنة منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم، فأفكاره وأنماطه المعرفيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة كلها تحكم العالم بشكل ما، وهذه الهيمنة لا ينبغي أن تُغفل عند المناقشة، فمن حاربها في مجال فهو يرحِّب بها في مجالاتها الأخرى دون تردُّدٍ أو مواربة.
ثالثا: التنوير الأوروبي قابلٌ للنمو والتطوّر ويمتلك النقد الذاتي، ولا يزال المفكّرون الغربيّون يناقشون أي عصر يسمَّى الأنوار ومتى بدأ، وما هي جغرافيته العالميَّة، وما هي الأفكار المؤسَّسة له، ولا يزال أيضا يتطوَّر وينتشر وتنتقد الكثير من أطروحاته السابقة، هذه الفاعليَّة والثراء جعلت التنوير الأوروبي الأبرز في الانتشار العالمي لنشاط وحيويَّة مدارسه الفلسفيَّة والمعرفيَّة.
أمام هذه المعطيات الواقعيَّة لقوَّة التنوير الأوروبي في التأثير العالمي، نتساءل عن مدى حاجتنا إلى تنويرٍ إسلامي مستمدّ من التنوير الأوروبي، هذا المحكّ المعرفي هو المطروح والمتداول في غالب أدبيات الحداثة العربيَّة، وحاجتنا للتنوير قائمة وملحَّة، ولكن يبقى السؤال الأهم عن موقفنا كمسلمين من التنوير الأوروبي، ولعلي ألخّص الإجابة في النقاط التالية:
4-أن فلسفة التنوير وما قدَّمته من نظريات معرفيَّة، لم ينتج مباشرة من أوروبا؛ بل هو مستفاد من نتاج أمم سابقة أهمَّها ما قدَّمه العرب المسلمون من علوم ومكتشفات ساهمت في دفع النهضة الأوروبيَّة من تراجم وشروح ابن رشد(1198م) لأرسطو، ثمَّ الإسهامات التي قدَّمها جمع من العلماء كالحسن بن الهيثم (1040م)والخوارزمي(850م) وعلماء الأندلس وغيرهم، وهذه لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد، فالتواصل المعرفي بين الحضارات يقتضي أن نستفيد كمسلمين من إنتاج الأمم الأخرى، يؤيِّد ذلك قوله تعالى:” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” (الحجرات 13) فعلاقة (التعارف) هي أساس التواصل بين شعوب الأرض، والمعرفة رحم بينهم في المفهوم الإسلامي، والاعتبار للحقّ أيًّا كان مصدره.[انظر للاطلاع على هذا التراث الكبير في المراجع التالية: كتاب “الشهود الحضاري”. للدكتور عبدالمجيد النجار.الطبعة الأولى 1999م. دار الغرب الإسلامي. بيروت، وكتاب “من أجل انطلاقة حضاريَّة شاملة”.للدكتور عبدالكريم بكار. الطبعة الأولى 1415ه.دار المسلم بالرياض، وكتاب “دراسات في الحضارة الإسلاميَّة وثقافة الغرب الإسلامي”.للدكتور محمد زنيبر. الطبعة الأولى 2010م. من منشورات جامعة محمد الخامس بالرباط، كتاب “تأمّلات في روائع الحضارة العربيَّة والإسلاميَّة في العلوم والفنون ودورها في الترقّي العلمي”. للدكتور حمدي نافع. الطبعة الأولى 2012، مكتبة الجامعة بالشارقة ]. فليس من المستغرب أو المنكر أن نتوافق مع التنوير الغربي على بعض النظريات وان نستنير بتجاربهم في الإصلاح.
5-أن في كل مشروع إصلاحي تغييري قدر من الأخطاء لا يجب تبريرها أو السماح بتكرارها ولا يعني وجود الخطأ في الفهم والتأويل منع العمل بالمشروع المتوخَّى خصوصًا إذا ثبتت صلاحيته في التطبيق بوجهٍ من الوجوه، وناسخو التنوير الأوروبي لا يمثِّلون سوى أنفسهم، وتجربتهم الاستنساخيَّة هي مجال للنقد لم تنتهِ بعد، ولا يزال الباب مفتوحًا لتجارب أخرى تستلهم كل محاولات التنوير والإصلاح في أيّ مجتمعٍ كان، فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها فهو أحقّ بها، وقبل تجربة الحداثيِّين العرب كانت تجربة الأفغاني والطهطاوي وعبده ورشيد رضا والتونسي وإقبال وغيرهم، وهناك تجربة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وتجربة النهضة التونسيَّة، وتجربة الحريَّة والعدالة التركيَّة، والتجربة الماليزيَّة، وغيرها من التجارب التي تفتح الباب لعدم محاكمة التنوير الغربي من خلال أنموذج وحيد.
6-أنَّ التنوير الإسلامي ليس مصطلحًا لجماعة معيّنة، وإن ادّعاه أحد فهو يمثِّل نفسه، وقد سبق في التاريخ الإسلامي نماذج كثيرة مارست هذه الاستحقاق المصطلحي على ذاتها، لهذا نجد أنَّ أغلب مناقشات رافضي التنوير تصبّ حول نماذج معيَّنة من منتسبي التنوير، وهذا ما يجعل المثال هو مصدر قبول القاعدة أو رفضها، وهناك الكثير من الردود المعاصرة في غالبها نحت هذا التوجّه وقامت بمحاكمات معرفيَّة للتنوير أساسها تبنِّي بعض الأفراد للفكر التنويري حسب فهمهم الخاص ومنهجهم المتّبع في اختزال التنوير في تلك القوالب المشخَّصة. [انظر بعض الكتب التي اتَّجهت في هذا المضمار: كتاب “التنوير الإسلامي في المشهد السعودي” لمؤلفه عبد الوهاب آل غظيف، مركز تأصيل، الطبعة الأولى، 1434هـ، وكتاب” التنوير بالتزوير” وهو مساهمة في نقد الخطاب العلماني والردّ على سيد القمني وخليل عبد الكريم ورفعت السعيد لمؤلفه منصور أبو شافعي، مكتبة النافذة بالقاهرة].
وفي الختام، أخلص بنتيجة تؤكِّد حاجتنا للحسم والبداية الراشدة لعهدٍ تنويري يقوم على مشاريع معرفيَّة متكاملة يتداعى لها كل المفكّرين والعلماء بقصد علاج مشكلاتنا الراهنة وليس من أجل التمادي في الانقسام وتعزيز الفئويَّة بيننا، ليس إنكارًا للتعدّديَّة وأهميتها، بل لأجل أن تكون الأفكار خارجة عن أرض المعارك الشخصيَّة نحو معارك الإصلاح والبناء وبينهما فرق كبير.
إن الإصلاح التنويري – من وجهة نظري-سيجدِّد الاجتهاد الفقهي الذي لا يهمّش النص؛بل يحسّن فهمه وفق مستجدّات تنزيله وتطبيقه، ويعالج النقص الإبداعي في مجالات العلوم الاجتماعيَّة والنفسيَّة والإنسانيَّة بشكل عام، كما نأمل أن يخلق نظريات سياسيَّة مستقرَّة تعالج اضطراب واقعنا الفكري قبل واقعنا المجتمعي، هذه وغيرها، هي ما ننتظره من حراك التنوير الواسع المتجدِّد، والطريق إنما يعرف سبيل الاهتداء إليه بقوَّة النور المشع فيه.
____
*د.مسفر بن علي القحطاني/ أستاذ الدراسات الإسلاميَّة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن/ الظهران –المملكة العربيَّة السعوديَّة.

