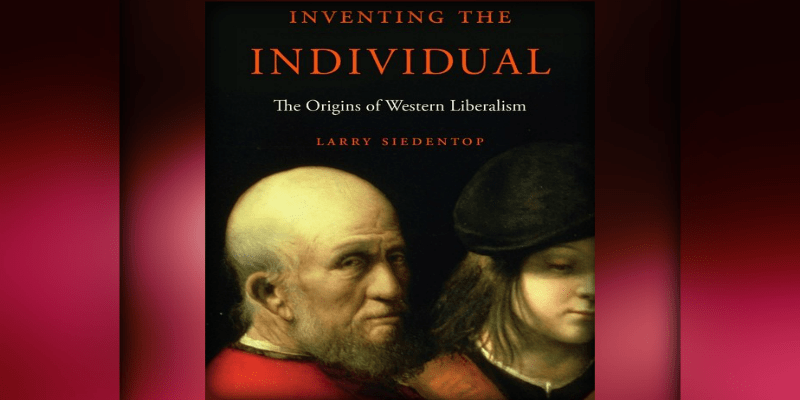
مدخل:
تتمثَّل الحيويَّة الفكريَّة للغرب في الحرص على التنقيب الدائم عن كنوز المعرفة المنسيَّة، والحفر في الذاكرة المكتنزة بميراث الماضي، وإعادة القراءة الفاحصة للتاريخ، واستجلاء النماذج الحضاريَّة، واستيضاح التجارب الإنسانيَّة، في محاولات مستمرَّة لتجديد الواقع وتطوير مفاهيمه الجوهريَّة لمصلحة الحاضر. وسيراً على هذا المنوال، يشهد الغرب على مدى العشرين عاماً الماضية، أو نحو ذلك، ثورة في بعث الاشتغال بالفلسفة العامَّة والقراءة المنهجيَّة للتاريخ، تنزع لإعادة النظر في العلاقة بين المسيحيَّة كعقيدة تكوينيَّة للوجدان العام وبين الحداثة ومركباتها من الليبراليَّة، والعلمانيَّة، والديمقراطيَّة، والمقاربة بينهما، وما إلى ذلك من ممسكات الثقافة المؤطِّرَة والمُعَرِّفَة لسلوك المجتمع. وقد انضمَّ مؤلِّف كتاب “اختراع الفرد: أصول الليبراليَّة الغربيَّة”، الدكتور لاري سيدنتوب، إلى صفوف جمهرة من العلماء الكبار، أمثال؛ فيليب غورسكي من جامعة ييل، وإريك نيلسون من جامعة هارفارد، وتشارلز تايلور الأستاذ الفخري في جامعة ماكقيل، وكذلك تالكوت بارسونز، الذي عمل في جامعة هارفارد، والمتوفى منذ فترة طويلة، ولكن ظلَّ مؤثِّراً للغاية ومحترماً، والذين أعادوا التأكيد على ما قد نُسِيَ سابقاً، بغض النظر عن “سؤال الإله”، وممَّا كان يُعتَقَدْ على نطاق واسع في الدراسات الأكاديميَّة أنه لا يمتُّ للمسيحيَّة بصلة، في حين أنه ساعد على نهوض المبادئ العلمانيَّة، وعزَّز القيم الغربيَّة المرتبطة بها.
حجَّة فكريَّة:
يُعتبر الدكتور لاري سيدنتوب حُجَّة في حقل الدراسات التاريخيَّة إلى جانب اهتماماته الفكريَّة والفلسفيَّة. لهذا، لم يكن مستغرباً أن يُعَيَّن في أول وظيفة أُنشئت في بريطانيا عام 1970 لتخصّص أكاديمي في التاريخ الفكري، الذي أُختيرت جامعة ساسكس مقرّاً له. وانتقل من هناك إلى جامعة أكسفورد، ليُصبح محاضراً في الفكر السياسي والفلسفة، وزميل في كليَّة كيبل. وقد أغنى المكتبة بالكثير من المؤلِّفات القيمة، التي اشتملت على دراسة عن “توكفيل”، و”الديمقراطيَّة في أوروبا”، والتي ترجمت إلى عشرات اللغات. وحظي كتابه الجديد: “اختراع الفرد” بإقبال كبير، وصار بطبعتيه الأمريكيَّة، التي قامت بنشرها مطبعة هارفارد بلكناب في 20 أكتوبر 2014، والأوروبيَّة، واحداً من أكثر الكتب إثارة وتشويقاً عن النظريَّة السياسيَّة، التي ظهرت في سنوات عديدة، إذ قدَّم إضافة رائعة لجملة الدراسات المتوفِّرة عن تنمية الفرد ككيان سياسي واجتماعي حيوي. وهذا الكتاب هو عبارة عن مراجعة ممتعة غير تقليديَّة عن جذور الليبراليَّة الحديثة في الفكر المسيحي في القرون الوسطى، ويمثِّل عرضاً ممتازاً لأفكاره، لأنَّه مكتوب بلغة رصينة، ويشمل جميع القضايا الرئيسيَّة المطروحة للنقاش في الأوساط العلميَّة الغربيَّة، وحججه موجزة، ومقنعة، ومفيدة للغاية لفهم موضوع الفرد والفردانيَّة في محتواها ومستواها الغربي.
هذا الكتاب هو عبارة عن مراجعة ممتعة غير تقليديَّة عن جذور الليبراليَّة الحديثة في الفكر المسيحي في القرون الوسطى، ويمثِّل عرضاً ممتازاً لأفكاره، لأنَّه مكتوب بلغة رصينة، ويشمل جميع القضايا الرئيسيَّة المطروحة للنقاش في الأوساط العلميَّة الغربيَّة، وحججه موجزة، ومقنعة، ومفيدة للغاية لفهم موضوع الفرد والفردانيَّة في محتواها ومستواها الغربي.
محتويات الكتاب:
اشتمل كتاب الدكتور لاري سيدنتوب “اختراع الفرد: أصول الليبراليَّة الغربيَّة”، الصادر في 20 أكتوبر 2014،[i] من مطبعة هارفارد بلنكاب في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، على 448 صفحة، حوت بين طياتها “مقدّمة” ضافية، وستَّة أجزاء، وخمسة وعشرين فصلاً، وخاتمة جامعة، وقائمة المراجع المختارة والهوامش ومؤشِّر السجل العام للأعلام والمعالم الأساسيَّة. وقد تناولت المقدِّمة محاولة جادَّة للإجابة على السؤال المحوري للكتاب، وهو: ما الذي يعنيه الغرب؟ وتوزَّع الجزء الأول، الذي جاء بعنوان: “العالم منذ العصور القديمة”، على ثلاثة فصول، هي: العائلة القديمة، والمدينة القديمة، والكون القديم. وضمَّ الجزء الثاني، الذي حمل عنوان: “ثورة أخلاقيَّة”، خمسة فصول، هي: بولس؛ انقلب العالم رأساً على عقب، والحقيقة الضمنيَّة: المساواة الأخلاقيَّة، وإعادة تعريف البطولة، وشكل جديد من الرابطة: الرهبنة، وضعف العزيمة: أوغسطين. وحمل الجزء الثالث عنوان: “نحو فكرة القانون الأساسي”، واستوعب أربعة فصول، هي: تشكيل المواقف الجديدة والعادات، وتمييز الروحي عن السلطة الزمنيَّة، والرموز البربريَّة، بديهيَّات القانون الروماني والمسيحي، والمساومة الكارولنجيَّة. وتناول الجزء الرابع موضوع “أوروبا تستحوذ على هويّتها”، مشتملاً على أربعة فصول، هي: لماذا لم يسعَ الإقطاع لإعادة إنشاء الرقّ القديم، وتعزيز “السلام الإلهي”، والثورة البابويَّة: دستور لأوروبا؟ والقانون الطبيعي والحقوق الطبيعيَّة. وقدَّم الجزء الخامس:”نموذج جديد من الحكومة”، شارحاً لهذا النموذج في أربعة فصول، هي: المركزيَّة وإحساس جديد بالعدل، ودمقرطة العقل، وخطوات نحو إنشاء الدول القوميَّة، والتمرُّد الحضري. وبينما اختصَّ الجزء السادس بالحديث عن: “مخاض ولادة الحريَّة الحديثة”، الذي ناقش في خمسة فصول قضايا: التطلُّعات الشعبيَّة والرهبان، وبدهيات الدفاع عن المساواة الأخلاقيَّة، والارتباط بين الحريَّة الإلهيَّة وحريَّة الإنسان: أُكهام، والنضال من أجل حكومة تمثيليَّة في الكنيسة، والاستغناء عن النهضة. قدَّمت الخاتمة خلاصات شارحة للمقاربة والمقارنة والتعارض بين “المسيحيَّة والعلمانيَّة”، مبرّرة موقف المؤلِّف واعتقاده بسبق المسيحيَّة على العلمانيَّة في اختراع الفرد وتشكيل الوعي الغربي بالفردانيَّة، التي قامت عليها النظريَّة الليبراليَّة الغربيَّة.
بين صفحات الكتاب:
لقد أرسى المؤلِّف في الفصول من الأوّل إلى الثالث، كيف يرى قضيَّة الولاء والهويَّة للمدينة وارتباطها بالخضوع للإله، وكيف تأسَّست فكرة الفرد على مثل هذه العلاقات. ومن ثم يقدِّم المؤلِّف في الفصل الرابع آراء بولس الطرسوسي في الوحدانيَّة في الثالوث بتعقيداتها اللاهوتيَّة. ويعرض في صفحة 60 من الكتاب استهلالاً لفكرة الفردانيَّة للقديس بولس؛ الفرد الجماعة والجماعة الفرد. فانصهار الـ”واحد” و”الجماعة” في المسيح، رغم كل مبرّراته العقديَّة واللاهوتيَّة، هو سلاح ذو حدين، إذ إنَّ الواحد هو “واحد” كمجموعة في المسيح، ولكن الواحد هو أيضاً “واحد” من الناحية الأخلاقيَّة، أي وجود المسار الفردي للخلاص؟ وقد تمَّ تطوير مفهوم الخلاص الفردي، أو الهلاك، إلى أقصى حدّ في كتابات القدّيس بولس. ففي صفحة 61 يؤكِّد المؤلِّف أنَّ ولادة “إرادة الفرد” جاءت حقاً مع فكرة بولس عن “الانصهار”.
ويناقش المؤلِّف في صفحتي 74-75، آراء “مرقيون”[ii] وبدعته حول “فردانيَّة” بولس المتطرِّفة. إذ يقول إنَّ الروح هو فردي في كل شخص والخلاص هو تصرّف فردي، ويجب رفض الطبيعة الطائفيَّة للعهد القديم مع المسؤوليَّة الفرديَّة للعهد الجديد. ومرقيون يقول، في الواقع، إن جميع ما يحتاجه الفرد هو رسائل بولس ولوقا، ورفض الباقي. ولهذا، فإنه قد أُتهم بالهرطقة.
ومن بعد، يتناول المؤلِّف الرهبنة والشهداء في عمليَّة بناء يَصِلُ به إلى أوغسطين. فجاء الفصل الثامن بمثابة تحليل لأوغسطين في سياق الفرد. فقد كان أوغسطين من جهة متمسِّكاً قوياً بأفكار بولس، في حين أنه كان مشرباً ومشبعاً بالثقافة الكلاسيكيَّة للإمبراطوريَّة الرومانيَّة. بمعنى أن المؤلف يرى تدفّقاً قوياً للهويَّة الفرديَّة في كتابته للـ”الاعترافات”. وضَمَّن المؤلف في هذا الفصل أيضاً صراع الجن، وذلك بمعنى إذا كان نزاع الفرد شخصي تكون الرحمة منه فرديَّة. وبدون رحمة فإنَّ المرء محكوم عليه بالفناء. ومع ذلك، فإنَّ أفعال المرء وحدها لا يمكن أن توفِّر الفداء، يجب على كل فرد، وفقا لأوغسطين، أن يحصل على نعمة الرحمة إذا أراد الحصول على الخلاص الأبدي. ويمكن للمرء أن يرى موقف الفردانيَّة في أوغسطين، ولكن مَنْح نعمة الرحمة على النحو الوارد، وليس كسبها، قد أوجدت دائماً ظلالاً من القلق الروحي.
ويحاور المؤلف، في صفحة 132-133، كلاً من غريغوري الأول وكولومبانوس بما يمثِّل نقطة مثيرة للاهتمام للمقارنة. فقد كان غريغوري من عائلة كلاسيكيَّة رومانيَّة قديمة وكان شهيد روما قبل أن يصبح أسقفاً لها. بينما كان كولومبانوس راهباً أيرلندياً أسَّس العشرات من المؤسَّسات الرهبانيَّة للدراسة، وكان في صراع مع غريغوري، ولكن مع توفّر الاحترام بينهما. إن كولومبانوس باعتباره راهب أيرلندي لم يسبق أن خضعت بلده لروما، وبالتالي في هذا التفاعل يمكن أن نرى هذه الخطوة من روما القديمة نحو الكنيسة الجديدة غير الرومانيَّة.
وقد انتقل المؤلِّف، في الفصل السادس عشر، إلى الحديث عن تطوّر القانون الطبيعي والحقوق الطبيعيَّة، وقدَّم استعراضاً متماسكاً عن هذين الموضوعين. فقد كان القانون الطبيعي وسيلة لشرح الأساس لقانون حقوق أصبح خارج الكنيسة، بينما مثَّلت الخقوق الطبيعيَّة حجر الأساس لما أصبح يُعرف بالحقوق الفرديَّة. بينما ركَّز في الفصل الحادي والعشرون على مناقشة موضوع الرهبان، بمعنى أن هذا هو أصل المعركة بين توماس الأكويني ووليام من أكهام، بين الدومينيكان والفرنسيسكان،[iii] وبين الجماعة والفرد، وبين أرسطو والانفتاح على رؤى فلسفيَّة جديدة. وفي هذا الفصل استخدم المؤلف ببراعة موضوع الفرنسيسكان حول الملكيَّة والعهد الجديد لمناقشة التَمَلُّك والمِلْكِيَّة الفرديَّة. يقول النصّ؛ “لاتباع المسيح يجب على المرء أن يتخلّى عن ملكيته الخاصَّة”. وللقيام بذلك، يجب على المرء أن يكون له بعض العلاقة مع خاصيَّة المِلْكِيَّة كفرد في المقام الأول. وقد يكون هذا النص هو الذي شكَّل أساساً جيداً لحجج جون لوك اللاحقة. وبينما ركَّز الفصل الثاني والعشرون على كليات قضيَّة أكهام، تلاه الفصل الثالث والعشرون بتفصيل ما أُجْمِلَ فيما سبقه من فصول.
لقد وردت الإشادة بـ”وليام أكهام” في جميع أنحاء الكتاب، وجرت لأفكاره مناقشة جديرة بالاهتمام. كان أكهام من المؤمنين بالمذهب الرمزي، وهو يعتقد أن المسلمات كانت خيالاً وأن المواضيع كانت في جوهرها هي الأفراد، وليس البشر، ولكن الأمور الفرديَّة. وهكذا، عندما نقول. “إنَّ زنبق النهار أزرق اللون.” نعني زنبقاً محدّداً، أي الموضوع. ولكن أكهام يسمح للمسند “الزنبق الأزرق” ليكون له بعض العلاقة مع عَالَمٍ يُسمى “الأزرق”. رغم إيمانه بأن زنبق النهار باعتباره حالة عالميَّة لا وجود لها. وزنبق النهار المحدّد مثل الواحد الذي أُمْسِكُ به قد يكون موجوداً، كفرد. ولكن لتمديد هذا نقول إنَّ زنبق النهار المحدّد باللون الأزرق، الذي نعنيه باعتباره المسند لبعض مفهوم عالمي من اللون الأزرق، أو أزرق وكأنه زهرة الردبكيَّة؟ ونحن نتقدَّم إلى مسار أكثر علميَّة يجوز لنا استخدام المسند “الأزرق” مثل طيف من الفراغ الذي نُريد، ثم نقول أزرق مثل “هذا”. وهكذا في النهاية نحن لا نستخدم البناء على العالميَّة ولكن كمفرد للموضوع، وكذلك للمسند.
هكذا كانت فصول الكتاب، وربما كان الفصل الأخير هو الأكثر إثارة للفكر، إذ أنه يدعو الأوروبيين والأميركيين اليوم إلى فهم تراثهم، وأن يروا أن المسيحيَّة والليبراليَّة الفرديَّة قد تطورتا معا، وأنهما لا يمكن فصلهما. إن الأوروبيين الذين هم ضدّ رجال الدين الذين يحاولون أن تكون الليبراليَّة دون المسيحيَّة، والأميركيين الأصوليين الذين يريدون أن تكون المسيحيَّة بدون الليبراليَّة، كلاهما يخطئ، وخطؤهم هو سبب الحرب الأهليَّة الثقافيَّة التي تُضعف الغرب وتجعله عرضة لتأثيرات الأديان الأخرى، وفي مقدّمتها الإسلام.
ربما كان الفصل الأخير هو الأكثر إثارة للفكر، إذ أنه يدعو الأوروبيين والأميركيين اليوم إلى فهم تراثهم، وأن يروا أن المسيحيَّة والليبراليَّة الفرديَّة قد تطورتا معا، وأنهما لا يمكن فصلهما. إن الأوروبيين الذين هم ضدّ رجال الدين الذين يحاولون أن تكون الليبراليَّة دون المسيحيَّة، والأميركيين الأصوليين الذين يريدون أن تكون المسيحيَّة بدون الليبراليَّة، كلاهما يخطئ، وخطؤهم هو سبب الحرب الأهليَّة الثقافيَّة التي تُضعف الغرب وتجعله عرضة لتأثيرات الأديان الأخرى، وفي مقدّمتها الإسلام.
افتراضات تأسيسيَّة:
يؤكِّد المؤلّف، في افتراضاته الأساسيَّة، أنّ “الفكر الليبرالي هو نسل المسيحيَّة”، و”الليبراليَّة تتكئ على الافتراضات الأخلاقيَّة التي تُقدّمها المسيحيَّة”. وهذه القيم الأخلاقيَّة هي التي تحتاج لمن يدافع عنها، في أجزاء أخرى من العالم، حيث توجد افتراضات مختلفة عن المجتمع والطريقة، والتي يمكن، أو ينبغي، أن يُوجّهه بها من يفرضون سيطرتهم عليه. وقدَّم تحليلاً استفزازياً لتطوّر فكرة الفرد في المعتقدات الشرقيَّة، في مقاربته لما قدّمته المسيحيَّة من فكر ليبرالي معزّز للفردانيَّة، ممثّلاً لذلك بحجج لا تخلو من موقف أيديولوجي سياسي عن قمع الدولة للطموحات الفرديَّة في الصين، وطرح إشارات خجولة للمقارنة مع الإسلام، وما تَرَسَّخ في الذهن الغربي عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في العالم الإسلامي.
إنَّ اللاهوت الكاثوليكي في القرون الوسطى، لم يكن من المظان الأكثر وضوحاً للبحث عن جذور الليبراليَّة الغربيَّة، وذلك على الرغم من ارتباطها بالفلسفة والقانون المُشَبَّع بقيم الدين، التي، وفقاً للمؤلف، يمكن العثور عليها، أي هذه القيم، في فكرة “المساواة الأخلاقيَّة” بين أفراد البشر. ويُعتقد سيدنتوب أنه من خلال هذا المفهوم تميّز الغرب المسيحي عن بقيَّة العالم، بتوفّره على الشروط الممهّدة، التي أنتجت إيديولوجيَّة ليبراليَّة متديّنة، والتي أخطأت لاحقاً فأعلنت عن نفسها كعلمانيَّة صارخة، متناسية أصولها الكاثوليكيَّة.
وبالرغم من أن عمليَّة البحث في الأصول الفكريَّة لأيَّة قضيَّة إشكاليَّة هي دائماً معضلة، ولا يُستثنى من ذلك فكرة تتبّع فعل النظرة الليبراليَّة للفرد والفردانيَّة، أياً كان المعنى المقصود من مصطلحي الليبراليَّة والفردانيَّة في الواقع، خاصَّة إذا كان هذا التتبّع في مجاهل العصور الوسطى أساساً، كما فعل سيدنتوب. نعم، قفز المؤلف بين حقب متطاولة حتى دخل الحيِّز الخاصّ للقرون اللاحقة، متناولاً كتابات عدد من المفكِّرين المسيحيين؛ القدّيس بولس والمفكر الإنكليزي من القرن الرابع عشر وليام من أكهام، ولكنه لم ينجح تماماً في إثبات أن العصور الوسطى كانت حقبة سعيدة من الفكر الليبرالي، على الرغم من أنه تمكّن من اكتشاف وجهات نظر شاملة عن الباباوات العظماء في القرن الثالث عشر، الذين كانوا الأكثر حزماً في استقلاليتهم عن نفوذ السلطة الزمنيَّة المهيمنة.
مفهوم الفرد:
استهلَّ المؤلف بحثه بدراسة العالم القديم باعتباره عالم الأسر والمدن حيث كانت أثينا مثالا نموذجيّا لهذا العالم، وكانت الحكايات الأفلاطونيَّة عن سقراط مفتاحيَّة لفهمهم لطبيعة المجتمع. وكان الولاء لمدينة أثينا، والهويَّة مرتبطة بها، أو في وقت لاحق، بالإمبراطوريَّة الرومانيَّة، عن طريق الأسرة. ونجد ذلك بوضوح في غرجس أفلاطون، وبروتاجوراس، ومينو، الذين أكَّدوا الولاء لأثينا، وهذا بدوره يقود إلى الولاء للآلهة باعتبارها وسيلة للانتماء، والأسرة باعتبارها الرابطة الملزمة للجميع للارتباط بالدولة المدينة.
لهذا، تركَّز بحث الدكتور سيدنتوب في كتابه “اختراع الفرد” على مفاهيم الفرد والفردانيَّة في المجتمع المسيحي القديم والتحوّلات الفكريَّة التاريخيَّة الباكرة، التي أوجدت أُصول هذه المفاهيم. وقد دَرَسَ بشكل أساسي في أعمال القديس بولس، ورسائله، التي وُجِدَت في العهد الجديد، والقديس أوغسطين ومؤلفه حول “مدينة الله”، ثمَّ اللاهوتيين والفلاسفة في العصور الوسطى، مثل وليام من أكهام، والقدِّيس توما الاكويني، وغيرهما. وسلَّط سيدنتوب الضوء حول كيف أُعتمدت هذه الأعمال المسيحيَّة كمراجع لإيجاد الأساس لليبراليَّة الغربيَّة، والفردانيَّة، والعلمانيَّة، و”جميع الأفكار الجيِّدة”، حسب تقديره.
ولهذا، يُستخلص من قراءة هذا الكتاب أن تطوّر مفهوم الفرد على مدى الألفي سنة الماضية، قد مَرَّ بمراحل مهمَّة، ولكنها وُلِدَتْ ونَمَتْ ورَبَتْ جميعاً داخل الحاضنة الدينيَّة للمسيحيَّة. وتُعبِّر المناقشة، التي ابتدرها سيدنتوب، عن لمحة رائعة من عمليَّة التطوّر تلك. لقد كانت عمليَّة معقَّدة، والانتقال من هويَّة الأسرة والقبيلة إلى القدرة على الحصول على هويَّة الذات، الفرد، وإلى جانب ذلك القدرة على الانتماء للذات، لشخص واحد وفرد تأتي معه العديد من الصفات، ويمثِّل هذا الفرد كذلك الأساس لكثير من نظرياتنا الحاليَّة في العلوم السياسيَّة.
تُعبِّر المناقشة، التي ابتدرها سيدنتوب، عن لمحة رائعة من عمليَّة التطوّر تلك. لقد كانت عمليَّة معقَّدة، والانتقال من هويَّة الأسرة والقبيلة إلى القدرة على الحصول على هويَّة الذات، الفرد، وإلى جانب ذلك القدرة على الانتماء للذات، لشخص واحد وفرد تأتي معه العديد من الصفات، ويمثِّل هذا الفرد كذلك الأساس لكثير من نظرياتنا الحاليَّة في العلوم السياسيَّة.
فضاء الليبراليَّة:
اجتهد أستاذ الفلسفة السياسيَّة بجامعة أوكسفورد الدكتور لاري سيدنتوب في رسم علاقة بين الليبراليَّة والفردانيَّة وجذورهما المسيحيَّة، وشخّص بدقة المعنى المراد من كلٍّ منهما، مركِّزاً على موضوعة “طلب الحريَّة” كمنجز ابستمولوجي لحضور الليبراليَّة اللغوي، في حين يتشكَّل فضاؤها الإصطلاحي من خلال تعبيرات الإيديولوجيَّة التي يستطيع على أساسها الإنسان أن يفعل ما يرغب في فعله من غير مؤثَّرات خارجيَّة، طالما أنه لم يتغوَّل على حريَّة وأمن الآخرين في الفضاء العام، أو داخل حيِّز السياسة، والدين، والثقافة، والاقتصاد.
وهنا، في هذا السرد الكبير، الذي يمتدّ لأكثر من ألف وثمانمائة عام من التاريخ الأوروبي، يرفض سيدنتوب بحزم تقدير الليبراليَّة الغربيَّة المعتاد لذاتها، وادِّعائها لظهورها في مواجهة الدين في بدايات العصر الحديث. إذ نجده يقول إنه بدلاً عن ذلك أن الفكر الليبرالي هو، في الافتراضات الكامنة وراءه، يُعتبر ابناً شرعياً للكنيسة؛ بدءاً من الثورة الأخلاقيَّة في القرون الأولى للميلاد، عندما صيغت مفاهيم حول المساواة وهيئة الإنسان أول مرة من قبل القديس بولس. فقد تتبَّع المؤلف هذه المفاهيم في المسيحيَّة من أوغسطين إلى الفلاسفة والمحامين المشرعين من القرن الرابع عشر إلى أوائل القرن الخامس عشر، وينتهي بعودة ظهورها في العلمانيَّة كآخر هدايا المسيحيَّة للغرب.
ويروي المؤلف كيف أن دوراً جديدًا؛ اجتماعياً عادلاً، للـ”الفرد”، قد نشأ وحَلَّ تدريجياً ادّعاءات الأسرة والقبيلة، والطائفة، كأساس للتنظيم الاجتماعي. إن سيدنتوب يدعو لإعادة التفكير في تطوّر الأفكار التي قام عليها بِناء المجتمعات الغربيَّة والحكومة، ويؤكد أن جوهر ما هو معروف الآن بنظام المعتقدات الغربيَّة قد ظهر في وقت سابق لما نعتقده عادة. إن جذور الليبراليَّة، والإيمان بالحريَّة الفرديَّة، والمساواة الأخلاقيَّة الأساسيَّة للأفراد، في ظل نظام قانوني يقوم على المساواة، وفي شكل تمثيلي للحكومة يليق بمجتمع يتمتَّع الناس فيه بالحريَّة. وكل هذه المفاهيم كانت عبارة عن مبادرات من المفكِّرين المسيحيين في العصور الوسطى، الذين بنوا على الثورة الأخلاقيَّة التي قامت بها الكنيسة في وقت مبكّر. لقد وضع هؤلاء الفلاسفة والمحامون المشرعون الكنسيون، وليس الإنسانيين العلمانيين من عصر النهضة، الأساس لمنظومة الحرّيات الفرديَّة والديمقراطيَّة الليبراليَّة في الغرب.
ملاحظات منهجيَّة:
يجب علينا، للتوسع في قراءة سيدنتوب، أن ننظر بعد ذلك نحو فلاسفة السياسة الذين دمجوا الأفراد في المجتمع، مثلما لاحظ دي توكفيل الحال في أمريكا في حوالي منتصف القرن التاسع عشر، إذ كان هناك رجحان للفردانيَّة. وتلك الفردانيَّة لم تكن من النوع الذي يمقت الروابط الجماعيَّة، بل على العكس تماماً، ولكن الفردانيَّة من النوع الذي يُطالب بالمساواة الفرديَّة في الحقوق والفرص. وهنا، يُمكن الزعم أنه لفهم هذه النظرة العلائقيَّة لدى دي توكفيل ينبغي قراءة تحليله الأمريكي مقروناً مع تحليله للثورة الفرنسيَّة وايرلندا تحت القمع والقهر الإنجليزي. ومن المؤكَّد أن جون لوك كان لديه فهم واضح وقبول بفكرة الفرد عندما وضع مفهومه للملكيَّة. فالنسبة له، كانت هذه الملكيَّة نتيجة لتوفير الفرد لبعضٍ من أشكال العمل، وتحويل ذلك العمل إلى عمليَّة مبادلة، أو مقايضة، مع قيمة الأصل المملوك؛ وهي أنَّ الفرد يمتلك عقاراً، مثلاً، ومن ثمّ، فإن لديه بعض الحقوق.
وهذا الجزء من التحليل، كما يلاحظ المؤلف، قد يكون مزعجاً، لأنه يقفز في مواجهة فكرة مريحة بأن الحريَّة والديمقراطيَّة، مثل العلم الحديث، انبثقت من عصر التنوير في القرن الثامن عشر، وعلى وجه الخصوص، من النضال التنويري ضدّ الكنيسة الرجعيَّة والقمعيَّة. إن الأمر لم يكن كذلك، كما يقول المؤلِّف، بل إن الحريَّة الغربيَّة ترتكز على مفهوم الفرد المسؤول الذي وهبه الله سيادة الضمير والحقوق الأساسيَّة، وأن هذه الفكرة ظهرت، على مراحل، خلال القرون بين بولس الرسول ورجال الكنيسة في العصور الوسطى.
إنَّ المسيحيَّة، كما بشر بها القديس بولس في القرن الأول والقديس أوغسطين في القرن الرابع، وعدت شيئاً مختلفاً تماماً، وثورياً. “في كتابات بولس،” يقول المؤلف، “نرى ظهور شعور جديد بالعدالة، التي تأسست على افتراض المساواة الأخلاقيَّة بدلاً من التركيز على عدم المساواة الطبيعيَّة.” وقد قادت الفكرة المسيحيَّة عن الكرامة الفرديَّة إلى ما نسميه القاعدة الذهبيَّة: عامل الآخرين بما تحب أن يعاملوك به. هذه الفكرة أدرجت مبدأ جديداً للعدالة وقوَّضت فكرة “إعطاء كل ذي حقّ حقّه.” وبعد مرور قرن على بولس، أصبح ممكناً لكاهن كنيسة أن يكتب “فعل القوي فقط”، مما يعني التجسّد، “كان كافيا لإلهنا جلب الحريَّة للإنسان “.
لقد كان من الصعب تغيير الأفكار القديمة عن عدم المساواة الطبيعيَّة، إلا أنَّ المرحلة الأولى من عكس الاتجاه، وفقاً للمؤلف، بدأت في العهد المسيحي الأول، وأنها وصلت مرحة الإثمار بعد تسعة قرون في الإمبراطوريَّة الكارولنجيَّة.[iv] إذ اعتمد حكام الإمبراطوريَّة بشكل كبير على رجال الكنيسة، الذين حملوا شعلة محو الأميَّة وتشجيع النخبة الإمبرياليَّة في الجمع بين العمل العلماني في الحكم مع “معالجة النفوس”، أي رعايَّة واحترام المكانة الأخلاقيَّة للأفراد من المواطنين.
وبدأت المرحلة الثانية من التغيير مع إصلاح الكنيسة التي أطلقها النظام البينديكتي في القرن العاشر،[v] وأنها بلغت ذروتها في ما يسمى بالثورة البابويَّة في القرن الحادي عشر بقيادة سلسلة من الباباوات المتميزين، مثل ليو التاسع وغريغوري السابع، وهدفت هذه الثورة إلى ضمان استقلال البابويَّة. حتى ذلك الوقت، كان الحكام العلمانيون يدعون الحقّ في “استثمار” تعيين الأساقفة، بما في ذلك البابا نفسه، ومن خلال هذه التعيينات يسيّطرون على ممتلكات وقوانين وقرارات الكنيسة. ففي إعلان مشهور، أكد غريغوري أن البابا لا يخضع لاختصاص أي حاكم دنيوي، وأنه لديه الحقّ في عزل الأباطرة، وأنه وحده الذي يمكنه أن يُصدر القوانين العامَّة “وفقا لاحتياجات العصر”.
الخاتمة:
يُعتبر هذا الكتاب مهمّاً لأنه يتضمَّن الكثير جداً من المعلومات. فقد فسَّر الدكتور لاري سيدنتوب في 363 صفحة من النصوص، وأكثر من ثمانين صفحة أخرى من المذكّرات والمؤشّرات، روح الحضارة اليونانيَّة والرومانيَّة القديمة، وكيفيَّة تأثرها بالمسيحيَّة المبكّرة، وكيف أنها تطوّرت لألف سنة خلال العصور الوسطى حتى بلغت المراحل الأولى من الفترة الحديثة. فقد سَلَّطَ سيدنتوب الضوء على ثلاثة أشخاص هم من الأهميَّة بمكان، خاصَّة في مساهمتهم في منشأ وتطوّر الليبراليَّة الفرديَّة الغربيَّة، وهم: القدّيس بولس، والقدّيس أوغسطين، وويليام من أُكهام.
إنَّ الكتاب يُمثِّل حجَّة قويَّة وتقديماً رائعاً بالنسبة للنظريَّة الليبراليَّة، وما سُميَ بـ”اختراع الفرد”، وضمانات حقوقه، مؤكِّداً بالوثائق المرجعيَّة أنَّ مفهوم الفرد لم ينبثق فجأة مع حركة التنوير، ولا من العلمانيَّة، أو الحداثة، بل ولد ونشأ وترعرع ونما في حُضن المسيحيَّة وتحت رعاية رجال الكنيسة، وهو بهذا قد قدَّم حججاً مُبرّرة ومقنعة لصالح الفرد وتعزيز حقوقه الطبيعيَّة والمكتسبة، وأوجد لليبراليَّة الغربيَّة مظلةً أخلاقيَّة ودينيَّة واقية من خواء العلمانيَّة الروحي. ولكنه تَعَمَّد، في الوقت نفسه، أن لا يخلق مفاصلة بين الدين والعلمانيَّة، ويحمي كليهما بمحاولة ربط الفردانيَّة المسيحيَّة مع الأهداف العلمانيَّة في المجتمع الحديث. رغم ما يراه من خطر على النظريَّة السياسيَّة الحديثة من سطوة جمود مذاهب الماضي الدينيَّة، التي تجنَّبت الفرد وبنت على القبيلة. لذا، يُعتبر هذا الكتاب مساهمة قيِّمة لفهم الفرد والفردانيَّة والليبراليَّة بسياج قيميي أخلاقي قديم حديث، ويهيئ العدَّة لوأد نوازع الصراع مع البُنى السياسيَّة المجتمعيَّة التقليديَّة البديلة، التي تُحَقِّر الفرد وتتغوَّل على حقوقه.
إنَّ الكتاب يُمثِّل حجَّة قويَّة وتقديماً رائعاً بالنسبة للنظريَّة الليبراليَّة، وما سُميَ بـ”اختراع الفرد”، وضمانات حقوقه، مؤكِّداً بالوثائق المرجعيَّة أنَّ مفهوم الفرد لم ينبثق فجأة مع حركة التنوير، ولا من العلمانيَّة، أو الحداثة، بل ولد ونشأ وترعرع ونما في حُضن المسيحيَّة وتحت رعاية رجال الكنيسة.

الكتاب: اختراع الفرد: أصول الليبراليَّة الغربيَّة
المؤلف: لاري سيدنتوب
الطابع: مطبعة هارفارد بلكناب، بوسطن، الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2014
اللغة: الانجليزيَّة
الصفحات: 448 صفحة
ISBN-10: 0674417534
ISBN-13: 978-0674417533
[i] أعتبرت طبعة بلنكاب موجهة للقراء في أمريكا والأقاليم المجاورة، أو التي خارج الدائرة الأوربيَّة، وأصدرت دار نشر مطبعة بنغوين في 29 يناير 2015 طبعة من الكتاب خاصة بأوربا.
[ii] مرقيون السينوبي 140 – 160م ، هو ابن أسقف سينوب في إقليم البنطس (على شاطئ البحر الأسود) تأثر بالأفكار الغنوصيَّة بعد أن أصبح غنياً فحرمه والده من الكنيسة، فخرج من سينوب وطاف آسيا الصغرى حتى روما التي منح كنيستها هديَّة ماديَّة قيمة، ونشر تعاليمه وتجمع حوله الكثير من الأتباع فكانت كنيسته الغنوصيَّة أكثر عدداً من جميع الكنائس الغنوصيَّة السوريَّة، وكان معاصرًا لباسيليدس. وقد بدأ مرقيون مسيرته كمسيحي أرثوذكسي لكنه سرعان ما صاغ مذهبًا مميزًا وجذريًّا رفض فيه كلَّ أسفار العهد القديم واعتبرها من عمل العقل الخلاّق الشرّير ولم يحتفظ من العهد الجديد إلاّ بإنجيل لوقا بعد أن غيرّه، وبقسم من رسائل القدّيس بولس، وأدَّى إلى إلقاء الحرمان عليه من قبل كنيسة روما في يوليو 144 م، وهو التاريخ التقليدي لتأسيس الكنيسة المرقيونيَّة.
[iii] ولد دومينيك (1170-1221) في أسبانيا، وبعد الانتهاء من دراسته الجامعيَّة رُسِّمَ كاهناً، وفي الثلاثين من عمره قام بجولة في جنوب شرقي فرنسا، وشهد الحرب الشرسة التي شنها الباباوات ضد ما أسموه هرطقة الألبين. واقتنع دومينيك بأن أسلوب الحوار والتعليم وإعلان الحقائق الإيمانيَّة هو الأسلوب الأمثل لمواجهه التعاليم المنحرفة التي شعر بأنه يجب أن تضع الكنيسة حدًا لها. وطرح فكرة تكوين مجموعة من الوعاظ تجوب البلاد طولا وعرضاً لتعليم الناس الأحوال الإيمانيَّة، لكن البابا انوسنت الثالث تردد في التصريح له بذلك، إلا أنه تمكن من الحصول من البابا هونوريوس الثالث سنة 1216 على تصريح بتأسيس نظام رهباني هو ما عرف بالنظام الدومنيكاني، وإحساساً منه بخطورة مهمة التعليم أقنع دومنيك عدداً من الجامعيين بالانضمام إلى قوافل العمل بهذا النظام. وتميز رهبان هذا النظام بسمو المعرفة والتعمق في العلم، خرج بين صفوفهم رجال عظماء سجل التاريخ أسماءهم مثل توما الاكويني.
وأسس القديس فرنسيس الأسيزي طائفة دينيَّة باسم الفرنسيسكان، ودعا إلى رهبنة الإخوة الأصاغر، تليها مجموعة مثاليَّة من الفقراء، التي تمتلك أي شيء مشترك أو فردي. وبحلول وفاة القديس فرنسيس (1226)، كان النظام قد انتشر من ايطاليا إلى انجلترا، والأرض المقدسة، وجميع أنحاء أوروبا. وكان الفيلسوف وعالم اللغة الإنجليزيَّة روجر بيكون من الفرنسيسكيين، وكذلك الفلاسفة اللاهوتيون، مثل دونس سكوت، وويليام من أوكام. من الفرنسيسكيين المشهورين، وتشمل القائمة القديس انتوني من بادوفا، واثنتان باباوات عصر النهضة؛ سيكستوس الرابع وسيكستوس الخامس، وسيرا جونيبيرو، مؤسس بعثات ولايَّة كاليفورنيا.
[iv] يُستخدم مصطلح الإمبراطوريَّة الكارولينجيَّة أحياناً للإشارة إلى إمبراطوريَّة الفرنجة تحت حكم سلالة الكارولينجيين، الذين أسسوا فرنسا والإمبراطوريَّة الرومانيَّة المقدسة. وقد كان آخر الملوك الكارولنجيين- لويس الرابع، ولوثير الرابع، ولويس الخامس، وبدأت بذلك الأسرة الكابتيَّة التي حكمت مملكة فرنسا إلى عهد الثورة الكبرى.
[v] ولد القديس بنديكت في أسرة لها مكانتها عام 480م، في قريَّة نورسيا بايطاليا، ثم تلقى دراسته الأولى في روما، ونظراً لاحتقاره الدراسات الأدبيَّة في تلك المدينة، قرر بان يكون راهباً، فرحل عن روما ولجا في أول الأمر إلى كهف في سوبياكو سنة 500م، وعاش فيه حياة قاسيَّة تشبه حياة الحيوانات البريَّة، حتى حسبه الرعاة وحشاً غريباً، وفيما بعد اختير القديس بنديكت كرئيس لدير مجاور للكهف الذي كان يعيش فيه، لكنه ما لبث أن تركه، ليعود إلى كهفه حيث كانت البدايَّة للنظام البندكتي الديري، وبدأ المريدون يتوافدون على هذا الكهف ليصنفهم بنديكت إلى جماعات صغيرة تتألف كل منها من اثني عشر راهبا يترأسهم رئيس. وفي سنة 520م انتقل بنديكت وأتباعه إلى هضبة تدعى مونت كاسينو، حيث أسس ديرا أطلق عليه اسم هذه الهضبة، فعرف سنة 529م باسم دير مونت كاسينو. ويقوم الدير البندكتي على أربع قواعد هي: التبادل بمعني عدم الزواج فلا يحق للمنتهي إلى الدير بالزواج. والطهارة بمعنى العفة. ونكران الذات والاستعداد لخدمة الأخر والتضحيَّة من أجله. والطاعة العمياء لرئيس الدير والانصياع لأوامره واجتناب نواهيه بدون نقاش.

