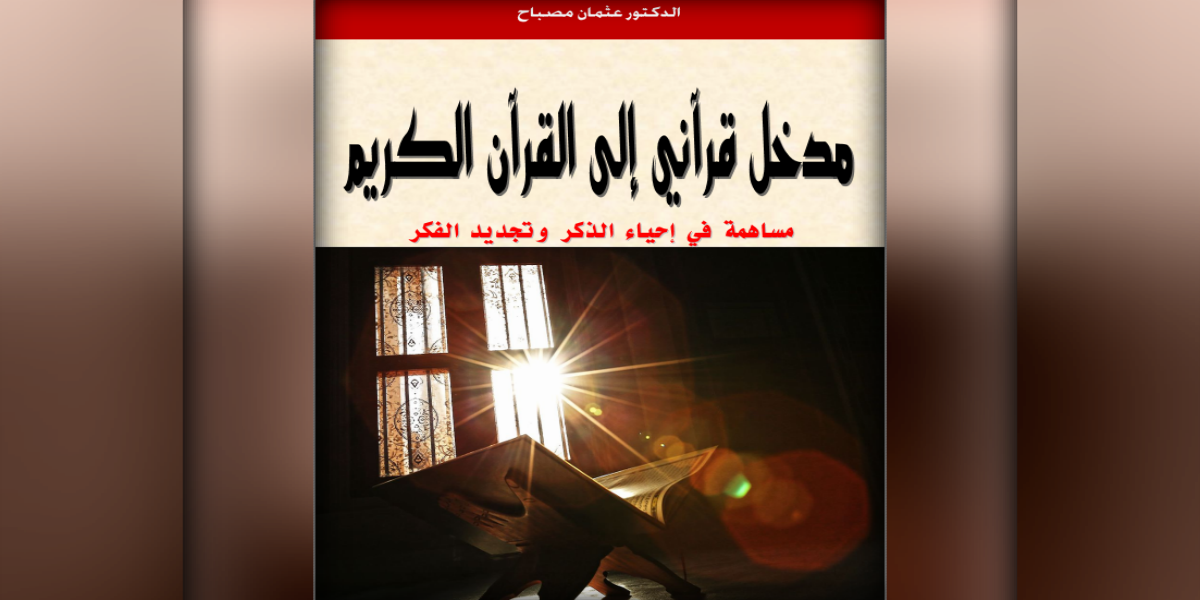
كلمة (قرآني) في عنوان الكتاب نعتٌ يميز به المؤلف مدخله عن نوعين من المداخل، النوع الأول ينتمي إلى التقاليد العلمية التي توارثتها الطوائف الإسلامية عبر تاريخ متطاول، والنوع الثاني من المداخل يستمد من التراث الغربي الحديث باعتباره الصورة المعاصرة للعقل العلمي.
يقول صاحب الكتاب: “بالنسبة إلي فقد تيقنت من خلال تجربتي الدينية والحركية والعلمية أننا في حاجة حيوية إلى مراجعة علمية صارمة تمكننا من الانفصال عما استدبرناه من التاريخ لإعادة الاتصال بالقرآن، اتصالا ليس فيه من شرط موروث إلا شرط القرآن، ولا من شرط مستحدث إلا شرط العصر من حيث ما يتيحه من إمكان”.
ينطلق المؤلف إذن من أن هداية القرآن ليست هداية عملية فحسب، بل هي قبل ذلك هداية منهاجية، تستهدف إعادة تأسيس العقل بالرد إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولأجل الكشف عن أصول هذا المنهاج قرر أن يبحث بحثا قرآنيا في أركان سياق النص القرآني.
ومن هنا جاء الكتاب جوابا على سؤالين كبيرين، فإذا كان القرآن رسالة الرحمن إلى الإنسان، فما حقيقة المتكلم بالقرآن الذي هو الرحمن؟ وما حقيقة المخاطب بالقرآن الذي هو الإنسان؟
أولا- المتكلم بالقرآن وهو الرحمن
هكذا عنون المؤلف الباب الأول حيث جعل سورة الفاتحة مجالا لاستنباطاته باعتبارها المعادل المعنوي للقرآن الكريم: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87]
فنظام الفاتحة يمكن اعتباره تمثيلا مجملا لنظام القرآن، وبناء عليه قرر أن نظام المعاني في الفضاء القرآني نظام هرمي مشدود كله إلى كلمة واحدة هي (الحمد)، الحمد باعتباره الأفق الأعلى للكمال، حيث يتطابق المعقول الفطري للحُسن مع الخبر القرآني الواصف للذات الإلهية وصف ثناء وتمجيد.
القرآن الكريم كتاب يسبح كله بحمد الله، كل مضامينه العلمية والعملية موجبة للحمد، فأسماء الله وصفاته القرآنية تفيد الحُسن بصيغة المبالغة، والخَلق والأمر كما يستعرضهما القرآن شاهدان على ذلك.
ونظام المعاني في القرآن يتوج المحامد الإلهية بصفة الرحمة، فيجعلها الغاية من الخلق، كما يجعلها الغاية من الأمر: {طه. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [طه: 1-8]
على هذا المنوال يشكل القرآن وعي قارئه المهتدي بهدايته، ليكون كدحه الدنيوي أسهل كدح تسمح به الشروط التاريخية، لينتج أحسنَ صورة للإسلام وأليقَها بالعصر، صورة جامعة بين الخير الأبقى والوقاية من مهالك الآخرة والأولى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الزمر: 55]، ولا معنى للحُسن إلا مراعاة المناسبات النفسية والاجتماعية والتاريخية، وتلك هي الحكمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لأمته.
ومن أكثر الفصول إثارة في هذا الباب الفصل الذي أداره المؤلف على بيان أن الابتلاء امتحان في الحمد، وأنه بدأ في الملأ الأعلى، فكان أول مبتلى في الحمد الملائكة والجن، وذلك حين أعلن الله عن خلافة الإنسان.
فكانت الملائكة تظن أن حمدها هو الحمد الأتم، وأن آدم ليس أهلا للخلافة لأنه ليس له علم كعلمهم بمن له الخلق والأمر، فكيف يكون خليفته، فإذا مُكن في الأرض وهو على هذه الحال فسوف يكون شر مخلوق عليها، وأما إبليس فكان يرى أن الحمد يوجب استخلافه دون آدم، لأنه مخلوق من نار، والنار أفضل من الطين.
فلما امتحنهم بالأسماء كلها ظهر فضل آدم، وسر اصطفائه للخلافة، لأنه لا سبيل لملك ولا جن ولا إنس إلى المعرفة بالله إلا عبر الأسماء، فصححت الملائكة حينئذ مقامها في الحمد بقولها: {سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [البقرة: 32]، فلما أمروا بالسجود لآدم ظهر فضل الملائكة على إبليس الذي أبى واستكبر، وكان من الكافرين، أي من الطاعنين في حمد الله المقتضي لكمال قضائه.
وخلاصة هذا الباب يمكن التعبير عنها بالقول إن الصورة الذهنية التي تشكلها العقائد عن الله تستلزم حمل كلامه على ما يتوافق مع تلك الصورة، وباختلاف الصور يختلف الحمل، فتختلف القراءات، مع أن المقروء واحد، والمخرج من هذا المأزق هو القراءة المسبحة بحمد الله حمدا يوافق ثناء الله على نفسه في كتابه العزيز.
ثانيا- المخاطب بالقرآن وهو الإنسان
إذا كانت حقيقة المتكلم بالقرآن قد كشفت عنها قاعدة الحمد المهيمنة على نظام المعاني في الفضاء القرآني، فإن حقيقة المخاطب بالقرآن حسب المؤلف لن تنكشف إلا بالوقوف على ما يقرره القرآن في معنى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
ويؤكد صاحب الكتاب على أن مفهوم الفطرة كما هو شأن أي مفهوم قرآني آخر لا يتوقف على أي بيان خارجي، إذ “ما ذُكر شيء في القرآن يحتاج إلى بيان قوليٍّ إلا وفي القرآن بيانُه”، مصداقا لقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]
وبعد استقراء مادة (فطر) في القرآن، والوقوف على سياقاتها المتنوعة خلص المؤلف إلى أن الفَطْر هو اللحظة التي اجتمعت فيها شروط البدء في تاريخ الخلق، ولا يتعلق هذا المفهوم في القرآن إلا بموضوعين: بالسماوات والأرض من جهة، وبالإنسان من جهة ثانية.
أما ما فطر الله عليه السماوات والأرض فيتمثل في أمرين، أولهما الانتصاب لابتلاء الناس عبر أدوار استخلافية، وثانيهما الدلالة على الله والشهادة لما جاءت به الرسل. وهذان الأمران يستتبعان أمرين آخرين هما: قابلية الارتفاق والتوسل، وقابلية الفهم والتعقل.
وأما فطرة الإنسان فهي ما ابتدأ الله عليه الناس خلقا وتعليما من أجل النهوض بخلافة الأرض، وهذا التعريف يجعل مفهوم الفطرة مركبا من عدة مفردات ابتداء من خلق آدم من طين، ومرورا بتسويته، والنفخ فيه من روح الله، وتعليمه الأسماء كلها، وابتلائه في الجنة، وإهباطه منها، ونشأة الأمة الأولى.
والجهود الفكرية في هذا الباب انصرف معظمها إلى تبديد الأوهام التي شوهت حقيقة الإنسان، وصارت جزء من الدين المتوارث، ومن ذلك مسألة الروح، وحقيقة النفس، وسبب الحياة، والفرق بين الموت والوفاة، وفطرة المولود، وحقيقة المشترك الإنساني.
انتهى المؤلف من كل ذلك إلى أن الإنسان ليس مزدوج الكيان، ولا هو معتقل في بدنه، بل هو مخلوق طيني فحسب، يحمل أسراره في قلبه، وعليه يكن مطالبا شرعا بالتخلص من رق الطين لكي يكون عبدا لرب العالمين كما ادعى العرفان الإسلامي.
أعظم سر إنساني هو سر الإرادة، فما من إنسان ينشأ في مجتمع بشري، إلا ويجد في قلبه إرادة لشيء ليس كمثله شيء، وهو أعظم من كل شيء، وهذا السر هو الذي يفسر السعي المحموم للإنسان من أجل امتلاك ما يزيد عن حاجته زيادة لا يتصور لها نهاية، وإذا تأملت وجدته يبحث عما ليس في هذه الدنيا، يبحث عن الله من حيث لا يدري، وهاهنا يتدخل العلم المنزل مستفيدا من بقايا الفطرة ليعين للإنسان وجهته الحقيقية، وهاهنا تلتقي قاعدة الحمد بقاعدة الفطرة لقاء محبة وسلام.
أخيرا:
يقول المؤلف في خاتمته: “بنينا جملة هذا الكتاب على أن الخطاب لا يكشف عن حقيقته … إلا بتحصيل المعرفة الصحيحة بالمتكلم والمخاطب، فإذا لم تحصل اضطربت الأفهام، لتوارد الاحتمالات بلا ضابط، فيفقد الخطاب وظيفته البيانية، ويتعرض للعزل الصريح أو المقنع.
وهذا الخطاب إذا كان بيانا مرجعيا لأمة ما، فعُطل سياقه الحالي قصدا أو خطأ، ظهرت في النظام الفكري للأمة ثغرات تقتحم منها الأهواء، فتقع الخصومات، وتتفرق إلى أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون.
والقرآن كأي خطاب تجري عليه هذه السنة، ولهذا اقترحنا أن يكون مدخلنا إليه تعريفا بالملقي وهو الرحمن، وبالمتلقي وهو الإنسان، تعريفا قرآنيا، وهذا ما سيمهد لنا الكلام تمهيدا للحديث عن الخصائص البيانية للقرآن، تلك التي جعلته بيانا حاكما في اختلاف الناس حُكما يقع به الفصل، ويفيد الهداية على نمط معجز خالد متجدد الأمجاد”.

